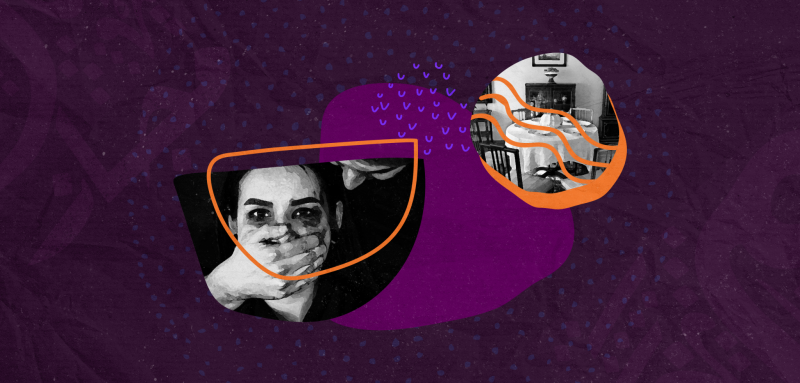الحميم، البيوت التي نسكنها فتسكننا
الحميم، البيوت التي نسكنها فتسكننا
يرى فوكو أن الغرض من المراقبة المستمرة ليس تخويف السجناء الذين يفكرون في الفرار، بل إجبارهم على الخضوع. ويستعيد في كتابه مخطط الفيلسوف الإنجليزي الأخلاقي جيرمي بنثام الذي اقترح بناء سجن شديد المراقبة تحت اسم "بانوبتيكون" وهو سجن مصمم لكسر روح السجين وإرادته. توضع الزنازين مباشرة في مواجهة برج المراقبة، مع إضاءة مستمرة مُسلّطة على الزنزانة بحيث يمكن لأي شخص في البرج مراقبة المساجين داخلها بصورة مستمرة. لا يستولي السجان هنا على الأجساد فحسب، ولكنه كسر للإرادة والروح يجعل السجين خاضعاً نفسياً وجسدياً لسلطة السجن. لكن هل يمكن أن يتحول البيت إلى سجن؟ البيت الذي يحمل ذكرياتنا ونلجأ إليه ويعتبر بالنسبة لنا رمز للألفة والحماية والدفء، أيا كان هذا البيت، كوخاً أو كهفاً أو قصراً.
تفاصيل مبعثرة
أتساءل الآن عن معنى البيت وأنا أنظر إلى أركان غرفتي ذات الطلاء الأبيض والستائر التركواز والسجاجيد الوردية. ملابسي معلقة على الشماعة الخشبية. روب وردي بقلوب رمادية، جلابية زرقاء طويلة، روب وردي بدببة بيضاء خاص بصغيرتي. فراشي الشعر متناثرة على التسريحة، بجوار زجاجات العطور، مزيلات العرق ومرطبات الوجه واليدين، بالإضافة إلى ملزمة من الورق لرواية أترجمها منذ ما يقرب من العام. ألعاب الصغار متناثرة في الصالة الصغيرة ذات الأرائك الحمراء. قطع البازل على الارض، الدمى نائمة على الأرائك. الألوان وأوراق الرسم مرتبة فوق الطاولة، وشجرة الكريسماس تومض برتابة لطيفة بجوار المدفأة، مع رائحة البخور الباقية من الصباح. هذا هو معنى البيت بالنسبة لي في هذه اللحظة. لا أعرف هل يتغير معنى البيت بالنسبة لكل شخص أم لا؟
قبل الزواج كان معنى البيت هو بيت أمي. غرفتي الصغيرة وألواني وستاند الرسم واللوحات المسنودة على الجدار. التلفاز الصغير، البطانية الحمراء التي ألفّ نفسي بها في الشتاء البارد. أي كان معنى البيت فهو مرادف للراحة والأمان والسكون وهو ما افتقدته في منزلي لسنوات.
دائما ما كنت تحت المراقبة. هاتفي مراقب، كتابتي مراقبة، رسائلي مراقبة. كل ما أفعله تحت المراقبة، حتى صدقت أن من حقوق الزوج مراقبة زوجته باستمرار. نسيت معنى الحرية والخصوصية... مجاز في رصيف22
أفكر: هل البيت مكان أم شعور أم فكرة أم شخص؟ أشعر بالبيت وأراه كمعنى ذاتي. فهو لا يقتصر على مكان واحد، بل يمكن اعتباره موطناً نفسياً للشخص، ليس مجرد هيكل مادي، لكنه مفهوم يختلف باختلاف الأشخاص. البيت كمكان نسكن فيه، أو مكان ننتمي إليه. المنزل امتداد للفرد، ملاذ ومساحة آمنة، ومعنى عاطفي عميق يحتمي فيه الشخص من الضغوط الخارجية، ويشعر بالحرية والاستقلال والأمان.
في بعض الأحيان لا يشعر الناس بالانتماء إلى بيوتهم، ولا يرتبطون بها عاطفياً، حتى عندما يعيشون فيها لفترات طويلة. الرغبة في الحصول على مكان ننتمي إليه جزء من الطبيعة البشرية. اختيار تفاصيل البيت وألوانه وأثاثه ورائحته، ليست رفاهية بقدر ما هي رغبة في الخصوصية والانتماء إلى مكان بعينه بكامل تفاصيله. أحيانا يفقد البيت معناه، ونفقد مشاعر الدفء فيه، بل الأسوأ من ذلك أن نشعر بداخله بالغربة والوحشة ونفتقد الشعور بالأمان داخله.
لسنوات كان البيت يمثل لي مكاناً أقرب إلى السجن المعنوي. لا يوجد به ركن واحد يخصني وحدي. لن أقول غرفة لأنه كان حلماً أقرب إلى الخيال. كل شيء كان أهم مني. السفرة التي لا ندخلها أبداً إلا عند استقبال ضيوف كانت أهم مني. لا يمكن الاستغناء عنها ولا عن كراسيها ولا عن النيش وما بداخله، لكن يمكنني بالتأكيد تجاهل رغبتي في مكان صغير يخصني، لأجل أن تكتمل الصورة الاجتماعية المثالية لمنزل بغرفة سفرة لا يدخلها أحد.
اعتدنا في ثقافتنا العربية أن تتغاضى المرأة عن رغباتها وحقوقها وأحلامها "عشان المركب تمشي". مع استمرار التغاضي والتنازل عن الحقوق، يصبح كل ما تقدمه حقاً مكتسباً لا يمكن استعادته. بمرور الوقت يشعرها كل من حولها بالذنب إذا فكرت في نفسها أو رغباتها. يرسخ كل من حولها شعورها بالذنب، حتى يتحول إلى غمامة تمنعها من الحياة، من الاستمتاع، من التفكير حتى في أحلامها المهدرة وحريتها المسلوبة وتقبل كل محاولات إخضاعها لأجل بقاء البيت.
سنوات من المراقبة
دائماً ما كنت تحت المراقبة. هاتفي مراقب، كتابتي مراقبة، رسائلي مراقبة. كل ما أفعله تحت المراقبة، وله تأويلات أكبر مما يحتمل الفعل. حدث معي تماماً ما يحدث مع السجناء عند وضعهم تحت المراقبة المستمرة. فقدان الهوية وفقدان تقدير الذات نتيجة الوقوف الدائم في وضع الدفاع عن النفس. شعور عميق بالإهانة نتيجة المراقبة المستمرة، ومحاولات لإقناع نفسي بأن الأمر لا يستحق الغضب، حتى صدقت أن من حقوق الزوج مراقبة زوجته باستمرار. نسيت معنى الحرية والخصوصية.
لسنوات لم أكن أعرف أنني امرأة مُعنّفة. أقول لنفسي: "لا. كل ما في الأمر اختلاف في وجهات النظر". أحمّل نفسي المسؤولية كاملة. أقول: "ربما أستفز مشاعر الغضب بعصبيتي وصوتي العالي. أو ربما هي غيرة الرجال". أوقات كثيرة لم أكن أصدق نفسي ولا أرغب في الاعتراف بالإساءة والعنف. يسألوني: "بيضربك؟" أقول: "لا. أبداً".
أين العنف إذن؟ أوقات أخرى كنت أنا أرفض دور الضحية ولا أريد أن أتلبسه أمام نفسي. أقول لنفسي: "لا. الضحايا ضعفاء. أنت لست ضحية. أنت امرأة متحققة وقوية". كنت أخشى الاعتراف بكل الظلم الواقع علي تحت دعاوى الزواج والأمومة والقوامة والحفاظ على البيت. أقول لنفسي: "نعم، أنت امرأة سيئة وأم سيئة". يتعاظم الشعور بالذنب داخلي حتى يبتلع كل لحظة سعادة، وكل إنجاز شخصي أحققه. كلما أثقلك أقرب الناس لك بالشعور بالذنب، كلما يترسخ داخلك أنك شخص سيء وكلما كبر شعور الخزي.
سنوات من حساب النفس، والقلق، والأرق والنظرة السلبية للذات. سنوات من الكآبة والاكتئاب، ورفض الذهاب إلى الطبيب النفسي. كلما رغبت في زيارة الطبيب النفسي لا أجد سوى جملة واحدة: "ماذا ينقصك لتشعري بالاكتئاب؟"، لديك منزل وزوج و أبناء. حياة تبدو مثالية تبحث عنها الكثيرات. لكنني لا أجد نفسي. الصراع بين ما أرغب به وما يفرضه علي المجتمع، يستعر بداخلي. الهوة كبيرة بين رغبتي في التحقق ومشاعر الذنب التي تلتهمني.
لم أجد طريقة للدفاع عن نفسي سوى البذاءة. ماذا تساوي البذاءة في وجه الكذب وفي وجه التسلط والألم. كان زوجي يكرة بذاءتي، ويتأفف من ألفاظي عندما أغضب. يقول لي: "بلاش قلة أدب"... مجاز في رصيف22
لم أجد طريقة للدفاع عن نفسي سوى البذاءة. ماذا تساوي البذاءة في وجه الكذب وفي وجه التسلط والألم. كان زوجي يكرة بذاءتي، ويتأفف من ألفاظي عندما أغضب. يقول لي: "بلاش قلة أدب". أغرس وردة حمراء في شعري، يقطفها. أكتب جملة، يمحوها. أضحك، يخرسني. أبكي، يسخر مني. يبتسم فقط في الصور الفوتوغرافية ليصفق الجميع للصورة المثالية. البذاءة لا تسكت ولا تخشى. البذاءة بصقة في وجه الجميع. في وجه الزوج والمعارف والجيران. بصقة في وجه التسلط و المثالية الزائفة. البذاءة بداية استعادة الذات والتمسك بها. البذاءة جزء من التحرر من القمع والقدرة على التعبير عن الغضب.
في مرة أخبرني أنني سأموت وحيدة، ولن يمشي في جنازتي أحد. لسنوات صدقت أنني سأموت وحيدة. يبدو أنها كانت رغبته أكثر من كونها حقيقة. تقول أمي: "الزن على الودان أمرّ من السحر"، وأنا صدقت أنني امرأة سيئة لا تستحق الحب ولا الأصدقاء، ولا أفعل ما يستحق الثناء. هناك وصفة واحدة لا تخيب لإفقاد شخص ما الثقة في نفسه: أخبره دائماً أنه لا يستحق وسوف يصدق في نهاية الأمر. لولا تلك الذكريات الصغيرة التي أهدتها لي الحياة لبقيت دائماً في ذلك القفص المسمّى "عدم الاستحقاق".
صديقة بعيدة تذكرني بأغنية، وأخرى تتذكرني كلما فارت منها القهوة وتبتسم. يتذكرني صديق عندما يشاهد الأفلام الإيطالية. يقول لي ذوقك في الملابس يشبه الذوق الإيطالي. صديق مقرب يقول لي دائماً إنه يثق في قدرتي على النجاح وإنهاء المهام طالما بدأتها. ذات مرة عانقتني امرأة سويدية بعدما أنهيت قراءة قصيدة باللغة العربية. قالت لي بالإنجليزية: "لم أفهم شيئاً ولكنني أحببت طريقتك". تأثرت حتى البكاء. في المترو أهدتني امرأة سويدية ثملة وردة حمراء، وقالت لي: "وردة لأجل عيونك الجميلة".
هدية الأربعين
أتحرّر الآن من ذلك القفص. أنظر إلى نفسي و بيتي واستعيد تفاصيله كوطن تم احتلاله لسنوات. أقف أمام المرآة وأتأمل الخطوط الرفيعة حول عيني. أنظر لوجهي الشاحب بامتنان لأنني قررت استعادة نفسي، رغم سنوات من الخضوع التام. في عمر الأربعين لم أعد بحاجة إلى مزيد من الصراعات ولا الجدل حول ما يحق لي أن أفعل وما لا يحق لي. اعتقدت دائماً أن الأربعين هو عمر السلام والهدوء، العمر الذي أعرف فيه ماذا سأفعل في السنوات المقبلة دون قلق أو خوف أو توجيه من أي شخص أي كان. هديتي لنفسي في عمر الأربعين كانت استعادة نفسي ومصالحتها، مثل طفل ابتعد عن حضن أمه وعاد لها من جديد.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.