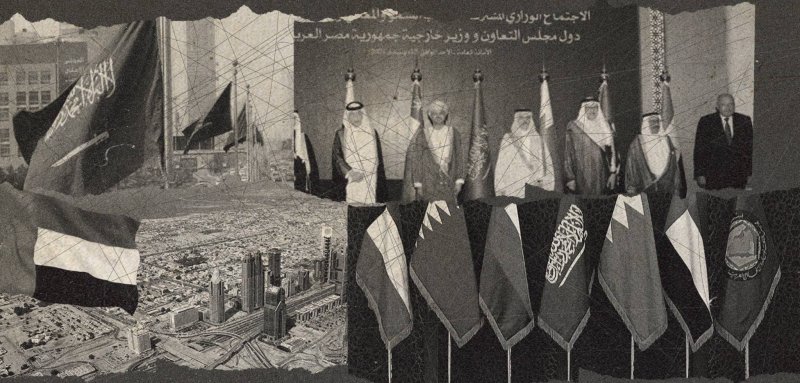"الهدف النهائي هو امتلاك أكبر قدر من الهيمنة، لأن الهيمنة وحدها هي طريق البقاء، والقوة هي الضامن الوحيد للأمان. ومزيد من القوة يعني مزيداً من الأمان" (جون ميرشايمر، مأساة سياسة القوى العظمى).
في 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عُقدت قمة مجلس التعاون الخليجي الـ42 في الرياض، في قمة تغيّب عنها ولي عهد أبوظبي، الحاكم الفعلي للإمارات، الشيخ محمد بن زايد.
لم يحضر بن زايد إلى الرياض، على الرغم من أنه كان قد استقبل قبل موعد القمة بيوم واحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في ما يبدو أنه يعكس قراءة جديدة للجغرافيا السياسية الإماراتية، يَظهر فيها الطريق إلى تل أبيب أقرب منه إلى "الشقيقة الكبرى".
ربما أرادت الإمارات إرسال رسالة واضحة تُقرأ بالفارسية والتركية والعبرية، مفادها أن أولوياتها الأمنية تُرسَم خارج نطاق البيت الخليجي، وأن ترتيباتها الأمنية لا تشرك فيها بالضرورة شركاء النسب والدم.
وقد سبق اللقاء الإماراتي-الإسرائيلي لقاءين آخرين ينبئان بسياسة جديدة للإمارات، وهي سياسة خفض التصعيد مع كلٍّ من إيران وتركيا. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، زار بن زايد تركيا، ثم قام مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد بزيارة إيران.
وفي مقابل خفض التصعيد مع تركيا وإيران، والتحالف مع إسرائيل، تتجه الإمارات إلى تبريد العلاقات مع محيطها العربي، بما في ذلك السعودية نفسها، بعيداً عن الدخول في مواجهات وصدامات تعود بالعلاقة إلى مرحلة كان يغلب عليها التنافس، لا التعاون.
ذهبت سكرة التنسيق المشترك إذاً، وبقيت فكرة الخلاف القديم، ذلك الخلاف الذي طفا فوق السطح، وأعاد التنافس الخفيّ داخل البيت الخليجي. فما سرّ هذا التنافس؟ وما هي جذوره التاريخية؟
الأرض مقابل الاعتراف
يرجع التنافس الإماراتي السعودي إلى مرحلة ما قبل تأسيس الاتحاد الإماراتي ذاته، وهي مرحلة أنتجت مرارة تاريخية لا تزال تشكّل أحد أبعاد العلاقة بين البلدين، إلى يومنا هذا.
ويعود الصراع إلى خلاف جرى عام 1949، وتطور إلى حرب محدودة في خمسينيات القرن الماضي، حول تبعية واحة البريمي الغنية بالنفط. ففي عام 1949، تصاعد الخلاف بين السعودية من جهة، وعُمان وإمارات الساحل المتصالح التي شكلت في ما بعد الاتحاد الإماراتي، من جهة أخرى، حول هذه الواحة.
حينها، ادّعت السعودية ملكيتها للواحة وما حولها من أراضٍ غنية بالنفط. وقام الجيولوجيون التابعون للشركة العربية الأمريكية للنفط (أرامكو)، باجتياز الحدود السعودية المرسّمة عام 1935، وفقاً لما عُرف باتفاق "خط الرياض" الذي يقسّم الحدود بين السعودية وعُمان وإمارات الساحل المتصالح، للتنقيب عن النفط.
وحاولت السعودية استمالة القبائل في المنطقة، وفي كانون الثاني/ يناير من عام 1952، جرّدت حملة مسلّحة للسيطرة على المنطقة، في ما عُرف تاريخياً بـ"غزوة حماسة"، نسبة إلى واحدة من قرى الواحة الثلاث، ثم وقعت أحداث عسكرية أخرى، إلى أن رست الأمور على تقسيم بريطانيا للمنطقة بين عُمان وإمارات الساحل المتصالح.
عام 1952، جرّدت السعودية حملة مسلّحة للسيطرة على منطقة البريمي المتنازَع عليها، في ما عُرف تاريخياً بـ"غزوة حماسة"، ثم وقعت أحداث عسكرية أخرى، إلى أن رست الأمور على تقسيم بريطانيا للمنطقة بين عُمان وإمارات الساحل المتصالح
بعد إعلان الاتحاد الجديد للإمارات، عام 1971، امتنعت السعودية عن الاعتراف بالدولة الوليدة، وامتنعت عن التعامل مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كرئيس لإمارات الساحل المتصالح، التي تغيّر اسمها إلى الإمارات العربية المتحدة. استخدمت السعودية الاعتراف السياسي بالدولة الوليدة كورقة ضغط على الشيخ زايد، لإجباره على القبول بالتفاوض حول الأراضي المتنازع عليها.
كان الشيخ زايد في حاجة ماسة إلى الاعتراف السياسي به، والتعاون مع السعودية، فوافق على شروط الملك فيصل للدخول في مفاوضات لحل النزاع الحدودي، مقابل الاعتراف.
وكان الملك فيصل مرتبطاً نفسياً بقضية النزاع الحدودي قبل عام 1974، إبان عمله وزيراً للخارجية في عهد والده الملك عبد العزيز. وشعر بأن استعادة أراضٍ في منطقة البريمي ستكون انتصاراً شخصياً له.
في كتابه "تأسيس الإمارات العربية المتحدة 1950-1985"، كتب السياسي والإعلامي الإماراتي الدكتور عبد الله عمران تريم: "قال الملك فيصل لوفد الإمارات الذي زاره في الطائف، في تموز/ يوليو 1972، إن السعودية تعرضت للإهانة في البريمي، وإنه سيتعيّن عليها استرداد حقوقها، متعهداً بعدم التخلي عن ممتلكات ورثتها بلاده من الآباء والأجداد".
في 21 آب/ أغسطس 1974، تمت تسوية بين الشيخ زايد والملك فيصل على ترسيم الحدود بين إمارة أبوظبي والسعودية، وأعلنت الأخيرة على الفور الاعتراف بجارتها الجديدة، وأرسلت سفيراً لها إلى أبوظبي.
بموجب هذه التسوية، ذهبت ملكية حقل شيبة إلى السعودية، وهو الحقل الذي وصفته صحيفة الغارديان البريطانية بأنه أقرب ما يكون إلى منجم ذهب، إذ يضخّ يومياً 750 ألف برميل من النفط الخام عالي الجودة، وقد يصل إنتاجه إلى مليون برميل.
لم تنهِ هذه الاتفاقية النزاع، بل أرجأته، وحملته لأجيال قادمة. تدّعي الإمارات أنه تم تغيير الاتفاق الشفهي لمشاركة الحقل بين البلدين، وأن حكومتها لم تلاحظ هذا التناقض حتى عام 1975، نتيجة غياب المحامين والفنيين والجغرافيين عن فريق التفاوض الخاص بها.
وبالنتيجة، لم تصادق الإمارات على الاتفاقية، بل إن حكومتها فتحت القضية علناً عام 2004، بعد وفاة الشيخ زايد، وانتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.
أعاد الشيخ خليفة الحديث عما جرى عدّه اتفاقيةً مجحفةً لبلاده، خلال أول زيارة دولة له إلى الرياض، كرئيس للدولة. وفي عام 2006، نشرت الإمارات خرائط حدودية تظهر فيها الأراضي المتنازع عليها داخل الحدود الإماراتية. وردّت السعودية بغلق مؤقت للحدود، في إشارة إلى القدرات العقابية التي تمتلكها، وهي الحقيقة التي لطالما أغضبت المسؤولين الإماراتيين، إذ يسود تصور بينهم مفاده أن السعودية تستغل وزنها السياسي والجغرافي، والحقائق الديموغرافية في المنطقة، لفرض إرادتها، وممارسة سياسات هيمنة في الإقليم، ما خلق ما يمكن أن نسميه بعقدة الشقيقة الكبرى، وهي العقدة التي دفعت المسؤولين الإماراتيين للبحث عن بدائل، لموازنة الكفّة المختلة لصالح السعودية، والظهور كقوة إقليمية تواجه تطلعاتها.
العاصمة الاقتصادية
تطلعت الإمارات إلى أن توازن الهيمنة السياسية السعودية بهيمنة أو ريادة اقتصادية، وأن تكون مركزاً مالياً كبيراً للمنطقة كلها. كان مشروع الوحدة النقدية، والبنك الخليجي المركزي فرصةً لأبوظبي لتقديم نفسها على أنها عاصمة الخليج الاقتصادية، في مقابل العاصمة السياسية "الرياض".
كان هذا إلى حد كبير ترضية مناسبة للإمارات. أطلقت الإمارات حملة لإقناع الدول الخليجية الست بالموافقة على استضافتها للبنك المركزي الخليجي الموحّد. وفي عام 2004، تقرر أن تكون أبوظبي مقر البنك المزمع إنشاؤه، مع خطط لعملة خليجية موحدة.
كان الشيخ زايد في حاجة ماسة إلى الاعتراف السياسي به، والتعاون مع السعودية، فوافق على شروط الملك فيصل للدخول في مفاوضات لحل النزاع الحدودي بين البلدين
لكنّ رياح الرياض هبّت من جديد، وعطلت الخطط الإماراتية، وتم تغيير القرار في أيار/ مايو 2007، واختيار الرياض مقراً للبنك الخليجي المركزي، ما أثار غضب الإمارات من السياسات السعودية، فانسحبت من مشروع العملة الموحدة والبنك المركزي، موجهةً ضربةً إلى المشروع أدت إلى تأجيله حتى أجل غير مسمى. ما جرى وصفه مراقبون بأنه "صدام الأيغوهات" حول كيفية صناعة السياسات في المنطقة.
ازداد الانقسام حول السياسات المشتركة مع مشروع الطاقة النووية الخليجي. فعام 2006، أُطلقت مبادرة الطاقة الخليجية حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية بشكل مشترك، واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على التعاون بشأن دراسة جدوى لبرنامج إقليمي للطاقة النووية، وتحلية المياه.
مرةً أخرى، رأت الإمارات في المشروع تعزيزاً للهيمنة الاقتصادية والسياسية للرياض. وفي خطوة مفاجأة، قررت أن تمضي في مشروع نووي خاص من دون تنسيق مع السعودية. وفي نيسان/ أبريل 2008، نشرت الإمارات خطة سياستها المستقلة للطاقة النووية، وأنشأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي، ودعت إلى تقديم عطاءات، عام 2009، لبناء أول محطة للطاقة النووية في الرويس.
ومؤخراً، صعّدت السعودية من جهودها لتقويض خطط الإمارات لأن تكون مركزاً اقتصادياً للمنطقة، بعد قرارها، في شباط/ فبراير 2021، عدم توقيع أي عقود مع أي شركة لا يكون مركزها الإقليمي الرئيسي في السعودية، في قرار يرى مراقبون أنه يستهدف دبي، المركز الإقليمي النشط للمال والأعمال.
وفي خطوة تصعيدية جديدة، رفعت السعودية في تموز/ يوليو 2021، الرسوم الجمركية على السلع المصنَّعة في المناطق الحرة، أو التي يدخل فيها منتج إسرائيلي، في خطوة جديدة من سلسلة خطوات لزيادة الضغوط على خطط الإمارات، ومشروع الهيمنة الاقتصادية الذي تستهدفه، الأمر الذي زاد من غضبها.
كان تراكم الغضب ينبئ برد انتقامي إماراتي، وكانت ساحة الانفجار هذه المرة منظمة الدول المصدرة للنفط، "أوبك"، إذ رفضت الإمارات في تموز/ يوليو 2021، خطة المجموعة التي حاولت السعودية وروسيا تمريرها للتحكم في سعر النفط، وتقوم على أساس زيادة قليلة نسبياً للإنتاج لا تتجاوز 400 ألف برميل يومياً كل شهر، حتى نهاية 2022.
طالبت أبوظبي بزيادة مقدارها 700 ألف برميل، ورفضت الاقتراح السعودي، ما أدى إلى عرقلة أي اتفاق لتحديد سقف للإنتاج، للحفاظ على سعر النفط.
كانت الإمارات مدفوعةً بمصالح اقتصادية لتمويل مشاريعها التوسعية خارج حدودها، والطريق البحري بين الخليج العربي وقناة السويس مروراً بباب المندب وغرب المحيط الهندي. كما كانت أيضاً مدفوعةً برغبتها في إيصال رسالة إلى السعودية مفادها أنها أيضاً لديها وسائل عقابية مضادة.
أحلام إسبرطة
يسكن العقل الإستراتيجي الإماراتي هاجس الفراغ الأمني الذي خلقه الانسحاب الأمني الأمريكي من الشرق الأوسط. تعززت هذه المخاوف بعد امتناع الولايات المتحدة عن معاقبة إيران، بعد الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو السعودية، في أيلول/ سبتمبر 2019، ومع الهجمات والأنشطة العدوانية الإيرانية ضد السفن الإماراتية والدولية في خليج عمان، وحول مضيق هرمز.
كما أن الإمارات كانت قد استقبلت الربيع العربي كتهديد وجودي يهدد وحدة الدولة، إذا ما انتقلت العدوى إلى أراضيها. وأيضاً، كان موقف الولايات المتحدة من أنظمة حليفة تركتها تسقط بعد الغضب الشعبي ضدها، حافزاً آخر للإمارات لكي تنشط في بناء قوة عسكرية هجومية تخرج خارج الحدود، وتحافظ على مصالحها الاقتصادية، وتطارد أعداءها، وتؤسس قواعد عسكرية وتحالفات عابرة للحدود، ما جعل البعض يصفها بإسبرطة الصغيرة، في إشارة إلى المدينة اليونانية القديمة التي كانت قوتها العسكرية أكبر من وزنها السياسي والديموغرافي، وهو وصف كان أول مَن أطلقه عليها جيمس ماتيس، وزير الدفاع في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
بعد انقشاع غبار معركة الربيع العربي، طفت فوق السطح التباينات القديمة التي تجعل نظرة كل من السعودية والإمارات إلى الأخرى محمّلةً بإرث العقد التاريخية
كان تأسيس قوة عسكرية هجومية جزءاً من إستراتيجية اتّبعتها الإمارات للحفاظ على أمنها، حتى لو كلّفها الأمر ثمناً سياسياً كبيراً يخصم من شعبيتها في محيطها العربي. فبخلاف القوة العسكرية الهجومية التي تنشط في اليمن والقرن الإفريقي وليبيا، وتشارك في مناورات في البحر المتوسط، اتّبعت الإمارات إستراتيجية ما يمكن أن نسميه بـ"حلفاء الجوار"، لتعويض الفراغ الأمريكي، وذلك بتأسيس شراكات أمنية مع إسرائيل، إذ يتشارك البلدان التوجس من إيران بدرجات متباينة.
تمثّل إسرائيل للإمارات نموذجاً ملهماً، كقوة عسكرية متقدمة تكنولوجياً، على الرغم من ضعفها الديموغرافي الذي يشبه حالة الإمارات. فبعد توقيع ما عُرف باتفاقيات أبراهام للسلام في صيف 2020، كان الاندفاع الإماراتي نحو إسرائيل مدفوعاً بقناعة إماراتية بأن الدولة العبرية قادرة على تقديم شراكة وتعاون تكنولوجيين وأمنيين، بخلاف أي دولة عربية أخرى، كما أنه كان مدفوعاً بفكرة أن إسرائيل هي البوابة الشرقية للولايات المتحدة.
وبالفعل، بعد توقيع اتفاقيات أبراهام، أصبحت الإمارات أقرب إلى الولايات المتحدة من السعودية، وأصبحت لدى حكام أبوظبي نسخة معتمدة لمفاتيح الحوار الأمريكي الشرق أوسطي. فقد أثبتت الموافقة الأمريكية المبدئية لبيع طائرات 35F، ذات القدرات الشبحية، وأكثر المقاتلات الأمريكية تقدماً، للإمارات، أن بوصلة الولايات المتحدة أصبحت تتجه إلى أبوظبي، كشريك أمني أولى بالرعاية، مقارنةً بالسعودية التي تفقد مكانتها لدى واشنطن.
هذه التحوّلات تسببت بمزيد من الغضب السعودي، فقد تعاظم نفوذ سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، الرجل الذي وصفه البعض بأنه الرجل الأكثر نفوذاً في واشنطن، والذي يأتي إليه الجميع، ويعرف أسراراً لا يعرفها غيره.
كان نجاح الإمارات في خلق تحالف مع إسرائيل، وشراكة أكثر عمقاً مع الولايات المتحدة، دافعاً لها للتفكير في فصل خططها الأمنية عن خطط الرياض، فانسحبت قواتها من اليمن، بعد أن خلقت شبكة ولاءات بين ما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى إلى الانفصال بجنوب اليمن، وقوات طارق صالح في الغرب، وقواعد عسكرية حول باب المندب وسقطرى، وتركت السعودية وحيدةً تتخبط في بحر الرمال اليمنية، في مواجهة أشبه بحرب استنزاف مع إيران، وميلشياتها الحليفة.
وعلى الجبهة الإيرانية، اختارت الإمارات احتواء طهران عن طريق فتح جبهة اتصال مباشرة معها، أتبعتها بزيارة دولة قام بها مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، إلى طهران، لتهدئة جبهتها.
في مقابل التهدئة مع إيران، والتحالف مع إسرائيل، لم تتحمس الإمارات كثيراً للمبادرة السعودية للتهدئة مع قطر، فرفضت تبادل السفراء، على الرغم من الترحيب المبدئي في "بيان العلا"، وزيارة طحنون بن زايد للدوحة في آب/ أغسطس الماضي، وذلك في إشارة جديدة إلى انفصال في مسارات الدبلوماسية السعودية الإماراتية.
الخلاصة
ترجع بدايات الخلاف السعودي-الإماراتي إلى عقدة التأسيس الأولى لدولة الإمارات، والخلاف المرير حول البريمي، وهي ما يمكن تسميتها بعقدة الشقيقة الكبرى المهيمنة.
تلك العقدة التي أسست لمرارة لدى الجانب الإماراتي، خلقت علاقةً تنافسيةً شبه مزمنة، وصراع هيمنة يتصاعد بين البلدين، ولكنه صراع يتوارى خلف التعاون الظاهري داخل البيت الخليجي.
تعزز التعاون بين أبوظبي والرياض مع التقاء مصالحهما بعد الربيع العربي، ومحاولتهما احتواء عدوى التغيير التي كانت بالنسبة إليهما خطراً وجودياً يهدد بقاء أنظمة الحكم. جمعت هذه النظرة العدائية للربيع العربي الدولتين في تنسيق غير مسبوق، لاحتواء ما اعتراه خطراً وجودياً، وتفكيكه.
لكن بعد انقشاع غبار معركة الربيع العربي، طفت فوق السطح التباينات القديمة التي تجعل نظرة البلدين إلى بعضهما محمّلةً بإرث العقد التاريخية. فبعد تصعيد السعودية ضغوطها لاحتواء طموح الهيمنة الاقتصادية الإماراتية، ردّت الإمارات بخطوات مضادة لتأكيد أنها أيضاً لديها أداوت عقابية تستطيع أن ترد على الشقيقة الكبرى.
رسمت الإمارات توجهاً إستراتيجياً منفرداً يستبدل التحالفات العربية بتحالف مع إسرائيل، واحتواء إيران وتركيا، وتكوين قوة عسكرية هجومية، وشبكة ولاءات، وقواعد عسكرية عابرة للحدود، وتنسيق مع الحليف الأمريكي يجعلها أولى بالرعاية، وأكثر قرباً من دوائر صنع القرار في واشنطن من السعودية المتخبطة بحروب لا تعرف كيف تخرج منها، وأزمات اقتصادية وسياسية.
وبقي البلدان على طرفَي مواجهة صامتة، وصراع مستتر على الهيمنة الإقليمية تظهر فيها الإمارات أنها أكثر من أي وقت مضى، مصممة على السير منفردةً، حتى لو كلفها ذلك، الصدام مع "الشقيقة الكبرى".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.