ليس الحديث عن التمييز الممنهج الذي يطال النساء دون غيرهن من البشر مجرد موضة أو طريق يسلكه تائقون/ات إلى الشهرة. وما قصص النساء وتجاربهن سوى إثبات على ديمومة حلقات التمييز التاريخية، هن اللواتي خسرن كثيراً وتحدين كثيراً، كل على حدة، إنما داخل القارب ذاته المخصص للمكافحة اليومية لجائحة الميزوجينية، أو كراهية النساء لكونهن نساء فحسب.
بعض النساء تفاءلن خيراً من التغييرات التي فرضت نفسها نتيجة امتلاكٍ متزايد للصوت والمساحة في السنوات الأخيرة، فيما بعضهن الآخر ظلت أحوالهن تتدهور والمظالم عليهن تنهمر.
وبين الحالتين، يبقى أملٌ متجدد بأن يوفّر تفاقم سوء أوضاع النساء، خلال العامَين الماضيَيْن اللذين أحكم خلالهما كورونا قبضته على فضاءات النساء، في بيوتهن كما خلف شاشاتهن، أن يوفّر المرئية اللازمة لتعبيد طريق اللاعودة إلى ما سلف.
إلى حينه، أشكال كثيرة من كراهية النساء ما زالت حيةً تُرزق.
كيس أسود... للفوط الصحية وللتعليقات الذكورية
في الوقت الذي سجّلت أرقام قوى الأمن الداخلي في لبنان ارتفاعاً حاداً في عدد شكاوى الابتزاز الجنسي الإلكتروني بين عامي 2019 و2020، بلغت نسبته 754%، نشأت عشرات المنصات النسوية، الواحدة تلو الأخرى، وبالأخص على إنستاغرام حيث النسب الأعلى من النساء والفئات الشابة، بهدف إعلاء الصوت ضد كل ما يؤذي النساء في العالم العربي ونشر معرفةٍ بديلة دأبت معايير النظام الذكوري على إبقائها مطمورة قبل أن تعود وتبصر النور بفضل همة فوجٍ نسوي يافع آخذ في التشكل.
منصة "زعفران"، للمصمّمة النسوية الشابة رند حمود، كانت إحدى المنصات التي ظهرت خلال الحجر المنزلي بعد أن قرّرت رند، على غرار عشرات الشابات في لبنان، الانتقال من حسابٍ خاص ومغلق على إنستاغرام إلى حسابٍ عام أرادت من خلاله تسليط الضوء على قضايا النساء أمام جمهورٍ أوسع.
من بعيد، قد تبدو عملية العبور من الخاص إلى العام مفهومة وطبيعية لأي فردٍ راغب في الإسهام في نقاش ما، إنما غالباً ما لن تتّسم هذه النقلة بالخفة والبساطة في ما لو كانت العابرة إلى العام، امرأة. توقّعت رند أن تصاحب خطوتَها انتقاداتٌ وآراء مخالفة لتعبيراتها، وربما جارحة أيضاً -وهو أمر اعتادته الناشطات- ولكن ليس إلى الحد الذي شهدته في الآونة الأخيرة.
"لا أفتح صفحة زعفران في الصباح"، تقول رند لرصيف22 بصوتٍ خافت.
"أعرف أنني إذا فتحتُ الصفحة سأقرأ تعليقات ستضايقني. من السهل أن نقول لأنفسنا إن يومنا لن تؤثر فيه تعليقات. لكنها تعليقات تذكّرنا دوماً بالواقع الذي نعيشه والذي ننساه أحياناً بحكم الدوائر الأصغر التي ننتمي إليها".
وتتابع رند: "بينما كنتُ أفكّر خلال الحجر المنزلي كيف يمكنني استخدام قدراتي البسيطة، مثل فنّي، لإيصال فكرة أراها بديهية، كان هناك شخص جالس أيضاً في منزله لكن مع فارق أنه كان يرى من حجره فرصةً جديدة للتحكّم بمساحات النساء، ومن ضمنها الإنترنت... كأنما كنّا أنا وهو نعيش في عالمين موازيين مختلفين".
بدأت إحدى مغامرات رند مع قصة منشور الدورة الشهرية التي ولّدتها ذكرى الكيس الأسود الشهير.
كانت رند في الـ12 من عمرها حين استوقفها مشهد وضع صاحب دكانة الحي علبة "الأولويز" (الفوط الصحية) داخل كيسٍ أسود، فاصلاً إياها عن بقية الأغراض كما يُفصل الشواذ عن الصواب. وتشرح رند: "كطفلة كان عمرها 12 عاماً تذهب للمرة الأولى ولوحدها لتبتاع لنفسها ‘أولويز’، دفعني الرجل إلى الإحساس بأنه من واجبي الشعور بالخجل إزاء هذا الموضوع".
جسّدت رند هذه الحادثة التي تختبرها ملايين النساء على الأقل مرة واحدة في حيواتهن، في رسومٍ وتصاميم بسيطة نشرتها على إنستاغرام لتتيح المجال أمام النساء والفتيات للحديث عن مشاعرهن إزاء الدورة الشهرية وعلاقاتهن بأجسادهن ولترسيخ التعامل مع الدورة الشهرية وغيرها من المسائل الجسدية والفيزيولوجية والجنسية بشكلٍ طبيعي وسلس.
لم تكن في أي حالٍ من الأحوال تتطلع إلى فتح نقاش حول الحلال والحرام مثلاً، أو الحياء والخجل، أو إلى وجوب تفادي خطر أن تفضح الدورة الشهرية المرأة المفطرة خلال رمضان، أو إلى أن تصبح هي المتهمة المدعوة إلى إخفاء طرحها، داخل كيس أسود، تيمناً بالرسول الذي أعرب ذات مرةٍ عن خجله من الحديث عن الحيض أمام النساء، كما أفتى أحدُ المعلقين.
يشبه ما تتعرض له رند يومياً قصصَ آلاف النساء الساعيات اليوم إلى وضع قضاياهن الحميمة وغير الحميمة على الطاولة. لا يكتفي الممتعضون من محتوى النساء بكتابة تعليقات سلبية أو جارحة إنما ينبَرون للبحث عن هوية صاحبة المنشور أو الصفحة والهجوم على علبة رسائلها الخاصة وتهديدها بإزالة صفحتها وسرقتها وملاحقتها هي أيضاً، في ما يمكن وضعه ضمن إطار "الميزوجينية الإلكترونية".
في هذا السياق، تروي رند أن ما لم تتوقعه "هو أن يكون التعبير مكلِفاً لهذه الدرجة". التعبير، برأيها، "أمر طبيعي والأمور التي أعبّر عنها يجب أيضاً أن تكون جداً طبيعية لكننا نُفاجأ بواقع يقول لنا إنها لم تغدُ بعد كذلك... تصل الأمور ببعض الأشخاص إلى إخراج مشاعر كراهية لدرجة يصبحون قادرين على كيل الشتائم ضدك وسرقة صفحتك وأذيتك".
وتردف أنه "من حق الشخص ألا يرغب في رؤية محتوى نسوي. ويمكنه ألا يراه. لكننا نرى كيف يعمد أحدهم إلى البحث عن هذا المحتوى بهدف أن يشتم ويهدد ويستحوذ على هذه المساحة مع العلم أن أصحاب هذه المساحة لا يحاولون الاستيلاء على مساحته. سببُ هذا التصرف هو كره النساء. هو النظام الأبوي المتربص بنا. هو عدم تقبل الأشخاص للتغيير الذي يحصل وتمسكهم بالتحكم والسيطرة على النساء، حتى على الإنترنت".
كانت رند في الـ12 من عمرها حين استوقفها مشهد وضع صاحب دكانة الحي علبة "الأولويز" (الفوط الصحية) داخل كيسٍ أسود، فاصلاً إياها عن بقية الأغراض كما يُفصل الشواذ عن الصواب. "دفعني الرجل إلى الإحساس بأنه من واجبي الشعور بالخجل إزاء هذا الموضوع"، تقول
معظم النساء اللواتي تحدثنا إليهن يخترن عدم الرد على التعليقات الجارحة والهجومية وغالباً ما يتفاعلن مع الاعتراضات من باب اغتنام فرصة شرح فكرة ما والإقناع بوجهة نظرهن.
اضطرّت رند إلى التبليغ والمتابعة مع إنستاغرام مرةً عندما تعرضت صفحتها للسرقة، ومرة أخرى مع فيسبوك عندما تلقت من حسابٍ مجهول صورةً في علبة رسائلها الخاصة يمكن أن توحي للوهلة الأولى بأنها لـ"ميكي ماوس"، غير أن رند رأت فيها عضواً ذكرياً، فبلغت فيسبوك بالأمر، فكان رد المنصة أن هذه الصورة وغيرها لا تتعارض مع معايير النشر الخاصة بفيسبوك.
برأيها، هم رأوا ميكي ماوس وحسب، أما هي فرأت صورة الإحليل وغيرها من الصور الإباحية من الحساب نفسه تجتاح مساحتها.
في المقابل، رسمت رند صورةً أظهرت فيها جزءاً من حلمة امرأة، فما كان بإنستاغرام (الذي يتبع سياسات نشر فيسبوك نفسها) إلا أن منع الترويج و"الريبوست" عنها، بحجة أنها تتعارض مع معايير النشر الخاصة به.

يكفي هذا المثل البسيط لتحديد العقلية التي تحكم "معايير" عمالقة الإنترنت: صورة الحلمة الأنثوية ممنوعة أما الصور ذات الإيحاءات الجنسية المرسلة إلى الخاص فمسموحة.
صورة الحلمة ليست الحادثة الوحيدة. صور أخرى عدّة على زعفران منع إنستاغرام الترويج المدفوع لها.

التحرش الجنسي: مُجرّم في النصوص ولكن...
ما حصل مع الفنانة رند حمود يتكرر مع مئات النساء، وفي بعض الأحيان، تتحدث نساء عن حالات أكثر عدائية إزاء شخصهن وأكثر خطورةً على مساحاتهن الخاصة.
آخر السجالات الواسعة حول مسألة التحرش أتت بعد مشاركة ممثلات وفنانات وصحافيات، خلال شهر أيار/ مايو 2021، تجاربهن مع الصحافي جعفر العطار. كتبنَ على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان يستدرجهن بوعودٍ بعرض نصوصٍ مسرحية عليهن من أجل قبول ملاقاته، وذكرنَ أنه ضغط على بعضهن لممارسة الجنس معه، ولاحق أخريات إلكترونياً بإلحاح بالرغم من تجاهلهن أو رفضهن له.
ما كتبته المتحدثات أظهر نمطاً متشابهاً في معظم القصص، إذ تكرر فيها مثلاً استخدام المُتهم حججاً مماثلة، كلومِه "الحشيش" الذي دخّنه لتبرير سلوكه المُدان، على حد أقوالهن.
تتحدث الصحافية لونا صفوان، وهي إحدى النساء اللواتي شاركن تجربتهن مع المتهم، لرصيف22 عن القضية، وتشرح أنه حتى الآن، أي بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من تقديم شكوى رسمية ضده، "لم تُسجَّل أي تطورات قضائية في الملف، باستثناء إصدار مذكرة توقيف بحق المشكو منه من دون أن تفضي إلى نتيجة، كما ولم تتواصل أي جهة رسمية مع الشاكيات حتى الساعة".
رغم ذلك، تعتبر لونا أن قانون "تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه"، الذي أُقرّ في كانون الأول/ ديسمبر 2020، غيّر المعادلة الراهنة وعلاقات القوة بين النساء والمتهمين بالتحرش بهن، وتروي لونا كيف قوّت كل واحدة من الناجيات الأخرى عندما تكاتفن ضمن حلقة دعم واحدة واجتمعن معاً واعتزمن تقديم دعوى ضد مُتهمٍ واحد.
"من حق الشخص ألا يرغب في رؤية محتوى نسوي. ويمكنه ألا يراه. لكننا نرى كيف يعمد أحدهم إلى البحث عن هذا المحتوى بهدف أن يشتم ويهدد ويستحوذ على هذه المساحة مع العلم أن أصحاب هذه المساحة لا يحاولون الاستيلاء على مساحته"
فبعد مشاركة ممثلة لبنانية الشهادة الإلكترونية الأولى ضد المتهم، كرّت سبحة الشهادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المتحدثات إلى الاتصال بعضهن ببعض والاجتماع سوياً لتبادل تجاربهن مع المتهم والتفكير بالخطوات اللاحقة، وصولاً إلى اتخاذ ثماني منهنّ قرار التقدم بدعوى قضائية ضد الشاب نفسه.
اليوم هناك مساران، تشرح لونا، "المسار الأول هو ذاك الذي حركته النيابة العامة وتولّى تحقيقاته وحفظ إفادات الناجيات فيه مكتب حبيش (الآداب) من دون أن يفضي الأمر إلى نتيجة حتى الساعة. أمّا المسار الثاني، فيتعلق بدعوى نقابة الفنانين التي تحرّكت ليس لمواجهة فعل التحرش فقط، بل فعل انتحال صفة فنان أيضاً بهدف استدراج فتيات، وذلك عبر محامي النقابة الأستاذ جوزيف غانم".
في المقابل، قابل المتّهم ما جرى بالتلويح برفع دعاوى افتراء وتشهير و"فبركة ملف" ضد كل امرأة تتهمه بالتحرش. ترى صفوان أن هذه الخطوة لا تعدو كونها "محاولة أخرى لتسكيت النساء وترهيبهن لكي لا تتجرّأ أخريات على البوح أو الشكوى".
في المحصّلة، يتضح أن هذه القضية هي الدعوى الأولى التي توصلها صاحباتها ضمن مجموعة دعم واحدة إلى القضاء بالاستناد إلى القانون الجديد، وتشكّل الاختبار الحقيقي الأول لكيفية تعاطي المؤسسات مع قضية التحرش وفق هذا القانون.
وكان حقوقيون قد انتقدوا ثغرات هذا القانون، ومن أبرزها برأيهم إبقاء عبء الإثبات على كاهل الضحية والتمسّك ببعض التعريفات ذات الطابع الأخلاقي، غير أنهم شجعوا على الركون إليه للاستفادة من إيجابياته، وعلى رأسها شمول القانون لمروحة واسعة من أشكال التحرش.
وينص القانون على أن "التحرش الجنسي قد يتم عبر أقوال، وأفعال، ووسائل إلكترونية"، وهو "كل فعل أو مسعى، لو كان غير متكرر، يستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري ويهدف فعلياً للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية".
فنقابة المصوّرين مثلاً لم يرف لها جفن عقب انتشار شهادات إلكترونية ضد مصوّرين، ونقابتا المحرّرين والصحافة تتجاهلان ما تتحدث عنه صحافيات بين حينٍ وآخر من تحرشٍ وتمييز، لا بل رأينا نقيب الصحافة عوني الكعكي يخرج بتصريحات معادية للنساء في قوله: "هذه السيدة (القاضية غادة عون) غير المتزوجة لا بد من أنها تعاني صحياً من أمراض عدة".
يأمل المتابعون أن يساعد القانون الجديد في ثني متحرشين مُحتملين عن الشروع في جرائمهم، خصوصاً إذا طُبّق بشكل يعطي الأولوية لحماية الناجيات وتحقيق العدالة لهن.
لكن يبقى السؤال الجوهري: هل يمكن أن يجري ذلك في بيئة تخرج فيها التصريحات المعادية للنساء من قمّة الهرم؟ لم يمر وقت طويل على صدمة رد النائب إيلي الفرزلي مثلاً، على وزيرة العدل ماري كلود نجم بعبارة "شيليه من فوق حطيه تحت" عندما طلبت شطب جملة "من فوق" من قانونٍ كان موضع دراسة.
"ما بتطبخي يا نادين؟"... سؤال أنّب به قاضٍ زوجةً تعرضت للتعذيب
إذا كان الإنترنت مكاناً رحباً يستوعب مساحاتٍ متناقضة ويتيح التفاوض على القوة والقدرة على بلورة خطاب، فالمنزل يبقى مكاناً ضيّقاً، إنْ مد النساء بشيء، فببضعة أسلحة تفاوُض تهاوت قيمتها إثر إقفال المنازل وتعليق عمل القضاء المتكرر بسبب انتشار كورونا -وربما قريباً بسبب أزمة ندرة المحروقات- بما في ذلك عمل محاكم الأحوال الشخصية التي تدير، وفقاً لـ15 قانونٍ طائفي ومذهبي، شؤونَ الزواج والنفقة والطلاق وحضانة الأطفال والولاية عليهم.
في الوقت الذي يُحرم فيه المقيمون/ات في لبنان من قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، تغيب أيضاً عن قوانين الأحوال الشخصية الدينية تعديلاتٌ كان يمكن أن تسهل حياة بعض النساء في الوقت الفاصل بين مرحلة اللاقانون الموحد ومرحلة القانون الموحد.
آلافُ الصفحات تُفرد منذ عقود لشرح ويلات قوانين الأحوال الشخصية الطائفية وممارسات المحاكم الدينية التي تميّز ضد النساء، وبين النساء، على جميع الأصعدة، من دون أن يحرّك الأمر ساكناً في ضمائر المشرعين.
ففي الوقت الذي قررت دار الفتوى رفع سن حضانة الأم لأطفالها إلى 12 عاماً للصبي والفتاة عام 2011، ومنع زواج كل مَن هم دون الـ15 من عمرهم في أواخر عام 2020، كانت الطائفة الكاثوليكية لا تزال تعتمد سن الرضاعة كسن حضانة رسمي للأم في نصوصها، فيما سن الحضانة لدى الروم الأرثوذكس هو 14 سنة للذكر و15 سنة للأنثى، ولدى الشيعة هو سنتان للصبي وسبع للفتاة.
تتعدد إذاً الفروقات بين السلطات الطائفية لناحية أحكامها في شؤون الولاية والوصاية والحضانة، ومعها تتعدد سقوف حقوق النساء باختلاف مرجعياتهن الدينية، ليبقين عالقات في دوامة مُرهِقة تبقيهن أسيرات نظريات زعمائهن الطائفيين والسياسيين ومصالحهم الذكورية.
لتصويب هذه الظلامة، ناضلت طوال عقودٍ خلت عشرات الحركات الحقوقية والنقابية من أجل التوصل إلى قانون مدني موحد ينطبق على جميع المقيمين/ات في لبنان، تتصدرها الحركات النسوية، نظراً إلى أن النساء، هنا أيضاً، يشكلن الفئة الأكثر تضرراً من النصوص والإجراءات المعمول بها تلبيةً لذهنية ذكورية تُربكها مفاهيم الشراكة وتوزيع الأدوار والمهام بعدل، لا بنمطية.
يستمع رجال الدولة ومللها الطائفية يومياً إلى نساء يروين أمامهم، على مضض، قصصاً عن مظالم تهطل فوق رؤوسهن وما في يدهن حيلة سوى التحايل الاضطراري بغية الصمود، أو الصبر القهري بغية النجاة.
تُجسد قصة "نادين" (اسم مستعار)، 38 عاماً، وهي أم لطفلَين، كل ما لم يمكن العقل تصوره من فظاعة ولا القلب من قسوة. مع ذلك، لم تُمنح نادين الطلاق رسمياً من المحكمة الروحية (المسيحية) حتى كتابة هذه السطور.
مَن يزور نادين يرى امرأةً متعلمة وقوية ومتحررة لا تتسع لطاقتها وطموحها الدنيا. حتماً لن يلتقي المرأة التي عذبها زوجها تعذيب الأنظمة الديكتاتورية لشعوبها. على امتداد 14 عاماً ذاقت مرارة العزلة، والنبذ، والإهانة، والتحقير، والملامة الروتينية على فشل زوجها في كل ما يقوم به تقريباً، وصولاً إلى مناداتها بـ"شرموطة" أمام أطفالها وأصدقائهم الصغار، فضلاً عن مراقبة خطواتها بشكل دوري، ومنعها من الاهتمام بجسمها كما يروق لها، وفرض ذائقته على شكل صدرها، وغيرها من التصرفات المؤذية.
"جسمي لم يكن لي"، تقول نادين. "منعني من الاختلاط ومن ممارسة أبسط الأنشطة، لا بل حتى من زيارة اختصاصي نفسي"، لكن الشابة التي درست علم النفس في الجامعة واظبت خفيةً على هذه الزيارات التي أنقذَتها، وصارت اليوم هي تعالج غيرها.
تخبر نادين كيف ملأ زوجها مساحاتها بآلات تسجيلٍ وتعقّب تحركاتها. كان يشاهد أفلام البورنو ويعيد تمثيل المشاهد على جسدها. وحتى تلك المحاكاة البورنوغرافية كانت غالباً ما تقتصر على الأوقات التي كان يخطط فيها للإنجاب، حفاظاً على سلالته، لا تعبيراً عن حبه لزوجته أو رغبته بها.
بعد أسبوعٍ واحدٍ من الزواج، سألَتْ نادين نفسها "ولك شو عملتي يا نادين؟". حتى شهر العسل كان شهر الكسل، إذ أمضاه الزوجُ نائماً لا يتفاعل مع عروسته ولا يقترب منها.
"جسمي لم يكن لي"، تقول نادين. كان زوجها يشاهد أفلام البورنو ويعيد تمثيل المشاهد على جسدها. وحتى تلك المحاكاة البورنوغرافية كانت غالباً ما تقتصر على الأوقات التي كان يخطط فيها للإنجاب، حفاظاً على سلالته، لا تعبيراً عن حبه لزوجته أو رغبته بها
وتبعت شهر العسل "المشؤوم" رحلة مضنية تخلّلها إدمان الزوج المديد على الكحول وإدمانه الأخطر على متعةٍ عميقة كان يستمدها من تعذيب زوجته ورؤيتها مُتعبة ومطيعة في آن. كان مثلاً يطلب منها قيادة السيارة لساعاتٍ طويلة في الليل ليتسنى له الجلوس إلى جانبها من دون الاضطرار إلى القيادة فيتمكن من شرب الويسكي بهدوء، فيما هي بالكاد كانت عيناها تبصران من شدة التعب بعد يوم عملٍ طويل خارج المنزل وداخله ومع أطفالها. ثم كان يطردها من السرير إذا رآها مرتاحة قليلاً. واستمرت هذه العادة لسنوات.
في إحدى الليالي، طردها خارج المنزل لأنه لم يرق له أنها عادت من جلسة مع الأصدقاء الساعة التاسعة ليلاً. كان يغيّر لها موعد العودة إلى المنزل كل ليلة، رغم أنهما كانا عملياً منفصلَين. كان يعاقبها على عدم احترام الموعد الجديد الذي حدده في رأسه ولم يبلغها به. حتى أنه وصل إلى تهديدها بالقتل.
تقول نادين لرصيف22: "كان يقول لي: ‘أحلم بأن أطلق النار عليكِ، لكن أفضّل رؤيتك مشلولة على كرسي متحرك تتعذبين مثلما عذبتني’. في حالات معينة، كانت تخرج دقات قلبي من عينَي".
تروي نادين أيضاً كيف هاجم زوجها السابق أقرباءها حين لجأت والأطفال إليهم بعد فشل محاولات "الإصلاح" التي قادتها لسنوات، على الرغم من كونها هي المظلومة. أصرت على دعمه نفسياً وظلت تحاول ترميم علاقتها به لأنها التزمت برعاية عائلة، أو بالأحرى، لأنه أخسرها كل شيء، بما في ذلك ثقتها بنفسها وقدرتها على الوجود في أي مكان آخر خارج عن سطوته.
وتروي أن قضاء العجلة لم يرَ العام الماضي أي موجب لمنحها أمر حماية يُبعد المعتدي عنها، على الرغم من وجود قانون العنف الأسري رقم 293/2014 الذي عُدّل عام 2020 آتياً بتسهيلات أكبر للنساء طالبات الحماية وأطفالهن ومجرّماً بشكل أوضح العنف المعنوي والاقتصادي تجاههن. فلا زرقة ولا كدمة كانتا باديتَين على وجهها، ومن دونهما، يبدو أن لا مسوغات جدية تستدعي الحماية.
في أيلول/ سبتمبر 2019، طلبت نادين رسمياً الانفصال عن زوجها، فرأى الزوج في ذلك فرصة ذهبية... لتدميرها. "سوف أحرقك وأكسرك"، قال لها.
اضطرت آلاف النساء إلى ملازمة منازلهن مع معنفيهن خلال فترة كورونا التي سجلت ارتفاعاً في حالات العنف الأسري بلغت نسبته الرسمية 100%، وارتفاعاً حاداً في عدد جرائم قتل النساء، من 13 جريمة عام 2019 إلى 27 عام 2020، فيما سُجّلت تسع حالات بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو 2021، بحسب ما أفادت به لرصيف22 الناشطة عليا عواضة، إحدى القائمات على موقع "شريكة ولكن" الذي يرصد حالات قتل النساء داخل الأسرة وخارجها بشكل دوري.
وبخلاف الكثير من النساء اللواتي اضطررن إلى حجر أنفسهن مع معنفيهن، قررت نادين الانتقال إلى منزل جديد مجهول العنوان مصطحبةً أطفالها معها. أدركت تمام الإدراك أن زوجها "السادي وغير القادر على التعاطف" لن يستطيع الاعتناء بالأطفال. وكانت محقة. فبالكاد مرت ساعات على إيصالهم إلى منزله خلال إصابتها بكورونا حتى أعادهم إليها لأنه خاف منهم، على حد قولها.
نسرد كل ما سبق بالتفصيل لنصل إلى ذروة التمييز الصادر ليس فقط عن الجهات القضائية المدنية التي لم تمنح نادين أمر حماية شديد اللهجة واكتفت بتعهد عدم تعرض، إنما عن الجهة الدينية التي ستبُت قريباً في ملفها، أي في مصير حياتها.
بعدما تقدمت بطلب انفصالٍ لم تحصل عليه إلا بعد ثمانية أشهر من تقديمه. وبعدما روت شريط التعذيب والتحقير والخيانة أمام القاضي الروحي الماروني في منطقة جونية، رد الأخير على تفصيلٍ واحد ذكره زوجها ضدها فقال لها بصوتٍ معاتب: "يا نادين أي رجل ممكن أن يتعرض للتجربة... لكن هل يعقل أنك امرأة لا تطبخ؟ يا ابنتي، حتى لو كنتِ تعملين، حين تعودين إلى المنزل، يجب أن تطبخي".
عن العمل الرعائي و"التمييز الناعم"
بينما تنتظر نادين وآلاف النساء قرارات طلاق أو بطلان زواج أو نفقة طفل ما زالت تحددها المحاكم بـ300 ألف ليرة حتى اليوم على رغم تدهور سعر صرف العملة اللبنانية وتردي الأوضاع المعيشية، تعيش راما أبو العينين، أم لطفلة، ما يمكن وصفه بـ"التمييز الناعم".

في العامين الماضيين، اغتنمت مناضلات وباحثات نسويات فرصة الحجر المنزلي لإلقاء الضوء أكثر على الأعباء الملقاة على كواهل النساء والتوزيع غير العادل للمهام المنزلية والرعائية. فأصبح العمل الرعائي ووجوب الاعتراف به وتقديره عناوين أساسية على الأجندة السياسية النسوية، خصوصاً بعد أن كانت السلطات التنفيذية والتشريعية، وعلى مدى عقود، لا تعيره الأهمية التي يستحق، ولم تكن تحتسب قيمته أصلاً في الاقتصادات الوطنية أو في قوانين الأحوال الشخصية، لا سيما تلك المتعلقة بتوزيع الثروة والتعويضات المترتبة عن انفصال الزوجَين.
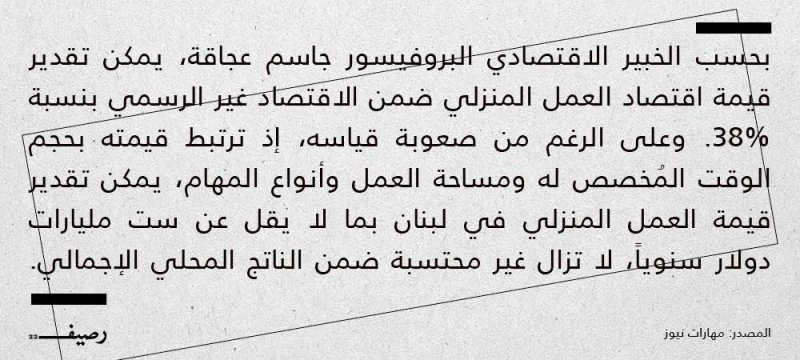
تتشارك راما وشريكها الاهتمام بطفلتهما ألمى البالغة سنتين من العمر. تعمل راما من المكتب وغالباً ما يعمل شريكها من المنزل.
"أنا وشريكي حالة نادرة ربما. كنتُ أشعر بالذنب أحياناً لأنني أنا التي أعمل خارج المنزل وهو الذي يعمل داخل المنزل. أنا التي أعود من الخارج إلى الداخل، إلى ابنتي. أكون على عجلة من أمري لإنهاء أعمالي والعودة إليهما. ربما لا ينبغي أن أشعر بالذنب. فأنا في مكتبي أعمل، ولا أستطيع العمل أصلاً من المنزل بوجود ألمى لأنني في مجال الإدارة المالية وأحتاج إلى الهدوء لأتمكن من التركيز".
تصف راما انكبابها على تحضير الطعام والتحميم والتنويم بـ"الطبيعي". ترى نفسها متورطة به من دون أن تخطط له بالضرورة. "من الصعب عليّ أن أطلب من غيري إتمام هذه الأمور إذا كنتُ في المنزل وغير منشغلة بشيء، علماً أنها مهام قابلة للتقاسم".
تصف راما لرصيف22 شعوراً ضمنياً بـ"التقصير" إذا لم تقم بكل هذه المهام الرعائية وتقول: "أشعر بالذنب تلقائياً، تلك المشاعر تبقى موجودة، لا أدري لماذا".
لو كانت ابنة راما في المدرسة، لكانت ربما أُضيفت إلى مسؤولياتها لائحة من الأعمال الأخرى كالتدريس والتوصيل وترتيب الأمور اللوجستية. ولو كان يقطن أحد أقربائها المرضى معها، لكانت اضطرت إلى الاعتناء به ومداواته، كما حصل مع ملايين الأمهات حول العالم اللواتي سرعان ما هببن لدعم مَن حولهن إما بشكل عفوي أو نتيجة التوقعات المجتمعية أو تقاعس الشريك، الأمر الذي دفع بالحقوقيات إلى دق ناقوس خطر إعادة ترسيخ كورونا لأدوارٍ نمطية كانت البشرية في طور تجاوزها بفضل عقودٍ من النضال النسوي والعمالي.
في هذا الإطار، تشير دراسة نُشرت مطلع عام 2021 لعلماء نفس اجتماعيين في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلس UCLA إلى أن "نظريات علم النفس التطوري والاجتماعي تُبيّن أن الشعورَ بغياب اليقين والأمان الناتج عن كورونا ربما يشكل تهديداً بخاصة عندما يقترن بخطر الإصابة بالأمراض المعدية والمخاوف الوجودية، مما يؤدي إلى جعل الناس أكثر تقليداً ومحافَظة".
علاوةً على ذلك، ذكرت منظمة العمل الدولية "أن "النساء العاملات تضررن من الوباء أكثر من غيرهن"، لأن تأثير كوفيد على النساء العاملات يعود إلى ارتفاع أعدادهن في بعض القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الأزمة، كالسكن والغذاء والمبيعات والتصنيع، وهنّ وجميع أصحاب الأجور المنخفضة تحملوا العبء الأكبر الناتج عن توسيع الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والعاملين/ات ذوي الأجور المنخفضة.
نسوياً، ماذا يعني كل هذا؟
تعلّق الناشطة النسوية ومديرة معهد الأصفري في الجامعة الأمريكية في بيروت لينا أبو حبيب على هذه التطورات، مذكرةً بأنه "منذ مئة عام والنسويات يسعين إلى تثبيت فكرة أن العنف ضد النساء قضية، والعمل المنزلي والرعائي قضية، ومسألة الهرمية داخل الأسرة قضية، وواقع أن عمل النساء خارج المنزل لم يعدل في توزيع الأعمال داخل المنزل، قضية... احتاج الأمر إلى وباء ليلاحظ العالم ذلك كله!".
وتضيف أبو حبيب لرصيف22: "أتاحت جائحة كورونا فرصةً ثمينة للحقوقيات تمثلت بقدرتها على لفت انتباه المجتمع إلى هذه القضايا القديمة التي برزت أكثر بفعل الحجر المنزلي وما رافقه من أعباء منزلية مُضاعفة. فهي لفتت الانتباه إلى صعوبة العمل المنزلي عموماً ومشكلة عدم تقديره، وإلى إشكالية عدم المساواة قبل كورونا التي فاقمتها الجائحة أو ساعدت، على أقل تقدير، في إظهارها".
"لم تكشف كورونا جديداً، إنما رفعت الغطاء عن مفاهيم وقضايا كانت النسويات تناضل أصلاً من أجلها"، تقول، وتعلّق بثقة واطمئنان: "اليوم أصبحت هناك داتا وفيرة حول التأثيرات المتفاوتة جندرياً لهذه الجائحة. لذلك، لسنا بصدد شرحها أكثر. ومَن يرغب بفهمها ليس أمامه سوى البحث بنفسه بين الموارد التي وفّرتها النسويات. إذا عنى ذلك شيئاً، فهو أن لا عودة بعد هذه القفزة إلى الوراء".
ربما يسلك النضال من أجل الاعتراف بالعمل المنزلي طريقاً مشابهاً لذاك الذي سلكه النضال من أجل الاعتراف بالعنف ضد النساء في لبنان أو بظاهرة سلخ الأطفال عن أحضان أمهاتهم تطبيقاً لقوانين وأعراف جائرة.
على طريق النضال من أجل إنهاء العنف ضد النساء، تطلّب الأمر أن تسيل دماء مئات النساء ليصدّق العالم أن النساء في خطر. أما على طريق النضال من أجل تقدير الأعمال المنزلية وتوزيعها بعدل، فتطلّب الأمر جائحةً ليصدّق العالم أن النساء، حالياً، مُستعبَدات.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


