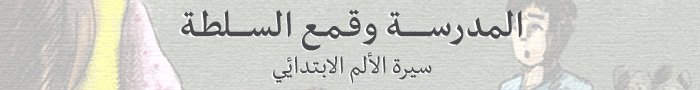صفعتنا الدهشة وأثارنا العجب والتعجب. التفت كلّ منا نحو الآخر، وسؤال قلق سُطّر على صفحات العيون المستفهمة: كيف تجرّأ هذا التلميذ على أن يقول للمعلم: "لا، هذا خطأ"؟ كيف واتته الشجاعة ليقول هذا؟ بل ما هذه "الوقاحة" ليظنَّ أنه يعرف أكثر من المعلم! صاحبَ هذه الأسئلة إعجابٌ بذكاء هذا التلميذ وحصافته.
وللحقّ، لم يكن التلميذ وقحاً أبداً؛ فهو لم يقل سوى رأيه الذي خالف رأي المعلم والشاعر كذلك، ولكننا بعقليتنا تلك، وبما تعودنا عليه من أن المعلّم دائماً على حقّ وصواب وعلم، كان في ظننا أنّ هذا التلميذ يستحق العقاب، وهو العقيدة المتَّبعة في المدارس.
التلميذ كان ذكياً. لم يرَ أن الشاعر الذي شبَّه حبيبته بالقمر، مدحها! فالقمر ليس جميلاً، لأنه مجرد عاكس لضوء الشمس الساقط عليه وليس مضيئاً بذاته، وهذه حقيقة علمية. لا يمكن لشيء سلبي وغير منتج أن يكون جميلاً، لذا فإن الشاعر لم يمدح المرأة التي يحبّها، وإنما ذمّها عندما شبهها بشيء سلبي ومظلم في الأساس، وإن أراد أن يمدحها فعليه أن يشبهها بالشمس بدلاً من القمر. قلتُ في سرّي: هذا مدهش، كيف استطاع هذا الولد أن يربط بين العلم والأدب!
ابتسم المعلم وعلَّق: ليس بالضرورة أن نُخضع الأدب للحقائق العلمية. اندهشنا من ردّ المعلم. كنا ننتظر أن يعاقب التلميذ، أو أن يؤنّبه، أو يطرده على أقل تقدير، ولكنه خيَّب توقعاتنا! ربما لأنه لم يكن معلماً نظامياً، ولأننا لم نكن في عام دراسي بالفعل.
المنهج المدرسي، اليوم، منهج تلقيني، يعتمد على الحفظ والاسترجاع، وليس على الفهم العميق والاستنباط والأسئلة والاستنتاج. ليس غرضي الحديث عن المنهج إنما عن البيئة التعليمية، فالمدرسة كجزء من المنظومة التعليمية تعتمد على الطاعة العمياء والتأدّب المفرط الذي قد يكون تمثيلاً من التلاميذ كي ينجوا من العقاب لا أكثر.
في المدرسة، كان علينا أن نكون تلاميذ مطيعين، مؤدّبين وناجحين، وإلا فإن صوت سوط "العَنَج" وهو يصرخ في الهواء قبل أن يلتصق بأيدينا أو أجسادنا، يعرف كيف يجعلنا كذلك. في الصَّف تقف "الألفة" التي مهمتها تسجيل إسم كل بنت تتحدث أو تشاغب بين الحصص، أو في الحصص الفارغة. تكون الألفة عادة فتاة قوية الشخصية، عندما تصرخ في زميلاتها بأن عليهن الاستجابة لها والجلوس بهدوء. تكون متسلطة، وغير محبوبة، ومع هذا فإن الجميع يسعى ليكسب ودَّها لتغضّ الطرف عن حديث أو حركة أو ضحكة خرجت عفواً.
ربما ثبت من تجارب العقاب المدرسية أن الجَلد ـ الذي يقع على كرامة المجلود قبل جسده ـ وسيلة ناجحة للتأديب. يُجلد الطلاب والطالبات، المتظاهرون والمتظاهرات، الزوجات، مرتديات البنطلونات، الصحافيات والصحافيون، المدونون والمدونات... صار كلّ الشعب يُجلد ليؤدَّب!
من تقوم "الألفة" ـ رئيسة جهاز الأمن الصفي ـ بتدوين إسمها في الورقة، تُعاقب بالجلد الذي يتراوح بين الجلد بالمسطرة على قفا الكف في مفاصل الأصابع، أو بالجلد بالسوط على الأيدي، أو تعاقب بأن تنظف الفصل في الغد، أو أن تلتقط الورق من باحة المدرسة، أو أي عقاب مناسب تراه المعلمة ـ وزيرة الداخلية ـ مقابل الخطأ الذي ارتكبته الطالبة، والذي قد لا يتعدّى كلمة قالتها أو ضحكة انفلتت منها أو حتى التفاتة للخلف ظنت "الألفة" أنها كلام.
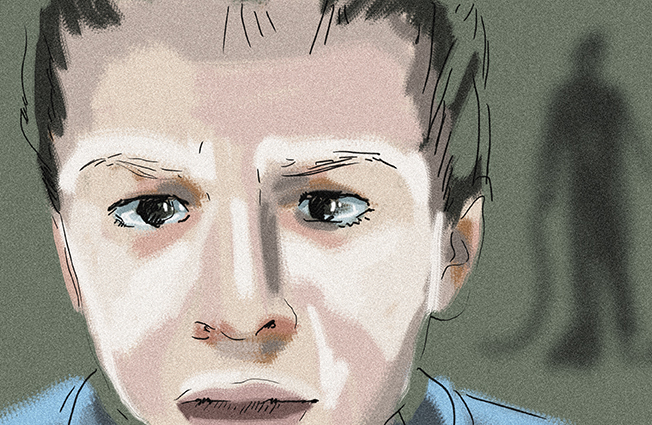
في سنواتي المدرسية في التسعينات، كانت أسباب العقاب مختلفة ومتباينة، منها ألا تسارع تلميذة إلى القيام مع زميلاتها فور دخول المعلمة حجرة الدارسة، أو لأنها لم تقم بواجبها المنزلي، أو أن كراستها متسخة وغير مرتبة، أو ربما رأت المعلمة في الشارع فتاة لا تضع الطرحة على رأسها، فتحفظ شكلها وتعاقبها عندما تصل إلى المدرسة! كان هذا في بواكير حكم الإنقاذ 1989 التي جعلت من الطرحة جزءاً لا يتجزأ من الزيّ المدرسي، وبالطبع، كل زي تبعاً للشريعة الإسلامية. وحتى الآن في بعض الجامعات كما تقول الدكتور ناهد محمد الحسن، فإن "المرابطات يقفن أمام البوابات للتدقيق في أزياء البنات، وقد وصل الأمر حدّ تحديد زيّ معين له لون ومقاس. وقد اعتمدت بعض الجامعات الخاصة نظام اليونيفورم في محاولة للتديين المؤسسي الذي يؤسس لجامعات تعتمد التلقين ونظام الطاعة العمياء كجزء من شروط البقاء في المؤسسة".
أتذكر أنني، في سنة من سنيّ دراستي، حين كنت في الصف الأول المتوسط، فُرضت علينا الصلاة الجماعية في المدرسة، صلاة الظهر، وهناك من المعلمات من تقوم بتفتيش حجرات الدراسة لجرّ كل من تخلّفت عن الصلاة لتصلي. أتذكر أننا أحياناً ـ صديقتي وأنا ـ كنا نقف دون وضوء ونركع مع الراكعات، ولم يكن مردّ ذلك خلفية فكرية أو دينية، إنما عناد، وتمرّد على القوانين التي كانت في اضطراد تضيّق الخناق.
في إحدى المرات (لا أذكر فيها "خطأي"، ولكني أذكر عقابي جيداً)، أوقفتني المعلمة لمدة حصتين، ووجهي إلى الحائط. كانت مدة الحصة الواحدة 45 دقيقة. لكن للحقّ، لم أقف طوال الحصتين، إنما جزء يسير لا يمكنني تقديره الآن، تُرك لي لأجلس فيه، وهذا ليس عقاباً قاسياً، بل كان عقاباً ظريفاً ولطيفاً. فالمعلّمة لم تضربني، أو توجّه إلي إساءة لفظية مؤلمة تجرحني بها أمام زميلاتي وتعلق مرارتها بحلقي لسنوات قادمات، أو تؤنّبني تأنيباً شديداً بأنني فاقدة للأدب مثلاً، أو ترسلني للمديرة، وهذا الأسوأ. أقول كان عقاباً ظريفاً لأنني بقيت داخل الصف، أدير وجهي لزميلاتي وأبتسم لهن ويبتسمن لي، وتزجرني المعلمة كلما لاحظت ذلك. ولكنني لا أتوب. في النهاية جعلتني أعود لمقعدي على أن ألتزم الأدب. لقد كانت معلمة عطوفة فعلاً.
هذه الذكريات جعلتني أدرك كم كانت الطاعة العمياء واحدة من أهم المواد التي علينا أن نلتزمها ونطبقها، وأن نتماشى مع الخط المرسوم لنا دون أي خروج عنه، دون ضحكة لنكتة داخل الصف أو لموقف طريف، دون كلمة في الحصة إلا إجابة على سؤال المعلمة أو المعلم، دون التفات، دون تفكير مخالف، دون لعب في وقت الفراغ، إنما الدراسة والحفظ والاجترار, لا غير. وإلا... فالعصا لمن عصى!
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.