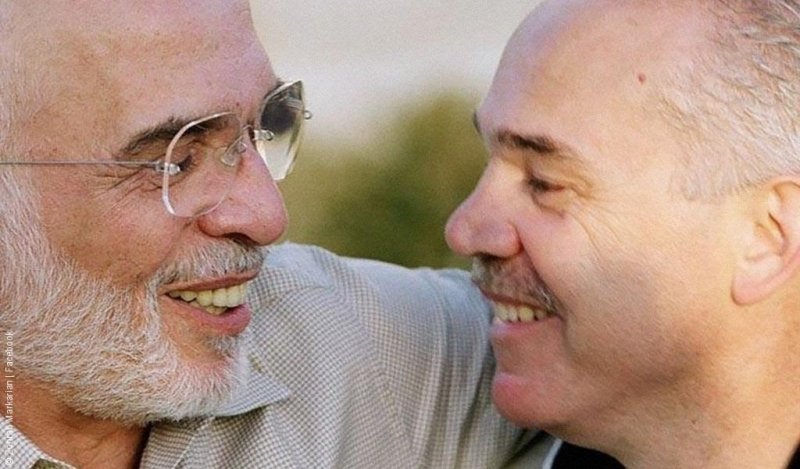ليالٍ قصيرة، أفكارٌ مُظلمة وخوفٌ مما في الانتظار. لا يعيش تلك المشاعر المُخبطة طالبو اللجوء في ألمانيا فقط، بل من يحاورهم ويستمع إلى رواياتهم أيضاً. إليكم أربع قصصٍ قصيرة من واقع المقابلات:
 INSIDE_RefugeesGermany4
أدرك جيداً أنني مجرد كائنٍ بشري له عواطف وميول وآراء وهواجس، ومن المستحيل أن أصلَ إلى الموضوعية الصِّرفة، فيشلّني التأرجح بين الخوف من الخطأ وبين التوقف عن عملٍ يساعد الآلاف على الهرب من ويلات الحرب والتعذيب، وبدءِ حياةٍ جديدةٍ بأمانٍ وكرامة.
أرتدي ثيابي التي حضّرتها أمس على الكرسي وأنا أحاول إقناعَ نفسي أن من لا يعمل لا يخطئ. بدلتي سوداء مع قميصٍ زهريٍّ فاتح جداً دون أزرار، يغطي الصدر حتى الرقبة. لا مجوهرات، لا مكياج، لا اكسسوارات، لا حقائب ثمينة، حتى الساعة تخليت عنها. أنتعل حذاءً أسوداً قديماً لكنه دافئٌ ومريح من أيام الجامعة، كنت قد جلتُ نصف العالم به. أربط شعري كذيل الحصان و أكتفي برشة Eau de Toilette خفيفة. أنظر في المرآة وأكاد لا أميّز هذه النسخة الشديدة التقشف عن نفسي.
الشيء الوحيد الذي احتفظت به من نفسي هو أظافري الجميلة المطلية بعناية، لا يمكن أبداً أن أخرج بأظافر غير مطليةٍ فعندها سأحسُّ أنني عاريةٌ تماماً. فليكن، هنا أرسم الحدّ الذي إن تجاوزته فسأصبح بعده جزءاً من الكوريدورات الرمادية اللامتناهية، الكراسي والطاولات والنوافذ التي لا لون لها التي تجفف الروح. لقد اقترب عيد الميلاد، والأحمر الجميل على يديّ هو على الأرجح اللون الوحيد الذي سيراه اليوم كل من أعمل معهم في هذا المبنى الكئيب من طالبي لجوءٍ وقضاة ومحققين.
أشرب فنجان الاسبريسو برشفةٍ واحدة وأركض خارجةً إلى الظلام البارد. الساعة في محطة المترو تشير إلى السادسة. نصف ساعةٍ في المترو أصعد بعدها إلى الشارع حيث أنتظر زميلي المصري على الطريق، ليقلّني معه بسيارته إلى الوزارة ، بذلك أوفّر على نفسي نصفَ ساعةٍ إضافية من التنقل بين الباصات. معظمُ المومسات في الطريق قد تقاعدن لهذا اليوم ما عدا عددٍ قليل منهنّ ما زلن يقفن بانتظار الزبائن. كل ما أفكر فيه هو كيف يمكنهنّ الوقوف على الطريق شبهَ عارياتٍ في هذا البرد؟
INSIDE_RefugeesGermany4
أدرك جيداً أنني مجرد كائنٍ بشري له عواطف وميول وآراء وهواجس، ومن المستحيل أن أصلَ إلى الموضوعية الصِّرفة، فيشلّني التأرجح بين الخوف من الخطأ وبين التوقف عن عملٍ يساعد الآلاف على الهرب من ويلات الحرب والتعذيب، وبدءِ حياةٍ جديدةٍ بأمانٍ وكرامة.
أرتدي ثيابي التي حضّرتها أمس على الكرسي وأنا أحاول إقناعَ نفسي أن من لا يعمل لا يخطئ. بدلتي سوداء مع قميصٍ زهريٍّ فاتح جداً دون أزرار، يغطي الصدر حتى الرقبة. لا مجوهرات، لا مكياج، لا اكسسوارات، لا حقائب ثمينة، حتى الساعة تخليت عنها. أنتعل حذاءً أسوداً قديماً لكنه دافئٌ ومريح من أيام الجامعة، كنت قد جلتُ نصف العالم به. أربط شعري كذيل الحصان و أكتفي برشة Eau de Toilette خفيفة. أنظر في المرآة وأكاد لا أميّز هذه النسخة الشديدة التقشف عن نفسي.
الشيء الوحيد الذي احتفظت به من نفسي هو أظافري الجميلة المطلية بعناية، لا يمكن أبداً أن أخرج بأظافر غير مطليةٍ فعندها سأحسُّ أنني عاريةٌ تماماً. فليكن، هنا أرسم الحدّ الذي إن تجاوزته فسأصبح بعده جزءاً من الكوريدورات الرمادية اللامتناهية، الكراسي والطاولات والنوافذ التي لا لون لها التي تجفف الروح. لقد اقترب عيد الميلاد، والأحمر الجميل على يديّ هو على الأرجح اللون الوحيد الذي سيراه اليوم كل من أعمل معهم في هذا المبنى الكئيب من طالبي لجوءٍ وقضاة ومحققين.
أشرب فنجان الاسبريسو برشفةٍ واحدة وأركض خارجةً إلى الظلام البارد. الساعة في محطة المترو تشير إلى السادسة. نصف ساعةٍ في المترو أصعد بعدها إلى الشارع حيث أنتظر زميلي المصري على الطريق، ليقلّني معه بسيارته إلى الوزارة ، بذلك أوفّر على نفسي نصفَ ساعةٍ إضافية من التنقل بين الباصات. معظمُ المومسات في الطريق قد تقاعدن لهذا اليوم ما عدا عددٍ قليل منهنّ ما زلن يقفن بانتظار الزبائن. كل ما أفكر فيه هو كيف يمكنهنّ الوقوف على الطريق شبهَ عارياتٍ في هذا البرد؟
 ـ ساعاتي يعني شو؟ سويعاتي؟
لا لا يا مدام، حضرتك، ساااعااتيي، بصلح ساعات يعني. اِتعلّمت المصلحة في محل أبويا في إسكندرية، وبعدها جيت ألمانيا من حوالي 33سنة وفتحت محل لتصليح الساعات.
لحدّ دلوقت، كل يوم أحد بعد الكنيسة، بنجتمع كلنا عند أورسولا بناكل تشيلي ونشرب قهوة واللّي عايز يصلح ساعة بيجيبهالي.
ـ لكن يا أنور لجبلك ساعتي الشواروفسكي تصلحها.
نصل إلى المبنى الواقع في ضاحية نائية وفقيرة من برلين الشرقية، مبنيٌّ على الطراز الهندسي الذي كان شائعاً في كل المباني الحكومية في عهد الشيوعية، رماديُّ اللون الإسمنت فيه ظاهر، لاتزيينٌ ولا بهرجة، فقط عناية قصوى للحصول على أكبر مساحة ممكنة بأقل كلفة، مع ذلك تبدو مهيبةً وتبثُّ شعوراً بالرهبة لدى الداخل إليها.
عند المدخل يفتشوننا تفتيشاً دقيقاً مشابهاً لتفتيش المطارات. ثم يُسمح لنا بالدخول، بعد تفتيش الهواتف طبعاً. أدخل التشيب chip الخاص بي في الباب الممكنن فيفتح الباب. إنها الساعة السابعة تماماً. ندخل معاً إلى غرفة الموظفين غير الثابتين، الغرفة تعجُّ بالمترجمين والمحققين من جنسياتٍ عديدة، عربٌ وأكرادٌ وأفغان وإيرانيون، تركٌ وأذربيجانيون إضافةً إلى الصرب، وكل الجنسيات الأخرى التي لديها الكثيرون من طالبي اللجوء في ألمانيا.
يسألني الكثير من المسؤولين والقضاة إن كنتُ أقرأُ وأكتبُ العربية، أستهجنُ السؤال إلى أن اكتشفت أن معظم المترجمين والمحققين من أصول عربية ومولودين في ألمانيا يتكلمون العربية فقط، ولا يستطيعون قراءتها، بالتالي هم غير قادرين على التحقق من المستندات العربية التي تُقدم إلينا من هوياتٍ وجوازات سفرٍ ودفاتر جيش وشهادات ولادة ووفاة، وغيرها من الأوراق والشهادات.
في غرفة الموظفين المتعاقدين أكثر من خمسين شخصاً، الكل مترقبٌ ومتحفز ويحاول إخفاءَ توتره عبر المبالغة بتأدية تحية الصباح، بالابتسام للزملاء والكلام بسرعةٍ وبصوت عالٍ، والكل يتكلم في الوقت نفسه حتى تصبح الغرفة صاخبةً جداً وليس بإمكان أحد سماعَ أيّ أحد فعلياً. لا أدري من الأكثر توتراً في هذه اللحظات، نحن أو اللاجئون.
يستدعيني القاضي زميلي لهذا اليوم كلّه، يحييني قائلاً: لدينا أربع حالات أتوقع أن تكون صعبةً اليوم وحالتان عاديتان بالمبدأ، رجلٌ وزوجته من الموصل، لنبدأ بالمرأة أولاً فهي الأسهل عادةً وبإمكاننا معرفة الكثير عن زوجها والعائلة منها. أتأملُ أن نتمكن من الاستماع إلى ستّ حالاتٍ قبل منتصف الليل، وبذلك نكون قد أنجزنا الكوتا اليومية.
ـ من يدري، أجبتُه، ليلة البارحة أمضيت ستَ ساعاتٍ في تحقيقٍ واحد، كنت فيه كمراقبة، كادت القاضية أن تفقد الوعي من الإجهاد، أنا كدت أنام على الكرسي، وطالب اللجوء ضابطٌ منشقٌّ من الجيش السوري، ما زال يؤلف الرواية بعد الأخرى، ويرفض كل عروضنا بأخذ استراحة.
في غرفةٍ أخرى انهارت إحدى السيدات بعد أكثر من ثماني ساعاتٍ من التحقيق، فاستدعوا الإسعاف لأنها غابت عن الوعي وقد رفضت مراراً أخذ استراحة رغم إلحاح المحقق والقاضي، خوفاً منها من انعكاس ذلك سلباً على قبول طلبها للجوء.
ـ تعالي ننزل إلى صالة الانتظار ونرافق مقدّم الطلب الأول إلى المكتب. تذكري سيدة فريدريش، لا مصافحة، لا لمس أبداً، حتى لو مدّ أحدهم يده للسّلام. حافظي على مسافة مترٍ على الأقل بينك وبين اللاجئين، ولو سمحت، حاولي ألَّا تظهري أيَّ تعاطفٍ أو تأثرٍ مهما حصل، لا تبكي بأيّ حالٍ من الأحوال .أرجوك ألَّا تبكي أمام اللاجئين لأن ذلك سيدمرهم ويحطّ من معنوياتهم.
بقي تعبير وجهي جامداً كلاعبي البوكر، حتى لا أظهرَ استيائي مما قاله، ترى هل كان سيعطي النصائح ذاتها لو كنت زميلاً رجلاً؟؟
ـ ساعاتي يعني شو؟ سويعاتي؟
لا لا يا مدام، حضرتك، ساااعااتيي، بصلح ساعات يعني. اِتعلّمت المصلحة في محل أبويا في إسكندرية، وبعدها جيت ألمانيا من حوالي 33سنة وفتحت محل لتصليح الساعات.
لحدّ دلوقت، كل يوم أحد بعد الكنيسة، بنجتمع كلنا عند أورسولا بناكل تشيلي ونشرب قهوة واللّي عايز يصلح ساعة بيجيبهالي.
ـ لكن يا أنور لجبلك ساعتي الشواروفسكي تصلحها.
نصل إلى المبنى الواقع في ضاحية نائية وفقيرة من برلين الشرقية، مبنيٌّ على الطراز الهندسي الذي كان شائعاً في كل المباني الحكومية في عهد الشيوعية، رماديُّ اللون الإسمنت فيه ظاهر، لاتزيينٌ ولا بهرجة، فقط عناية قصوى للحصول على أكبر مساحة ممكنة بأقل كلفة، مع ذلك تبدو مهيبةً وتبثُّ شعوراً بالرهبة لدى الداخل إليها.
عند المدخل يفتشوننا تفتيشاً دقيقاً مشابهاً لتفتيش المطارات. ثم يُسمح لنا بالدخول، بعد تفتيش الهواتف طبعاً. أدخل التشيب chip الخاص بي في الباب الممكنن فيفتح الباب. إنها الساعة السابعة تماماً. ندخل معاً إلى غرفة الموظفين غير الثابتين، الغرفة تعجُّ بالمترجمين والمحققين من جنسياتٍ عديدة، عربٌ وأكرادٌ وأفغان وإيرانيون، تركٌ وأذربيجانيون إضافةً إلى الصرب، وكل الجنسيات الأخرى التي لديها الكثيرون من طالبي اللجوء في ألمانيا.
يسألني الكثير من المسؤولين والقضاة إن كنتُ أقرأُ وأكتبُ العربية، أستهجنُ السؤال إلى أن اكتشفت أن معظم المترجمين والمحققين من أصول عربية ومولودين في ألمانيا يتكلمون العربية فقط، ولا يستطيعون قراءتها، بالتالي هم غير قادرين على التحقق من المستندات العربية التي تُقدم إلينا من هوياتٍ وجوازات سفرٍ ودفاتر جيش وشهادات ولادة ووفاة، وغيرها من الأوراق والشهادات.
في غرفة الموظفين المتعاقدين أكثر من خمسين شخصاً، الكل مترقبٌ ومتحفز ويحاول إخفاءَ توتره عبر المبالغة بتأدية تحية الصباح، بالابتسام للزملاء والكلام بسرعةٍ وبصوت عالٍ، والكل يتكلم في الوقت نفسه حتى تصبح الغرفة صاخبةً جداً وليس بإمكان أحد سماعَ أيّ أحد فعلياً. لا أدري من الأكثر توتراً في هذه اللحظات، نحن أو اللاجئون.
يستدعيني القاضي زميلي لهذا اليوم كلّه، يحييني قائلاً: لدينا أربع حالات أتوقع أن تكون صعبةً اليوم وحالتان عاديتان بالمبدأ، رجلٌ وزوجته من الموصل، لنبدأ بالمرأة أولاً فهي الأسهل عادةً وبإمكاننا معرفة الكثير عن زوجها والعائلة منها. أتأملُ أن نتمكن من الاستماع إلى ستّ حالاتٍ قبل منتصف الليل، وبذلك نكون قد أنجزنا الكوتا اليومية.
ـ من يدري، أجبتُه، ليلة البارحة أمضيت ستَ ساعاتٍ في تحقيقٍ واحد، كنت فيه كمراقبة، كادت القاضية أن تفقد الوعي من الإجهاد، أنا كدت أنام على الكرسي، وطالب اللجوء ضابطٌ منشقٌّ من الجيش السوري، ما زال يؤلف الرواية بعد الأخرى، ويرفض كل عروضنا بأخذ استراحة.
في غرفةٍ أخرى انهارت إحدى السيدات بعد أكثر من ثماني ساعاتٍ من التحقيق، فاستدعوا الإسعاف لأنها غابت عن الوعي وقد رفضت مراراً أخذ استراحة رغم إلحاح المحقق والقاضي، خوفاً منها من انعكاس ذلك سلباً على قبول طلبها للجوء.
ـ تعالي ننزل إلى صالة الانتظار ونرافق مقدّم الطلب الأول إلى المكتب. تذكري سيدة فريدريش، لا مصافحة، لا لمس أبداً، حتى لو مدّ أحدهم يده للسّلام. حافظي على مسافة مترٍ على الأقل بينك وبين اللاجئين، ولو سمحت، حاولي ألَّا تظهري أيَّ تعاطفٍ أو تأثرٍ مهما حصل، لا تبكي بأيّ حالٍ من الأحوال .أرجوك ألَّا تبكي أمام اللاجئين لأن ذلك سيدمرهم ويحطّ من معنوياتهم.
بقي تعبير وجهي جامداً كلاعبي البوكر، حتى لا أظهرَ استيائي مما قاله، ترى هل كان سيعطي النصائح ذاتها لو كنت زميلاً رجلاً؟؟
 INSIDE_RefugeesGermany
أنادي عالياً على طالب اللجوء بالاسم والشهرة فيقفز شابٌ أسمرٌ ويقترب والخوف والوجل على محيّاه. أرسم على شفتيّ شبه ابتسامةٍ، بقدر ما يسمحُ الظرف والموقف، فأنا أريد طمأنته وتقليلَ خوفه، لكن في الوقت نفسه عليّ ألَّا أفقدَ التعبير المهنيّ المحايد على وجهي. صوتي يقاربُ اللطافةَ ولا يلمسها فعلاً، ما زال هناك نصفُ (تون) بين الصداقة والرسميّة، أحافظُ عليه حتى لا أتعرضَ لانتقادٍ لأني أُظهر تعاطفاً مع أحدِ اللاجئين، أو ما هو أسوأ من ذلك، أنّي عاطفية! غريبٌ أنه ليس من مكانٍ للعواطف في العمل الإنساني.
يمدّ الرجل يده ليصافحَ القاضي، لكن الأخير يكتفي بابتسامةٍ حازمة، ثم يرمقني بنظرةٍ سريعةٍ مرتبكة ولا يلتقي عينيّ أبداً ويمشي معنا. نصعد ثلاثة طوابق مشياً إذ ليس هناك مصاعد في معظم مباني برلين. الصمت ثقيلٌ ومربك. نصل الغرفة 325، ثلاث طاولاتٍ موضوعة بشكل L يجلس القاضي خلف الكومبيوتر ويجلس طالب اللجوء أمامه وأجلس أنا مقابلةً لهما معاً.
ـ على فكرة سيّدة فريدريش، جاءنا اليوم تعميمٌ من الوزارة، التحقيق بات يُدعى "جلسة استماع" أما المحقق فيُسمى "المستمع" والقاضي أصبح "المقرر"، الرجاء اعتماد المصطلحات الجديدة عند التحدث مع "مقدم الطلب".
أرحبُ باللاّجىء قائلةً: أهلاً بك سيد أحمد الدرّ في وكالتنا، السيد باولين سيكون المقرر في قضيتك، وأنا اسمي فريدرش وسأقوم بطرح الأسئلة عليك ومن ثم ننقل ما تقوله إلى الألمانية بدقةٍ تامة حتى يتّخذ المقرِّر قرارَه بمنح اللجوء أو عدمه. لا أنظر الى الأسئلة في التابلت بين يديّ فقد حفظتها جميعاً.
ـ مهلاً هل أنتِ عربيّة؟
يباغتني سؤاله إذ لم أفكرْ بهذا من قبل، فأنا لبنانيةٌ فقط لا غير، لكن هذا العمل الغريب وضعني بمواجهة أسئلةٍ كبيرة ومفتوحة عن الهوية والإثنية والانتماء. قبل أن تتسنى لي الإجابةُ كان قد صرخ بعربيةٍ صحيحةٍ تماماً:
ـ أنا أرفضُ الكلام مع أيّ عربي، قولي للقاضي إنني كردي وأرفض التكلّم بالعربية، فليحضروا لي محققاً ومترجماً كردياً حالاً وهذا حقي.
أنظر إلى القاضي بيأسٍ وعدم فهمٍ وارتباك وأغادر الغرفة. أمشي في الكوريدور الطويل محاولةً ألَّا آخذ هذا الكمّ من الكراهية الذي صُبّ عليّ بشكلٍ شخصيّ، فالرجل لا يعرفني وأنا لم أخطىء بحقِّه. أتّصل بأبي سائلةً: بابا، ما هي مشكلة الأكراد مع العرب تحديداً؟
INSIDE_RefugeesGermany
أنادي عالياً على طالب اللجوء بالاسم والشهرة فيقفز شابٌ أسمرٌ ويقترب والخوف والوجل على محيّاه. أرسم على شفتيّ شبه ابتسامةٍ، بقدر ما يسمحُ الظرف والموقف، فأنا أريد طمأنته وتقليلَ خوفه، لكن في الوقت نفسه عليّ ألَّا أفقدَ التعبير المهنيّ المحايد على وجهي. صوتي يقاربُ اللطافةَ ولا يلمسها فعلاً، ما زال هناك نصفُ (تون) بين الصداقة والرسميّة، أحافظُ عليه حتى لا أتعرضَ لانتقادٍ لأني أُظهر تعاطفاً مع أحدِ اللاجئين، أو ما هو أسوأ من ذلك، أنّي عاطفية! غريبٌ أنه ليس من مكانٍ للعواطف في العمل الإنساني.
يمدّ الرجل يده ليصافحَ القاضي، لكن الأخير يكتفي بابتسامةٍ حازمة، ثم يرمقني بنظرةٍ سريعةٍ مرتبكة ولا يلتقي عينيّ أبداً ويمشي معنا. نصعد ثلاثة طوابق مشياً إذ ليس هناك مصاعد في معظم مباني برلين. الصمت ثقيلٌ ومربك. نصل الغرفة 325، ثلاث طاولاتٍ موضوعة بشكل L يجلس القاضي خلف الكومبيوتر ويجلس طالب اللجوء أمامه وأجلس أنا مقابلةً لهما معاً.
ـ على فكرة سيّدة فريدريش، جاءنا اليوم تعميمٌ من الوزارة، التحقيق بات يُدعى "جلسة استماع" أما المحقق فيُسمى "المستمع" والقاضي أصبح "المقرر"، الرجاء اعتماد المصطلحات الجديدة عند التحدث مع "مقدم الطلب".
أرحبُ باللاّجىء قائلةً: أهلاً بك سيد أحمد الدرّ في وكالتنا، السيد باولين سيكون المقرر في قضيتك، وأنا اسمي فريدرش وسأقوم بطرح الأسئلة عليك ومن ثم ننقل ما تقوله إلى الألمانية بدقةٍ تامة حتى يتّخذ المقرِّر قرارَه بمنح اللجوء أو عدمه. لا أنظر الى الأسئلة في التابلت بين يديّ فقد حفظتها جميعاً.
ـ مهلاً هل أنتِ عربيّة؟
يباغتني سؤاله إذ لم أفكرْ بهذا من قبل، فأنا لبنانيةٌ فقط لا غير، لكن هذا العمل الغريب وضعني بمواجهة أسئلةٍ كبيرة ومفتوحة عن الهوية والإثنية والانتماء. قبل أن تتسنى لي الإجابةُ كان قد صرخ بعربيةٍ صحيحةٍ تماماً:
ـ أنا أرفضُ الكلام مع أيّ عربي، قولي للقاضي إنني كردي وأرفض التكلّم بالعربية، فليحضروا لي محققاً ومترجماً كردياً حالاً وهذا حقي.
أنظر إلى القاضي بيأسٍ وعدم فهمٍ وارتباك وأغادر الغرفة. أمشي في الكوريدور الطويل محاولةً ألَّا آخذ هذا الكمّ من الكراهية الذي صُبّ عليّ بشكلٍ شخصيّ، فالرجل لا يعرفني وأنا لم أخطىء بحقِّه. أتّصل بأبي سائلةً: بابا، ما هي مشكلة الأكراد مع العرب تحديداً؟
 INSIDE_RefugeesGermany2
ـ سيّد بغدادي هل يمكنكَ فهمي وفهم لهجتي جيّدا أثناء الحديث؟
ـ نعم، لكن هناك اختلاف في اللهجة، إنتِ لبنانية ما؟
ـ أجل، لكن من المهم أن أعرفَ إن كنت تفهم كل ما أقول من أجل سير المقابلة.
ـ هسّا إنت لهجتك شوي غريبة بس ماكو مشكلة، لبنان والعراق واحد.
ـ مع ابتسامةٍ خفيفة أقول له: بإذن الله سنتمكن من إجراء المقابلة دون أية مشاكل.
تنظر إليّ القاضية مستفسرةً، فأعلمها أن ليس هناك مشكلةٌ في التواصل بيننا. تنظر إليّ بأن تابعي. هي سيّدةٌ لطيفةٌ في حوالي الأربعين من العمر، أستطيع أن أجزمَ أنها أمٌ مع أنني لا أعرف، من نظرتها التي يلتمع فيها الحنان لصغار السنّ والمراهقين الذين يدخلون الغرفة، من التواطؤ غير المعلن الذي لا تستطيع إخفاءه عند استماعنا إلى الأمهات. في جلستها ونظرتها وقميصها الورديّ الذي يصل تحت الكوعين، كل شيءٍ يشي بالأمومة، حنانٌ مترفع وصامتٌ، موجودٌ كي يذود ويحمي.
أرتاح لوجودها أنا أيضاً وأشكر الله أنّ يوميَ لن يكون كرباً كما لو كان مع قاضٍ من النازيين الجدد أو الروبوتات، أو أسوءِ نوعٍ وهو أولئك الذين "يعيشونها" ظانينَ أنهم أهمّ خبراء بمنطقة الشرق الأوسط وأنهم الذين سيغيرون وجه العالم، وسيوقفون الحرب في سوريا وسيحقّقون السلام في المنطقة بإيجادهم حلّاً للصراع العربي الإسرائيلي.
INSIDE_RefugeesGermany2
ـ سيّد بغدادي هل يمكنكَ فهمي وفهم لهجتي جيّدا أثناء الحديث؟
ـ نعم، لكن هناك اختلاف في اللهجة، إنتِ لبنانية ما؟
ـ أجل، لكن من المهم أن أعرفَ إن كنت تفهم كل ما أقول من أجل سير المقابلة.
ـ هسّا إنت لهجتك شوي غريبة بس ماكو مشكلة، لبنان والعراق واحد.
ـ مع ابتسامةٍ خفيفة أقول له: بإذن الله سنتمكن من إجراء المقابلة دون أية مشاكل.
تنظر إليّ القاضية مستفسرةً، فأعلمها أن ليس هناك مشكلةٌ في التواصل بيننا. تنظر إليّ بأن تابعي. هي سيّدةٌ لطيفةٌ في حوالي الأربعين من العمر، أستطيع أن أجزمَ أنها أمٌ مع أنني لا أعرف، من نظرتها التي يلتمع فيها الحنان لصغار السنّ والمراهقين الذين يدخلون الغرفة، من التواطؤ غير المعلن الذي لا تستطيع إخفاءه عند استماعنا إلى الأمهات. في جلستها ونظرتها وقميصها الورديّ الذي يصل تحت الكوعين، كل شيءٍ يشي بالأمومة، حنانٌ مترفع وصامتٌ، موجودٌ كي يذود ويحمي.
أرتاح لوجودها أنا أيضاً وأشكر الله أنّ يوميَ لن يكون كرباً كما لو كان مع قاضٍ من النازيين الجدد أو الروبوتات، أو أسوءِ نوعٍ وهو أولئك الذين "يعيشونها" ظانينَ أنهم أهمّ خبراء بمنطقة الشرق الأوسط وأنهم الذين سيغيرون وجه العالم، وسيوقفون الحرب في سوريا وسيحقّقون السلام في المنطقة بإيجادهم حلّاً للصراع العربي الإسرائيلي.
أخاف الظلم
الساعة الخامسة والنصف صباحاً يرن جرس المنبه، كان ليلي قصيراً لأنني نادراً ما أنام جيداً حين يكون لدي عملٌ في تحقيقات اللجوء اليومَ التالي. أهو الخوف من القصص الرهيبة التي تنتظرني أم الخوف من الظلم. أرتدي ثيابي عاقدةً العزم أن أعملَ كلَّ ما بوسعي لتوَخّي أقصى درجات التجرد والموضوعية. ليس أمراً سهلاً أبداً في ظل هذا الانقسام الفظيع حول أكبر مأساةٍ إنسانية في التاريخ الحديث. عادةً أستطيع وضع رأسي على مخدتي ليلاً بضميرٍ مرتاح، ما عدا الشعور بالذنب لأنني في فراشٍ دافئ، بأمان، أطفالي أصحاء، ولدينا ما نأكله ونشربه. منذ اليوم الذي نزلتُ فيه إلى قسم العمليات، أصبحتُ أقدّر كل الأشياء التي لم أفكر بها يوماً باعتبار توفرها بديهياً. نحن ننسى أنّه بحصولنا على ضروريات الحياة الأساسية، وعيشنا بحريةٍ من العبودية والتعذيب فقط، نكون محظوظين أكثر من مئات الملايين على هذا الكوكب. INSIDE_RefugeesGermany4
أدرك جيداً أنني مجرد كائنٍ بشري له عواطف وميول وآراء وهواجس، ومن المستحيل أن أصلَ إلى الموضوعية الصِّرفة، فيشلّني التأرجح بين الخوف من الخطأ وبين التوقف عن عملٍ يساعد الآلاف على الهرب من ويلات الحرب والتعذيب، وبدءِ حياةٍ جديدةٍ بأمانٍ وكرامة.
أرتدي ثيابي التي حضّرتها أمس على الكرسي وأنا أحاول إقناعَ نفسي أن من لا يعمل لا يخطئ. بدلتي سوداء مع قميصٍ زهريٍّ فاتح جداً دون أزرار، يغطي الصدر حتى الرقبة. لا مجوهرات، لا مكياج، لا اكسسوارات، لا حقائب ثمينة، حتى الساعة تخليت عنها. أنتعل حذاءً أسوداً قديماً لكنه دافئٌ ومريح من أيام الجامعة، كنت قد جلتُ نصف العالم به. أربط شعري كذيل الحصان و أكتفي برشة Eau de Toilette خفيفة. أنظر في المرآة وأكاد لا أميّز هذه النسخة الشديدة التقشف عن نفسي.
الشيء الوحيد الذي احتفظت به من نفسي هو أظافري الجميلة المطلية بعناية، لا يمكن أبداً أن أخرج بأظافر غير مطليةٍ فعندها سأحسُّ أنني عاريةٌ تماماً. فليكن، هنا أرسم الحدّ الذي إن تجاوزته فسأصبح بعده جزءاً من الكوريدورات الرمادية اللامتناهية، الكراسي والطاولات والنوافذ التي لا لون لها التي تجفف الروح. لقد اقترب عيد الميلاد، والأحمر الجميل على يديّ هو على الأرجح اللون الوحيد الذي سيراه اليوم كل من أعمل معهم في هذا المبنى الكئيب من طالبي لجوءٍ وقضاة ومحققين.
أشرب فنجان الاسبريسو برشفةٍ واحدة وأركض خارجةً إلى الظلام البارد. الساعة في محطة المترو تشير إلى السادسة. نصف ساعةٍ في المترو أصعد بعدها إلى الشارع حيث أنتظر زميلي المصري على الطريق، ليقلّني معه بسيارته إلى الوزارة ، بذلك أوفّر على نفسي نصفَ ساعةٍ إضافية من التنقل بين الباصات. معظمُ المومسات في الطريق قد تقاعدن لهذا اليوم ما عدا عددٍ قليل منهنّ ما زلن يقفن بانتظار الزبائن. كل ما أفكر فيه هو كيف يمكنهنّ الوقوف على الطريق شبهَ عارياتٍ في هذا البرد؟
INSIDE_RefugeesGermany4
أدرك جيداً أنني مجرد كائنٍ بشري له عواطف وميول وآراء وهواجس، ومن المستحيل أن أصلَ إلى الموضوعية الصِّرفة، فيشلّني التأرجح بين الخوف من الخطأ وبين التوقف عن عملٍ يساعد الآلاف على الهرب من ويلات الحرب والتعذيب، وبدءِ حياةٍ جديدةٍ بأمانٍ وكرامة.
أرتدي ثيابي التي حضّرتها أمس على الكرسي وأنا أحاول إقناعَ نفسي أن من لا يعمل لا يخطئ. بدلتي سوداء مع قميصٍ زهريٍّ فاتح جداً دون أزرار، يغطي الصدر حتى الرقبة. لا مجوهرات، لا مكياج، لا اكسسوارات، لا حقائب ثمينة، حتى الساعة تخليت عنها. أنتعل حذاءً أسوداً قديماً لكنه دافئٌ ومريح من أيام الجامعة، كنت قد جلتُ نصف العالم به. أربط شعري كذيل الحصان و أكتفي برشة Eau de Toilette خفيفة. أنظر في المرآة وأكاد لا أميّز هذه النسخة الشديدة التقشف عن نفسي.
الشيء الوحيد الذي احتفظت به من نفسي هو أظافري الجميلة المطلية بعناية، لا يمكن أبداً أن أخرج بأظافر غير مطليةٍ فعندها سأحسُّ أنني عاريةٌ تماماً. فليكن، هنا أرسم الحدّ الذي إن تجاوزته فسأصبح بعده جزءاً من الكوريدورات الرمادية اللامتناهية، الكراسي والطاولات والنوافذ التي لا لون لها التي تجفف الروح. لقد اقترب عيد الميلاد، والأحمر الجميل على يديّ هو على الأرجح اللون الوحيد الذي سيراه اليوم كل من أعمل معهم في هذا المبنى الكئيب من طالبي لجوءٍ وقضاة ومحققين.
أشرب فنجان الاسبريسو برشفةٍ واحدة وأركض خارجةً إلى الظلام البارد. الساعة في محطة المترو تشير إلى السادسة. نصف ساعةٍ في المترو أصعد بعدها إلى الشارع حيث أنتظر زميلي المصري على الطريق، ليقلّني معه بسيارته إلى الوزارة ، بذلك أوفّر على نفسي نصفَ ساعةٍ إضافية من التنقل بين الباصات. معظمُ المومسات في الطريق قد تقاعدن لهذا اليوم ما عدا عددٍ قليل منهنّ ما زلن يقفن بانتظار الزبائن. كل ما أفكر فيه هو كيف يمكنهنّ الوقوف على الطريق شبهَ عارياتٍ في هذا البرد؟
لو كنت رجلاً
يركنُ زميلي سيارته في الطابق السادس من موقف السيارات الملحق بمبنى الوزارة. هو مصريٌّ قبطيّ في الخامسة والستين من العمر، كل أعراض التقاعد من طريقة الكلام إلى الملل مع استمرار الرغبة بالعمل والوجود والنشاط، تدبُّ في الروح والجسد. نتحدث ونحن نمشي صوب مبنى الوزارة. "تعرفي يا صوفي، أنا لحد دلوقتي مش مصدق إنّي أنا بعمل في الشغل ده، بعد كل السنين دي، ده أنا ساعاتي ابن ساعاتي. الشغل ده وجدني وأنا وجدت نفسي بيه". ـ ساعاتي يعني شو؟ سويعاتي؟
لا لا يا مدام، حضرتك، ساااعااتيي، بصلح ساعات يعني. اِتعلّمت المصلحة في محل أبويا في إسكندرية، وبعدها جيت ألمانيا من حوالي 33سنة وفتحت محل لتصليح الساعات.
لحدّ دلوقت، كل يوم أحد بعد الكنيسة، بنجتمع كلنا عند أورسولا بناكل تشيلي ونشرب قهوة واللّي عايز يصلح ساعة بيجيبهالي.
ـ لكن يا أنور لجبلك ساعتي الشواروفسكي تصلحها.
نصل إلى المبنى الواقع في ضاحية نائية وفقيرة من برلين الشرقية، مبنيٌّ على الطراز الهندسي الذي كان شائعاً في كل المباني الحكومية في عهد الشيوعية، رماديُّ اللون الإسمنت فيه ظاهر، لاتزيينٌ ولا بهرجة، فقط عناية قصوى للحصول على أكبر مساحة ممكنة بأقل كلفة، مع ذلك تبدو مهيبةً وتبثُّ شعوراً بالرهبة لدى الداخل إليها.
عند المدخل يفتشوننا تفتيشاً دقيقاً مشابهاً لتفتيش المطارات. ثم يُسمح لنا بالدخول، بعد تفتيش الهواتف طبعاً. أدخل التشيب chip الخاص بي في الباب الممكنن فيفتح الباب. إنها الساعة السابعة تماماً. ندخل معاً إلى غرفة الموظفين غير الثابتين، الغرفة تعجُّ بالمترجمين والمحققين من جنسياتٍ عديدة، عربٌ وأكرادٌ وأفغان وإيرانيون، تركٌ وأذربيجانيون إضافةً إلى الصرب، وكل الجنسيات الأخرى التي لديها الكثيرون من طالبي اللجوء في ألمانيا.
يسألني الكثير من المسؤولين والقضاة إن كنتُ أقرأُ وأكتبُ العربية، أستهجنُ السؤال إلى أن اكتشفت أن معظم المترجمين والمحققين من أصول عربية ومولودين في ألمانيا يتكلمون العربية فقط، ولا يستطيعون قراءتها، بالتالي هم غير قادرين على التحقق من المستندات العربية التي تُقدم إلينا من هوياتٍ وجوازات سفرٍ ودفاتر جيش وشهادات ولادة ووفاة، وغيرها من الأوراق والشهادات.
في غرفة الموظفين المتعاقدين أكثر من خمسين شخصاً، الكل مترقبٌ ومتحفز ويحاول إخفاءَ توتره عبر المبالغة بتأدية تحية الصباح، بالابتسام للزملاء والكلام بسرعةٍ وبصوت عالٍ، والكل يتكلم في الوقت نفسه حتى تصبح الغرفة صاخبةً جداً وليس بإمكان أحد سماعَ أيّ أحد فعلياً. لا أدري من الأكثر توتراً في هذه اللحظات، نحن أو اللاجئون.
يستدعيني القاضي زميلي لهذا اليوم كلّه، يحييني قائلاً: لدينا أربع حالات أتوقع أن تكون صعبةً اليوم وحالتان عاديتان بالمبدأ، رجلٌ وزوجته من الموصل، لنبدأ بالمرأة أولاً فهي الأسهل عادةً وبإمكاننا معرفة الكثير عن زوجها والعائلة منها. أتأملُ أن نتمكن من الاستماع إلى ستّ حالاتٍ قبل منتصف الليل، وبذلك نكون قد أنجزنا الكوتا اليومية.
ـ من يدري، أجبتُه، ليلة البارحة أمضيت ستَ ساعاتٍ في تحقيقٍ واحد، كنت فيه كمراقبة، كادت القاضية أن تفقد الوعي من الإجهاد، أنا كدت أنام على الكرسي، وطالب اللجوء ضابطٌ منشقٌّ من الجيش السوري، ما زال يؤلف الرواية بعد الأخرى، ويرفض كل عروضنا بأخذ استراحة.
في غرفةٍ أخرى انهارت إحدى السيدات بعد أكثر من ثماني ساعاتٍ من التحقيق، فاستدعوا الإسعاف لأنها غابت عن الوعي وقد رفضت مراراً أخذ استراحة رغم إلحاح المحقق والقاضي، خوفاً منها من انعكاس ذلك سلباً على قبول طلبها للجوء.
ـ تعالي ننزل إلى صالة الانتظار ونرافق مقدّم الطلب الأول إلى المكتب. تذكري سيدة فريدريش، لا مصافحة، لا لمس أبداً، حتى لو مدّ أحدهم يده للسّلام. حافظي على مسافة مترٍ على الأقل بينك وبين اللاجئين، ولو سمحت، حاولي ألَّا تظهري أيَّ تعاطفٍ أو تأثرٍ مهما حصل، لا تبكي بأيّ حالٍ من الأحوال .أرجوك ألَّا تبكي أمام اللاجئين لأن ذلك سيدمرهم ويحطّ من معنوياتهم.
بقي تعبير وجهي جامداً كلاعبي البوكر، حتى لا أظهرَ استيائي مما قاله، ترى هل كان سيعطي النصائح ذاتها لو كنت زميلاً رجلاً؟؟
ـ ساعاتي يعني شو؟ سويعاتي؟
لا لا يا مدام، حضرتك، ساااعااتيي، بصلح ساعات يعني. اِتعلّمت المصلحة في محل أبويا في إسكندرية، وبعدها جيت ألمانيا من حوالي 33سنة وفتحت محل لتصليح الساعات.
لحدّ دلوقت، كل يوم أحد بعد الكنيسة، بنجتمع كلنا عند أورسولا بناكل تشيلي ونشرب قهوة واللّي عايز يصلح ساعة بيجيبهالي.
ـ لكن يا أنور لجبلك ساعتي الشواروفسكي تصلحها.
نصل إلى المبنى الواقع في ضاحية نائية وفقيرة من برلين الشرقية، مبنيٌّ على الطراز الهندسي الذي كان شائعاً في كل المباني الحكومية في عهد الشيوعية، رماديُّ اللون الإسمنت فيه ظاهر، لاتزيينٌ ولا بهرجة، فقط عناية قصوى للحصول على أكبر مساحة ممكنة بأقل كلفة، مع ذلك تبدو مهيبةً وتبثُّ شعوراً بالرهبة لدى الداخل إليها.
عند المدخل يفتشوننا تفتيشاً دقيقاً مشابهاً لتفتيش المطارات. ثم يُسمح لنا بالدخول، بعد تفتيش الهواتف طبعاً. أدخل التشيب chip الخاص بي في الباب الممكنن فيفتح الباب. إنها الساعة السابعة تماماً. ندخل معاً إلى غرفة الموظفين غير الثابتين، الغرفة تعجُّ بالمترجمين والمحققين من جنسياتٍ عديدة، عربٌ وأكرادٌ وأفغان وإيرانيون، تركٌ وأذربيجانيون إضافةً إلى الصرب، وكل الجنسيات الأخرى التي لديها الكثيرون من طالبي اللجوء في ألمانيا.
يسألني الكثير من المسؤولين والقضاة إن كنتُ أقرأُ وأكتبُ العربية، أستهجنُ السؤال إلى أن اكتشفت أن معظم المترجمين والمحققين من أصول عربية ومولودين في ألمانيا يتكلمون العربية فقط، ولا يستطيعون قراءتها، بالتالي هم غير قادرين على التحقق من المستندات العربية التي تُقدم إلينا من هوياتٍ وجوازات سفرٍ ودفاتر جيش وشهادات ولادة ووفاة، وغيرها من الأوراق والشهادات.
في غرفة الموظفين المتعاقدين أكثر من خمسين شخصاً، الكل مترقبٌ ومتحفز ويحاول إخفاءَ توتره عبر المبالغة بتأدية تحية الصباح، بالابتسام للزملاء والكلام بسرعةٍ وبصوت عالٍ، والكل يتكلم في الوقت نفسه حتى تصبح الغرفة صاخبةً جداً وليس بإمكان أحد سماعَ أيّ أحد فعلياً. لا أدري من الأكثر توتراً في هذه اللحظات، نحن أو اللاجئون.
يستدعيني القاضي زميلي لهذا اليوم كلّه، يحييني قائلاً: لدينا أربع حالات أتوقع أن تكون صعبةً اليوم وحالتان عاديتان بالمبدأ، رجلٌ وزوجته من الموصل، لنبدأ بالمرأة أولاً فهي الأسهل عادةً وبإمكاننا معرفة الكثير عن زوجها والعائلة منها. أتأملُ أن نتمكن من الاستماع إلى ستّ حالاتٍ قبل منتصف الليل، وبذلك نكون قد أنجزنا الكوتا اليومية.
ـ من يدري، أجبتُه، ليلة البارحة أمضيت ستَ ساعاتٍ في تحقيقٍ واحد، كنت فيه كمراقبة، كادت القاضية أن تفقد الوعي من الإجهاد، أنا كدت أنام على الكرسي، وطالب اللجوء ضابطٌ منشقٌّ من الجيش السوري، ما زال يؤلف الرواية بعد الأخرى، ويرفض كل عروضنا بأخذ استراحة.
في غرفةٍ أخرى انهارت إحدى السيدات بعد أكثر من ثماني ساعاتٍ من التحقيق، فاستدعوا الإسعاف لأنها غابت عن الوعي وقد رفضت مراراً أخذ استراحة رغم إلحاح المحقق والقاضي، خوفاً منها من انعكاس ذلك سلباً على قبول طلبها للجوء.
ـ تعالي ننزل إلى صالة الانتظار ونرافق مقدّم الطلب الأول إلى المكتب. تذكري سيدة فريدريش، لا مصافحة، لا لمس أبداً، حتى لو مدّ أحدهم يده للسّلام. حافظي على مسافة مترٍ على الأقل بينك وبين اللاجئين، ولو سمحت، حاولي ألَّا تظهري أيَّ تعاطفٍ أو تأثرٍ مهما حصل، لا تبكي بأيّ حالٍ من الأحوال .أرجوك ألَّا تبكي أمام اللاجئين لأن ذلك سيدمرهم ويحطّ من معنوياتهم.
بقي تعبير وجهي جامداً كلاعبي البوكر، حتى لا أظهرَ استيائي مما قاله، ترى هل كان سيعطي النصائح ذاتها لو كنت زميلاً رجلاً؟؟
لبنانية فقط لا غير
نزلنا إلى الطابق الأرضي أنا والقاضي لاستدعاء اللّاجئ التّالي. قاعةُ الانتظار شبيهةٌ بقاعات الانتظار في المطارات القديمة والمهترئة، الكراسي لا تتسع للجميع، الكثير منهم واقفون، البعض يجلسون على الأرض. عائلاتٌ بأكملها حتى الرضَّع يحملونهم معهم من المأوى الى التحقيق. فوضى وَضجّة، نضّطر لأن ننادي عالياً حتى يسمعنا الشخص. INSIDE_RefugeesGermany
أنادي عالياً على طالب اللجوء بالاسم والشهرة فيقفز شابٌ أسمرٌ ويقترب والخوف والوجل على محيّاه. أرسم على شفتيّ شبه ابتسامةٍ، بقدر ما يسمحُ الظرف والموقف، فأنا أريد طمأنته وتقليلَ خوفه، لكن في الوقت نفسه عليّ ألَّا أفقدَ التعبير المهنيّ المحايد على وجهي. صوتي يقاربُ اللطافةَ ولا يلمسها فعلاً، ما زال هناك نصفُ (تون) بين الصداقة والرسميّة، أحافظُ عليه حتى لا أتعرضَ لانتقادٍ لأني أُظهر تعاطفاً مع أحدِ اللاجئين، أو ما هو أسوأ من ذلك، أنّي عاطفية! غريبٌ أنه ليس من مكانٍ للعواطف في العمل الإنساني.
يمدّ الرجل يده ليصافحَ القاضي، لكن الأخير يكتفي بابتسامةٍ حازمة، ثم يرمقني بنظرةٍ سريعةٍ مرتبكة ولا يلتقي عينيّ أبداً ويمشي معنا. نصعد ثلاثة طوابق مشياً إذ ليس هناك مصاعد في معظم مباني برلين. الصمت ثقيلٌ ومربك. نصل الغرفة 325، ثلاث طاولاتٍ موضوعة بشكل L يجلس القاضي خلف الكومبيوتر ويجلس طالب اللجوء أمامه وأجلس أنا مقابلةً لهما معاً.
ـ على فكرة سيّدة فريدريش، جاءنا اليوم تعميمٌ من الوزارة، التحقيق بات يُدعى "جلسة استماع" أما المحقق فيُسمى "المستمع" والقاضي أصبح "المقرر"، الرجاء اعتماد المصطلحات الجديدة عند التحدث مع "مقدم الطلب".
أرحبُ باللاّجىء قائلةً: أهلاً بك سيد أحمد الدرّ في وكالتنا، السيد باولين سيكون المقرر في قضيتك، وأنا اسمي فريدرش وسأقوم بطرح الأسئلة عليك ومن ثم ننقل ما تقوله إلى الألمانية بدقةٍ تامة حتى يتّخذ المقرِّر قرارَه بمنح اللجوء أو عدمه. لا أنظر الى الأسئلة في التابلت بين يديّ فقد حفظتها جميعاً.
ـ مهلاً هل أنتِ عربيّة؟
يباغتني سؤاله إذ لم أفكرْ بهذا من قبل، فأنا لبنانيةٌ فقط لا غير، لكن هذا العمل الغريب وضعني بمواجهة أسئلةٍ كبيرة ومفتوحة عن الهوية والإثنية والانتماء. قبل أن تتسنى لي الإجابةُ كان قد صرخ بعربيةٍ صحيحةٍ تماماً:
ـ أنا أرفضُ الكلام مع أيّ عربي، قولي للقاضي إنني كردي وأرفض التكلّم بالعربية، فليحضروا لي محققاً ومترجماً كردياً حالاً وهذا حقي.
أنظر إلى القاضي بيأسٍ وعدم فهمٍ وارتباك وأغادر الغرفة. أمشي في الكوريدور الطويل محاولةً ألَّا آخذ هذا الكمّ من الكراهية الذي صُبّ عليّ بشكلٍ شخصيّ، فالرجل لا يعرفني وأنا لم أخطىء بحقِّه. أتّصل بأبي سائلةً: بابا، ما هي مشكلة الأكراد مع العرب تحديداً؟
INSIDE_RefugeesGermany
أنادي عالياً على طالب اللجوء بالاسم والشهرة فيقفز شابٌ أسمرٌ ويقترب والخوف والوجل على محيّاه. أرسم على شفتيّ شبه ابتسامةٍ، بقدر ما يسمحُ الظرف والموقف، فأنا أريد طمأنته وتقليلَ خوفه، لكن في الوقت نفسه عليّ ألَّا أفقدَ التعبير المهنيّ المحايد على وجهي. صوتي يقاربُ اللطافةَ ولا يلمسها فعلاً، ما زال هناك نصفُ (تون) بين الصداقة والرسميّة، أحافظُ عليه حتى لا أتعرضَ لانتقادٍ لأني أُظهر تعاطفاً مع أحدِ اللاجئين، أو ما هو أسوأ من ذلك، أنّي عاطفية! غريبٌ أنه ليس من مكانٍ للعواطف في العمل الإنساني.
يمدّ الرجل يده ليصافحَ القاضي، لكن الأخير يكتفي بابتسامةٍ حازمة، ثم يرمقني بنظرةٍ سريعةٍ مرتبكة ولا يلتقي عينيّ أبداً ويمشي معنا. نصعد ثلاثة طوابق مشياً إذ ليس هناك مصاعد في معظم مباني برلين. الصمت ثقيلٌ ومربك. نصل الغرفة 325، ثلاث طاولاتٍ موضوعة بشكل L يجلس القاضي خلف الكومبيوتر ويجلس طالب اللجوء أمامه وأجلس أنا مقابلةً لهما معاً.
ـ على فكرة سيّدة فريدريش، جاءنا اليوم تعميمٌ من الوزارة، التحقيق بات يُدعى "جلسة استماع" أما المحقق فيُسمى "المستمع" والقاضي أصبح "المقرر"، الرجاء اعتماد المصطلحات الجديدة عند التحدث مع "مقدم الطلب".
أرحبُ باللاّجىء قائلةً: أهلاً بك سيد أحمد الدرّ في وكالتنا، السيد باولين سيكون المقرر في قضيتك، وأنا اسمي فريدرش وسأقوم بطرح الأسئلة عليك ومن ثم ننقل ما تقوله إلى الألمانية بدقةٍ تامة حتى يتّخذ المقرِّر قرارَه بمنح اللجوء أو عدمه. لا أنظر الى الأسئلة في التابلت بين يديّ فقد حفظتها جميعاً.
ـ مهلاً هل أنتِ عربيّة؟
يباغتني سؤاله إذ لم أفكرْ بهذا من قبل، فأنا لبنانيةٌ فقط لا غير، لكن هذا العمل الغريب وضعني بمواجهة أسئلةٍ كبيرة ومفتوحة عن الهوية والإثنية والانتماء. قبل أن تتسنى لي الإجابةُ كان قد صرخ بعربيةٍ صحيحةٍ تماماً:
ـ أنا أرفضُ الكلام مع أيّ عربي، قولي للقاضي إنني كردي وأرفض التكلّم بالعربية، فليحضروا لي محققاً ومترجماً كردياً حالاً وهذا حقي.
أنظر إلى القاضي بيأسٍ وعدم فهمٍ وارتباك وأغادر الغرفة. أمشي في الكوريدور الطويل محاولةً ألَّا آخذ هذا الكمّ من الكراهية الذي صُبّ عليّ بشكلٍ شخصيّ، فالرجل لا يعرفني وأنا لم أخطىء بحقِّه. أتّصل بأبي سائلةً: بابا، ما هي مشكلة الأكراد مع العرب تحديداً؟
"أنا أرفض الكلام مع أي عربي، قولي للقاضي إنني كردي وأرفض التكلّم بالعربية".. نظرتُ إلى القاضي بيأسٍ، وغادرتُ الغرفة، واتصلتُ بأبي سائلة: بابا، ما هي مشكلةُ الأكراد مع العرب تحديداً؟
تذكري سيدة فريدريش.. لا مصافحة، لا لمس أبداً، حتى لو مدّ أحدهم يده للسّلام. حافظي على مسافة مترٍ على الأقل بينك وبين اللاجئين، ولو سمحتِ، حاولي ألَّا تظهري أيَّ تعاطفٍ أو تأثرٍ مهما حصل. لا تبكي بأيّ حالٍ من الأحوال!
امرأتان.. ترتديان الوردي
ـ أهلاً بك سيد حسن البغدادي في جلسة الاستماع خاصّتك. هل لديك مشكلةٌ أنّ المستمعةَ لقضيّتك والمقرّرةَ، امرأتان؟ ينظر إليّ بحيرةٍ من سؤالي، فأشرح: هل هناك أشياءٌ ليس باستطاعتك أن تقولها لنا، ولكنك قد تقولها، أو ستقولها، في حال كان المحققان رجلَين؟ ـ لا لا يا أختي، ولم لا أرضى بامرأة، فأنا جئت إلى هذه الدنيا من امرأة. ـ حسناً ،لا مشكلة لدى مقدم الطلب بكوننا نساء، أترجم للقاضية، وأنا أحس بالاشمئزاز لأنني مضطرةٌ أن أطرحَ سؤالاً مهيناَ لي بالدرجة الأولى ولكل النساء، لاعنةَ السّاعة التي قبلت فيها العمل في هذه الإدارة، متسائلة إن كنتُ أنا شديدةَ الحساسية أم هي الحكومة أذعنت لقيَمِ بعض اللّاجئين الذكورية، مع أنها في موقعٍ يسمح بإجبارهم على قبول قيَم البلد الذي يطلبون اللجوء إليه، ولو شكليّآً. لا أتخيّل أنه لو كنت في بلدي الأمّ أعمل لدى أيّة إدارة رسمية أنني كنت سأتعرّض لمذلّة سؤال ذكرٍ ما، إن كان بإمكاني إنجاز معاملته لأنني أنثى، أو أنه يفضل موظفاً ذكراً عليّ! هل تخلّت أوروبا عن أنوارها وعادت للقرون الوسطى؟ لماذا فقد الغرب ثقته بقيمه، وأفسح مجالاً للإسلاميين بأن يدخلوا للمجتمع المتنوّر أفكاراً تنتمي إلى عصور الظلام؟ أليست المعركة مع الإرهاب معركةً قيميّةً أخلاقيّة بالدرجة الأولى؟ الوحدة والعزلة جفّفتا روح أوروبا العلمانية المنفتحة. أمستْ أوروبا وحيدةً وفريدةَ في ليبراليتها في هذا العالم الذي يزداد تعصّباً وتقوقعاً يوماً بعد يوم، فهل تستسلم قلعة الحريّة لحصار الظلام؟ INSIDE_RefugeesGermany2
ـ سيّد بغدادي هل يمكنكَ فهمي وفهم لهجتي جيّدا أثناء الحديث؟
ـ نعم، لكن هناك اختلاف في اللهجة، إنتِ لبنانية ما؟
ـ أجل، لكن من المهم أن أعرفَ إن كنت تفهم كل ما أقول من أجل سير المقابلة.
ـ هسّا إنت لهجتك شوي غريبة بس ماكو مشكلة، لبنان والعراق واحد.
ـ مع ابتسامةٍ خفيفة أقول له: بإذن الله سنتمكن من إجراء المقابلة دون أية مشاكل.
تنظر إليّ القاضية مستفسرةً، فأعلمها أن ليس هناك مشكلةٌ في التواصل بيننا. تنظر إليّ بأن تابعي. هي سيّدةٌ لطيفةٌ في حوالي الأربعين من العمر، أستطيع أن أجزمَ أنها أمٌ مع أنني لا أعرف، من نظرتها التي يلتمع فيها الحنان لصغار السنّ والمراهقين الذين يدخلون الغرفة، من التواطؤ غير المعلن الذي لا تستطيع إخفاءه عند استماعنا إلى الأمهات. في جلستها ونظرتها وقميصها الورديّ الذي يصل تحت الكوعين، كل شيءٍ يشي بالأمومة، حنانٌ مترفع وصامتٌ، موجودٌ كي يذود ويحمي.
أرتاح لوجودها أنا أيضاً وأشكر الله أنّ يوميَ لن يكون كرباً كما لو كان مع قاضٍ من النازيين الجدد أو الروبوتات، أو أسوءِ نوعٍ وهو أولئك الذين "يعيشونها" ظانينَ أنهم أهمّ خبراء بمنطقة الشرق الأوسط وأنهم الذين سيغيرون وجه العالم، وسيوقفون الحرب في سوريا وسيحقّقون السلام في المنطقة بإيجادهم حلّاً للصراع العربي الإسرائيلي.
INSIDE_RefugeesGermany2
ـ سيّد بغدادي هل يمكنكَ فهمي وفهم لهجتي جيّدا أثناء الحديث؟
ـ نعم، لكن هناك اختلاف في اللهجة، إنتِ لبنانية ما؟
ـ أجل، لكن من المهم أن أعرفَ إن كنت تفهم كل ما أقول من أجل سير المقابلة.
ـ هسّا إنت لهجتك شوي غريبة بس ماكو مشكلة، لبنان والعراق واحد.
ـ مع ابتسامةٍ خفيفة أقول له: بإذن الله سنتمكن من إجراء المقابلة دون أية مشاكل.
تنظر إليّ القاضية مستفسرةً، فأعلمها أن ليس هناك مشكلةٌ في التواصل بيننا. تنظر إليّ بأن تابعي. هي سيّدةٌ لطيفةٌ في حوالي الأربعين من العمر، أستطيع أن أجزمَ أنها أمٌ مع أنني لا أعرف، من نظرتها التي يلتمع فيها الحنان لصغار السنّ والمراهقين الذين يدخلون الغرفة، من التواطؤ غير المعلن الذي لا تستطيع إخفاءه عند استماعنا إلى الأمهات. في جلستها ونظرتها وقميصها الورديّ الذي يصل تحت الكوعين، كل شيءٍ يشي بالأمومة، حنانٌ مترفع وصامتٌ، موجودٌ كي يذود ويحمي.
أرتاح لوجودها أنا أيضاً وأشكر الله أنّ يوميَ لن يكون كرباً كما لو كان مع قاضٍ من النازيين الجدد أو الروبوتات، أو أسوءِ نوعٍ وهو أولئك الذين "يعيشونها" ظانينَ أنهم أهمّ خبراء بمنطقة الشرق الأوسط وأنهم الذين سيغيرون وجه العالم، وسيوقفون الحرب في سوريا وسيحقّقون السلام في المنطقة بإيجادهم حلّاً للصراع العربي الإسرائيلي.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.