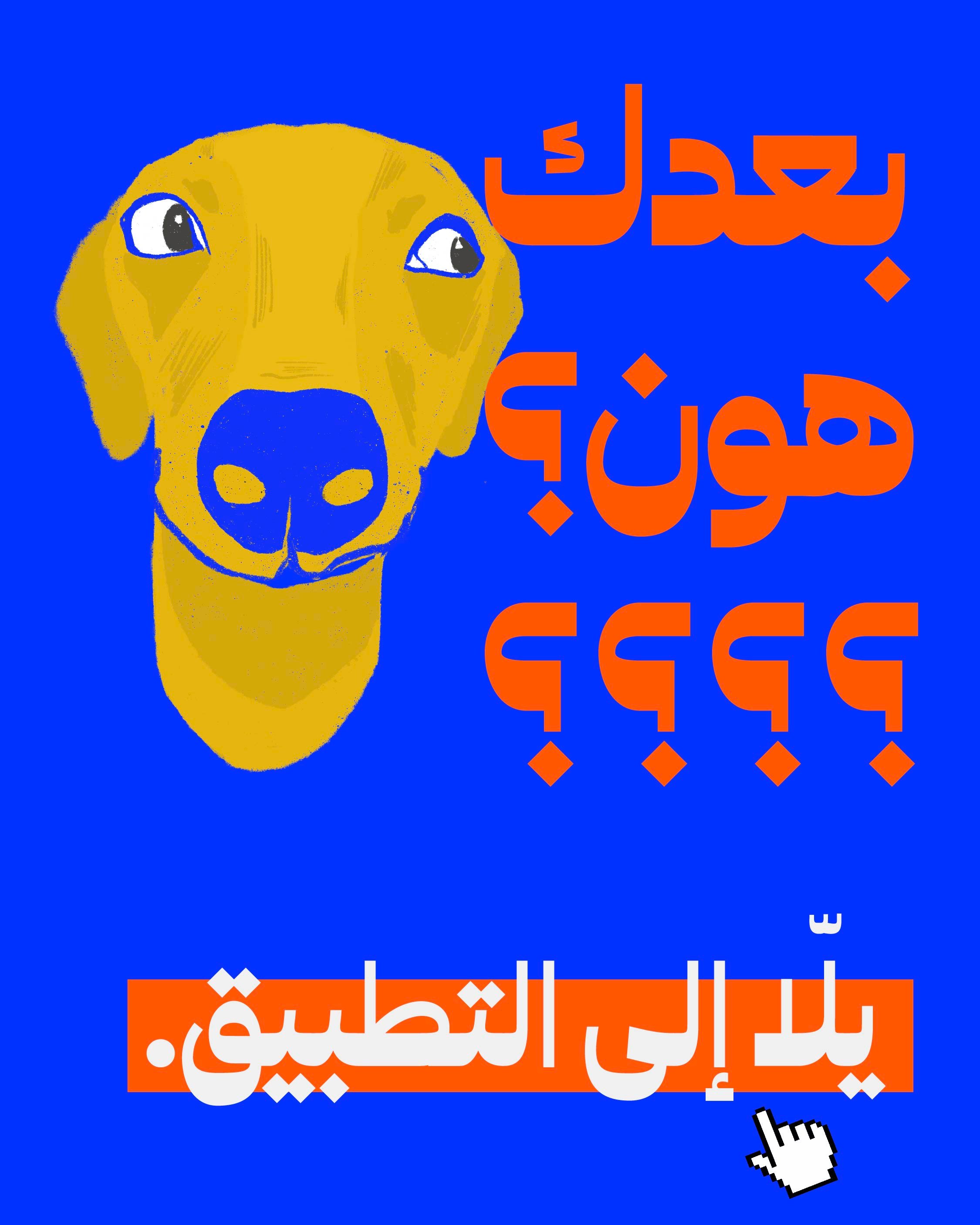فاجأ المخرج السعودي علي سعيد جمهور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته رقم 46 بفيلمه "ضد السينما"، وهو فيلم وثائقي طويل يرصد حكاية الجيل الذي وُلد في بدايات الثمانينيات في المملكة، ويتابع تعاطيه مع السينما في الوقت الذي لم تكن فيه دور عرض عامة يمكن ارتيادها.
يعتمد الفيلم بصورة رئيسية على الصوت الشخصي لمخرجه الذي يحكي تجربة اكتشافه لشريط الصورة وقصته مع كاميرا فيديو أتاحها له والده لتصوير مناسبات عائلية، ثم يعود لرسم الخطوط الرئيسية التي صنعت تاريخ السينما السعودية، وهي تبدو مجهولة لغالبية المشاهدين، وذلك استناداً إلى شهادات الرواة الذين صنعوا هذا التاريخ وناضلوا لأجله.
قبل خمس سنوات من هذا الفيلم قدّم سعيد فيلمه "رقم هاتف قديم" ونال عدداً من الجوائز، منها جائزة أفضل فيلم روائي قصير في مسابقة الأفلام العربية في مهرجان البحرين السينمائي.
ونظراً إلى طابعه المثير حظي فيلم "ضد السينما" باهتمام كبير من النقاد العرب الذين تابعوا عرضه داخل مهرجان القاهرة السينمائي، كما وجد تفاعلاً من الجمهور الذي انتبه لمفارقات وطرائف وردت في شهادات الرواة، وحفلت الندوة التي أعقبت الفيلم بإشادات متعددة بالفيلم وموضوعه.
سعيد الذي درس الصحافة في دمشق وعمل لسنوات محرراً أدبياً، لجأ هذه المرة إلى روايته الشخصية لكشف أزمة جيله والأجيال التي تلته في نيل فرصتها في حق مشاهدة فيلم داخل دار عرض سينمائي وليس داخل غرفة مغلقة.
"عيال الثمانينات"
ينتمي فيلم "ضد السينما" إلى السينما الوثائقية، ورغم أنه طويل نسبياً (يزيد على 118 دقيقة)، فإنه يحفل بالانتقالات المهمة والشهادات التي تكشف أمام المشاهد ما يجهله عن السعودية التي تعيش اليوم فترة تغيير تحتاج إلى مكاشفة مع تاريخها مع المحظورات، وهذا ما سعى الفيلم إلى إبرازه استناداً إلى ذاكرة شخصية لا تنفصل عن التاريخ العمومي أو الذاكرة بحسب فهم المنظر الفرنسي بول ريكور. .
الأهم أن الفيلم يصحّح معلومة ظلت تتكرر في الموسوعات، بعدما رسّخ لها المؤرخ جورج سادول صاحب كتاب "تاريخ السينما في العالم"، وأكد فيها: أن الجزيرة العربية ظلت هي البقعة الوحيدة التي تجهل السينما حتى منتصف القرن العشرين.
انطلقت رحلة علي سعيد، التي استمرت خمس سنوات، من تلك المفارقة التي تعامل معها كخرق في نسيج اجتماعي يعرف تاريخه غير المتداول، لذلك انشغل بطبيعة الحياة الاجتماعية قبل السماح بافتتاح صالات السينما في السعودية خلال السنوات الأخيرة.
يعبر صوت الراوي عن جيل يسميه المخرج "عيال الثمانينات" الذين دفعوا أثمان "ذهنية التحريم" ومن ثم كانت لهم خصوصية مؤثرة، وبفضل الفيديو كوسيط تكنولوجي نشأ هؤلاء على حب الأفلام، لكن لم يتحول ارتياد دور العرض إلى طقس اجتماعي أو نزهة كما هو الحال في مجتمعات أخرى
بحسّ الصحافي الراسخ داخله، سأل سعيد عن الكيفية التي تشكّلت من خلالها الذائقة السينمائية للأجيال السابقة وكيف تغلّبت على سنوات الحظر والرقابة التي تنوّعت بين الرقابة الدينية والمجتمعية، خصوصاً إلى أن تراجعت هذه الرقابة مع التحولات التي شهدتها السعودية اعتباراً من 2018 .
يرى سعيد أن التغييرات الأخيرة غمرت المجتمع، لكنها قامت على شيء من النسيان الثقافي الذي أُهدرت معه الذاكرة التي كانت موجودة قبل السبعينيات.
تخيّل البعض أن السعوديين عاشوا تاريخهم المعاصر دون فن أو إبداع أو غناء، لذلك يواجه الفيلم هذا التغييب بالكشف عمّا هو غائب ومطمور عن قصد، لأن فكرة المنع مغرية بذاتها.
يكشف سعيد عبر فيلمه الكثير من التاريخ المجهول، ويزيل الركام عن تواريخ وأرشيفات مهملة، ويؤرخ لظواهر أساسية كانت موجودة مثل "سينما الأحواش" التي رافقت عملية التحديث التي نهضت بها شركة أرامكو، إلى أن جاء زمن محال الفيديو، وأعقبه بعد سنوات تأسيس أول مهرجان للفيلم السعودي القصير عام 2008.
يبدو من الفيلم أن السينما السعودية ليست لها "تجربة مكتملة" مماثلة لما لدى بلدان أخرى، لكن ما لدى السعوديين هو تاريخ من التضاد مع السينما ووجودها في المجال العام.
يعبر صوت الراوي عن جيل يسميه المخرج "عيال الثمانينات" الذين دفعوا أثمان "ذهنية التحريم" ومن ثم كانت لهم خصوصية مؤثرة، وبفضل الفيديو كوسيط تكنولوجي نشأ هؤلاء على حب الأفلام، لكن لم يتحول ارتياد دور العرض إلى طقس اجتماعي أو نزهة كما هو الحال في مجتمعات أخرى.
ويكشف الفيلم شغف هؤلاء وسبل التحايل على فكرة المنع التي تحولت إلى مفارقات تثير الشفقة والضحك أمام الجمهور، مما أكسب السرد شيئاً من الفانتازيا، عزّزها البناء والمونتاج السلس اللذان صنعا توليفة متجانسة بين الشهادات الحية والمصادر الوثائقية والأرشيفات.
يقدّم الفيلم تحية لزمن الفيديو كاسيت بوصفه المتنفس الرئيسي لهذا الجيل الذي حافظ على وثائقه التي اعتمد عليها المخرج كـ"كلمة سر".

عين منحازة
انحاز المخرج لتفكيك الفضاء الاجتماعي بالضرورة، لذلك ركز على الأدوار التي لعبتها المخرجات الرائدات بمعايير التاريخ، وهو يتقصّى دوافع الحظر. ومن ثم قابل شخصيات من أجيال أخرى عاشت الأزمة نفسها وتعاملت مع المشاهدة بوصفها عملاً سرياً.
تمثل المصادر البشرية مادة خاماً للفيلم، ولأن صاحبه جاء إلى السينما من الصحافة، لم يجد صعوبة في محاورة هذه الشخصيات وتفكيك رواياتها أو تعزيزها بوسائط أخرى والبناء عليها.
يظهر هؤلاء الرواة إلى جانب صوته كراوٍ رئيس للفيلم، ويتحولون جميعاً إلى شهود أساسيين، ثم نراهم وقد أصبحوا فاعلين في المشهد الكرنفالي الحالي الساعي لبناء صناعة سينما سعودية جديدة بمفاهيم فنية خالصة تتخطى التنميط الشائع.
خلال عملية البحث، يعثر المخرج عن طريق أستاذ في جامعة السوربون على فيلم عن البعثة الفرنسية التي جاءت إلى الشريف حسين عام 1917، وقامت بتصوير فيلم نادر عنه.
نرى على الشاشة عبد الله المحيسن، صانع أول فيلم سعودي يشارك في مهرجان القاهرة عام 1977، نراه وهو يحاول إقناع والده بحلمه في ترك دراسة الحقوق ليصبح "محامياً عن الشعب" يتبنى قضاياه، وهي الفكرة التي يقاومها الأب تماماً، لكن تمسك المحيسن بالحلم يحوّله إلى رمز وعلامة على الطريق الذي سار فيه بعده كل من المخرجة هيفاء المنصور، والشاعر أحمد الملا مؤسس أول مهرجان للفيلم السعودي، وعبد الله العياف الرئيس الحالي لهيئة الأفلام.
خلال الأحداث نرى مناطق تدخلها الكاميرا لأول مرة وتظهر وثائق تُكشف للمرة الأولى، أبرزها فيلم مفقود من الأفلام التي صورتها شركة أرامكو وفُقد.
أنتجت أرامكو عام 1956 فيلم "المياه" الذي يعد أول الأفلام السعودية، لكنه فُقد بعد أن تخلص منه البعض خوفاً من وطأة الأجهزة الدينية.
كما تمكن المخرج من الوصول إلى نسخة فيلم آخر على بكرة 16 مم، وهو فيلم وثائقي بعنوان "الحرب على الملاريا" تم تصويره في المنطقة الشرقية، فعثر عليه وعرضه ضمن مواد فيلمه الجديد، ليبرز عوالم وأزمنة راحت ولم يعد لها وجود.
خلال عملية البحث، يعثر المخرج عن طريق أستاذ في جامعة السوربون على فيلم عن البعثة الفرنسية التي جاءت إلى الشريف حسين عام 1917، وقامت بتصوير فيلم نادر أظهره جون فراش. أحد أبطال فيلميه، وقد كتب يومياته عام 1918 عن أول عرض سينمائي في تاريخ الجزيرة العربية جرى في جدة لفيلم فرنسي صامت اسمه "بودوزان والجدري" وبودوزان شخصية تشبه شارلي شابلن.
طمسٌ متعمد
يدخل فيلم "ضد السينما" من عام 1918 ليحكي الحكاية من ثيمة التضاد مع السينما، ثم يمضي ليوثق كل البعثات التي صنعت الالتماسات الأولى لتداخل تاريخ الجزيرة العربية مع السينما، ومتى دخلت كاميرا لأول مرة هناك. كما تظهر لقطات من رحلة ستوديو مصر عام 1938 لتصوير مكة المكرمة بالصوت والصورة، ولرحلة الملك عبد العزيز.
يأخذنا الفيلم إلى ذاكرة تم طمسها عن عمد، كما يقول سعيد، الذي استفاد من اهتمامه بعالم الأدب ليخرج بوثائقي حي لا يعتمد على المعلومات فقط، بل يستند إلى مسحة سرد روائي ويحتفل بلحظات عاطفية كاشفة عن سبل مقاربة المحرمات القديمة.
يبرز المخرج مدى مساهمة الثورة الإيرانية وحادثة اقتحام جهيمان العتيبي للحرم المكي في تغيير دفة التاريخ ودفع المجتمع نحو التشدد؛ فالصدمة التي عاشتها الدولة عقب حادثة جهيمان لم تكن هينة، بل حلقة في سلسلة أحداث شملت الغزو السوفيتي لأفغانستان وانشغال الغرب بالمنطقة، مما عزز مخاوف الأطراف كافة، وجعل المنطقة موبوءة بصراعات متعددة ينظر إليها الفيلم بحساسية جمالية لافتة
يرى سعيد أن الدولة السعودية منذ أيام الملك عبد العزيز كانت تمتلك مشروعاً للتحديث، ويعطي مثالاً تجلى عقب زيارة الملك لمصر عام 1947 حيث شاهد قطارات السكك الحديد واقتنع بأن المملكة بحاجة لقطار مماثل، وبالفعل تم تشغيل قطار عام 1951 بين الدمام والرياض
ومن ثم كان الملك عبد العزيز مشغولاً بفكرة ما بعد تأسيس المملكة، وظلت الفكرة تتواصل إلى أن جاءت تحولات ما بعد 1979، بعد أن تم اختطاف الدولة ومشروعها للتحديث. ويصف السنوات التي أعقبت 1979 بأنها "مربكة وحرجة"، وكانت السينما أبرز ضحاياها، ومعها الحياة الفنية والثقافية التي تأثرت كثيرًا بالخطاب المتشدد الذي واجه الحداثة.
إذ حرص كثيرون على إخفاء صلتهم بالفن، وبالتالي حصل انقطاع في هذا التاريخ؛ لأن الناس كانت تخفي علاقتها بالسينما خوفًا من الجماعات المتشددة وتحوّل الناس من مشاهدة السينما ضمن طقس اجتماعي يومي إلى المشاهدة عبر الديجيتال داخل البيوت، لذلك غابت وثائق كثيرة ولم تُؤرشف، خصوصاً وأن المؤسسات لم يكن لديها وعي بقيمة الأرشيف، على عكس ما يجري اليوم، إذ أسست هيئة الأفلام المركز الوطني للأرشيف.
من جهة أخرى، يبرز المخرج السعودي مدى مساهمة الثورة الإيرانية وحادثة اقتحام جهيمان العتيبي للحرم المكي في تغيير دفة التاريخ ودفع المجتمع نحو التشدد؛ فالصدمة التي عاشتها الدولة عقب حادثة جهيمان لم تكن هينة، بل حلقة في سلسلة أحداث شملت الغزو السوفيتي لأفغانستان وانشغال الغرب بالمنطقة، مما عزز مخاوف الأطراف كافة، وجعل المنطقة موبوءة بصراعات متعددة ينظر إليها الفيلم بحساسية جمالية لافتة.
يضع الفيلم أمام الأجيال السعودية الجديدة ذاكرة أخرى، تخترق سردية يعمل بعض صناع الأفلام الجدد على إشاعتها، وهي أن السينما السعودية بدأت معهم. وبالتالي فإن ما ينجح الفيلم في كشفه هو العثور على وثائق لحظة التأسيس، التي تُنصف الأجيال التي ناضلت لصناعة مهرجانات سينمائية في زمن المواجهة مع قوى التشدد.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.