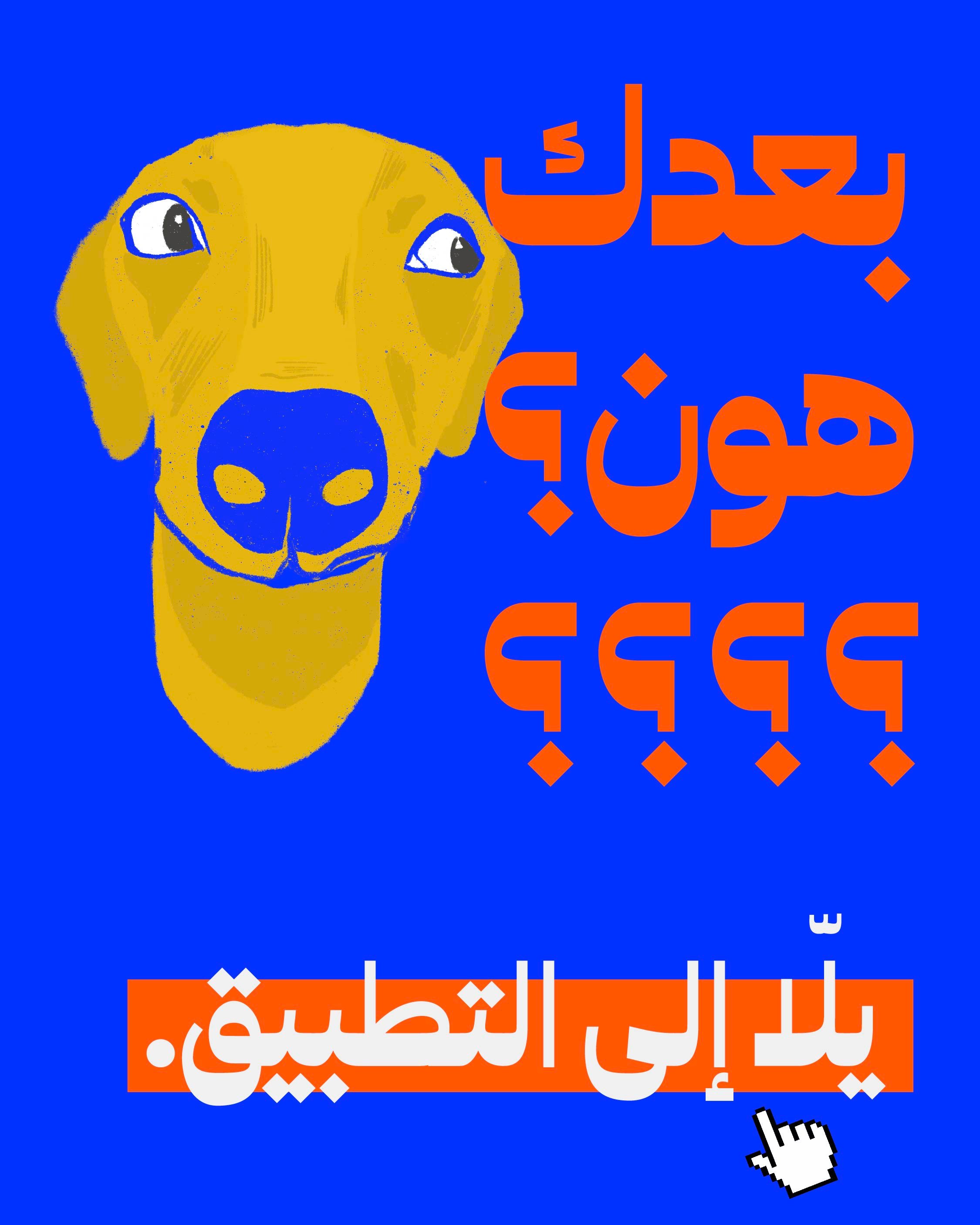في عام 1548، جلس شاب في الثامنة عشرة من عمره، ليكتب أطروحةً فكريةً حول مفهوم الحرّية. لم يدرك إتيان دو لا بوسي، في ذلك الوقت، أنَّ الثلاثين صفحةً التي لم يقُم بنشرها حتى، ستتحوّل إلى واحدة من أكثر الوثائق إزعاجاً للسلطات في أوروبا.
رحل دو لا بوسي، شابّاً عن خمسةٍ وثلاثين سنةً، وبقي نصّه يتنقّل على أوراقٍ متهالكة من يدٍ إلى يد حتى العام 1574، وفي خضم الحروب الدينية في فرنسا، انفجر النصّ إلى العلن، مطبوعاً لأوّل مرّة على يد "الهوغونوت" (أقلية دينية إصلاحية في فرنسا). وبهذا، بقي "خطاب العبودية الطوعية" حيّاً، ليفضح جوهر الاستبداد والمستبدين، ويقول بأنَّ الطاغية "لا يملك من القوّة سوى ما يمنحه إياه الناس"، كما لو أنّه أراد أن يُذكّرنا على الدوام بحقيقة نحاول تناسيها: السلاسل التي تُقيّدنا، كثيراً ما نصنعها نحن، ونحملها نحن، ونسلّمها بأيدينا لمن نسمّيه حاكماً.
كيف نقرأ "خطاب العبودية الطوعية" في منطقتنا؟
يتطلّب فهم آليّات عمل "العبودية الطوعية" في منطقتنا، تجاوز التفسيرات المبسَّطة التي تحصر أسباب الاستبداد في عوامل خارجية أو في استخدام القوّة المُفرطة. فهذا النوع من الاستسلام للآخر لا يمكن إلَّا أن يكون نتاج تفاعلٍ بين البنى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي توهم الكثيرين "بأنَّ الخضوع هو إستراتيجية بقاء عقلانية". وعليه، يمكننا تقسيم هذه الآليّات إلى ثلاث أزمات رئيسية:
إنتاج العقل المُطيع
تجد هذه الآليّة تربةً خصبةً في ما يمكننا تسميتها بـ"أزمة تربوية جماعية" تفاقمت على مدى العصور. إذ سرعان ما يجد الأفراد في منطقتنا أنفسهم محاصرين على مستوى الوعي الذاتي من قبل ثلاث مؤسسات رئيسية: المنزل والمدرسة ودار العبادة. تعمل هذه المؤسّسات، على بناء فردٍ يتنازل طواعيةً عن حرِّيته، ويتقبَّل فكرة الخضوع والامتثال غير المشروط بوصفها قدراً محتوماً وجزءاً لا يتجزَّأ من هويته.
في البيت يبدأ كلُّ شيء. حيث تُغرس بذور الطَّاعة الأولى. ففي أغلب العائلات، يُنظر إلى الطفل ككائن فاقدٍ الأهلية (الطفل فاقد الأهلية القانونية وليس الإنسانية والمعيشية)، مهمَّته الأساسية هي الاستماع والتنفيذ. نادراً ما يُمنح الطفل فرصة الاختيار أو التعبير عن رأيه في أمورٍ تخصُّه، فيُقرَّر عنه ماذا يلبس، ومن يُصاحِب، وبماذا يؤمن، وماذا عليه أن يدرس، وماذا عليه أن يغدو حين يكبر، بل أحياناً من يحبُّ، ومن يتزوَّج. وحتَّى عندما يسأل، تُغلق في وجهه الأبواب. فهناك أسئلة "لا تُسأل": لماذا لا يعتذر الأب والأم إن أخطأوا؟ لماذا يجب أن أطيع حتَّى لو كنتُ على حق؟ لماذا أبي يعامل أمّي بهذه الطريقة أو العكس؟ ماذا عن الجنس؟ ما هي حقوقي؟ تُصنّف هذه الأسئلة بوصفها تمرّداً مبكّراً أو نقصاً في الأدب، لا كعلاماتٍ على فضولٍ طبيعيٍّ وبحثٍ عن فهمٍ أعمق.
إنَّ طباعة الطاعة في البيت تتشكّل عبر منظومةٍ يوميةٍ من الطقوس الصغيرة التي تُعلِّمُ الجسد والعقل أن يقيسا كلَّ شيءٍ على "ميزان" الآخر الأعلى. تتكوّن اللغة المنزلية من مفرداتٍ تقنّن الشعور بالاحتجاج: "عيب"، "اسكت"، "هيك أحسن لك"، فتعمل كحوائط صوتية تحدُّ من مدى التفكير وتُفرِّغ الاختلاف من شرعيَّته. وتتمُّ ترجمة الهَرَمية المنزلية إلى خرائط زمنية ومكانية تختزلها مواعيد النوم والصيغ الجاهزة للرد، وترتيبات جلوسٍ على المائدة، وأحياناً نظام مراقبةٍ غير مُعلَن، تُشرف عليه الأسرة الأوسع عبر مقارنة "الأولاد المثاليين" في محيط الأقارب والجيران. وسرعان ما يصبح التقييم الخارجي معياراً للقيمة الذّاتية؛ فيُعاد تعريف الفضيلة لتساوي "الانضباط"، فيما يُسجَّل الخيال واللعب والفضول ضمن خانة "تشويش الانتباه". كما علينا أن لا ننسى التفاوت في السُلطة بين الإخوة والأخوات، إذ يُمنح الأكبر حقَّ التوجيه ويُسحب من الأصغر حقُّ الاعتراض، وتُعاد إنتاج الفوارق الجندرية تحت عناوين "الشرف" و "السُمعة".
المنزل والمدرسة ودار العبادة تبني أفراداً يتنازلون طواعيةً عن حرِّيتهم ويتقبّلون فكرة الخضوع والامتثال، و"عيب" و"اسكت" و"هيك أحسن لك" حوائط صوتية تحدّ من مدى التفكير وتُفرِّغ الاختلاف من شرعيّته. كيف؟
إن نقد هذا النَّسق لا يطعن بقيمة الاحترام أو مكانة الوالدين، بل يميّز بين طاعةٍ تُنتج تكاملاً داخلياً واستقلاليةً مسؤولة، وطاعةٍ تُعيد تدوير العبودية على أنَّها فضيلة. الأولى تنشأ حين تُعامِلُ الأسرة السؤال كحقّ، والخطأ كفرصةٍ للتعلّم، والاعتذار كقيمةٍ تُرمّم الثقة ولا تهدم الهيبة. أمَّا الثانية فتستبدل التربيةَ بالاستبداد، والحوارَ بلوائح سلوك، وتحوّل "المصلحة" إلى ذريعةٍ لاستباحة حقوق الآخرين. في الحالة الأولى، ينمو الطفل وهو يتعلّم كيف يختار ويُعلل اختياره، وفي الثانية، يكبر وهو يتقن الخنوع.
ثم تأتي المدرسة لتصقل العادة. المنهج المُعلن يتحدَّث عن كتابة نصوصٍ وحلّ مسائل، لكنَّ المنهاج الحقيقي يعلِّمُ أشياء أخرى؛ الحِفظ والتلقين ومركزية المُعلِم. وبدلاً من أن تكون المدرسة فضاءً رحباً لتنمية التفكير النقدي والإبداع، تتحول الفصول الدراسية في كثيرٍ من الأحيان إلى مصانع للنسخ واللصق. هذا ما سمّاه المعلم الأمريكي فيليب جاكسون في كتابه "الحياة في الفصول الدراسية"، بالمنهج الخفي، وما انتقده الفيلسوف البرازيلي باولو فريري، تحت عنوان "النموذج المصرفي" للتعليم. طلابٌ يُعامَلون كمستودعات للمعلومات. مناهج دراسية غالباً ما تقدِّم المعرفة كحقائق مُطلقة لا تقبل النقاش، تتبعها امتحانات عالية المخاطر تكافئ الاسترجاع أكثر مما تكافئ التفكير.
دعوني هنا أخبركم عن حادثتين شخصيتين في هذا المجال؛ الأولى كانت في الصف التاسع، والثانية في البكالوريا (الثالث الثانوي). الأولى مرَّت مرور الكرام ولكنَّ الثانية غيَّرت مسار حياتي الدراسي والمهني. في الصف التاسع في سوريا، كنتُ واحداً من آلاف الطلاب الذين يخضعون لامتحانٍ موحّد على مستوى البلاد. في مادة الرياضيات، طُرحت مسألة هندسية تتعلَّق باستنتاج طول أحد أضلاع مثلث مجهول. فتوصلت إلى حلٍّ صحيح بأسلوبٍ لم يكن تقليدياً ولا وارداً في النماذج الدراسية المعتادة.
بعد الامتحان، جاء صديقٌ لوالدي إلى منزلنا، وهو أستاذ رياضيات مخضرم، كنتُ ألجأ إليه إذا ما استعصى عليَّ فهم أيّ شيء في المادَّة. ببساطة، أراد الرجل أن يطمئن على أدائي بعد الامتحان. حين شرحتُ له الطريقة التي استخدمتها في الحل، نظر إليّ بدهشة، وطلب أن أعيد عليه الخطوات مرةً تلو أخرى، ثم قال: "اكتبْها على ورقة بيضاء، بخطّ واضح، سآخذها معي إلى وزارة التربية". فعلتُ ما قاله، فابتسم وقال إنَّ عليّ ألّا أخسر علامة السؤال لمجرَّد أنّ طريقتي لا تشبه الطريقة الرسمية.
لاحقاً، علمت أنَّه لم يتمكّن من إدراج الحل ضمن نموذج التصحيح المُعتَمَد في الوزارة. كان المبرّر سخيفاً: "الطريقة غير مدرجة في الدليل الرسمي". لم تكن المسألة في الخطأ أو الصواب، بل في كون الإجابة لم تمرّ عبر القالب المرسوم سلفاً.
في الامتحانات النهائية للصف الثالث الثانوي أو ما يعرف بامتحان البكالوريا، وهو امتحانٌ تتحدد عليه مصائرنا التعليمية والمهنية لبقية الحياة، وجدت نفسي أكرِّر الخطأ ذاته الذي ارتكبته قبل سنوات. كانت مادة اللغة العربية أقرب المواد إلى قلبي. منذ أن كنت في الرابعة عشرة من عمري، قرأت دواوين الجواهري والسياب ودرويش ونزار قباني وإيليا أبو ماضي وجبران خليل جبران، وأكثر من مرّة أعدتُ قراءة ما كان متاحاً في منزلنا من القصص والروايات. أحببت الشعر، وحفظت منه الكثير، حتى صار لديّ مخزون شعريّ أوسع من المنهاج نفسه. في يوم الامتحان، كان أهم سؤال هو موضوع التعبير (الإنشاء)، لأنَّه يحمل العدد الأكبر من العلامات. كتبتُ بطريقتي الخاصة، وربطت الموضوع بأبيات من الشعر قرأتها خارج المنهج الدراسي. كنت أظنُّ أنَّ ذلك يعزِّز قوّة الموضوع ويُظهر ثقافتي. لكن النتيجة كانت عكس ما توقعت. خسرت معظم علامات التعبير (خسرت 15 علامةً)، لأنَّني كتبت بطريقة مختلفة واستخدمت أبياتاً من خارج الكتاب، وخرجت عن الطريقة المعتمدة في الإجابة.
باختصار، هذا النظام التعليمي لا يمكن إلّا أن يُخرِّج أجيالاً تفتقر إلى مهارات حلِّ المشكلات واتخاذ القرارات، وتجنح إلى تقبُّل ما يُقدَّم لها دون تمحيص، مما يُسهِّل انقيادها لأيِّ سُلطةٍ لاحقاً.
بالتوازي مع الأسرة والمدرسة، يأتي دور الخطاب الديني ليرسِّخ هذه المنظومة ويمنحها بُعداً مُقدَّساً. هنا، يتمُّ استدعاء تأويلات محددة، نشأت في سياقات تاريخية غلب عليها الاستبداد، لترسيخ طاعة الحاكم المطلقة. فتُنتزع آياتٌ مثل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (النساء: 59)، من سياقها القرآني، لتصبح سوطاً في يد الحاكم على المحكوم، دون الإشارة إلى أنَّ الفعل "أطيعوا" تكرر مع الله والرسول ولم يتكرر مع "أولي الأمر"، ما يشير إلى أنَّ طاعتهم ليست مستقلَّة أو مطلقة، بل هي تابعة ومشروطة بإقامة العدل وإحقاق الحق. لكن الخطاب السلطوي يبتر الآية، ويقدِّمها كأمرٍ إلهيٍّ بالطاعة العمياء. ويتمُّ تعزيز ذلك بحديثٍ "منسوبٍ" إلى النبي يقول فيه: "اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ" (صحيح مسلم)، ويتم تجاهل تعارضه صراحةً مع كلام الله في القرآن حين يقول: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: 188) أو أحاديث نبويّة أخرى صريحة تقيِّد هذه الطَّاعة، مثل قوله: "إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ" (متَّفق عليه). حبّذا لو توقّف الخطاب الديني عند هذا الحد، لكنّه ذهب أبعد من ذلك إلى فقهٍ سياسيٍّ أقرَّ بـ"ولاية المُتغَلِّب"، وهي النظرية التي تمنح الشرعية لمن يستولي على الحكم بالقوَّة، ما يحوِّل الانقلاب والاستيلاء على السلطة إلى أمرٍ يجب التسليم به دينياً.
لماذا فشلت ثورة 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 برغم كونها أكبر حركة عابرة للطوائف في تاريخ لبنان؟ وهل الضربة الأقسى للحراك جاءت من الأزمة الاقتصادية؟ وهل استغلّت الأحزاب الطائفية الوضع لتعزيز سيطرتها؟ وكيف؟
وفي الضفة المسيحية، تُساق نصوصٌ مثل الرسالة الأولى لبطرس (1 بطرس 2: 13–17) لتكريس خضوعٍ بلا قيد: "خافوا الله، أكرموا الملك". متجاهلين سياقها الكامل: "اخضعوا من أجل الربّ لكلِّ ترتيبٍ بشريّ... لمعاقبة فاعلي الشرّ وتكريم فاعلي الخير... أكرموا الجميع... خافوا الله، أكرموا الملك"، أي إنّ "الخضوع" فضيلةٌ مدنيةٌ مقيَّدةٌ بالخير العام وتحت سقف "خوف الله"، وليس إذعاناً أعمى. وحين تُفرَض أوامر تُناقض الضمير والرسالة، يضع العهد الجديد كابحاً قاطعاً: "ينبغي أن يُطاعَ اللهُ أكثر من الناس"، ومن هنا انطلق توما الأكويني لوضع قاعدته الشهيرة"القانون الجائر ليس قانوناً بالحقيقة". هكذا، تصبح النصوص القرآنية والإنجيلية إذا قُرئت كاملةً لا مُجزّأةً، أدوات تقييد للسلطة، لا أختاماً لقداستها، لكن مئات السنين من التحوير والتزييف لا تمحى بسهولة، خاصَّةً في ظلِّ هيمنة "رجال الدين" على النصوص التي وُجدت أصلاً ليقرأها كلُّ الناس ويفهمها كلُّ الناس، لكنَّهم اختاروا اختطافها واختطافنا معها، لتكون النتيجة النهائية، تشكيل ضميرٍ جمعيٍّ يرى في الاعتراض والنقد خروجاً على الله وحدوده، بدلاً من رؤيته كحقٍّ أساسيٍّ. ويتحوَّل الخوف من السُلطة إلى تقوى، والاستسلام للظلم إلى صبرٍ يُرجى ثوابه.
وهكذا، تكتمل دورة إنتاج "العقل المطيع" بأبعادها المتكاملة، ويجد الإنسان في بلادنا نفسه وقد تشرَّب ثقافة الخضوع من كلّ حدبٍ وصوب، لتتشكل لديه قناعة داخلية بأنَّ دوره في الحياة هو أن يكون تابعاً ومطيعاً، فيقبل الاستعباد، لأنَّه سُحرَ وافتُتن بفكرة الطاعة، ليصبح في نهاية المطاف حارساً لسجنه، وعبداً باختياره.
قدسيّة الجماعة
تتمثّل الأزمة الثانية في "قدسية الجماعة"، حيث يتحوّل الانتماء الطائفي أو العشائري أو المناطقي إلى قيمةٍ تتجاوز الروابط الاجتماعية إلى حدِّ عبادة جماعةٍ تختزل الكرامة والأمان والهوية. يترسّخ في وعي الفرد أنّ طاعة الزعيم والحفاظ على الولاء أعلى من أيِّ قيمة أخلاقيةٍ أو مصلحةٍ عامَّة. بهذا الشكل، تُعلَّق حرية الفرد وحقُّه في التفكير المستقل، ويُعاد تعريف المواطنة بوصفها امتداداً للجماعة لا للأمَّة أو الدولة. ويبدو للأفراد بأنَّ أيّ اعتراض، سيبدو خروجاً عن حدود الانتماء وتمرّداً على "العُرف". في مثل هذا السياق، يتحوّل الفرد إلى "رهينة هوية"، لا يجرؤ على المطالبة بالحرية خوفاً من خسارة حماية الجماعة أو نفيه من دائرة الانتماء.
يمثِّل لبنان المختبر الأكثر اكتمالاً لفهم كيف تتحوّل قدسية الجماعة من ظاهرةٍ اجتماعية إلى نظام حكمٍ يستمدُّ قوَّته من الانهيارات. كما أشار مركز كارنيغي (2022)، فإنَّ "اشتداد الأزمات ينتج تكريس الطائفية، والنظام اللبناني يحافظ على استمراريته من خلال هذه الصراعات وإنّ اشتدادها يُقوّيه، ولا يُضعفه". حين تنقطع الكهرباء عشرين ساعة يومياً، يلجأ اللبناني إلى الحزب الطائفي الذي يوفر له خطّ الاشتراك. حين ينهار النّظام الصّحي، يذهب إلى المستشفى الطائفي. وحين يفقد وظيفته، يلجأ إلى الزعيم الطائفي. هكذا، تصبح الطائفة بديلاً عن الدولة، والزعيم بديلاً عن المؤسسة، والولاء للجماعة بديلاً عن المواطنة.
منذ ولادة الكيان الحديث للبنان عام 1920، والسؤال المركزي ليس "كيف نبني دولةً؟"، بل "كيف نوزّعها؟". التغيّرات الديموغرافية (تزايد نسبة المسلمين)، والتحوّلات الإقليمية (صعود القومية العربية، الصراع العربي-الإسرائيلي)، والتفاوت الاقتصادي بين الطوائف، كلُّها عوامل أدت في ما بعد إلى اندلاع الحرب الأهلية (1975-1990)، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 ألف قتيل، وهُجّرت مئات الآلاف، ودُمّرت البنية التحتية للبلاد. كان من المفترض أن تكون هذه الحرب لحظة مراجعة للنظام الطائفي، لكنَّ ما حدث كان العكس تماماً. في عام 1989، توصّل النّواب اللبنانيون في مدينة الطائف السعودية إلى اتفاقٍ لإنهاء الحرب، لكن بدلاً من إلغاء الطائفية، تم تكريسها دستورياً. نعم، تم تعديل نسبة التمثيل إلى 50:50 بين المسيحيين والمسلمين، وتم تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء السنّي على حساب رئيس الجمهورية الماروني، لكنَّ المبدأ الطائفي ظلَّ قائماً. بل إنَّ اتفاق الطائف نصَّ على أنَّ "إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي"، لكنه "مرحلة انتقالية" دون تحديد مدَّة زمنية أو آليات واضحة للتنفيذ. هكذا، تحوّلت "المرحلة الانتقالية" إلى نظام دائم، وأصبح الحديث عن إلغاء الطائفية تابو يُتَّهم من يطرحه بـ"إثارة الفتنة".
هذا النوع من الاتهامات كان سبباً في إفشال ثورة 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، برغم كونها أكبر حركة عابرة للطوائف في تاريخ لبنان. خرج مئات الآلاف رافعين شعار "كلن يعني كلن"، كاسرين التابو الطائفي. لكنَّ الضربة الأقسى للحراك جاءت من الأزمة الاقتصادية، فدخل لبنان في أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخه الحديث، وصفه البنك الدولي بأنَّه "من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر". فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار، فانخفض سعر الصرف من 1،500 ليرة للدولار إلى أكثر من 90 ألف ليرة في السوق السوداء. هذا يعني أن الرواتب فقدت قيمتها بالكامل؛ الموظف الذي كان يتقاضى (1.5 مليون ليرة) أي ما يعادل 1،000 دولار قبل الأزمة، أصبح راتبه يساوي17 دولاراً فقط. أغلقت البنوك أبوابها أمام المودعين، ورفضت إعطاءهم أموالهم، فخسر اللبنانيون أكثر من 70 مليار دولار من مدخراتهم. انقطعت الكهرباء بشكل شبه كامل (20-22 ساعةً يومياً)، وانهار النظام الصحي، وأصبح 80%من اللبنانيين تحت خطّ الفقر. في هذا الوضع الكارثي، لم يكن أمام المواطن العادي سوى خيارين: إما الهجرة (وهو ما فعله مئات الآلاف)، أو اللجوء إلى الأحزاب الطائفية، التي استغلت هذا الوضع لتعزيز سيطرتها، من خلال توزيع المساعدات المالية على أتباعها بالدولار، وتوفير الوظائف في المؤسسات الحكومية للأنصار. هذا كلّه من خلال السيطرة على شبكات الفساد والتهريب والمولدات الكهربائية. هكذا، تحوّلت الأزمة إلى فرصة لتعزيز التبعية الطائفية، والسبب يكمن في غياب الدولة وقدرة هذه القوى على تقديم الخدمات التي ملأت الفراغ.
لماذا يستمر اللبنانيون في قبول هذا؟ الجواب يكمن في ما يسميه ميشال فوكو بمعادلة القوة/ المعرفة. اللبناني يعرف أنَّ الزعيم فاسد، لكنَّه يخشى فقدان الحماية. يعرف أنَّ النظام فاشل، لكنّه يخشى أن يؤدّي التغيير إلى فوضى أسوأ. هذا الخوف نتاج تجربة تاريخية من الحروب، وتسوية "لا غالب ولا مغلوب" التي جعلت التغيير الجذري ممنوعاً. هكذا يصبح الاستقرار الهش أفضل من الفوضى المحتملة، وهذه العبودية الطوعية في أوضح صورها: حين يختار الناس جماعاتهم وطوائفهم خوفاً من دفع ثمن المواطنة.
الصفقة الاستبدادية
تستفيد الأنظمة الاستبدادية في منطقتنا من الديناميكيات الفكرية والاجتماعية سابقة الذكر لتطوير "إستراتيجيات الهيمنة الناعمة"، التي تجعل الخضوع يبدو للشعوب، خياراً عقلانياً وضرورياً. وتبني شرعيّتها لا على المشاركة السياسية أو المساءلة، بل على التوزيع الانتقائي للثروة والامتيازات. الدولة هنا لا تُعامل المواطن كفاعل سياسي، بل كمتلقٍّ للريع.
هيمن رجال الدين على النصوص واختطفوها واختطفونا معها. والنتيجة؟ تشكّل ضمير جمعيّ يرى في الاعتراض والنقد خروجاً على الله وحدوده، بدلاً من رؤيته كحقٍّ أساسيٍّ، وتحوّل الخوف من السلطة إلى تقوى، والاستسلام للظلم إلى صبرٍ يُرجى ثوابه
في عام 2007، نشر ثلاثة باحثين من معهد بروكينغز (راج ديساي وأندِرس أولوفسغورد وطارق يوسف)، دراسةً بعنوان "منطق الصفقات الاستبدادية: اختبار لنموذج بنيوي"، قدّموا فيها إطاراً نظرياً متماسكاً لفهم كيف تستمرّ الأنظمة السلطوية في الحكم دون اللجوء إلى القمع المباشر. الفكرة المركزية التي طرحوها بسيطة: "الحكم الاستبدادي لا يُفرض دائماً بالقوة، بل غالباً ما يُشترى بالمال".
وفق هذا النموذج، تقدِّم الأنظمة السُلطوية مزايا اقتصادية واجتماعية لشعوبها، وظائف مضمونة، دعم للسلع الأساسية، خدمات صحية وتعليمية مجانية، إعانات سكنية، مستويات معيشية أساسية، مقابل التخلي الطوعي عن الحقوق السياسية كحرية التعبير، حق التنظيم، المشاركة في صنع القرار، ومحاسبة الحُكَّام. المواطن في هذا النموذج لا يُعامل كـفاعل سياسي له حق في تقرير مصيره، بل كـمتلقٍّ للريع، دوره هو الانتظار والامتنان، وليس المطالبة والمحاسبة. هذا التحويل الجذري في طبيعة المواطنة يُنتج وعياً سياسياً مشوّهاً. وحين يعتاد المواطن على أن يُعطى دون أن يطالب، وأن يُطيع دون أن يُحاسِب، فإنَّه يفقد تدريجياً القدرة على التفكير السياسي، ويتحوّل من مواطن-شريك إلى مواطن-مستفيد، ومن ذات سياسية إلى موضوع اقتصادي.
هنا يمكنني أن أضيف على "منطق الصفقة الاستبدادية"، أنّ هذا النموذج لا يمكن أن يتكامل، إلّا بتحالفٍ عضويٍّ بين السُلطة وشبكات رأس المال؛ إذ تُسخَّر أدواتُ الدولة الاقتصادية لتحويل جزءٍ من الريع إلى فئاتٍ محدّدة مقابل الولاء السياسي. ويتجلّى ذلك في الامتيازات التنظيمية والضريبية والجمركية، وتخصيص الأراضي العامَّة، وتفضيل الشركات "المقرونة سياسياً" في المشتريات الحكومية والائتمان المصرفي، وخلق حواجز دخول تُقصي المنافسين. بهذه الهندسة يتراجع الطابع الشامل للدعم والخدمات، لصالح رعايةٍ انتقائية تُثبّت طبقةً أوليغارشية حول النظام، فيما يُعاد تعريف "الاستقرار" بوصفه استقرار أرباح تلك الشبكات لا استقرار عيش العامة. وتُظهر الأدلَّة في الحالة المصرية، أنَّ الشركات المرتبطة سياسياً حازت نفاذاً تفضيلياً للموارد والائتمان وعلاوةَ تقييم في السوق قبل 2011 (شكير وديون 2012)، وأنَّ البنوك الخاصَّة وجَّهت حصَّةً غير متكافئة من القروض إلى تلك الشركات خلال 2003–2011 (ديون وشيفباور 2016). هكذا يغدو التحالفُ بين السلطة ورأس المال جزءاً بنيوياً من "الصفقة": يُموَّل الامتثال العام من الأسفل، وتُكافَأ الحاشيةُ الاقتصادية من الأعلى، وتُهمَّش المصلحةُ العامَّة بينهما.
لكن من أين تأتي الموارد التي تُموّل هذه الصفقة؟ الجواب في معظم الحالات، هو الريع الخارجي. الأنظمة الاستبدادية في المنطقة لا تعتمد على ضرائب المواطنين لتمويل نفسها (وهو ما كان سيجبرها على تقديم تنازلات سياسية)، بل على مصادر خارجية لا تتطلَّب مشاركة المجتمع، مثل صادرات النفط والغاز في دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وسوريا، المساعدات الخارجية من القوى الكبرى (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الصين، الخليج) في مصر والأردن، تحويلات العمالة المهاجرة والسياحة في المغرب ولبنان والأردن. هذه المصادر الريعية تُحرّر الدولة من الاعتماد على المجتمع، وتالياً تُحرّرها من الحاجة إلى الشرعية الديمقراطية، "فالأنظمة غير الديمقراطية تؤمّن دعم النظام من خلال المنافع الاقتصادية، دون الحاجة إلى تقديم تنازلات سياسية جوهرية".
لكن ماذا تفعل السلطات المستبدة عندما تعجز عن سداد مستحقات هذه الصفقة؟ هنا يأتي دور "الريع الجيوسياسي"، حيث يتم تسليع سيادة الدولة لعقد صفقات مع القوى الكبرى، في سبيل الإبقاء على الطبقة الحاكمة. مصر، على سبيل المثال، تحصل على مليارات الدولارات سنوياً من الولايات المتحدة والخليج والاتحاد الأوروبي، ليس لأنها ديمقراطية أو ناجحة اقتصادياً، بل لأنها تُسيطر على قناة السويس، وتوقّع اتفاقية سلام مع إسرائيل، وتضبط الحدود مع غزّة وتُحارب الإرهاب، وتُسيطر على الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا. المغرب يحصل على دعم أوروبي كبير، ليس لأنَّه يحترم حقوق الإنسان، بل لأنَّه يُسيطر على الهجرة من أفريقيا نحو أوروبا، ويُحارب التطرُّف، ويُقدّم نفسه كنموذج للاعتدال في المنطقة.
هذه الديناميكية تخلق علاقةً زائفةً بين الدولة والمجتمع، حيث الاستقرار يقاس بمقدار تدفّق الريع وقدرة النظام على توزيعه. طالما أن الموارد متوفرة، والدولة قادرة على شراء الولاءات، فإن النظام يبدو مستقراً. لكن حين يتراجع الريع بفعل انخفاض أسعار النفط، أو تراجع المساعدات الخارجية، أو الأزمات الاقتصادية، أو سوء الإدارة والفساد المستشري، ينكشف غياب أي بنية مؤسّسية وقانونية تحمي المواطنين أو تتيح لهم مُساءلة السلطة، فيجد المواطنون أنفسهم عاجزين عن التصرُّف، لأنَّهم لم يتعلَّموا كيف يُنظّمون أنفسهم، أو كيف يُطالبون بحقوقهم، أو كيف يُحاسبون حكَّامهم. كلُّ ما تعلّموه هو كيف ينتظرون ما تمنحه الدولة، وكيف يشكرون على ما يحصلون عليه، وكيف يصمتون حين لا يكفيهم ما يُعطى.
برأيي، الأخطر مما ذكرناه سابقاً، هو ما لم يركِّز عليه "نموذج الصفقة الاستبدادية" بشكل كافٍ، وهو أن هذه الصفقة لا تُفرض قسراً، بل يقبلها الناس باعتبارها صفقةً عقلانية. المواطن في منطقتنا، في معظم الحالات، لا يُجبر على التخلّي عن حقوقه السياسية، بل يختار ذلك لأنَّ تكلفة الحرية تبدو أعلى من ثمن الصمت. هذا القبول هو جوهر العبودية الطوعية: حين يُفضّل الناس الحصول على السَّمكة بسعرٍ زهيد، على تعلُّم الصيد.
النموذج التفسيري "للعبودية الطوعية"
حين كتب إتيان دو لا بويسي، في القرن السادس عشر عن العبودية الطوعية، كان يتساءل: "كيف يمكن لرجلٍ واحدٍ أن يضطهد الكثيرين"؟. الإجابة التي توصّل إليها، هي أنَّ السُلطة لا تُفرض دائماً، بل تُمنح. لكننا عندما نجمع خيوط التحليل، يظهر لنا بأنّ "العبودية الطوعية" منظومة متعددة الطبقات تتداخل فيها التنشئة والهوية والاقتصاد والجغرافيا السياسية. ليست ظاهرةً ثقافيةً موروثةً كما تدّعي التيارات الفكرانية النظرية، ولا طفرة بيولوجية كما يدَّعي العرقيون المؤمنون بسلطة المورّثات المُطلَقة، ، ولا نتاجاً لصِراعٍ طبقيِّ كما يدَّعي أبناء اليسار، ولا نتاجاً للدولة العميقة كما يدّعي الشعبويون. العبودية هنا، منتجٌ بنيوي لتفاعل ثلاث آليات؛ "تدجين الوعي" عبر مؤسسات التنشئة التي تُنتج ذاتًا مُطيعة، و"أسر الهوية" عبر تقديس الجماعة الفرعية وتفتيت المواطنة، و"تسليح الريع" الذي يُحوِّل الخضوع إلى معاملة تبادلية مُموّلة من الخارج. هذه الآليات تتفاعل لإنتاج واقع يُصبح فيه الخروج من المنظومة أصعب من البقاء داخلها، ليس فقط لأنَّه محفوفٌ بالمخاطر، بل لأنَّه يتطلَّب إعادة بناءٍ للذَّات والجماعة والنِّظام في آنٍ معاً. والنتيجة: كارثة على مستوى الشعوب والأوطان.
تعتمد الأنظمة الاستبدادية في المنطقة لتمويل نفسها على مصادر خارجية لا تتطلَّب مشاركة المجتمع، مثل صادرات النفط والغاز في دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وسوريا، والمساعدات الخارجية من القوى الكبرى في مصر والأردن، وتحويلات العمالة المهاجرة والسياحة في المغرب ولبنان والأردن. فهل تحرّر المصادر الريعية هذه الدولة من الحاجة إلى الشرعية الديمقراطية؟
لكنَّ الاعتراف بهذا التعقيد لا يعني القبول بالحتميَّة. المنظومة قوية، لكنَّها ليست مصمتة. كلُّ آليَّةٍ من آليَّاتها الثلاث تحمل في داخلها تناقضاتها. هذه التناقضات تُفسّر لماذا اندلعت ثورات "الربيع العربي"، ولماذا ستندلع موجات احتجاجية أخرى في المستقبل، ولماذا لا يمكن لهذا النموذج أن يستمرّ إلى الأبد. السؤال الحقيقي إذاً، ليس ما إذا كانت هذه المنظومة ستنهار؟ بل ماذا سيحلُّ محلّها؟ تاريخ المنطقة يُظهر أنَّ انهيار الاستبداد لا يُنتج تلقائياً ديمقراطية. قد يُنتج فوضى وانقساماً (ليبيا، اليمن)، أو حرباً أهلية (سوريا)، أو استبداداً أشدّ (مصر)، أو تفتُتاً طائفيّاً (لبنان والعراق). السبب هو أنَّ العبودية الطَّوعية لا تُزال بمجرَّد إسقاط الحاكم، لأنَّها متجذِّرة في بُنية الوعي والجماعة والاقتصاد. إسقاط النظام السياسي دون تفكيك الآليِّات التي أنتجته يعني فقط استبدال الوجوه، وليس تغيير البُنية.
من هنا، فإنّ أيّ مشروعٍ تحرّري جاد يجب أن يعمل على المستويات الثلاثة في آنٍ واحد. على مستوى الوعي الفردي، لا بدَّ من ثورةٍ تربويةٍ تُعيد تعريف التعليم كفضاءٍ للتفكير النقدي، وليس للتلقين، وتُعيد بناء الأسرة كعلاقةٍ قائمة على الاحترام المتبادل، وليس على الهرمية القسرية، وتُعيد قراءة النصوص الدينية في سياقاتها التحرُّرية، وليس كأدواتٍ للسيطرة على الناس. على مستوى الهوية الجماعية، لا بدَّ من تفكيك قدسية الجماعة وإعادة القيمة للأفراد، وبناء المواطنة كانتماء أفقي يتجاوز الطائفة والعشيرة، وهذا يتطلَّب دولةً فعّالةً تُوفّر الخدمات والحماية، بحيث لا يحتاج المواطن إلى اللجوء إلى الجماعة الفرعية. على مستوى الاقتصاد السياسي، لا بدَّ من كسر الصفقة الريعية عبر بناء اقتصادٍ مُنتِج يعتمد على الضرائب، مما يُجبر الدولة على المساءلة، وعبر تقليص الاعتماد على الخارج، مما يُعيد الشرعية إلى الداخل.
الفيلسوف البرتغالي/ الهولندي باروخ سبينوزا، ربط الخضوع بالحالة المعرفية للأفراد. بالنسبة له، العبودية تَنتُجْ عن "الأفكار غير الكافية" أي عدم قُدرة الفرد على فهم أسباب معاناته الحقيقية، فيميل إلى إسقاط المسؤولية على قوى خارجية أو على المجهول. لذا، من المهم جداً أن نفهم، أنَّ العبودية الطَّوعية خيارٌ يُعاد إنتاجه يومياً عبر آلاف القرارات الصغيرة، فرض الطاعة العمياء في البيت، وتحييد التفكير في المدرسة، وقبول الانبطاح لرجال الدين وتملُّق الزعيم الطائفي أو القبلي، وبيع الصوت مقابل وظيفة أو إعانة. كلُّ قرارٍ من هذه القرارات يبدو صغيراً أو عاديّاً في حياتنا اليومية أو حتَّى في مصلحتنا على المدى القريب، لكنَّ مجموعها يُنتج سجناً جماعياً يصعب الخروج منه. لذلك، يكفي أن يُعمِلَ الناسُ عقولهم وضمائرهم ويفكّروا بحيادية في الأسباب الكامنة وراء معاناتهم ويتوقَّفوا عن خِدمة طُغاتِهم، وأن يُصرّوا على بناء بدائل، مهما بدت هشَّة أو بطيئة. لأنَّ الحرّية، في نهاية المطاف، ممارسة يومية، تُبنى قراراً بعد قرار، وجيلاً بعد آخر.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.