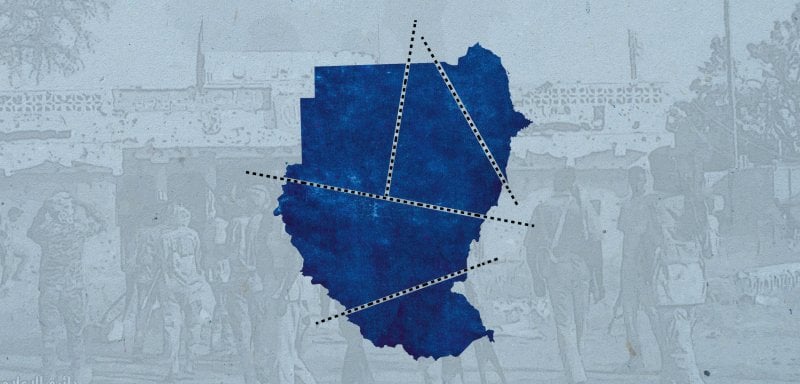يقف السودان اليوم عند مفترق طرقٍ مصيري، وسط دوامةٍ من الصراعات المتصاعدة والانقسامات الحادة، في وقتٍ تشهد فيه الساحة سقوط مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور، ما ينذر بانهيار ما تبقّى من "مؤسسات الدولة ووحدة أراضيها". وفي خضم هذا المشهد المضطرب، تبرز تساؤلات حول الدور الإسرائيلي المحتمل في تأجيج الصراع الداخلي واستثمار الفوضى لتحقيق مكاسب إستراتيجية بعيدة المدى.
فالسودان، منذ عقود، يمثل لإسرائيل "دولة المفصل" في معادلة الأمن الإقليمي، بفضل موقعه الجيوسياسي الحساس المطل على البحر الأحمر، ومساحته الشاسعة التي تربطه بالعالمين العربي والإفريقي. ومن ثمّ، فإن أي تصدع في بنيته الوطنية يشكل فرصة لإعادة رسم خرائط النفوذ وموازين القوى في المنطقة بما يخدم الرؤية الإسرائيلية طويلة الأمد. في ضوء ذلك، تفرض المرحلة الراهنة ثلاثة تساؤلات جوهرية: ما طبيعة الدور الذي تضطلع به إسرائيل في الحرب الدائرة اليوم في السودان؟ ما المكاسب الإستراتيجية التي قد تحققها تل أبيب من سيناريو تفتيت السودان؟ وما المخاطر والتداعيات المحتملة لهذا السيناريو على الأمن الإقليمي ومستقبل القارة الإفريقية؟
إسرائيل ومخطط التفتيت... بلقنة الشرق الأوسط كوسيلة للهيمنة
منذ تأسيسها عام 1948، ظلّ الهاجس الأمني لإسرائيل محورياً: كيف تبقى دولة صغيرة في محيطٍ يُعدّها عدواً؟ أمام جغرافيا محدودة وعمق استراتيجي ضئيل، عملت إسرائيل على بناء سياسات استباقية تهدف إلى منع تشكّل تحالفات إقليمية واسعة قادرة على تهديد وجودها. إحدى أدوات هذه السياسة كانت ولا تزال تقسيم ساحات النفوذ وتغذية الاختلافات الداخلية لدى الدول المجاورة.
عام 1982، قدّم الباحث عوديد ينون، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، خطة لتفكيك دول المنطقة، بهدف إضعاف تماسكها وإتاحة تفوق إستراتيجي لإسرائيل وسط محيطٍ من الانقسام، لم تقترح الورقة إعادة رسم حدود سايكس-بيكو فحسب، بل دعَت إلى بروز كيانات مبنية على اعتبارات طائفية وإثنية
في العقود الأولى بعد قيامها، ركّزت أوساط صنع القرار الإسرائيلية على سيناريوهات وإجراءات تهدف إلى إضعاف أو تفكيك دول الطوق. امتدّ هذا التفكير ليبلور ما يُعرف بـ"عقيدة شدّ الأطراف"، التي يعود أصلها الفكري إلى ممارسات وأفكار تبنّتها الدوائر الاستراتيجية الإسرائيلية منذ منتصف القرن العشرين. تقوم هذه العقيدة على نسقٍ مزدوج: تكثيف العلاقات مع كيانات خارج المحيط العربي لتطويق الدول المجاورة، وفي الوقت نفسه إشعال بؤر توتر داخل حدود تلك الدول لإلهائها عن مواجهة إسرائيل مباشرة.
تتجلّى آليات هذه الاستراتيجية في استثمار الانقسامات العرقية والطائفية، وتطبيق مبدأ "فرق تسد"، وتحريك النزاعات الحدودية، وبثّ عناصر الفتنة التي تؤدّي إلى حروب داخلية أو نزاعات ممتدة. الهدف الاستراتيجي واضح ومباشر: تحويل الدول القوية نسبياً إلى دويلات صغيرة هشة، غارقة في صراعاتها الداخلية، بحيث لا تستطيع أن تكون عامل قوة توازن مع إسرائيل. في هذا المشهد تتحوّل إسرائيل إلى قاطرة إقليمية نسبياً، محاطة بكِيانات ضعيفة تعتمد على دعمها أو تقيم معها علاقات تصالحية، مما يعزّز مصالحها الأمنيّة والسياسية.
في عام 1982، طرح الباحث عوديد ينون، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون في ورقته الشهيرة "استراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات" رؤية جذرية لإعادة ترتيب النظام الإقليمي. لم تقترح الورقة إعادة رسم حدود سايكس-بيكو فحسب، بل دعَت إلى بروز كيانات مبنية على اعتبارات طائفية وإثنية، أي بلقنة المنطقة بحيث تصبح الدول الكبرى المجاورة أقل قدرة على التلاحم والمواجهة. وقد ذُكرت فيها فكرة تفكيك دولٍ مثل السودان لإقامة مجموعة من الدول الصغيرة المتناحرة، وهو تصوّر يتيح لإسرائيل التفوّق الإستراتيجي بالاعتماد على حالة الانقسام والتبعثر في محيطها.
ومع أن نص ينون لم يكن وثيقة حكومية رسمية، إلا أنه عبّر عن توجه فكري استراتيجي أضحى جزءًا من الخطاب التحليلي لدى بعض الدوائر الإقليمية والدولية. تقوم هذه الرؤية على افتراض مؤداه أن "سوداناً مجزّأ وهشّاً أفضل من سودانٍ قوي وموحّد" من منظور موازين القوة الإسرائيلية؛ فالتجزئة تُضعف قدرة الدول على التنسيق في ملفات حسّاسة مثل منابع نهر النيل، وتؤدي إلى تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتقلّل من التأييد الإفريقي للقضايا العربية الكبرى.
السياق التاريخي للعلاقات الإسرائيلية – السودانية
تعكس العلاقات بين السودان وإسرائيل، منذ استقلال السودان عام 1956، مساراً متقلّباً بين القطيعة والتقارب، وبين المصالح الاستراتيجية والخصومات الإقليمية. فمع استقلال الخرطوم، انضم السودان إلى الصف العربي الرافض للاعتراف بإسرائيل، وكان من أبرز المشاركين في مؤتمر الخرطوم عام 1967، الذي رفع شعاره الشهير: "لا سلام، لا تفاوض، لا اعتراف بإسرائيل"، لتصبح البلاد رسمياً في موقع الخصومة مع تل أبيب.
إلا أن هذه الصورة العلنية لم تحجب واقعاً آخر من الاتصالات الخفية والمصالح المتشابكة. فمنذ خمسينيات القرن الماضي، أولت إسرائيل القارة الإفريقية أهمية خاصة في سياستها الخارجية، معتبرةً أن بناء علاقات متينة مع دولها يمكن أن يساعد في كسر الطوق العربي المعادي، وتخفيف الضغوط الإقليمية الواقعة عليها. وقد تأسست هذه الرؤية على ما عُرف بـ"عقيدة شدّ الأطراف"، التي وضع أسسها ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، والقائمة على مبدأ التحالف مع الدول المحيطية غير العربية لمواجهة القلب العربي المعادي في الشرق الأوسط.
في هذا السياق، سعت إسرائيل مبكراً إلى استمالة السودان أو تحييده على الأقل. ففي آب/ أغسطس 1956، التقى ممثلو حزب الأمة السوداني، بزعامة الصادق المهدي، بمسؤولين إسرائيليين، من بينهم مردخاي غازيت، المدير العام الأسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في لقاءٍ سري بلندن. كان حزب الأمة، المعارض آنذاك للنفوذ المصري، يخشى طموحات جمال عبد الناصر وسعيه إلى الهيمنة على إفريقيا والعالم العربي تحت راية القومية العربية، ورأى في إسرائيل قوة يمكن أن تساعده في تحقيق استقلال القرار السوداني عن القاهرة ولندن. وطالب الوفد السوداني بدعم دبلوماسي واقتصادي إسرائيلي لموازنة النفوذ المصري، وفقاً لما ذكره محمد أبو القاسم في كتابه "السودان: المأزق التاريخي وآفاق المستقبل".
استمرت هذه الاتصالات السرية لسنوات بعد الاستقلال، وانتقلت لاحقاً من وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى جهاز الموساد، الذي تولّى إدارة القنوات غير الرسمية. ولعب رجل الأعمال نيسيم جاون، وهو تاجر سويسري من أصل سوداني، دور الوسيط الحيوي في تمتين العلاقات الاقتصادية والسياسية، مستفيداً من موقعه التجاري وخبرته في قطاعات السياحة والفنادق. غير أن انقلاباً عسكرياً في نهاية الخمسينيات أنهى هذه المرحلة الودية القصيرة، وحوّل السودان إلى خصمٍ معلن لإسرائيل. ومع اندلاع حرب الأيام الستة عام 1967، قدّم السودان دعماً عسكرياً لمصر، ما أدى إلى قطيعة تامة بين الخرطوم وتل أبيب استمرت قرابة عقدٍ كامل.
في صيف 1956، عقد حزب الأمة السوداني بقيادة الصادق المهدي لقاءً سرياً في لندن مع مسؤولين إسرائيليين، سعياً لتحييد السودان عن النفوذ المصري، ولدعم دبلوماسي واقتصادي لموازنة تأثير عبد الناصر.
رغم القطيعة الرسمية، واصل الموساد اتصالاته مع المعارضة السودانية. ففي عام 1969، تمكّن الجهاز بقيادة ديفيد بن أوزيل من النفاذ إلى الداخل السوداني عبر دعم بعض القبائل المعارضة للحكومة المركزية في الخرطوم. ومع نهاية الحرب الأهلية الأولى منتصف السبعينيات، لم تتوقف الأنشطة الإسرائيلية في السودان، إذ أشرفت تل أبيب، في إطار عملية موسى عام 1984، على نقل آلاف اليهود الإثيوبيين سراً إلى إسرائيل عبر الأراضي السودانية وبالتعاون مع البحرية الإسرائيلية.
في مطلع الثمانينيات، تعززت الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين. ففي عام 1981، التقى آرييل شارون، وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، بالرئيس السوداني جعفر النميري، وتم بحث مشروع تحويل السودان إلى مركز لتخزين الأسلحة الإسرائيلية، يتيح لتل أبيب هامش تحرك استراتيجياً تجاه تهديدات إقليمية، أبرزها إيران في بداياتها الثورية. غير أن هذا التقارب تراجع لاحقاً مع تحولات الداخل السوداني وصعود عمر البشير إلى السلطة عام 1989، إذ انخرطت الخرطوم في "محور المقاومة" المدعوم إيرانياً، مما جعل العلاقات مع إسرائيل في أدنى مستوياتها، وبلغ التوتر حد قيام الطيران الإسرائيلي بشنّ غارات على مصانع أسلحة في السودان كانت تُتهم بإرسال دعمٍ إلى غزة.
دور إسرائيل في انفصال جنوب السودان
يُعدّ انفصال جنوب السودان عام 2011 محطةً محورية في تاريخ العلاقات الإسرائيلية – السودانية، ومثالاً واضحاً على نجاح السياسة الإسرائيلية القائمة على تفكيك الدول الكبرى في محيطها الإقليمي. فهذه العملية لم تكن حدثاً معزولاً أو وليد اللحظة، بل نتيجة تراكم جهود استخبارية وإستراتيجية ممتدة لعقود، منذ خمسينيات القرن الماضي، هدفت إلى إضعاف السودان وشطره جغرافياً وسياسياً.
في عام 2008، صرّح آفي ديختر، وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، في محاضرة ألقاها أمام معهد أبحاث الأمن القومي، قائلاً: "نحن نقود خراب السودان، يجب ألا نسمح لهذا البلد، رغم بعده عنا، بأن يصبح قوة مضافة إلى العالم العربي، لأن موارده، لو استقر، ستجعل منه قوة يُحسب لها ألف حساب". خلال حفل تقاعده، كشف مائير داغان، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي آنذاك، عن أن انفصال جنوب السودان كان "ثمرة جهود استخبارية إسرائيلية بدأت منذ عام 1956"، مضيفاً أن تل أبيب "استغلت العوامل المفرقة بين الشمال والجنوب لتمزيق دولةٍ ذات موقفٍ عدائي تجاه إسرائيل وتمثل عمقاً إستراتيجياً لمصر، العدو الأكبر لتل أبيب". وأشار داغان إلى أن "جهوداً مماثلة تُبذل في دول عربية أخرى" لتطبيق ذات النهج.
بمرور الوقت، أثبتت هذه الاستراتيجية فاعليتها. إذ ساهمت إسرائيل، بشكل غير مباشر، في تهيئة الظروف التي قادت إلى انفصال جنوب السودان عام 2011، وهو ما اعتُبر في تل أبيب نصراً إستراتيجيًا يؤكد نجاح سياسة تفتيت الدول من الداخل لتحقيق مكاسب إقليمية بعيدة المدى. وبعد الانفصال، تشكلت علاقات علنية ووثيقة بين إسرائيل ودولة جنوب السودان. ففي لقاء جمع سيلفا كير، رئيس جنوب السودان، بالرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، قال كير: "لولاكم لما كنا وُجدنا". وردّ بيريز مؤكداً: "التقينا بالسودانيين أول مرة في باريس، وقدمنا مساعدات كبيرة في مجالات البنية التحتية والزراعة، وما زلنا نقدم الدعم في شتى المجالات". هذه التصريحات تعكس عمق الدور الإسرائيلي في رعاية مشروع الانفصال.
وكانت إسرائيل أول دولة في العالم تعترف رسمياً بجنوب السودان، إذ أعلن رئيس الوزراء المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو في 10 كانون الثاني/ يناير 2011 بعد يوم واحد فقط من إعلان الاستقلال اعتراف بلاده بالدولة الجديدة، قائلًا: "بالأمس وُلدت دولة جديدة هي جنوب السودان، وإسرائيل تعترف بها وتتمنى لها النجاح والتوفيق". ولم يكن هذا الموقف رمزياً فحسب، بل تُرجم إلى تعاون سياسي وعسكري واقتصادي واسع، إذ كشفت مصادر إسرائيلية لاحقاً عن دور الموساد في بناء الهياكل الأمنية لدولة الجنوب، وتدريب كوادرها العسكرية، وإقامة شبكة علاقات اقتصادية واستخبارية راسخة.
وقد وثّق كتاب إسرائيلي بعنوان "مهمة الموساد في جنوب السودان" تفاصيل التدخل الإسرائيلي في دعم الحركات الانفصالية منذ ستينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن ضباطاً مثل ديفيد بن عوزيل، إيلي كوهين، وشارلي، كانوا من أوائل من تعاونوا مع قوات أنيانيا النواة الأولى لجيش تحرير شعب السودان. شمل الدعم عمليات تدريب، وتسليح، وتنسيق عبر دول وسيطة كإثيوبيا وأوغندا، بهدف إضعاف الحكومة المركزية في الخرطوم، وحرمانها من دورها التقليدي في دعم القضايا العربية، خصوصاً القضية الفلسطينية.
اعتبرت إسرائيل استقلال الجنوب نقطة تحول إستراتيجية، لأنها قطعت التواصل الجغرافي بين مصر وليبيا والدول العربية الإفريقية، وفتحت لتل أبيب نافذة مباشرة على موارد النيل والبحر الأحمر، ومجالات النفوذ في شرق إفريقيا. كما أقرّ عاموس يادلين، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، بالدور الإسرائيلي في "تدريب وتسليح الحركة الشعبية لتحرير السودان وتنظيم قوى المعارضة في دارفور"، مؤكداً أن إسرائيل "أنجزت عملاً عظيماً في السودان، نظّمت خطوط السلاح للقوى الانفصالية، ونشرت شبكات استخبارات قادرة على الاستمرار إلى ما لا نهاية". كما أشارت تقارير متعددة إلى أن بعض اجتماعات المعارضة السودانية في أوروبا كانت تُعقد بإشراف إسرائيلي مباشر.
لم تتوقف هذه السياسة عند حدود تقسيم السودان إلى دولتين، بل تستمرّ اليوم في سعيٍ متجدد لتفتيت ما تبقّى من السودان إلى كيانات متعددة، في إطار مشروع إسرائيلي أوسع يرمي إلى إعادة تشكيل ميزان القوى في إفريقيا والشرق الأوسط بما يخدم مصالحها الإستراتيجية والأمنية.
الدور الحالي لإسرائيل في ظل النزاع السوداني
بعد سقوط نظام عمر البشير عام 2019، وجدت إسرائيل في السودان ساحة جديدة لإعادة تموضعها في شرق إفريقيا، مستغلة حالة الفراغ السياسي والأمني التي خلفها انهيار النظام السابق. ومع توقيع اتفاقيات إبراهام عام 2020، سعت تل أبيب إلى تحويل الانفتاح السوداني نحوها إلى نفوذ فعلي في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي، وذلك من خلال نشاط استخباري ودبلوماسي مكثّف هدفه تعزيز حضورها الأمني والاقتصادي في السودان. فبعد عقود من القطيعة، بدأت إسرائيل في إرسال وفود استخبارية وتجارية إلى الخرطوم وشرق السودان تحت غطاء التعاون في مجالات الزراعة والأمن، فيما كان الهدف الحقيقي يتمثل في بناء شبكة تأثير متشعبة داخل مؤسسات الدولة الانتقالية والقوى شبه العسكرية الناشئة.
حافظ الموساد على اتصالاته مع المعارضة السودانية، فدعم عام 1969 بعض القبائل المناهضة للحكومة في الخرطوم، واستمر نشاطه حتى منتصف السبعينيات. والتقى آرييل شارون بالرئيس جعفر النميري عام 1981 لكن التقارب تراجع مع صعود عمر البشير عام 1989 وانخراط الخرطوم في محور المقاومة
ومع اندلاع القتال في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أصبح الدور الإسرائيلي أكثر وضوحاً وتعقيداً في الوقت نفسه. فقد أشارت تقارير ودراسات متعددة إلى أن إسرائيل فتحت قنوات اتصال سرية مع قوات الدعم السريع، من خلال وسطاء إقليميين وعلى رأسهم الإمارات، وقدمت عبرهم مساعدات تقنية ومعلوماتية متطورة، تضمنت أجهزة مراقبة وتجسس وتكنولوجيا اتصالات ميدانية متقدمة. ويُذكر أن حميدتي كان قد التقى برئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهين في أبوظبي عام 2020، كما تم الكشف لاحقاً عن اجتماعات أخرى جرت بينه وبين مسؤولين من الموساد في الخرطوم وأبوظبي خلال عامي 2021 و2022، في إطار ما وُصف حينها بتفاهمات أمنية متبادلة.
وقد أعلن حميدتي في أكثر من مناسبة عن رغبته في إقامة علاقات مع إسرائيل وليست تطبيعاً، مشيراً إلى تطور إسرائيل التقني والزراعي، وأن السودان يحتاج إلى التعاون معها من منطلق المصلحة الوطنية. هذه التصريحات عكست تحولاً واضحاً في خطاب بعض النخب السودانية التي باتت ترى في إسرائيل شريكاً محتملاً لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية في ظل انقسام البلاد.
ومع تصاعد الحرب، بدأت تتكشف أبعاد أعمق للدور الإسرائيلي، حيث أكدت تقارير صادرة عن مواقع مثل "ميدل إيست آي" أن تل أبيب تنظر إلى الدعم السريع بوصفها القوة الأكثر ملاءمة لخدمة مصالحها الإستراتيجية في السودان، لما تملكه من ثروات هائلة من الذهب وشبكات تهريب تمتد إلى ليبيا وإفريقيا الوسطى. وبالنسبة إلى إسرائيل، فإن دعم حميدتي يمثل وسيلة مزدوجة: من جهة، لضمان الوصول إلى الموارد الطبيعية وخطوط التجارة في غرب السودان، ومن جهة أخرى، لإضعاف الجيش السوداني الذي ظل تاريخيًا معاديًا للمشروع الإسرائيلي في المنطقة وداعماً للقضية الفلسطينية.
الرهان الإسرائيلي على حميدتي يرتبط أيضاً باعتبارات جيوسياسية أوسع، إذ ترى إسرائيل في السودان بوابة استراتيجية للضغط على مصر من الجنوب والتحكم في مفاتيح نهر النيل. فإضعاف الدولة السودانية المركزية وتفكيكها إلى كيانات إقليمية أو قبلية يحقق هدفاً قديماً ضمن العقيدة الأمنية الإسرائيلية، يتمثل في منع ظهور دولة قوية وموحدة على حدود مصر الجنوبية يمكن أن تشكل تهديداً إستراتيجياً أو منافساً سياسياً. لذلك، فإن تل أبيب تتعامل مع الحرب الحالية في السودان كفرصة لإعادة هندسة التوازنات في وادي النيل، عبر دعم أطراف قادرين على إخضاع المناطق الحيوية، مثل دارفور وغرب السودان، لمجال نفوذها الأمني والاستخباري.
ويشير الصحفي والكاتب الفلسطيني نبهان خريشة إلى أن سقوط مدينة الفاشر في يد "الدعم السريع" شكّل محطة محورية في هذا السياق، إذ منح حميدتي السيطرة على إقليم دارفور الغني بالموارد والمعادن، وفتح أمامه طريقاً إستراتيجياً يربط الخرطوم بحدود تشاد. ويؤسس هذا الواقع الميداني الجديد تهديداً لوحدة السودان ويُقرّب البلاد من سيناريو التقسيم الفعلي. في المقابل، فإن استمرار الحرب يمنح إسرائيل فرصة أكبر لتعزيز نفوذها الاستخباري في المنطقة عبر واجهات اقتصادية وإنسانية، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع الطرفين، لكنها تراهن بشكل أكبر على الدعم السريع باعتباره الأكثر استعداداً للتعاون معها بشكل مباشر.
مصالح إسرائيل من تقسيم السودان
تُدرك إسرائيل أن السودان يمثل أحد المفاصل الجيوسياسية الأهم في القارة الإفريقية والعالم العربي على السواء، لما يتمتع به من موقع استراتيجي فريد يربط بين القرن الإفريقي وشمال إفريقيا وعمق القارة جنوباً، ويشرف على ساحل طويل يمتد على البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية. هذا الموقع الحيوي جعل السودان، قبل انفصاله، أكبر دولة في إفريقيا مساحة، وحدودُه المشتركة مع تسع دول تجعله حلقة وصل بين محاور عربية وإفريقية متقاطعة. ومن هذا المنطلق، ترى تل أبيب أن أي دولة سودانية قوية وموحدة يمكن أن تتحول إلى عنصر فاعل في معادلات الإقليم، وربما تهديد محتمل للتفوق الإسرائيلي في البحر الأحمر وشرق إفريقيا.
راهنت إسرائيل على حميدتي باعتباره أداةً لتوسيع نفوذها في السودان، والضغط على مصر والتحكم في نهر النيل. لذا فهي تستثمر في الحرب الحالية لإعادة ترتيب توازنات وادي النيل.
لقد عبّر وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق آفي ديختر عن هذه الرؤية بوضوح حين قال في إحدى محاضراته عام 2008 إن السودان بموارده ومساحته وعدد سكانه يمكن أن يصبح قوة كبرى منافسة لبلدان عربية رئيسية، مشيراً إلى ضرورة منع هذا السيناريو من التحقق. فالسودان، بما يمتلكه من مقومات بشرية وطبيعية وموقع إستراتيجي حساس، يمكن أن يتحول إلى دولة عربية إفريقية مؤثرة، قادرة على موازنة النفوذ الإسرائيلي في البحر الأحمر، والتحكم في مفاتيح حيوية تمسّ الأمن الإسرائيلي بشكل مباشر. لذلك، يُنظر في تل أبيب إلى تفتيت السودان ليس كهدف معزول، بل كجزء من إستراتيجية شاملة لإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة بما يضمن إضعاف الدول العربية المحيطة بإسرائيل وحرمانها من العمق الإفريقي والمائي.
من منظور الأمن القومي الإسرائيلي، يمثل السودان أحد أهم مفاتيح الأمن المائي والغذائي لمصر، وبالتالي فإن زعزعة استقراره تؤثر مباشرة في أمن القاهرة واستقلال قرارها. فالسودان يشكل الامتداد الطبيعي لمصر جنوباً، وأي اضطراب فيه ينعكس على مواردها المائية وعلى قدرتها في إدارة ملف نهر النيل. لذا، فإن تقسيم السودان وإضعاف مركزه السياسي يحقق هدفين متلازمين لتل أبيب: إضعاف الدولة السودانية كفاعل إقليمي، وتقييد قدرة مصر على الحركة في محيطها الجنوبي. كما أن الفوضى في السودان تتيح لإسرائيل التمدد بحرية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، وتعزز قدرتها على مراقبة خطوط الملاحة العالمية والتحكم فيها بما يخدم مصالحها الاقتصادية والأمنية.
وعلى الصعيد الأمني، كان السودان تاريخياً ممرّاً لدعم المقاومة الفلسطينية، خصوصاً عبر تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من خلال البحر الأحمر وسيناء. لذلك حرصت إسرائيل على استهداف قدراته العسكرية والبنية التحتية الخاصة به، سواء من خلال الغارات الجوية أو عبر دعم النزاعات الداخلية التي تُضعف سلطة الخرطوم المركزية، ما يسهم في تقليص قدرة السودان على مراقبة حدوده وموانئه. فإضعاف الدولة المركزية يعني بالضرورة تعطيل خطوط الإمداد للمقاومة، وتقليص قدرة مصر وحلفائها على استخدام العمق السوداني في أي مواجهة محتملة مع إسرائيل.
اقتصادياً، يُعد السودان من أغنى الدول الإفريقية بالموارد الطبيعية، حيث يمتلك احتياطات كبيرة من النفط والذهب والأراضي الزراعية الخصبة والمياه الوفيرة. وتُقدّر بعض المصادر احتياطي النفط فيه بأكثر من ثلاثة مليارات برميل، فيما لا تزال مساحات واسعة من أراضيه غير مكتشفة بعد. كما يضم السودان ثروات معدنية وزراعية هائلة، ويشكّل نهر النيل أهم مصادره المائية بإيرادات سنوية تبلغ نحو 85 مليار متر مكعب. هذه الثروات، من منظور تل أبيب، تمثل فرصة اقتصادية واستخبارية في آنٍ واحد، إذ يمكن لإسرائيل، في حال تقسيم السودان، أن تعقد شراكات منفصلة مع الكيانات الجديدة، وتؤسس لنفوذ اقتصادي مباشر في مجالات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا المائية، مما يتيح لها تحكماً طويل الأمد في الموارد الإفريقية الحيوية.
وعليه، يمكن القول إن الهدف الإستراتيجي الأعمق لإسرائيل من تفكيك السودان يتجلى في ضمان تفوقها الإقليمي طويل الأمد، عبر السيطرة على خطوط التجارة والمياه والموارد، وتطويق مصر جيو-سياسياً، وحرمان العالم العربي من أحد أهم مصادر قوته الاستراتيجية في إفريقيا. إن تفتيت السودان، في الحسابات الإسرائيلية، ليس مجرد مشروع جغرافي، بل هو أداة لإعادة صياغة موازين القوى في المنطقة، وترسيخ نظام إقليمي جديد تكون فيه إسرائيل اللاعب الأكثر نفوذًا وهيمنة.
التداعيات والمخاطر المحتملة لتفتيت السودان
يمثّل تقسيم السودان، في حال تحقّقه، أحد أخطر السيناريوهات على الأمن الإقليمي والإفريقي، لما يحمله من تداعيات سياسية وأمنية وإنسانية عميقة تمتد آثارها إلى دول الجوار والمنظومة الدولية برمتها. فتمزيق السودان لن يقتصر أثره على حدوده الجغرافية، بل سيطلق موجات جديدة من الاضطراب قد تعيد تشكيل خريطة القرن الإفريقي وشمال القارة على نحو غير مسبوق. تشير تقديرات مراكز الأبحاث الدولية إلى أن الانقسام سيؤدي إلى نزوح ملايين السودانيين باتجاه دول الجوار والبحر الأحمر، هرباً من تصاعد العنف والصراعات العرقية بين الميليشيات المتنازعة. وقد حذّر معهد كارنيغي للسلام الدولي من أن تفتيت السودان سيكون كارثة إنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وتفتح الباب أمام انهيار مؤسسات الدولة بشكل شامل.
ترافق الفوضى السياسية غالباً مع تمدد الجماعات المتطرفة، مما يجعل السودان في حال تفككه ساحة مفتوحة لنشاط التنظيمات المسلحة القادمة من منطقة الساحل وغرب إفريقيا. هذا التدهور الأمني سيؤدي حتماً إلى توتر العلاقات مع الدول المجاورة مثل مصر وتشاد وجنوب السودان، التي ستجد نفسها أمام تحديات جديدة تتعلق بالنزاعات الحدودية، وتدفق اللاجئين، والتنافس على الموارد والحقوق المائية. ومع تفكك السلطة المركزية، ستفقد الدولة القدرة على ضبط حدودها الواسعة أو إدارة ثرواتها، مما يجعلها عرضة لاختراق القوى الإقليمية والدولية التي تبحث عن موطئ قدم في قلب القارة الإفريقية.
سياسياً، يقضي التقسيم على الآمال الشعبية في إقامة نظام ديمقراطي مدني، لطالما حلم به السودانيون بعد سقوط نظام البشير. فبدل أن يؤدي الانقسام إلى إنهاء الاستبداد، سيكرّس حالة جديدة من السلطوية تتقاسمها قوى مسلحة محلية، في مقدمتها ميليشيا الدعم السريع التي تسعى إلى فرض واقع الأمر الواقع بقوة السلاح. ومع تعدد الكيانات السياسية وتضارب المصالح، تصبح فرص الانتقال الديمقراطي شبه معدومة، وتزداد معاناة المواطنين في ظل انعدام الخدمات الأساسية وتشتت مؤسسات الدولة. كما أن مسألة الشرعية الدولية ستدخل في دوامة جديدة من التعقيد، إذ سيجد المجتمع الدولي نفسه أمام أكثر من حكومة متنازعة تدّعي تمثيل الشعب السوداني، مما يوجد فراغًا قانونيًا يهدد الاستقرار الإداري والاقتصادي ويعطل حياة المواطنين في أبسط تفاصيلها.
وعلى المستوى الأمني، لا يضمن التقسيم وقف القتال بين الأطراف المتصارعين، بل قد يؤدي إلى اشتعال حروب جديدة بين الكيانات الوليدة حول الحدود والثروات. فمع غياب سلطة مركزية قوية، تبقى احتمالات اندلاع صراع مسلح بين الدول الجديدة قائمة، خصوصاً في ظل طموح قوات الدعم السريع للسيطرة على كامل الأراضي السودانية. هذا السيناريو سيجعل من التقسيم عملية غير مستدامة، ويفتح الباب أمام موجات متتالية من الانفصال والانقسام الداخلي، في تكرارٍ لنموذج الصومال الذي ما زال يعاني حتى اليوم من آثار التفكك.
يتّضح من مجمل ما تقدّم أن قضية السودان لم تعد شأناً داخلياً فحسب، بل تحوّلت إلى عقدة جيوسياسية تتقاطع عندها مصالح قوى إقليمية ودولية كبرى، تتقدّمها إسرائيل التي تسعى منذ عقود إلى إعادة رسم خرائط النفوذ في إفريقيا والشرق الأوسط بما يضمن أمنها وتفوّقها الإستراتيجي. فمشروع تفتيت السودان ليس معزولًا عن الرؤية الصهيونية الأشمل القائمة على إضعاف الدول المحيطة وإشغالها بصراعات داخلية، بما يمنع تشكّل أي محور عربي أو إفريقي قادر على موازنة القوة الإسرائيلية في الإقليم.
ومع تفاقم الحرب الحالية بين الجيش والدعم السريع، وجدت تل أبيب في هذا الصراع فرصة نادرة للتغلغل في عمق السودان عبر أدوات استخبارية واقتصادية ناعمة، لتأمين موطئ قدمٍ في البحر الأحمر، والسيطرة غير المباشرة على منابع النيل، وتعزيز نفوذها في منطقة تشهد فراغاً إستراتيجياً متزايداً. بيد أن هذه السياسة، وإن حققت مكاسب مؤقتة لإسرائيل، فإنها تزرع بذور فوضى قد تمتد آثارها لتقوّض استقرار المنطقة برمّتها، وتفتح الباب أمام انهيار منظومات الأمن الإقليمي والإفريقي.
مستقبل السودان، بين خيار الوحدة أو التفكّك، لا تحدّده القوى الخارجية بقدر ما يصنعه السودانيون أنفسهم بقدرتهم على استعادة مشروع الدولة الوطنية الجامعة. فالحوار الوطني الشامل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس المواطنة والعدالة، وتحييد التدخلات الأجنبية، هي وحدها الضمانة لقطع الطريق أمام مشاريع التفتيت والتبعية.
ختامًا، يمكن القول إن وحدة السودان لم تعد مجرد مسألة حدود أو جغرافيا، بل قضية بقاء وسيادة وكرامة أمة بأكملها. فإما أن ينهض السودان موحّداً بمشروع وطني جامع يُفشل مخططات الخارج، أو يظل رهينة تجاذبات القوى الإقليمية التي ترى في ضعفه فرصة لتكريس هيمنتها. وهنا تتجلى مسؤولية النخب السودانية والعربية والإفريقية في إدراك أن حماية السودان ليست فقط دفاعًا عن دولة، بل عن توازن المنطقة ومستقبلها بأسره.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.