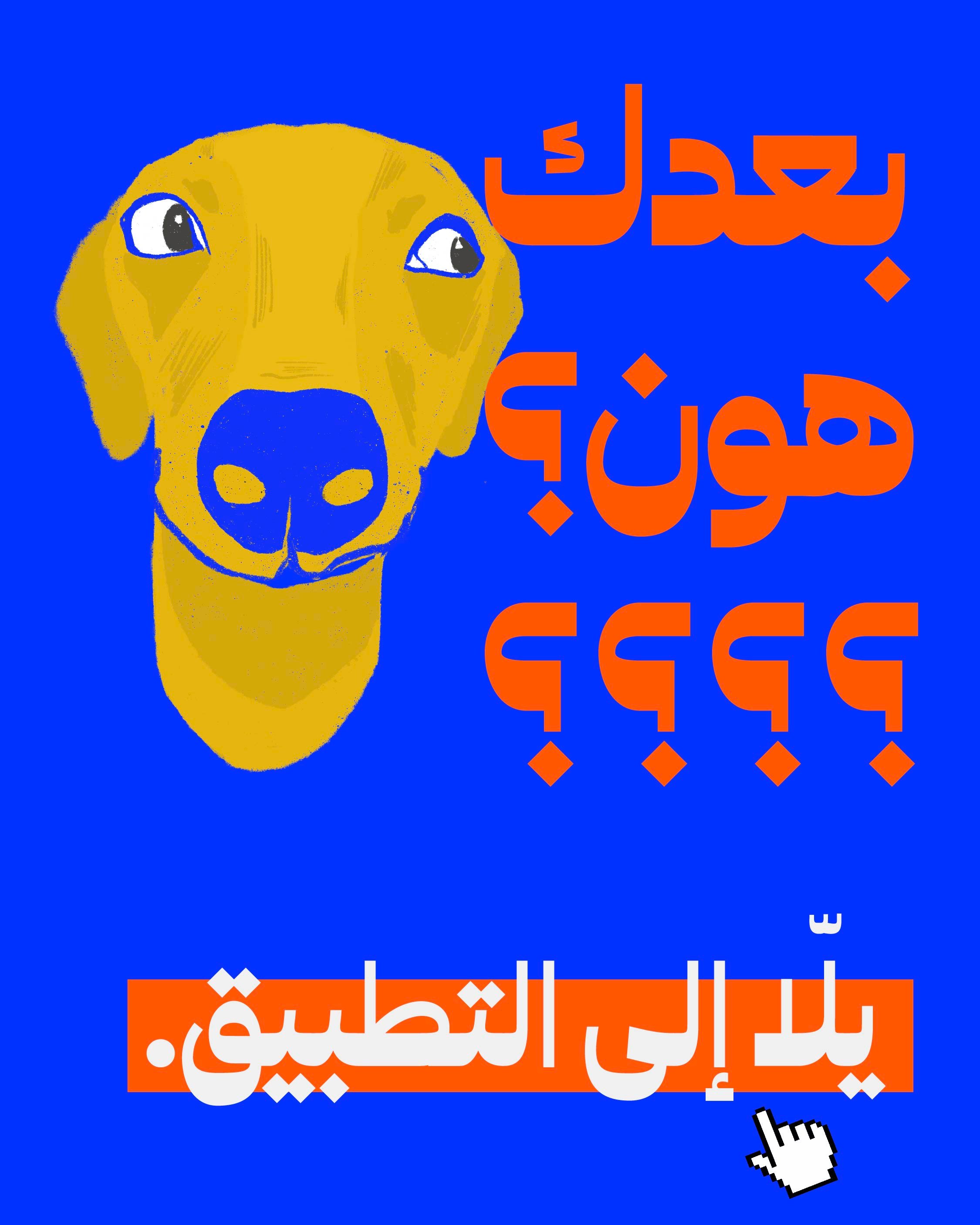هناك مفهوم شائع عن نمط غنائي معيّن، يطلَق عليه أغاني التسعينيات، والتسمية هنا لا يُقصد بها الإنتاجات التي وُجدت خلال ذلك العقد فحسب، بل مكتبة غنائية لحقبة كاملة، ابتدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، واستمرت إلى ما بعد الألفية الجديدة، ولو أنها وصلت إلى الذروة في منتصف التسعينيات، فانتسب ذلك اللون إلى تلك السنوات.
إلا أن أغاني التسعينيات، وبعيداً عن تفاصيل التسمية، تبقى أسلوباً غنائياً، تأثيره ما زال يمارس سطوته على مشاعرنا حتى اللحظة، فلا يمكن الاستماع إلى أغنية من تلك الفترة، دون أن يداهمنا إحساس يصعب تفسيره، قد يكون له علاقة بحنين ما، أو أبعد من ذلك، بينما إنتاج أغنية جديدة عليها طابع موسيقي يشبه ما أنتج آنذاك، يجد جاذبيةً عاليةً، لتتحول المرحلة التي كانت عبارةً عن لحظة تمرّد على تراكم غنائي تشبّع منه المستمع، إلى قيد يحاصرنا، ولا نستطيع الانفكاك عنها.
ويبدو أننا سنستمر طويلاً، لأنه، وحتى اللحظة، لا شيء يلوح في الأفق، ويقول إنّ هناك قدرةً على الإتيان بجديد يتجاوز الماضي، ويرتقي بما هو موجود، لتبقى أغاني التسعينيات بشكلها الموسيقي المغاير هي السائدة، بينما يعود رسوخها في وجداننا، إلى أنّ الجيل الذي نشأ عليها هو صاحب الصوت الأعلى حالياً، والأكثر حضوراً.
الملل من الطرب؟
قبل الذهاب نحو التعامل مع الحالة، من المهم التعريج على طريقة مجيء ذلك اللون الغنائي الجديد، والمختلف، بل يجب الذهاب نحو الجذر، والذي بكل تأكيد لم يكن مجرد إحساس بالملل من التطريب انتاب بعض الفنانين، فذهبوا للإتيان بالجديد، ولا لأن هناك حميد الشاعري -بالرغم من دوره الكبير مع آخرين في تغيّر شكل الغناء العربي- أو بسبب بدء تقبّل المجتمع للجديد، ونجاح هذا اللون مع أغنية "لولاكي"، أو لأنّ هناك تمهيداً للتمرد ابتدأه زياد الرحباني مع فيروز في منتصف السبعينيات.
أغاني التسعينيات، وبعيداً عن تفاصيل التسمية، تبقى أسلوباً غنائياً، تأثيره ما زال يمارس سطوته على مشاعرنا حتى اللحظة، فلا يمكن الاستماع إلى أغنية من تلك الفترة، دون أن يداهمنا إحساس يصعب تفسيره، قد يكون له علاقة بحنين ما، أو أبعد من ذلك
الحالة كانت بسبب أبعاد ثقافية، وسياسية أكثر عمقاً، وتغيرات عمّت العالم لا المنطقة العربية فحسب، فالعالم يعدّ النصف الثاني من القرن العشرين، أكثر فترة زمنية نتجت فيها تحولات، حتى أُطلق عليها "عالم ما بعد الحداثة"، عالم فيه كل شيء نسبي بعد حتمية الحداثة، عالم اتسم بالانقلاب على كل ما قبله، حتى موسيقياً.
كان الوطن العربي جزءاً من هذا التغير، ولو متأخراً، وانتقل من يقين الأغاني الطويلة، إلى شكوك الأغاني القصيرة، ومن بطء التطريب، إلى تقلّب الأغاني السريعة. ساعد في ذلك الاتصال الذي كان يمضي في صناعة عالم متداخل مع بدء التكنولوجيا، بينما العربي كان، ولأول مرة، صاحب دول وطنية مستقلة، يستلهم ما هو عالمي، لإنتاج شيء خاص به، كمواكبة لا كفرض استعماري، لأنّ المسألة كانت هنا اختيارية.
قمع جيل التسعينيات
بالطبع، لن يكون ذلك التغيّر سهلاً، فالأسماء التي يطلق عليها جيل التسعينيات تلقّوا قمعاً شديداً في البداية، بل بالإمكان القول إنهم كانوا مرفوضين تماماً، فعلى سبيل المثال، الجيل الذي تعلّق بأمّ كلثوم، وعبد الحليم، ووديع الصافي، وصباح فخري، وفيروز، كان من الصعب عليه أن يستمع إلى راغب علامة، وعمرو دياب، وسميرة سعيد، بالرغم من أنّ الأخيرة لم تمضِ في البوب من بدايتها.
وحتى عقب تراجع حضور أغاني الرعيل الأول، بقى جمهور ميادة الحناوي، ووردة، مثلاً، هو الأعلى حينها، وكانت المجتمعات تجد فيهما امتداداً للقديم، إلا أنّ التكرار الذي طغى على الغناء العربي في الأغاني الطربية، أتاح المجال للاتجاه الجديد بأن يتجلّى، وهو الاتجاه الذي لا يزال من الصعب تحديد من بدأ به، إلا أننا نعرف جيداً من مضى معه، وبقي ملتزماً بنمطه حتى اليوم، كمحمد منير، وعمرو دياب، وراغب علامة، وغيرهم ممن حققوا النجاح آنذاك. لكن الوصول إلى ذروة الانتشار الذي رافق أغنية "لولاكي"، لعلي حميدة، 1988، والتي عدّ النقاد أنها شكّلت منعطفاً لهذا النوع من الغناء، أصبح ما بعده ليس كما قبله.
موسيقى الحركة مقابل موسيقى الأريكة
مع النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، استمر عصر موسيقى الحركة بالتصاعد، على حساب غناء الأريكة المريحة، وهذا نتاج لعامل نفسي واسع، مضى فيه العالم كله، حيث التقلب يطغى على الثبات، بينما عدّ من رفض ذلك النوع من الغناء، أنه مجرد موجة.
في تسعينيات القرن الماضي، واصل الفنانون الذين بدأت بوادر نجاحهم في الثمانينيات خطهم الفني، بينما صعد معهم فنانون جدد، وأنتجت أغاني تنافسيةً، وارتفعت نسبة المستمعين إلى ما أُطلق عليه "البوب العربي"، وتعلّقوا بطريقة هي المستمرة حتى اليوم، وما تم عدّه موجةً بات حالةً راسخة.
بقى جمهور ميادة الحناوي، ووردة، مثلاً، هو الأعلى حينها، وكانت المجتمعات تجد فيهما امتداداً للقديم، إلا أنّ التكرار الذي طغى على الغناء العربي في الأغاني الطربية، أتاح المجال للاتجاه الجديد بأن يتجلّى.
استطاع نجاح هذه الأغاني تغيير المعايير، لا معايير السوق فحسب، حيث أصبحت معظم الأغاني الذي تقع ضمن إطار ذلك اللون تنجح، وحتى معايير الفنان ذاته، إذ لم يعد الفنان يحتاج إلى ملحّنين كالسنباطي والقصبجي وبليغ حمدي، ولا يتطلب صوتاً قوياً كعلي الحجار، ومحمد الحلو، بل أغنيات بألحان بسيطة فحسب، ترتكز على توزيع أكثر ذكاءً.
دخول الكاسيت وانتشار التلفزيون
هنا جاء دور الشاعري في تأسيس هذا الاتجاه، الذي مضى فيه فنانون وموسيقيون كثر. هذه المعايير التي تغيرت، لشكل الأغنية، وأصبحت بسيطةً وغير متطلبة، ساهمت في ظهور فنانين كثر، رافقتهم شركات إنتاج جديدة، ساعدت في ازدهار السوق، وتالياً ضخت أغاني أكثر في حياتنا، وساهمت في وصول أكثر كثافةً. وهنا، بات احتمال الانسجام أعلى، وهو ما حصل، ووصل إلى حد الارتباط العميق، لأنّ كل تكريس من شأنه أن يفضي إلى نتيجتين؛ تعلّق شديد، أو نفور صارم.
ما جعل تلك الأغاني جزءاً من حياتنا، يعود لأسباب عديدة أيضاً، منها: تطور شكل الانتشار، على سبيل المثال، مجيئها في لحظة تصاعد حضور "الكاسيت" في الفضاء العام، صحيح أنه كان قد بدأ في مرحلة سابقة، لكن في التسعينيات كان عدد من يقتنون الكاسيت، ويملكون "مسجلة" في منازلهم، أعلى، وتالياً يتم هنا استماع من نوع خاص، عكس اقتصار الأغاني على الراديو الذي يتحكم بنوع الأغاني، أو في زمن "الأسطوانة" الصعب.
يمكن القول بأنّ كل إنسان أصبح بإمكانه صناعة مسرح مصغّر في منزله، وحين ترافق ذلك فترة انتشار لأغانٍ معينة، يذهب للاستماع إليها، ولو من باب التجربة.
أيضاً، اتسع سوق التلفزيون، ووصل إلى كل منزل، واقتحمت الشاشة مساحة منازلنا، ما أعطى بعداً بصرياً أعمق لكل أغنية، فالمقطع الذي يشاهده الفرد وفيه غناء مع فيديو كليب، يصبح راسخاً في الذاكرة أكثر، ويتخذ مساحةً أوسع في الذهن، بينما الاتصال بين الفنان والشخص، أصبح أعمق، وتالياً جعل هذا التجذر من احتمالية انبعاث الحنين كلما صادفنا أغنيةً من ذاك الزمن، مرتفعةً للغاية.
هذا بالإضافة إلى الرواج الذي حظيت به تلك الأغاني، بسبب تبدّل العصر، فالأغاني أصبحت تُسمع بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق، بل أصبحت في كل مكان، في المقاهي المنتشرة، والأكشاك الموزعة، في السيارات التي أصبحت تملأ الشوارع، وقاعات الأفراح، والتجمعات الشخصية، وفيما بعد في الهواتف الشخصية، وأجهزة الكمبيوتر.
البعد التجاري وانتعاش الأغنية الفرحة
تعدد الوسائل هنا مفهوم، الأمر الذي جعل الاستماع إلى أغاني التسعينيات بالتحديد مفهوماً، ولا سيّما مع النهضة بالوسائل المتعددة التي وُجدت في الحقبة ذاتها، ولا يستبعد دور شركات الإنتاج، وانتشار التسويق في استخدام الطرق الجديدة والمتنوعة لإيصالها.
جاء دور حميد الشاعري في تأسيس هذا الاتجاه، الذي مضى فيه فنانون وموسيقيون كثر. هذه المعايير التي تغيرت، لشكل الأغنية، وأصبحت بسيطةً وغير متطلبة، ساهمت في ظهور فنانين كثر، رافقتهم شركات إنتاج جديدة، ساعدت في ازدهار السوق
أساليب التسويق وارتفاع البعد التجاري، شملت أيضاً التركيز في صناعة أغنية تجذب نفسية الفرد المستمع، ما أفضى إلى موسيقى ذات مزاج فرح وراقص أكثر، على العكس من الأغاني السابقة التي كانت تتسم بالحزن، والأنين.
هذا التحول لقي إقبالاً، خاصةً مع وجود وعي جديد يدرك تأثير الأغاني في مشاعر الإنسان، وتحديد هوية لحظته، ومع هذه اللعبة العاطفية المضافة، أصبحت الأغاني التي قيل إنّ الموسيقار محمد عبد الوهاب، وبعض مجايليه رفضوها، تجوب الأرجاء، وتحقق نجاحات ليست على مستوى الوطن العربي، بل على مستوى العالم.
الجميع اضطر إلى المضي مع هذا اللون الغنائي، بما في ذلك الخليج، مع راشد الماجد، وعبد المجيد عبد الله، وغيرهما، بينما النجاح الذي حققه عمرو دياب مثلاً، بالوصول إلى العالمية، والحصول على جوائز عالمية، ساهم في قيادة جيل بالكامل إلى هذا الحقل، من فنانين، ومستمعين.
فحتى من لم تعجبه، ذهب للاستماع إلى الأغاني التي أصبحت حديث الناس، فالفرد الذي قرأ خبراً في مجلة عابرة بأنّ الأغنية العربية باتت مسموعةً في كل القارات، شعر بالانتماء لهذا النجاح، وتالياً ذهب للاستماع إليها ولو من باب الفضول، وهذه الأسباب التي دفعته، أجبرته على الإعجاب، ولو تدريجياً، وحتى لو فشل في التقبل لما استمع إليه في البداية، فاضطر إلى الضغط على نفسه، والإنصات أكثر، فهو هنا محل شك، بأنه غير معاصر، ويريد أن يخرج من قالبه القديم، وهكذا تعددت الأسباب، واستمر الانتشار، فالتداول ولّد مستمعين، والاستماع ولّد الإعجاب، والإعجاب ولّد التعلق، والتعلق ولّد حصاراً لم نستطع الخلاص منه حتى الآن.
تزامن الأغاني تلك مع حقبة عربية مستقرة، له علاقة في رسوخ موسيقى التسعينيات وجدانياً أكثر، فمثلاً، عقب التحرر من الاستعمارات في منتصف القرن العشرين، وبدء نشوء الدول الوطنية، والتي بالإمكان القول إنها وصلت في التسعينيات إلى قمة الاستقرار الوطني، قبل أن تتوالى انهيارات الأوطان العربية، والذي يحدد بعض الباحثين بدايتها باجتياح العراق عام 2003، تلتها مراحل من الصراعات، والحروب، إلى الحد الذي وصلنا الآن، بعد اثنين وعشرين عاماً من الغزو الأمريكي، ومعظم بلدان الوطن العربي قد عاشت حروب وشتات من نوع ما خلال العقدين المنصرمين. هذه الاهتزازات الأهلية، والتي أفقدت الكثير من الشعوب العربية الاستقرار، والحياة الآمنة، ضاعفت بشكل غير مباشر قيمة تلك الأغاني، فكل أغنية يستمع إليها الشخص، تأتي محمّلةً بالذكريات عن الأيام الهانئة التي انقضى عهدها، تعيده إليها، وتغرقه في حنين مبالغ به، فما أن يستمع إليها في أثناء عبوره في مكان ما، حتى يدقّ قلبه على إيقاع قديم، وما أن تأتي أغنية جديدة كأغنية فضل شاكر، "صحّاك الشوق"، والتي تم الاشتغال عليها بمزاج تسعيني واضح، حتى لا يكاد أن يتوقف الاستماع إليها.
ما عزز حضور أغاني التسعينيات في أعماقنا إلى الحد الذي أصبح يصعب غيابها، يعود لأسباب كثيرة، ولا نهائية، منها أنّ الجيل الذي يعيش فترة الشباب، ومتوسطي العمر، هم الأعلى صوت حالياً في المجتمع، ورأيهم هو الطاغي على المشهد العام، وهؤلاء نشأوا على تلك الأغاني، أو التحقوا بتلك الحقبة ولو متأخرين، بينما الجيل الذي تربى على "الطرب الأصيل" بدأ يشيخ، ويتراجع حضوره، ولو أنّ هناك جيلاً جديداً ما زال يستمع إلى الفنانين القدامى، لكن ذكرياتهم مع الجديد أعلى، لأنهم نشأوا مع انتشارها في كل الأماكن العامة، والالتصاق الموسيقي الذي يحدث إثر الاستماع لأغنية في الطفولة، من الصعب أن يفلت منه الإنسان، فالاستماع إلى أغنية "نور العين"، أو "مغرم يا ليل"، أو "يا طيب القلب"، وكذلك "المسافر راح"، وغيرها في عمر مبكر، لا يمكن التخلص منه أبداً.
هل تفوّقت الألفية على التسعينيات؟
أيضاً، استمرار مرافقة تلك الحقبة لنا، يأتي بسبب عدم مجيء الجديد الذي يتفوق عليها، ويجعلها من الماضي، فعلى سبيل المثال، لا يمكن لأغاني المهرجانات مهما طغت، أن تتفوق على ذلك اللون لأسباب عدة، وما دام الجديد لم يأتِ بعد، سنجد بأن نجوم اليوم، هم أنفسهم من كانوا نجوم التسعينيات، من عمرو دياب، إلى راغب، وراشد، وعبد المجيد، وسميرة سعيد، ونوال الزغبي، وإليسا، وكاظم (ولو أنه استمر في التطريب أكثر)، وغيرهم.
في التسعينيات كان عدد من يقتنون الكاسيت، ويملكون "مسجلة" في منازلهم، أعلى، وتالياً يتم هنا استماع من نوع خاص، عكس اقتصار الأغاني على الراديو الذي يتحكم بنوع الأغاني... فأصبح بإمكانه صناعة مسرح مصغّر في منزله.
وحتى أغاني هؤلاء فيها خيط ما ممتد من ذلك العصر، على العكس من الفنانين الذي ظهروا مؤخراً، فهم متحررون من السابق أكثر، لكن مهما نجحت أغاني جديدة، مثل "ثلاث دقات" لأبو، أو "البخت" لويجز، من الصعب أن يقول شخص ما، بأنها كانت افتتاحاً لعصر جديد في الموسيقى، أو كونت نمطاً غنائياً حديثاً، ومغايراً، لأنها مجرد طفرة، ولم يستطيعوا تكرارها حتى هم أنفسهم.
الحقيقة هي أنّ العالم يمرّ في لحظة ملل موسيقي، ويفتش عن أي شيء جديد، ليخرج من ركوده الرتيب، إلى الحد الذي يذهب معه إلى الاستماع إلى أي وقع مختلف، من قبيل الشيلات، والمهرجانات، والزوامل، أو الراب الممزوج بالبوب، وأشكال غنائية من الصعب تشخيصها ضمن لون معيّن، مثل تلك التي يقدّمها حالياً الفنان السوري الشاب؛ الشامي، وسبق أيضاً أن غنّى شيئاً مقارباً له ويجز، وسيلاوي، وغيرهما.
هذا الانجذاب إليهم قد لا يعكس جودة ما أُنتج حديثاً، بقدر ما جاء من التشبع مما هو موجود، فما أُنتج مؤخراً، لا يدلّ على أي صناعة لاتجاه من أي نوع. وهذا إذا كان بإمكانه تعزيز شيء معيّن، فهو يعمق من استمرار حضور أغاني التسعينيات في حياتنا، وقدرتها على مرافقتنا حتى لو وُجد الجديد، لأنها استطاعت أن تشقّ طريقها إلى ذاكرتنا، وذكرياتنا مثلها مثل أغاني المطربين الكبار، فيروز، وصباح، وأم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، ووديع الصافي، وصباح فخري، وغيرهم.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.