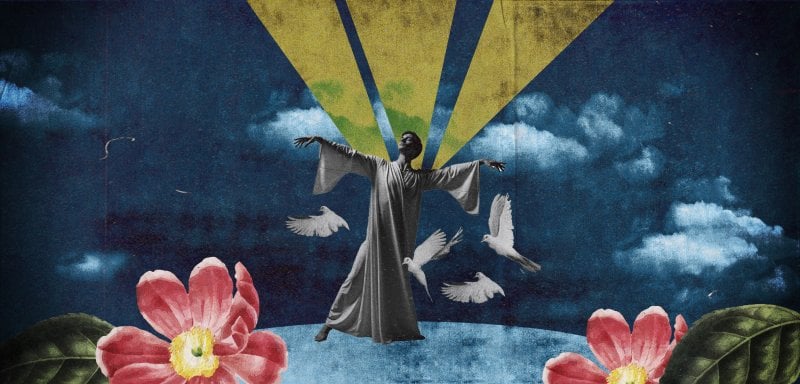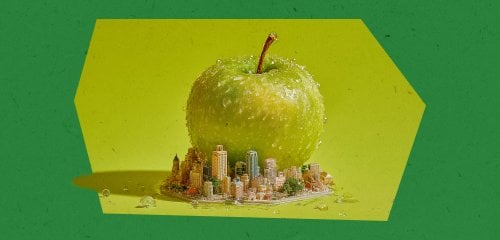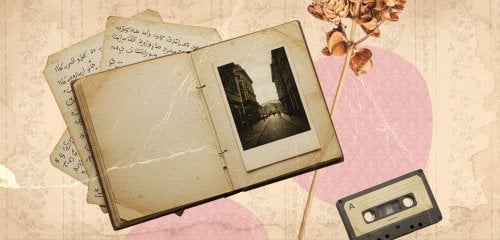حدث ما لم أستطع تسميته، لكنه غيّر كل شيء.
لم يكن حادثاً ولا فقداً، بل كان شرخاً صغيراً في القلب والعقل معاً، كأنّ ضوءاً خافتاً تسلّل من شقّ غير مقصود فأضاء كل ما ظننته صلباً ومقدساً.
تلك اللحظة لم تكن صدمةً، بل يقظة، كأنّ أحدهم أيقظ فيّ السؤال الذي كنت أهرب منه: ماذا لو أنني لم أفهم الإيمان بعد؟
الخوف من العقل
قبل نحو تسع سنوات، كنت في بدايات العشرينات، مسلماً بالفطرة، لكنني التحقت بمجتمع السلفيين ظنّاً أنّ فيه الطريق المستقيم. سرعان ما اكتشفت أنّ هذا النموذج من التديّن يقوم على الكراهية لا المحبة، وعلى الخوف لا الحرية، وأنه لا يمثل الله ولا القيم الإنسانية العليا التي كنت أشعر بها بفطرتي.
ومن شدّة نفوري من هذا الشكل الجامد من الإيمان، بدأت أنفر أيضاً من التدين السطحي الذي ورثته بلا وعي. كنت أمارسه بعادة المراهق لا بعقل الباحث، حتى وجدتني أردد في داخلي صرخةً تخرج من أعماقي: "لا إكراه في الدين، قد تبيّن الرشد من الغي"، لا كآية أحفظها، بل كحقيقة أعيشها.
ومن هنا بدأت أخلع عني الموروث قطعةً قطعةً، وأسأل نفسي من جديد: من أين جئت؟ لماذا أعيش؟ هل الله موجود حقاً كما يصوّره الناس؟ وهل الدين طريق إلى الحرية أو إلى الخوف؟
كنت أشعر أنّ التفكير في هذه الأسئلة جريمة فكرية، كأنّ مجرد استخدام عقلك يُغضب الله الذي وهبك إيّاه. أيّ شاب أو مراهق يجرؤ على السؤال يُردع فوراً بعبارة "حرام تفكر في كده"، وتُلقى عليه إجابات جاهزة لتسكينه لا لإقناعه.
بدأت رحلتي من داخل كهفٍ من الأفكار الجاهزة، أبحث عن الله وسط الخوف لا الحب، فاكتشفت أن المشكلة ليست في الدين بل في الخطاب المتشدد الذي اختطفه، يزرع الرعب بدل الرحمة، ويستبدل الفهم بالطاعة العمياء
هكذا صار السؤال نفسه تهمةً، وصار التفكير عبئاً يولّد الخوف والذنب… حتى من الله.
كنت كلما سألت سؤالاً عن الدين أو الوجود، أجد الرد الجاهز نفسه:
"حرام، لا تتفلسف، لا تشك، لا تسأل"... حتى صرت أخاف من عقلي، وأحسّ بالذنب لمجرد أنني أفكر.
كانوا يقنعوننا بأنّ التقوى في المنع، حتى مما لم يحرّمه الله.
وكنت أردد لنفسي في لحظة ضيقٍ ورفضٍ صامت: ما أجهل الناس الذين يتوهّمون أن التقوى في تحريم ما لم يحرمه الله.
من هنا بدأت أرى أنّ المشكلة لم تكن في الدين، بل في الخطاب الذي اختطفه المتشددون، وهو خطاب وهابي جامد لا يعرف الحوار ولا يقبل الاختلاف، يزرع الخوف بدل الحب، والطاعة العمياء بدل الفهم.
كنت أشعر أنني أعيش داخل كهف كبير، كل ما فيه ظلٌّ لما هو حقيقي، وقررت أن أخرج منه إلى النور. بدأت أتعلم كيف أفكر، لا لأتمرّد، بل لأتحرر، ولأرى الله لا كما يُملى عليّ أن أراه، بل كما يكشفه لي ضوء العقل وفضاء المعرفة، في رحلةٍ للبحث عن الحق والخير والجمال أينما وُجدت في الوجود.
التفلسف والتفكير النقدي... عندما فكّرت كيف أفكّر
كنت أشعر أن النجاة في العثور على إجابات، لكن الحقيقة أن البداية كانت في أن أتعلم كيف أطرح الأسئلة، وكيف أفكر في التفكير نفسه.
لذلك لجأت إلى دراسة الفلسفة والتفكير النقدي كأساس أبدأ منه. فتنتُ بالإنسان المتمرّد الذي يجسده الفيلسوف، ذاك الذي يدعو الناس إلى الخروج من كهفهم واكتشاف الحقيقة بأنفسهم، لكنهم يخافون الضوء أكثر مما يخافون الظلام.
أدركت أن الشرخ الصغير الذي أصاب قلبي وعقلي لم يكن كسراً بل يقظةً، كضوء خافت تسلّل من شقٍّ غير مقصود فأضاء كل ما ظننته صلباً ومقدساً، فبدأت أسأل نفسي للمرة الأولى: ماذا لو أنني لم أفهم الإيمان بعد؟
فالحرية مربكة، والمجهول لا يُطمئن، وكثيرون حين يخرجون من السجن يبنون لأنفسهم سجناً آخر في الخارج، لأنّ السجن الحقيقي بداخلهم أصلاً.
هكذا تصير العادة أقوى من الفطرة، وتطغى على العقلانية. الخروج من الكهف يحتاج إلى جرأة، وإلى قدرة على الدهشة والمخاطرة.
قلة من البشر لديهم الشجاعة لهدم المعتقدات الموروثة أو الشهيرة أو القديمة، التي ربما حملوها دون مراجعة. فإذا كان الدين يقول إنّ النار تحرق، فالفيلسوف لا يكفّ عن الاقتراب منها، برغم الألم، ليختبر بنفسه سبب الحرق ومعناه. وإذا كان الدين يقدم معادلةً أو كتالوغاً للحياة، فالفلسفة هي التجربة التي تضع تلك المعادلة على المحك.
في تلك المرحلة كنت أشاهد مناظرات بين متدينين وملحدين، أبحث فيها عن نور أو يقين، لكنني كنت أجد جدالاً بلا فهم.
يتحول الحوار فيها إلى ساحة اتهامات:
المتديّن يرى الملحد فاسداً أخلاقياً، يتمرد على الله ليبرّر لنفسه ما حرّمه الدين، بينما يرى الملحد المؤمن شخصاً لا يستخدم عقله، ومتديناً بالوراثة يعيش في جاهلية فكرية ويحاول استلاب حرية الآخرين.
المشكلة التي كانت تؤرقني لم تكن في إيمان هذا أو إنكار ذاك، بل في منطق الحوار ذاته الذي يقوم على مغالطاتٍ وانفعالاتٍ تفسد أي نقاشٍ حقيقي.
كلا الطرفين يرى أنه على صواب، وهذا طبيعي؛ لأنّ كلاً منهما يبني معتقداته الجزئية على مقدماتٍ كليةٍ مختلفة.
العاطفة تسوق الإنسان إلى تصديق ما ينتمي إلى معتقده الموروث دون تفكير نقدي. لكن كي نصل إلى لغة حوار مشتركة تمكّننا من الفهم، لا من الانتصار، يجب أن نتفق أولاً على منطق واحد، وعلى آداب عامة للحوار.
ليس بالضرورة أن نتفق أو يُقنع أحدنا الآخر في قضية جدلية كبرى -كوجود الإله مثلاً- لأنها قد لا تحتمل رأياً وسطاً.
لكن ما يجعل التعايش ممكناً، هو أن نبحث عن المشترك الإنساني بيننا، وعن الأخلاق التي تجمعنا، لا عن العقائد التي تفرّقنا. فكلنا، في النهاية، نؤمن بالحق والخير والجمال، أيّاً كان اسمها أو طريقها. كما قال الحكماء في "الريج فيدا": "الحق واحد، لكن الحكماء يسمّونه بأسماء مختلفة".
(الهندوسية – البهاجافاد جيتا – ريج فيدا 1:164:46)
قد يصحّ أن نُعرّف الجاهل المتعصب بأنه ذاك الذي لا يعرف إلا معتقده ويظن أنه الحق المطلق، لا ينظر إلى أفكار الآخرين إلا بعدسة الحكم والإدانة، ويدخل النقاش لا ليبحث أو يكتشف، بل ليفوز ويُثبت أنه على صواب.
وإن خسر الحجة شعر بالهزيمة، لأنّ قوة معتقده -إن كانت حقيقيةً- لا تحتاج إلى صراخٍ أو عنادٍ لتثبت نفسها.
من يخاف المراجعة يبرهن على هشاشة إيمانه. أما من يتسلّح بالمعرفة، فيدرك أن العالم ليس أبيض أو أسود، بل هناك درجات كثيرة من الرمادي، ومساحات واسعة للنسبي والمحتمل. حينها أدركت أنّ الصراع لم يكن بين الحق والباطل كما تخيّلت يوماً، بل بين وعيي المحدود بالحق وقدرته اللامحدودة على التجلي.
تعلمت أن التفكير ليس جريمةً بل بداية الحرية، وأن العقل الذي يُخاف منه هو ذاته الطريق إلى الله. حين خرجت من كهف الموروث، رأيت أن الحقيقة لا تُورّث، بل تُكتشف، وأن الإيمان لا يُفرض، بل يُعاش بصدق ودهشة دائمة
فالحق في جوهره ثابت لا يتغيّر، لكننا نحن من نراه كل مرة بوجهٍ جديد، بحسب ما اتّسع له عقلنا وتطهّر به قلبنا.
ما تغيّر هي نظرتي إلى الحق، لا الحق نفسه؛ فكل خطوة في طريق التساؤل والدهشة كانت تُعيد تشكيل علاقتي به، وتُعلّمني أنّ البحث عن الحقيقة ليس خروجاً عليها، بل اقتراب أعمق منها.
الطريق إلى الله بعد اكتشاف خريطة جديدة للدين
مررتُ بمحطات كثيرة في رحلتي نحو الحقيقة، انتقلتُ فيها من الشك إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى إعادة تعريف الإيمان نفسه. في مرحلة ما، عدتُ تدريجياً للاعتقاد بوجود الله، لكن بطريقة لا تنتمي إلى دينٍ محدّد. كنت مؤمناً بما يشبه "الربوبية الحديثة"؛ إيمانٌ بالعقل والأخلاق والضمير الإنساني، لا بالوصايا المغلقة أو الطقوس الجامدة. ظننت أنّ الخلاص في الفن، وأنّ الجمال وحده كافٍ لملء فراغ الروح، فكنت أجد في الأدب والسينما شكلاً من العبادة، كأنّ التأمل الجمالي طريقاً روحيّاً آخر.
ومع مرور السنوات، بدأت أشعر بحاجة داخلية إلى الصلاة، لا كتكرارٍ لما عرفت، بل كلجوء صادقٍ إلى الله بطريقتي الخاصة. كنت أؤمن بأنّ الطريق إليه بعدد البشر، وأنّ النية الخالصة أهم من الشريعة. لذلك كنت أصلّي صلاة الإسلام، لأنها لغتي الأولى مع الله، برغم أنني لم أكن أقتنع بالكثير من المعتقدات أو القواعد الفقهية التي أحاطت بها.
خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومع نضوج التجربة، بدأت أكتشف معنى أعمق للدين، فعدت إلى الإسلام مجدداً، لكن بعقلٍ مختلف وقلب أكثر اتزاناً. لم تكن العودة استسلاماً، بل فهماً جديداً بأنّ الدين ليس سلطةً على الناس، بل مسؤولية على النفس.
كنت أستعيد في داخلي عبارة الرومي: "غاية التدين هي السيطرة على النفس، لا على الآخرين".
لم أعد أبحث عن الله في السماء أو النصوص، بل في داخلي، في صدقي ورحمتي واتساقي مع نفسي. الإيمان عندي صار رحلةً لا تنتهي، تتسع كلما شككت، وتصفو كلما أحببت، طريقاً تتقاطع فيه الحقيقة والإنسان.
حين فهمت ذلك، تبدّل كل شيء. صرت أرى أنّ الله لا يُطلب في الصراع ولا في الجدل، بل في السكينة التي تأتي من مصالحة الذات.
لم أعد أبحث عن الله في السماء، ولا بين نصوص الكتب، بل في داخلي، في قدرتي على أن أكون إنساناً أكثر صدقاً ورحمةً واتساقاً مع نفسي. شيئاً فشيئاً، أدركت أن التدين الحق لا يعني الانغلاق داخل طقوس أو شعائر، بل الانفتاح على معنى أوسع للعبادة، حيث تكون كل لحظة صدق، وكل فعل عدل، وكل نظرة حب، ضرباً من الصلاة.
جاء هذا التحوّل بعد إدراك بسيط لكنه عميق: الامتناع عن الخطأ أحياناً أهم من السعي وراء الصواب، وقاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة" لم تكن مجرد قاعدةٍ فقهيةٍ، بل حكمة إنسانية للحياة نفسها.
منذ تلك اللحظة، تغيّرت علاقتي بالناس وبالعالم. لم أعد أبحث عن الإقناع أو الهيمنة، بل عن الفهم. تعلّمت أن أحبّ الناس كما هم، لا كما أريدهم أن يكونوا، وإن لم أستطع حبّهم، أتقبّلهم على الأقل. أكره الخطأ لا المخطئ، وأؤمن بأنّ ما قاله المسيح: "تحب قريبك كنفسك" ليست مجرد وصيةٍ دينيةٍ، بل جوهر الإنسانية.
وهكذا صرت أرى الدين لا كعقيدةٍ مغلقةٍ، بل كموقفٍ أخلاقيّ من الذات والعالم.
الإيمان عندي اليوم رحلة لا تنتهي، تتسع كلما اقتربت، وتصفو كلما شككت. بحث دائم، يتجدد مع كل سؤال، ويتسع مع كل تجربة.
ما زلت أتساءل وأتأمل، أقرأ وأقارن، أبحث في الإسلام وفي الأديان كلها من زاوية إنسانية تدعو إلى الحوار لا الصدام، وإلى التقاطع لا الانقسام.
أحاول أن أكون مؤمناً بالعقل، وباحثاً عن الله في الناس، لا في الصراع حول من يملكه أكثر.
ما زلت أؤمن بأنّ الطريق إلى الله -مثل الحقيقة- لا يُرسم بخط مستقيم، بل بخطوط كثيرة تتقاطع عند الإنسان.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.