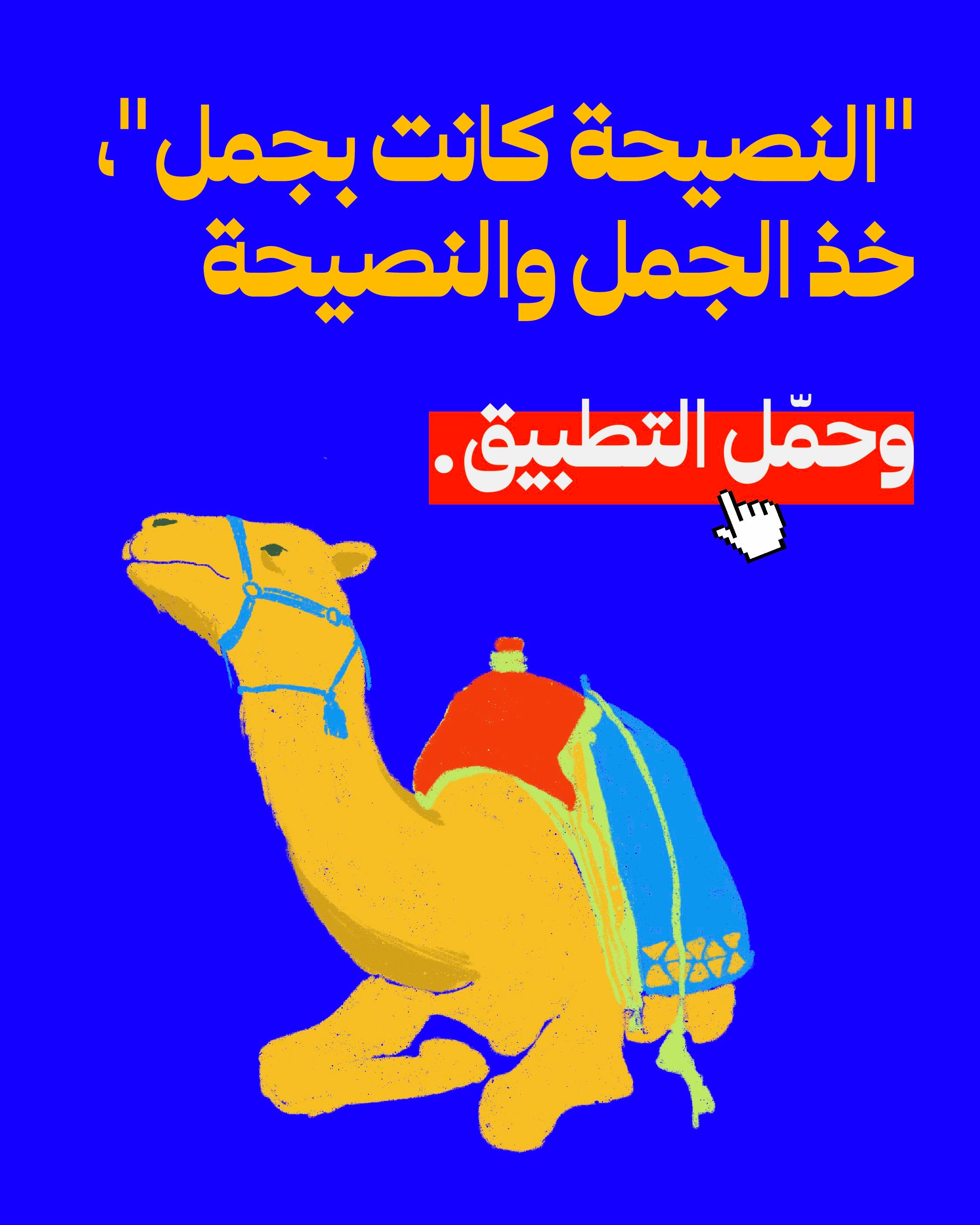خلال السنوات الأخيرة، طرأت تحولات جوهرية على أنماط التديّن في العالم العربي، بفعل التغيرات السياسية التي أعقبت ثورات الربيع العربي، بجانب التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي. هذا التغيّر أدى إلى تراجع دور الشيخ التقليدي والمؤسسات الرسمية التي احتكرت الفضاء الدعوي.
في المقابل، برزت أشكال جديدة من الخطاب الديني، يتجلى أبرزها حالياً في انتشار "البرامج الدينية" عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية التي أصبحت تجذب شريحةً متزايدةً من الشباب، حتى غدت أحد المكوّنات الأساسية في المشهد الديني اليوم.
هذه الظاهرة تعكس تحولاً عميقاً في بنية التلقّي الديني وفي مضمون الخطاب ذاته، فقد صار "الشيخ الرقمي"، إن جاز التعبير، يخاطب جمهوره عبر شاشات الهواتف ويصوغ مفاهيم الدين بلغة رقمية أكثر قرباً من نبض الشباب وأسئلتهم. وتلك التحولات ليست مجرد تطور في أدوات التعليم الديني، بل هي تنذر بتغيرات بنيوية في الطريقة التي يُعاد بها إنتاج الفهم الديني في زمن الشبكات المفتوحة والانتماءات السائلة.
من هذا المنطلق، يتناول هذا التقرير نشأة هذه الظاهرة وتوسعها، متتبعاً البدايات الأولى مع تجربة الشيخ محمد صالح المنجد، والتي فتحت الطريق أمام تعليم شرعي خارج الإطار الرسمي، وصولاً إلى نماذج جديدة أكثر تنظيماً وتأثيراً إحدى التجارب التي تجسدها هي تجربة الشيخ أحمد السيد، والتي مثلت تحوّلاً نوعياً في منهجية التعليم الشرعي عبر الفضاء الإلكتروني.
ينظر العديد من الدعاة إلى الإنترنت ليس فقط كأداة تبليغ، بل أيضاً كبيئة علمية متكاملة، يمكن أن تُخرّج طلاب علم حقيقيين يتلقّون المعارف الشرعية بمنهجية مدروسة خارج أسوار المؤسسة الدينية التقليدية. فهل نحن بصدد أفول تدريجي للمشيخات التقليدية؟
كما يحلل التقرير طبيعة هذه البرامج، ومحتواها، وآلياتها، وجمهورها، والتحديات التي تواجهها، ولماذا تنجح في الوصول إلى الجيل الجديد، في محاولة لفهم ما إذا كانت هذه الظاهرة تمثّل مرحلةً انتقاليةً أو بديلاً مستقبلياً عن المشيخة التقليدية.
من المسجد إلى الفضاء الرقمي… نشوء الظاهرة وتوسعها
يُعدّ الشيخ محمد صالح المنجد، الداعية السلفي ذو الأصول السورية، من أوائل من كسروا حدود التلقين الديني التقليدي، وفتحوا المجال لتعليم شرعي واسع خارج إطار المساجد والمؤسسات الرسمية.
منذ تسعينيات القرن العشرين، كان الشيخ المنجد من أوائل من استثمروا الفضاء الرقمي في تقديم التعليم الشرعي، إذ أسس موقع "الإسلام سؤال وجواب"، كمنصة إلكترونية للفتوى والتثقيف الديني، وإن كانت تفتقر إلى المنهجية التعليمية المتكاملة.
ثم في عام 2015، أطلق المنجد منصة "زادي للتعليم الشرعي المفتوح"، والتي مثّلت نقلةً نوعيةً باعتبارها أول مبادرة منظمة لتدريس العلوم الشرعية عبر الإنترنت باستخدام تقنيات حديثة، ما جعل المنجد من أوائل المؤسسين لظاهرة البرامج الدينية الرقمية.
نجاح المنجد وانتشاره الواسع ألهما عدداً من الدعاة الشباب الذين وجدوا في تجربته وسيلةً للوصول إلى جمهور جديد أكثر تنوعاً بعيداً عن الإطار المؤسسي الرسمي، فبدأت تظهر مواقع إلكترونية شبيهة، ومنصات تعليمية تقدّم دورات فقهيةً وعقائديةً بشكل منهجي، بعضها حاول تقليد أسلوب المنجد، وأخرى سعت إلى تقديم دورات بصيغ أكثر تفاعليةً تتلاءم مع الجيل الرقمي.
وأصبح كثير من هؤلاء الدعاة لا ينظرون إلى الإنترنت كأداة تبليغ فقط، بل كبيئة علمية متكاملة، يمكن أن تُخرّج طلاب علم حقيقيين يتلقّون المعارف الشرعية بمنهجية مدروسة خارج أسوار المؤسسة الدينية التقليدية.
ومع تصاعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر جيل جديد من الدعاة الذين استخدموا منصات مثل يوتيوب، وتليغرام، ليقدّموا برامج دينيةً متنوعةً تتسم بمواكبة اهتمامات الجيل الجديد وإشكالاته وأسئلته.
وسرعان ما شهدت هذه البرامج تطوراً ملحوظاً من مجرد مبادرات بسيطة إلى مشاريع تعليمية منظمة ذات طابع منهجي، تتضمن دورات في الفقه وأصول الدين، وتطرح مناهج علميةً متكاملةً تُقدَّم بصيغة رقمية، ومن اللافت أن معظم القائمين على هذه المبادرات لا ينتمون إلى المؤسسات الدينية الرسمية.
وقد تزامن هذا التحول مع تزايد إقبال الشباب على هذه المنصات، إذ وجدوا فيها إجابات عن تساؤلاتهم وبديلاً عن الخطاب المؤسسي. هذا التفاعل الشبابي النشط أسهم في توسيع نطاق هذه البرامج بسرعة، لتنتقل من الهامش إلى صدارة المشهد الديني.
ويُعدّ الشيخ أحمد السيد، أحد أبرز الوجوه الفاعلة في ظاهرة البرامج الدينية الرقمية، والمجدد الأهم في هذه الظاهرة بصيغتها الحالية، فقد شكلت تجربته نموذجاً مؤثراً استلهمته العديد من المبادرات اللاحقة، لما اتسمت به برامجه من تنظيم منهجي وتفاعل شبابي واسع.
ويظهر أثره بوضوح في حجم التفاعل الذي تحققه برامجه على وسائل التواصل، حيث يتفوق السيد على نظرائه من دعاة البرامج الرقميين في نسب المشاهدة وعدد المتابعين، ما يجعله علامةً بارزةً في إعادة تشكيل المشهد الدعوي عبر الفضاء الرقمي.
برز اسم السيد في الساحة الدعوية الرقمية بعد تقديمه برنامج "صناعة المحاور"، الذي شكل انطلاقةً قويةً عرّفته على جمهور واسع، وأسّس السيد لنمط جديد في مخاطبة الشباب فكرياً وعقائدياً، وما يميّز السيد هو تفرغه الكامل لهذا المجال، وانخراطه الجاد في تقديم برامج دينية وفكرية موجه بدقة، بجانب تجاوزه الطابع الوعظي التقليدي.
وقد أسس السيد عدداً من البرامج المشهورة، أبرزها "البناء المنهجي والبناء الفكري" و"أكاديمية الجيل الصاعد"، فضلاً عن برنامجه الأوسع "مشروع العمر للمصلحين"، الذي يمتد لخمس سنوات ويتضمن مسارات تخصصيةً في الفكر والتربية والدعوة والعلوم الشرعية.
سمات هذه البرامج
تتميز هذه البرامج بطابعها المنهجي المنظم، حيث تُقدَّم المعرفة في صورة مترابطة ومتدرجة، لا كمجرد دروس متفرقة أو نصائح عشوائية، وتُبنى العديد منها على مبدأ التدرج والاختيار الحرّ، ما يجعل مسارها طويل الأمد.
على سبيل المثال، يتضمن برنامج "البناء المنهجي"، ثلاثة مسارات رئيسية: شرعي، ثقافي، وفكري، بالإضافة إلى مسار لحفظ القرآن، ويستغرق كل مسار أكثر من عام، ويشترط البرنامج اجتياز اختبارات مرحلية للانتقال إلى المرحلة التي تليها، انتهاءً بمطالبة المشاركين بمشاريع تخرّج إلى أن يتم منحهم شهادات غير معترف بها رسمياً.
تتسم هذه البرامج بعدد من الخصائص اللافتة، أبرزها استقلالها المالي والإداري عن المؤسسات الرسمية، وبعضها يعتمد على التبرعات التي تأتي من منصة "باتريون"، ما يمنحها حريةً أكبر في المحتوى والتنظيم، علماً بأن أغلب هذه البرامج مجانية بالكامل، ولا يُطلب من المشاركين أي رسوم، باستثناء من يرغب في اقتناء الكتب الورقية بدلاً من النسخ الإلكترونية المتاحة.
كما تمتاز بتنوّع مصادرها، إذ تضمّ محاضرين من بلدان مختلفة، وتستند إلى مرجعيات فكرية وفقهية متعددة، ما يُخرج الطالب من دائرة التلقّي الأحادي المرتبط بشيخ واحد أو مدرسة واحدة.
كذلك تتميز هذه البرامج بقدرتها على الانطلاق من واقع الشباب واستيعاب تساؤلاتهم المعاصرة، ما يمنحها قدرةً أكبر على ملامسة احتياجات الجيل الجديد والتفاعل مع اهتماماته الفكرية والدينية. كما تتميز بمرونتها في استيعاب شرائح عمرية وثقافية متعددة، مع تركيز واضح على فئة الشباب الجامعي، والأهم أنها بالفعل توفر فرصةً لمن لم تتسنَّ لهم دراسة العلوم الشرعية عبر القنوات التقليدية، ما يجعلها أكثر انفتاحاً مقارنةً بالمؤسسات الدينية الكلاسيكية.
لا تقتصر غالبية البرامج الدينية الرقمية على الجوانب الوعظية أو العلوم الشرعية، وفي حين أنها لا تتبنى خطاباً سياسياً مباشراً، إلا أنها ليست منفصلةً عن الواقع ولا تغفل القضايا السياسية والاجتماعية المحيطة. فهل يكسبها ذلك شعبية أكبر؟
وبرغم أنّ هذه البرامج تُسهم في بناء مجتمع واسع يتشارك أفراده القيم والطموحات نفسها، إلا أنها تواجه تحديات بارزةً، من أهمها غياب الإطار المؤسسي الرسمي، ما يقلّل من القيمة الأكاديمية لشهاداتها، كما تعاني من صعوبة الحفاظ على انخراط المشاركين واستمراريتهم في ظل غياب المتابعة المباشرة.
وزيادةً على اعتماد العديد من هذه البرامج على التبرعات كمصدر تمويل رئيسي، ما يجعلها عرضةً لتقلبات مالية قد تؤثر على استمراريتها، يتمثّل التحدي الأكبر في غياب الروابط الحية والروحية بين الطلاب والأساتذة، وكذلك بين الطلاب أنفسهم، وهو ما قد يُفضي إلى شعور بالعزلة وغياب الصحبة العلمية التي لطالما كانت جزءاً جوهرياً من بيئة التعلم التقليدي.
وقد حاولت بعض البرامج، مثل "البناء المنهجي"، تجاوز هذه الإشكالية من خلال إنشاء مجموعات تفاعلية عبر تطبيق تلغرام، أو ما يسمّيها طلاب هذه البرامج "الصحبة الصالحة" أو "البيئة النظيفة" وهي عبارة عن غروب تفاعلي على تلغرام، واحد خاص بالبنات والآخر خاص بالشباب، ومن خلال هذه المجموعات يتعرفوا/ ن على بعضهم/ نّ.
كذلك شهدت بعض المدن مثل القاهرة وطرابلس، مبادرات للتلاقي الواقعي بين طلاب هذه البرنامج، عبر تنظيم لقاءات دورية واحتفالات تخرّج لطلاب هذه البرامج، وبجانب ذلك يسعى القائمون على هذه البرامج إلى الحفاظ على التواصل المباشر مع الطلاب من خلال جلسات تفاعلية رقمية تُعقد بين الحين والآخر للإجابة عن أسئلتهم، فضلاً عن وجود قنوات دعم تقني مثل "بوتات" على تطبيق تلغرام، وكوادر فنية مخصصة للتواصل مع الطلاب وتقديم الدعم المستمر لهم.
ما هي الموضوعات التي تطرحها هذه البرامج؟
لا تقتصر غالبية هذه البرامج الدينية على الجوانب الوعظية أو الشرعية فحسب، وبرغم أنها لا تتبنى خطاباً سياسياً مباشراً وتركّز على الجانب التعليمي، إلا أنها ليست منفصلةً عن الواقع ولا تغفل القضايا السياسية المحيطة.
كما أنّ معظم هذه البرامج لا تسعى إلى تعويض غياب الفعل السياسي بنجاح اقتصادي، كما هو الحال في بعض التجارب الأخرى التي أشرنا إليها سابقاً، فغالبية هذه البرامج تُقدّم دون أي مقابل مادي، ما يعكس طابعها الرسالي.
أما في ما يتعلق بالمنظومة التعليمية لهذه البرامج فهي ذات شقّين، الأوّل: المناهج المؤلفة من المتون التأصيلية والشروح والحواشي في أصول الفقه والتفسير والحديث واللغة العربية، وفلسفة ذلك التعليم قائمة بالدرجة الأولى على النمط التقليدي القديم الذي انتشر في ربوع العالم الإسلامي قبل الاستعمار، لكن بشرح وأسلوب معاصرين مبسطين، وبشكل تدريجي منظم. والشق الثاني هو الجانب التربوي والطرق التزكوية والتثقيفية.
عموماً، فإنّ معظم موضوعات هذه البرامج تدور حول تعزيز مرجعية الوحي، معرفة أصول وقواعد الإسلام، التوفيق بين الإيمان والعلم، إثبات صحة القرآن والسنّة، كما تتناول موضوعات مثل تأسيس التفكير النقدي، معالجة الإشكالات الفكرية المشككة للمسلم في دينه، بجانب التزكية وأعمال القلوب وأخوّة الإسلام. وبرغم هذا المنحى، تسلك بعض البرامج القليلة مساراً مختلفاً، إذ تنشغل بالتفاصيل الخلافية الفقهية والعقائدية.
وبينما تركز معظم البرامج على موضوعات تأصيلية شرعية، يُلاحظ أنّ برامج الشيخ أحمد السيد تتميز بتركيز خاص على قضايا الهوية والإصلاح، بجانب التأكيد على الثوابت والغايات الإسلامية التقليدية، ويمكن فهم مشروعه باعتباره إعادة إنتاج للهياكل الدينية التقليدية، لكن في قالب معاصر يستجيب لحاجات الجيل الرقمي ويتفاعل مع أسئلته الراهنة.
كذلك وبرغم تركيز برامج الشيخ على الثقافة والبناء الفكري وأصول الدين، إلا أنها لا تنحصر في هذه الجوانب فقط، فقد عبّر أحد المشاركين في برنامج البناء المنهجي بقوله إنّ "الشيخ عزز لدينا الهوية الإسلامية، وأحيا فينا روح الانتماء للدين والعمل الإسلامي".
وفي حديثه إلى رصيف22، يوضح محمود زكريا، وهو طالب جامعي مصري في أوائل العشرينات ومن المنتسبين إلى برنامج البناء المنهجي، أنّ برامج السيد تمسّ جوانب واقعيةً من حياته، قائلاً: "معظم الأمثلة التي يستخدمها الشيخ أحمد السيد في محاضراته حديثة ومعاصرة، وغالباً ما تتعلق بأشياء في حياتنا اليومية، مثل الحياة الجامعية والتحديات التي نواجهها في عصرنا، مثل الشهرة والشهوات، وقد مررت بمواقف في حياتي اليومية استشعرت فيها نصوصاً شرعيةً من القرآن أو الحديث تذكرتها من خلال دروسنا في البناء المنهجي".
وما يميّز برامج السيد عن غيرها، هي أنها تستهدف معظم الفئات العمرية على اختلاف طبقات أبنائها وقضاياهم وتوزع جغرافيتهم، وقد قام السيد بالفعل بتخصيص برامج لاستيعاب كل الفئات العمرية بمن فيهم الأطفال والنساء، لكن معظم برامجه تركز على الشريحة ما بين 16 و30 سنةً، ويبدو أنّ أكثر الشرائح التي انضمت إلى برامج السيد هي شريحة طلبة الجامعة.
حتى اللحظة، لا يوجد برنامج رقمي يُضاهي برنامج البناء المنهجي من حيث الشمول والمنهجية والانتشار، وبرغم أنّ "أكاديمية زاد" تُعدّ الأقرب من حيث الشكل، إلا أنها لا تُلبي احتياجات شريحة واسعة من الشباب الباحثين عن بناء فكري وثقافي إلى جانب التأصيل الشرعي، كما يعبّر أحد طلاب البناء المنهجي في حديثه إلى رصيف22: "اشتركت في أكاديمية زاد، لكنها كلها مقررات شرعية مجردة، دون أن تشمل مساقات فكرية أو ثقافية".
حتى اللحظة، لا يوجد برنامج رقمي يُضاهي برنامج البناء المنهجي من حيث الشمول والمنهجية والانتشار.
من الواضح أنّ الجانب الثقافي والفكري يشكل ركيزةً محوريةً في برامج السيد، إذ يُخصص نصف مقرر برنامج البناء المنهجي لموضوعات ترتبط بالثقافة والتفاعل مع قضايا الواقع، باستثناء الجوانب الاقتصادية. ويرى عدد من المنتسبين إلى برنامج البناء المنهج أنّ قسم الثقافة هو الأكثر تأثيراً، كونه أسهم في تعميق فهمهم للعالم، وبلورة وعيهم بالقضايا التي تهمّ المسلمين، ومنحهم أدوات للتفاعل الواعي مع ما يحيط بهم.
برغم الخلفية السلفية للسيد، واعتماده في القسم الشرعي من برامجه على شروحات علماء مثل العثيمين وعبد الكريم الخضير، إلا أنّ خطابه يتجاوز في كثير من جوانبه النمط السلفي التقليدي، فهو لا يلتزم بمنهجية صارمة في اختيار مقررات برامجه، بل ينفتح على طيف واسع من المرجعيات الإسلامية، مع توجيه طلابه للتمييز بين ما يُؤخذ وما يُردّ، ومع ذلك، تظهر في برامجه بصمة واضحة للمدرسة السلفية الإصلاحية في السعودية، من خلال اعتماد كتب تعود لرموز من تيار الصحوة، كان بعضهم قد تعرّض للاعتقال في السنوات الأخيرة.
لماذا ينضم الشباب إلى هذه البرامج؟
يمكن القول إن أبرز ما يميز الكثير من هذه البرامج هو ارتباطها بالواقع الاجتماعي والنفسي والثقافي الذي يعيشه الشباب العربي، وقد عبّر أحد تلامذة السيد عن ذلك في حديثه إلى رصيف22، موضحاً أنه نشأ بعيداً عن الالتزام الديني، وأنّ تعرّفه إلى السيد جاء في سياق سعيه للعثور على إجابات لأسئلة فكرية كانت تؤرقه.
أحد الشباب المغاربة نشر فيديو على يوتيوب تحدث فيه عن تجربته الشخصية مع برامج السيد، وضمن الحجج التي قدّمها لإقناع متابعيه بالانضمام إليها، هي أنّ هذه البرامج أكثر ارتباطاً بواقع الشباب واهتماماتهم الفكرية والقضايا المعاصرة التي تواجه العالم الإسلامي.
بينما أوضح شاب سوري آخر أنّ دافعه للالتحاق بهذه البرامج كان اهتمامها بالقضايا المركزية الكبرى ونظرتها الشمولية إلى الشريعة. وفي تجربة مغايرة، كان أحد الشباب السعودي يتبنى فكر التكفير وانضم سابقاً إلى جماعة "الأحباش"، لكنه تخلّى عن هذا المسار بفضل ما تلقّاه من هذه البرامج.
رغدة السعداوي، طالبة ليبية في جامعة إسطنبول، عانت طويلاً من التشتت المعرفي وتضارب الآراء، وظلّت حبيسة الحيرة لفترة طويلة، لكن بعد التحاقها ببرنامج البناء المنهجي، وجدت الاستقرار الفكري الذي كانت تنشده، واستقرت لديها الأسس المعرفية، فشعرت أخيراً بالاطمئنان الذي لطالما بحثت عنه.
تشير تجارب هؤلاء الشباب إلى أن التديّن الرسمي في معظم البلدان العربية لم يعد قادراً اليوم على استيعاب الجيل الجديد وأفكاره وتنوعه، ومن الصعب حقيقةً أن يجتذب شريحة الشباب التي اجتذبتها هذه البرامج الدينية على الإنترنت.
ففي الحالة المصرية على سبيل المثال، معظم الشخصيات التي كانت تُلهم الشريحة ذاتها من الشباب التي تأثرت لاحقاً ببرامج السيد، أصبحت خلف القضبان، كأيمن عبد الرحيم وأنس سلطان ومشايخ مؤسسة شيخ العمود وغيرهم. ومع غياب هذه النخبة وسجنها، بجانب عجز المؤسسة الأزهرية عن ملء هذا الفراغ بمفردها وفشل خطابها في جذب الشباب، وجد كثير من هؤلاء اليافعين ضالتهم في برامج السيد وأمثاله.
حتى مبادرة الأروقة العلمية في الأزهر التي أُطلقت برعاية شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبموافقة الدولة منذ عام 2013، لم تنجح في استقطاب شريحة الشباب الذين انجذبوا إلى برامج السيد وغيره. الإشكال لا يكمن فقط في محتوى هذه الأروقة الذي يبدو بعيداً عن هموم الواقع الشبابي، بل أيضاً في الأسلوب التقليدي للمشايخ القائمين عليها.
خلال مقابلات رصيف22، مع عدد من مرتادي هذه البرامج، برز توجه واضح لدى هؤلاء الشباب نحو البحث عن “علم وتدين” خارج الأطر الرسمية التي يرون أنها باتت سطحيةً ومتساهلةً، وغير قادرة على تلبية أسئلتهم المعاصرة.
كما عبّر بعضهم عن خيبة أملهم من خطاب الإعلام الديني التقليدي وظاهرة الدعاة الجدد، معتبرين أنّ هذه الأنماط لم تعد تعبّر عن احتياجات وتطلعات شريحة واسعة من طلاب المدارس والجامعات في العالم العربي.
في الواقع، لم يقتصر عجز التدين الرسمي أو المدعوم من المؤسسات الدينية التقليدية على عدم استيعاب الغالبية من الشباب، بل ساهم أيضاً في تعميق أزمة الشباب المعرفية وشعورهم بالاغتراب عن الدين.
ويعود ذلك إلى ارتباط هذه المشيخات الوثيق بالسلطة، وسعيها للهيمنة على المجال الديني، مع ابتعادها عن هموم الشباب وواقعهم المعاصر. نتيجةً لذلك، اتجه كثير من الشباب للبحث عن بدائل خارج الأطر الرسمية، ومسارات تعبّر عن تطلعاتهم وأسئلتهم.
ومن الواضح أنّ هذه البرامج تناسب شريحةً واسعةً من الشباب العربي، وتلبّي احتياجاتهم الروحية والعقلية والنفسية. يروي محمود زكريا، وهو شاب مصري جامعي في أوائل العشرينات، لرصيف22، كيف أنّ مواضيع برامج السيد تشتبك بشكل كبير مع احتياجاته، ويذكر أنّ حياته تغيرت بشكل كبير على المستوى الإيماني والسلوكي بعدما التحق ببرنامج البناء المنهجي الذي مثّل له نقلةً نوعيةً في حياته واهتماماته.
يقول محمود: "برنامج البناء المنهجي أثّر في حياتي بشكل كبير، سواء على المستوى الوجداني أو المعرفي. غيّر أسلوب حياتي تماماً، وعلّمني الانضباط بعد فترة من الفوضوية، وأصبحت أكثر انتباهاً إلى أفعالي وواجباتي تجاه الله، وأصبح الدين محوراً أساسياً تدور حوله باقي المحاور في حياتي".
تكشف رواية محمود بما تحمله من شواهد وتجربة شخصية، عن ملامح عميقة لحالة الاغتراب التي يعيشها كثير من شباب هذا الجيل، نتيجة الفوضى والتشتت وغياب القدوات. وبرغم تنوع دوافع الشباب للالتحاق بهذه البرامج، إلا أنّ تجربة محمود تكررت كثيراً في روايات المنتسبين إليها، حيث يميزون بين مرحلتين، مرحلة الضياع واللامبالاة، وتعقبها لحظة الصحوة واكتشاف الذات والمعنى مع الانخراط في أحد هذه البرامج. واللافت أنّ تأثير هذه البرامج لم يعد في حدود الأفكار والمعتقدات فحسب، بل امتدّ إلى أسلوب النظر إلى الأشياء، وجُلّ تجليات الحياة اليومية.
وفي ظل المشهد الديني الممزق، وافتقاد الشباب القدوات، خاصةً مع العديد من التغيرات والأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة العربية، فإنّ انتقال آلاف الشباب إلى هذه البرامج يبدو وكأنه مساحة التنفس الوحيدة المتاحة.
في الواقع، يبرز حجم الإقبال على هذه البرامج كدليل على اتساع تأثيرها، فعلى سبيل المثال، وبرغم أنّ برنامج البناء المنهجي يمتد لأكثر من أربع سنوات، إلا أنّ دفاعاته تشهد تسجيلات ضخمةً، تجاوزت في آخرها 600 ألف مشترك، بينهم أكثر من 100 ألف من مصر.
تنقسم الآراء بشأن البرامج الدينية الرقمية، بين من يعدّها مشروعاً واعداً لإعادة بناء الوعي والمعرفة الإسلامية، ومن يراها خطراً على الموروث الشرعي أو بوابةً لأدلجة الشباب. لكن زيادة شعبيتها يثير التساؤلات حول قدرتها على تشكيل الوعي الإسلامي الشبابي في السنوات القادمة
المعترضون على هذه البرامج
برغم أنّ هناك الكثير من تزكيات العلماء والمشايخ المشهورين لهذه البرامج، فإنّ هناك نقداً للأشخاص الذين أسسوا هذه البرامج ولطبيعة البرامج، على سبيل المثال، يتهم البعض أحمد السيد بأنه يميل إلى "النسوية"، ويلقّبونه بـ"شيخ النسوية الإسلامية" بسبب محاضراته عن "التأصيل المنهجي لقضايا المرأة"، والتي حاول فيها معالجة أبرز الإشكالات المعاصرة المتعلقة بالمرأة.
كما تتباين المواقف تجاه برامج الشيخ أحمد السيد، داخل الأوساط السلفية نفسها، فبينما يتهمه بعض السلفيين في السعودية ومصر والكويت، بتخفيف الطابع العقدي الصارم للسلفية وبتقريب الخلاف مع الفرق المخالفة، واصفين مشروعه بأنه "فكر إخواني بواجهة سلفية"، يرى آخرون العكس تماماً، إذ يعدّون برامجه متشددةً في العقيدة، وتروّج لمقولات التيار الوهابي من خلال الاعتماد على تراث ابن عبد الوهاب وابن تيمية، وهو ما عبّر عنه الدكتور عبد القادر الحسين، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، في نقده العلني لبرامج السيد، قائلاً: "حذّرت الناس من متابعة ما يسمّى برنامج البناء المنهجي، إذ هو مقدمة لإدخالهم إلى أتون الفرقة الوهابية، حيث يكون ابن تيمية شيخاً وحيداً للإسلام لا شريك له، ويكون ابن عبد الوهاب المقياس لعلماء الاسلام".
من جانبه، عبّر الداعية الكويتي علي السالم، عن انتقادات حادة لبرامج مشابهة لتلك التي يقدمها الشيخ أحمد السيد، كما خص السيد بالنقد معتبراً أنه غير مؤهل للتدريس الشرعي، مستنداً في ذلك إلى خلفيته العلمية وظروف تعلّمه خلال فترة سجنه، حيث كان الدكتور عبد العزيز العلوان أحد أبرز من تأثر بهم.
كما أبدى السالم اعتراضه على بعض المقررات المعتمدة في البناء المنهجي، مثل كتب الشيخ محمد صالح المنجد وإبراهيم السكران، عادّاً أنها لا تُناسب بناء منهج شرعي رصين.
ووجّه السالم انتقادات لاذعةً لبرامج السيد وغيره، متهماً إياها بدسّ السمّ في العسل واستغلال أحاديث السنّة وشمّاعة السلف لاختراق الشباب وفق تعبيره، ورأى السالم أنّ هذه البرامج ما هي إلا وسيلة لاختراق عقول الشباب الصغار، وتهيئتهم لتبنّي أفكار فكرية وتنظيمية قريبة من جماعة الإخوان، وتشير لهجته إلى أنّ دافع هذا النقد قد يكون الشعور بأن هذه البرامج تسحب البساط من تحت المؤسسات الدينية التقليدية، وهو ما ألمح إليه في تصريحاته قائلاً: "لا يزالون يبتكرون ويخترعون مثل هذه البرامج ليصطادوا بها الناس ويحولوهم إلى دمى فكرية تتبنى منهج سيد قطب والإخوان المسلمين. الحذر كل الحذر من الحلقات المشبوهة التي ينتمي أصحابها إلى التنظيمات الإسلامية السياسية أو المجهولة والمشبوة ونحو ذلك. لا بدّ من الرجوع إلى الحلقات الرسمية الموثوقة من الدولة".
في المحصلة، تنقسم الآراء بشأن هذه البرامج بين من يعدّها مشروعاً واعداً لإعادة بناء الوعي والمعرفة الإسلامية، ومن يراها خطراً على الموروث الشرعي أو بوابةً لأدلجة الشباب.
ومع تنامي حضورها، لم تعد هذه البرامج ظاهرةً هامشيةً، بل مرشحة للتوسع في المستقبل القريب، وهو ما يثير تساؤلات جوهريةً: هل نحن بصدد أفول تدريجي لدور المشيخات التقليدية؟ وهل ستشكل هذه الظاهرة الوعي الإسلامي الشبابي في السنوات القادمة؟
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.