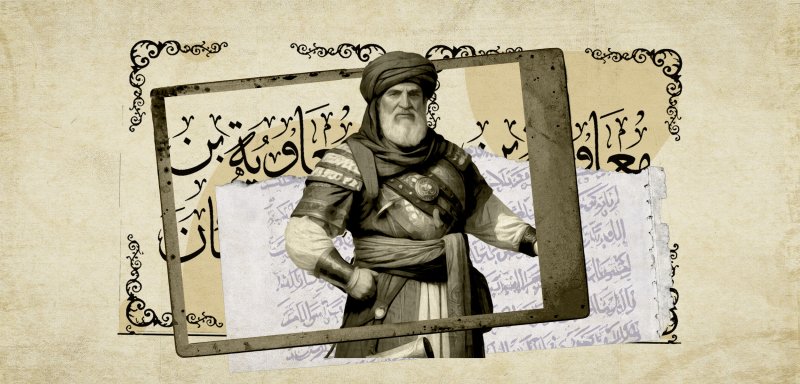"ومنه أنّ رسول الله، قال: إذا رأيتُم معاويةَ على منبري فاقتلوه". (الطبري، "تاريخ الرّسُل والملوك").
"قال رسول الله: إذا ملكتَ يا معاوية، فأحسِن". (المقريزي، "النزاع والتخاصم").
قد نجد أنفسنا في حيرةٍ شديدةٍ إذا قررنا العودة إلى روايات التراث الإسلامي لتحديد موقفنا من الشخصية التاريخية الجدلية: معاوية بن أبي سفيان، حيث تتناقض الروايات إلى حدٍّ يصل إلى الانفصام، بين رواياتٍ تصفه ونسله بأنهم "قردةٌ على المنبر"، وأخرى تمجّده بوصفه "خال المؤمنين".
قد يظنّ البعض أنّ هذا التناقض يعكس الانقسام الإسلامي الشهير بين الروايتين السنّية والشيعية، حيث تمنح الرواية السنّية شيئاً من الاعتبار لمعاوية، مقارنةً بالرواية الشيعية التي تصفه أحياناً بالكفر أو النفاق. إلا أنّ الواقع يكشف أنّ هذا الانقسام متجذّرٌ داخل الرواية السنّية ذاتها، وليس مجرد صراعٍ بين المدرستين.
لم يكن هذا الاضطراب العميق في تقييم شخصية معاوية مفتعلاً، فقد كان ابناً لأحد أشدّ أعداء الدعوة المحمدية: أبو سفيان، زعيم قريش، وزوجته هند بنت عتبة. ظلّ مشركاً حتى فتح مكة، وكان أشدّ معارضي حكم الخليفة الرابع عليّ بن أبي طالب، مشعلاً الحرب الأشرس في الإسلام المبكر: الفتنة الكبرى التي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان. وفي المقابل، هو ذاته من أرسى دعائم الإمبراطورية الإسلامية في لحظة تاريخية حرجة، مانحاً إيّاها بداية عمرها الطويل، الذي امتدّ حتى مشارف العصر الحديث!
أربكت هذه الحقيقة مؤرّخي الإسلام وعلماءه، قديماً وحديثاً؛ فكيف يمكن لابن العدوّ الأوّل للإسلام، المشكوك في إخلاصه الديني، أن يتحوّل إلى رمزٍ لقوّتها التاريخية؟
ازدادت إشكالية معاوية تعقيداً مع مرور الزمن، وتجددت فصول الجدل حولها عبر العصور. واليوم، تأخذ هذه الإشكالية أقصى أشكالها إثارةً للجدل، من خلال أوسع منصةٍ جماهيريةٍ للتلقّي: الإنتاج الفني متمثلاً في المسلسل الرمضاني لعام 2025: "معاوية".
قد نجد أنفسنا في حيرةٍ إذا قررنا العودة إلى روايات التراث الإسلامي لتحديد موقفنا من الشخصية التاريخية الجدلية: معاوية بن أبي سفيان، حيث تتناقض الروايات إلى حدٍّ يصل إلى الانفصام، بين رواياتٍ تصفه ونسله بأنهم "قردةٌ على المنبر"، وأخرى تمجّده بوصفه "خال المؤمنين"
قد يرى البعض أنّ الخوض في هذا الجدل ضربٌ من الإلهاء، أو محاولة لصرف الأنظار عن قضايا أكثر إلحاحاً. لكن في مقالتنا هذه، سنكتشف أنّ تتبّع مسار صناعة معاوية في التراث الإسلامي ليس ترفاً فكرياً، ولا مجرد نزاع حول تقييم شخصية تاريخية، بل هو رحلة في أعماق الوعي الإسلامي، تكشف كيف تمت محاصرة العقل وإضعاف حريته النقدية، وكيف تحوّل التراث إلى أداةٍ لقمع الحاضر، لا مجرد سجلٍّ لأحداث الماضي.
فشبحُ معاوية، بالتباساتِه وصراعاته المتجددة كلها، لم يبقَ محصوراً في صفحات التاريخ، بل ظلّ قادراً على إلقاء ظلاله الكثيفة على مسارنا الفكري والسياسي حتى اللحظة الراهنة.
اللعن على المنابر... معاوية في فوضى الروايات العباسية
عند البحث عن معاوية كشخصية تنتمي إلى الحقبة المبكرة من التاريخ الإسلامي، فإنّ الأدقّ أن نقول إننا نستكشف الطبقات التي راكمتها العصور اللاحقة حوله، أكثر من محاولتنا الوصول إلى صورةٍ أصليةٍ واضحة. فقد نشأت غالبية المرويّات الإسلامية،كما هو معلوم، في بيئة العراق، وتحت إشراف الخلفاء العباسيين، بدءاً من منتصف القرن الثاني الهجري، أي بعد ما يقرب من مئة عام من صمت الكتابة الإسلامية عن معاوية (منتصف القرن الأول الهجري).
وبعيداً عن دوافع الخلفاء العباسيين، مثل المنصور والمأمون، لإعادة تشكيل تاريخ أعدائهم الأمويين من منظورٍ دينيٍّ بعد الإطاحة بدولتهم في الشام عام 750م، فقد كانت المشاعر المعادية للأمويين في العراق جزءاً من مزاجٍ شعبيٍّ عام، نتيجةً للتنافس الدموي الطويل بين البلدين على الحكم، ما أفرز رواياتٍ وقصصاً اتّسمت بحدّة النقد للحكم الأموي ورموزه، وعلى رأسهم معاوية وابنه يزيد.
غير أنّ هذه الحقيقة لا تعني أنّ معاوية كان بريئاً من الاتهامات التي وُجّهت إليه. لكنّ المرويات ذات الصبغة الدينية بالغت في التركيز على حياته الشخصية، وانزلقت إلى شيطنةٍ مطلقةٍ للحكم الأموي عموماً، ما جعلها أداةً مثاليةً لتثبيت شرعية الحكم العباسي الناشئ، الذي لم يكن، في نهاية المطاف، مختلفاً عن الأساليب السلطوية ذاتها التي أدانتها المرويات الإسلامية المبكرة في هجومها على الحكم الأموي.
وهكذا، تبدلت القضية من إدانةٍ للممارسات السلطوية وغير الأخلاقية للخلفاء، إلى مجرّد رفضٍ لحكم أسرةٍ بعينها، بوصفها غير مؤهلةٍ لشرعية الخلافة، دون أن يؤدي ذلك إلى مساءلةٍ حقيقيةٍ لطبيعة النظام السياسي ذاته.
زاد الأمر تعقيداً أنّ المرويات الإسلامية التي نُسجت خلال العصر العباسي، لم تُترك متناثرةً بلا ضابط، بل جرى تنظيمها ضمن إطارٍ علميٍّ ممنهج على يد الفقهاء والرواة، تحت مظلّة ما عُرف لاحقاً بـ"علوم الرواية". هذا التصنيف منحها حصانةً منيعةً أمام أيّ مراجعةٍ تاريخيةٍ جادّة. ونتيجةً لذلك، وجد العقل الإسلامي نفسه غارقاً في دوامة "السند وصحّة الرواية"، برغم أنّ تلك المناهج، بما فيها علم الجرح والتعديل وعلم الرجال، لم تكن في جوهرها سوى أدواتٍ لضبط التحيّز المذهبي من ناحية، ولتكريس شرعية الخلفاء العباسيين الذين مثّلوا السلطة السنّية الجديدة من ناحية أخرى.
ومن خلال هذا التشابك المعقّد بين فوضى المرويات المعادية للأمويين من جهة، والمنظومة المذهبية لعلوم الرواية الفقهية من جهة أخرى، تشكّلت النواة الأولى لصورة معاوية بن أبي سفيان، في الذاكرة الإسلامية، تحت الرعاية المباشرة للخلفاء العباسيين، الذين سعوا إلى ترسيخ قصة تاريخية تتماشى مع شرعيتهم السياسية الجديدة.
شبحُ معاوية، بالتباساتِه وصراعاته المتجددة كلها، لم يبقَ محصوراً في صفحات التاريخ، بل ظلّ قادراً على إلقاء ظلاله الكثيفة على مسارنا الفكري والسياسي حتى اللحظة الراهنة.
وتبلغ ذروة هذا النهج في ما أورده الطبري في تاريخه، إذ يذكر أنّ الخليفة المعتضد بالله (حكم 279-289 هـ)، فكّر في استحداث تقليد جديد يقضي بلعن معاوية على المنابر بعد صلاة الجمعة، بل ذهب أبعد من ذلك حين عدّه، وبني أمية، تجسيداً لـ"الشجرة الملعونة" المذكورة في سورة "الإسراء".
غير أنّ هذه النواة لم تكن العامل الوحيد في خلق التناقضات المحيطة بصورة معاوية، إذ أضاف تطوّر الخلافة العباسية وتعاقب الأحداث السياسية، طبقاتٍ متراكمةً عليها، ما زاد من تشابك صورته التاريخية، وأحاطها بتناقضات صارخة، يصعب تفكيكها إلا من خلال تحليل دقيق للسياقات التي وُلدت فيها عبر الزمن.
على سبيل المثال، يذكر المؤرخ ابن تغري بردي الظاهري (تـ847 هـ)، واحدةً من أولى المحاولات لإعادة تشكيل صورة معاوية بشكل يناقض المزاج العراقي، وذلك في سياق حديثه عن الوالي أحمد بن طولون، الذي استقلّ بحكم مصر والشام عن سلطة الخلافة العباسية في منتصف القرن الثالث الهجري.
في خضم صراعه السياسي مع العباسيين في بغداد، خاصةً الموفَّق، شقيق الخليفة العباسي المعتمد، أعاد ابن طولون ترميم قبر معاوية في الشام، الذي كان قد هُدم في أثناء الثورة العباسية، وشيّد فوقه أربعة أروقة، كما رتّب عنده أشخاصاً يتلون القرآن ويوقدون الشموع، في مشهدٍ أعاد الاعتبار الديني للخليفة الأموي الأول.
لم يكن تحرّك ابن طولون مجرد عملٍ ديني فحسب، بل كان رسالةً سياسيةً مباشرةً، إذ أيقظ معاوية من قبره ليكون ورقةً في صراع الشرعية، متحدّياً بها السلطة الدينية للخلافة العباسية، من خلال تقديم معاوية، مؤسس الحكم الأموي، في صورة "التقيّ" التي تناقض تماماً الرواية الرسمية للعباسيين.
ومع انقضاء القرن الثالث وحلول القرن الرابع الهجري، تصاعدت حركات التمرد في أرجاء الخلافة العباسية، وتعرضت مركزية السلطة في بغداد لهزّات متتالية، خاصةً مع تفشّي حركات الانفصال والاستقلال عن هيمنة الخليفة العباسي.
وبدلاً من تحليل الأسباب السياسية التي أفضت إلى هذا التصدّع، انحازت الكتابات الإسلامية، ولا سيّما الفقهية منها، إلى تعزيز صورة الخليفة الواحد القويّ القادر على توحيد أقاليم الدولة بقبضةٍ حازمة، باعتباره ماضياً مفقوداً تنبغي استعادته.
وهكذا عاد معاوية ليطلّ من جديد في السرديات التاريخية، لكن هذه المرة في هيئة "الحاكم الضرورة"، أي ذلك القائد الذي افتقده المسلمون في ظل اضطراب السلطة العباسية، فجَرَت إعادة تشكيل صورته ليُقدَّم كنموذج للقوة والاستقرار السياسييَّن، بعد أن كان محوراً للجدل الديني المحتدم في العصور السابقة.
لكن العقبة الأكبر التي واجهتها الكتابة الإسلامية في تلك الفترة، تمثّلت في الإرث العميق المعادي للأمويين في العصر العباسي المبكر، وهو إرثٌ لم يكن بالإمكان تجاوزه بسهولة بعد أن ترسّخ بقوة في الروايات الإسلامية. ونتيجةً لذلك، عندما حاول الفقهاء والكتّاب في العصور اللاحقة إعادة ترميم صورة معاوية، لم تكن محاولاتهم محكومةً بعملية مراجعة تاريخية للروايات العباسية، بل انزلقت إلى اضطرابات في الشروحات والتفسيرات، تراوحت بين الدهشة والاستغراب في البداية، ثم بلغت حدّ التبرير الفجّ مع مرور الزمن.
بعث معاوية... كيف حوّل الفقهاء اللعنات إلى بركة؟
نرى أولى بوادر هذه الازدواجية المبكرة في "سنن" الترمذي، أواخر القرن الثالث الهجري، حيث أورد حديثاً يُنسب إلى النبي، يقول فيه عن معاوية:
"اللهم اجعله هادياً، مهدياً، واهدِ به".
لكن الترمذي، بدلاً من تصنيفه ضمن الأحاديث الصحيحة أو الحسنة، وصفه بعبارته الشهيرة: "حديثٌ حَسَنٌ غريب"، وهو تصنيفٌ كان يستخدمه عند الوقوف أمام روايات مقبولة من وجهة نظرِه، لكنها مشكوك فيها، إما لغرابة معنى الحديث، أو لغموض أصل الرواية ورُواتها، ما يعكس حالة التردد في تقبّل الرواية أو رفضها.
غير أنّ المحاولة الأكثر فجاجةً نجدها في شرح الإمام النووي للحديث، حين بلغ التناقض ذروته في القرن السابع الهجري، خاصةً عند معالجته حديثاً شهيراً ورد في "صحيح" مسلم، جاء فيه أنّ النبي دعا على معاوية قائلاً: "لا أشبع الله بطنه".
كانت المشاعر المعادية للأمويين في العراق جزءاً من مزاجٍ شعبيٍّ عام، نتيجةً للتنافس الدموي الطويل بين البلدين على الحكم، ما أفرز رواياتٍ وقصصاً اتّسمت بحدّة النقد للحكم الأموي ورموزه، وعلى رأسهم معاوية وابنه يزيد
في السياق الطبيعي، يُفهم هذا الحديث على أنه دعاءٌ صريحٌ ضدّ معاوية، لكن النووي لم يكتفِ فقط بتخفيف وطأته، بل قلب الذمّ إلى مكرمة، مؤوّلاً الحديث بقوله: "وقد فهم مسلم من هذا الحديث أنّ معاوية لم يكن مستحقاً للدعاء عليه، وجعله البعض من مناقب معاوية لأنه في الحقيقة دعاء له"، كما جاء في "صحيح" مسلم بشرح النووي.
لم يكن هذا التفسير مجرد اجتهاد عابر، بل كان حلقةً في سلسلةٍ طويلةٍ من التحوير التاريخي الممنهج، حيث لم تُمحَ الروايات العباسية المعادية لمعاوية، بل أُعيدت صياغتها في هوامش التفسير الفقهي، ليولد معاوية من جديد، لا كحاكم فاسقٍ، بل كرمزٍ لوحدة الخلافة وقوتها. وهكذا، تحوّلت اللعنة إلى بركة، والذمّ إلى شهادة فضل، في عملية تأويلٍ لا تكتفي بتجميل الصورة، بل تعيد رسمها بالكامل.
أما تلك الروايات المجهولة التي امتدحت معاوية، والتي اكتسبت مساحةً أوسع في هذه العملية، فقد كان مصدرها الأساسي يعود إلى الحقبة الأموية في نهاية القرن الأول الهجري، حيث انتشرت شفهياً في الشام، قبل بداية عصر التدوين العباسي في نهاية القرن الثاني الهجري، وذلك تحت إشراف مباشر من البيت الأموي نفسه.
بمعنى آخر، فإنّ التشويه العباسي لصورة الأمويين لم يكن سوى انعكاس لعمليةٍ سبقتها، حيث كان تمجيد معاوية في البلاط الأموي جزءاً من مشروعٍ سياسي متكامل يرمي إلى ترسيخ شرعية حكمهم دينياً.
لكن المفارقة الأبرز حدثت مع عودة الأمويين إلى المسرح السياسي، بعد سقوط دولتهم الكبرى على يد العباسيين، وذلك في أبعد نقطة عن مركز الخلافة الإسلامية: جنوب الأندلس. فهناك، أسس عبد الرحمن الداخل (المعروف بصِقر قريش)، حكماً أموياً جديداً بعد فراره من الشام، وأعلن نفسه خليفةً على قرطبة عام 138 هـ، متحرراً تماماً من سلطة العباسيين في بغداد.
وفي ظلّ الحكم الأموي في الأندلس، ازدهرت من جديد حركة إعادة الاعتبار لمعاوية، بل إنّ الكتابة التاريخية هناك لم تكتفِ بمجرد التصدي للروايات العباسية، وإنما سخّرت كل الأدوات الممكنة لتمجيد الأمويين، وعلى رأسهم معاوية. ويتجلى ذلك بوضوح في كتاب "العواصم من القواصم" للقاضي أبي بكر بن العربي (القرن السادس الهجري)، الذي لم يكتفِ بمجرّد تنقيح الروايات، بل خاض عملية إعادة كتابة كاملة لتاريخ الفتنة الكبرى، واضعاً معاوية في مقام الصحابة المعصومين، ومدافعاً عن شرعية خلافته، حيث يقول: "عجباً لاستكثارِ الناس ولايةَ بني أمية، وأول من عقد لهم الولايةَ رسولُ الله".
وهكذا، على يد القاضي المالكي، لم يعد معاوية مجرد ملكٍ أمويّ، بل بات خامس الخلفاء الراشدين: "خير الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليّ، ثم معاوية خال المؤمنين".
وقد بلغت عملية إعادة تشكيل صورة معاوية ذروتَها مع الفقيه الشهير ابن تيمية (القرن الثامن الهجري)، الذي عاش في واحدة من أكثر الفترات اضطراباً في التاريخ الإسلامي، حيث اجتاحت جحافل المغول والترك قلب العالم الإسلامي، وضاعت وحدة الخلافة بين الغزاة والأمراء. في ظلّ هذا الاضطراب العنيف، ترسخت في وعي ابن تيمية، الحاجة إلى "الحاكم الضرورة" أكثر من سابقيه، فارتقى معاوية في نظره إلى أعلى مقاماته الدينية والتاريخية معاً.
لم يكن هذا مجرد تفضيل سياسي، بل تحوّل إلى عقيدة دينية، إذ نراه يفسّر آية التوبة في "مجموع الفتاوى"، "ثمّ أنزلَ اللهُ سكينتَه على رسولِه وعلى المؤمنين"، بقوله: "وكان معاوية من المؤمنين الذين أنزل الله سكينتَه عليهم مع النبي، وممن وعدهم اللهُ الحُسنى".
لم تكن خطوة ابن تيمية، مجرد تحسين لصورة معاوية، لكن التأثير الأخطر لموقفه كان بترسيخه مبدأ "الصمت عن الصحابة"، حينما قال: "يجب أن يكون حظُّ العاقلِ منها، حسنَ الظنّ بالصحابة، والسكوت عن الكلام فيهم إلا بخير"، في إشارة منه إلى الفتنة الكبرى في "مجموع الفتاوى".
لم يكن مبدأ الصمت الذي رسّخه ابن تيمية، مجرد موقف فقهي، بل تحوّل إلى سياجٍ خانقٍ يطوّق العقل الإسلامي، إذ أُخضِع الوعي السياسي لقاعدة تحرّم المساءلة التاريخية. وحين فقد المسلمون حقّهم في استجواب الماضي، فُرض عليهم القبول الأعمى برواياتٍ متناقضة حول شخصيات مثل معاوية، حيث لم يعد السؤال عن الحقيقة التاريخية أمراً مشروعاً، بل أصبح الصمت تقرّباً دينياً بتقديس عصمة الصحابة، وذلك الإصرار على قبول التناقضات، تحت مظلّة الصمت، طلباً لانتحارٍ عقلي.
وهكذا، ترسّخ الصمت المقدّس ليغدو جداراً عازلاً لا يحجب تناقضات الرواية الإسلامية فحسب، بل يطمس حتى بقايا الجدل الفقهي الذي كان يوماً ما حاضراً في قلب التراث ذاته.
وبفعل هذه المسافة الشاسعة التي صنعها التقديس المطلق لشخصيات الإسلام المبكر، مقروناً بوصية الصمت عند التعرّض لأخبارهم، لم تعد المشكلة مقتصرةً على تقبّل التناقضات التي تحيط بأطراف الفتنة الكبرى، وعلى رأسهم معاوية، بل تجاوزه الأمر إلى إنكار وجود التناقض أصلاً، وكأنّ الرواية التاريخية تحولت إلى حقيقة معصومة لا يُساءَل منطقها ولا يُستجوَب محتواها.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.