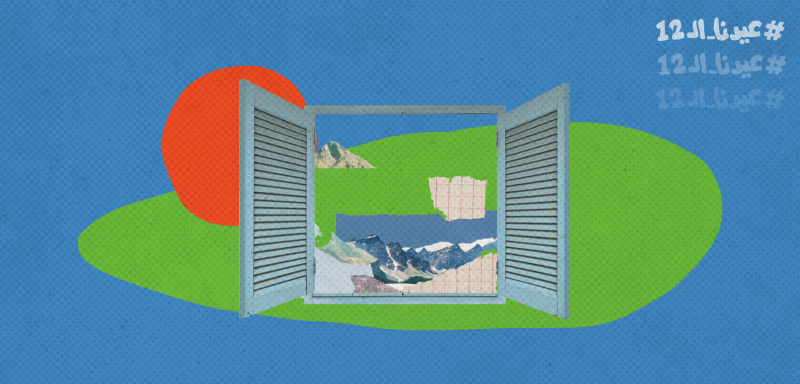تندرج هذه المادة ضمن ملف "12 سنة على رصيف22 وما زلنا نقول لا". للاطلاع على مواد الملف كاملة، يُرجى الدخول إلى الرابط.
كان أوّل بيت أسكنه في حيفا خلال سنتي الجامعية الثانية، يقع في حيّ الحليصة، أحد الأحياء العربية للمدينة، وأوّل حي نراه ونحن ندخل حيفا من جهة الشرق، الشارع الذي يصلها من عكّا أيضاً. البيت يقع في الطابق الثاني لبناية من طابقين، وهو ملك لمشروع طلّابي في جامعة حيفا. سكنته أربع طالبات تطوّعن للعمل مع أطفال في الحيّ لساعات محددة أسبوعياً، مقابل تغطية تكاليف الدراسة الجامعية.
كانت غرفتي تطلّ على مدخل البناية، أكبر الغرف ربما، وفيها وضعتُ ثيابي، شالاتي الكثيرة، آلة العود التي توقفت عن التدريب عليها، وإكسسواراتي التي اشتريتها وجمعتها من سفري إلى عمّان ورام الله والقدس، حيث الفضّة التي أحبّها.
في الثاني عشر من تموز/ يوليو 2006، كنتُ عائدةً من زيارة إلى القدس، ومررتُ على البيت في حيفا، أخذتُ قطعاً قليلةً من الملابس، وشالي الأحمر الصيفي، وركبتُ السرفيس باتجاه عكّا.
يبدو أنّ حرباً على الأبواب.
في زمن الحرب
بقيتُ مع أهلي في عكّا طوال فترة الحرب. بيت أهلي يقع في بناية من أربعة طوابق، ولا ملجأ فيه. مع كل صفّارة إنذار، كان علينا النزول إلى الطابق الأرضي كي ندخل ملجأ العمارة؛ الكل كان يركض إلى الملجأ. كنا آنذاك ربما العائلة العربية الوحيدة، أقصد الفلسطينية الوحيدة. فمع أنّ كل جيراننا كانوا إسرائيليين، إلا أنهم لم يكونوا جميعهم "أشكناز". الكل كان يركض باتجاه الملجأ، باستثناء شخص واحد: أبي.
كان أبي بكرشٍ وسيجارة آنذاك. كان "بصحّته"، و"صحّته" سمحت له أن يتحوّل إلى محلل عسكري يعرف أنّ الصاروخ القادم من لبنان لن يخبط في الطابق الثالث من البناية. فشبّاك البناية يطلّ على الجنوب، ومن جهة الشمال بناية أخرى تغطينا. وفي مطلق الأحوال، كان الفلسطيني على ثقة لا يفهمها أحد بأنّ الصاروخ من لبنان لا يستقصده.
كانت ليال نجيب، أوّل صحافية لبنانية تُقتل على يد إسرائيل في الحرب على لبنان في عام 2006. لم أعرفها بالطبع، لكن عرفت بخبر مقتلها. صورتها، وشعرها الأحمر القصير، بالربطة الحمراء أيضاً، والبلوزة السوداء، والوجه المدوّر، والعيون الزرقاء، والابتسامة. وعرفت أنها كانت تكبرني بعام، وأنها من طرابلس. وأنا ابنة عكّا
وأنا في الملجأ، لم أكن خائفةً على أبي بقدر ما كنتُ خائفةً على من هم في جنوب لبنان. وجميعهم غرباء. لم تكن هذه حالتي وحدي. فخوف الفلسطيني في الجليل على جاره اللبناني من قنابل إسرائيل، ليس عاطفياً فحسب.
في ساعات "الصمت"، كنا نشاهد الأخبار. مرةً، تركتُ أبي يواصل مشاهدة التلفاز، ومشيتُ باتجاه غرفتي، غرفتي التي بشبّاكَين؛ أحدهما يطلّ باتجاه الشمال، والغربيّ يطلّ على البحر. بجانب مكتبتي البيضاء، كانت طاولة الحاسوب، كبير الحجم. الإنترنت موصول بشكل دائم إلى الخطّ. التكنولوجيا تطوّرت ولم يعد علينا فصل خط الهاتف الأرضي كي نشبك الإنترنت. جلستُ على الكرسي، وبدأتُ بالكتابة عن ليال.
كانت ليال نجيب، أوّل صحافية لبنانية تُقتل على يد إسرائيل في الحرب على لبنان في عام 2006. وفي نصّ بعنوان "ليال في صور"، نُشر في صحيفة "الاتحاد" الشيوعية، في الثاني من آب/ أغسطس 2006، كتبت (واعذروا نصّاً لفتاة في الثانية والعشرين من عمرها!):
"تحمل حقيبة الكاميرا في يدها اليمنى، وداخل الحقيبة تضع حاجياتها للنهار الآتي: دفتر صغير، علبة سجائر وولاعة، نظارات للشمس، وأمل في العودة إلى فراشها.
تخرج من بيتها باتجاه الشارع، توقف سيارة أجرة، تجلس بجانب السائق..: "صباح الخير، صور إذا أمكن..".
تحاول "ليال" ألا تخسر إمكانية صورة مميزة، فهي تلتقط كل شيء عابر. وحرّ.
تعلو أصوات طبول الحرب كلما تقترب جنوباً أكثر، تمرّ أمامها صور تأتي من الجنوب لم يلتقطها أحد. تبكي ليال وتصرخ لوحدها:"لماذا لم يلتقطها أحد بعدسته؟ مَن يجعل هذه الصور تهرب من دون أن تُخلّد؟". تحاول أن تُخرج يدها من شباك السيارة لتمسك صورة مُسرعة، يصرخ عليها سائق الأجرة لأنها تُعرض يدها للخطر. لا تهتم "ليال"، فهي تعلم أنها تعمل من أجل هذا الخطر ومن أجل هؤلاء الناس وهذه الصور".
لم أعرف ليال بالطبع. عرفت بخبر مقتلها. صورتها، وشعرها الأحمر القصير، بالربطة الحمراء أيضاً، والبلوزة السوداء، والوجه المدوّر، والعيون الزرقاء، والابتسامة. هذا كلّ ما عرفته عنها. عرفت أنها كانت تكبرني بعام، أو للدقّة بأحد عشر شهراً، وأنها من طرابلس. وأنا ابنة عكّا، كل ما ربطني بطرابلس آنذاك هي زميلة قديمة في المدرسة حملت اسم المدينة نفسه. ولم أفهم أنا وزملائي لماذا فعل والداها هذا بها!
ريحة البلاد...!
عندما أفكّر في عدد السنوات التي مارستُ فيها العمل الصحافي، أعود إلى هذا النصّ كي أتأكد من اليوم والشهر والتاريخ. كانت هذه الكتابة، وغيرها من النصوص، هي بداية تكوين مسار "شو بدّي أصير لما أكبر". وهذا المسار لم يكن مفصولاً عن الصدف التي وُلدت بينها؛ فتاة فلسطينية من عكّا، بكل ما في هذه الهوية من مركّبات لم أخترها، لكني أحبّها جداً. إلا أنّ الحقيقة التي لم أختَرها وشكّلت حياتي، هي انتمائي إلى الأقلية العربية الفلسطينية داخل دولة إسرائيل. وكل ما أردته من مهنتي كصحافية هو أن أحكي عمّن أنتمي إليهم، وعن تفاصيل "هاربة" لا تحظى عادةً بالاهتمام، أو لا تصبّ في السردية العامّة التي تُحكى عن المكان وناسه.
في عام 2008، ذهبنا أنا وصديقة وصديق من حيفا إلى عمّان لحضور مؤتمر للشباب الفلسطيني. قبل أن نصل إلى الفندق، ذهبنا إلى بار وشربنا الكثير من الويسكي. وعندما وصلنا إلى مكان المؤتمر، وكنّا آخر وفد يصل، استقبلنا الجميع بالأحضان والدموع، قائلين: "هدول من ريحة البلاد". تأثّرنا فعلاً، وضحكنا لاحقاً كثيراً ولسنوات على أنّ "ريحة البلاد ويسكي". كان يمكن أن نشرب عرقاً. لكن في هذه القصة و"خصوصيتها"، يمكن لكأس العرق أن يكون أيضاً متوقّعاً.
من الصحافة الورقية إلى الإذاعة، ومن ثم إلى الرقمية، فالتدوين، ومن ثم الورقي… هكذا تبلورت رغبتي في ما أريد أن أكتب عنه أو أحكي. ولسنوات عديدة، رأيت أنّ مسؤوليتي كصحافية تكمن في مواصلة ما فعله من هم قبلي في الرفع من قيمة الثقافة والفنّ وأهميتهما في الحفاظ على الهوية الجماعية للفلسطينيين في الداخل كجزء من المسار النضالي السياسي. فكتبتُ عما يحدث في الداخل للقارئ في الخارج، سواء كان فلسطينياً أو عربياً. وكانت الرحلة مليئةً بالتعلّم والمطبّات.
في عام 2008، ذهبنا أنا وصديقة وصديق من حيفا إلى عمّان لحضور مؤتمر للشباب الفلسطيني. قبل أن نصل إلى الفندق، ذهبنا إلى بار وشربنا الكثير من الويسكي. وعندما وصلنا إلى مكان المؤتمر، وكنّا آخر وفد يصل، استقبلنا الجميع بالأحضان والدموع، قائلين: "هدول من ريحة البلاد". تأثّرنا فعلاً، وضحكنا لاحقاً كثيراً ولسنوات على أنّ "ريحة البلاد ويسكي"!
في فترة الهدنة بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، هاتفتني زميلتي في السكن وأخبرتني بأنّ البيت سُرق، ويبدو أنّ اللص دخل من شبّاك غرفتي وسرق الكثير. أخذني أبي في السيارة من عكا إلى حيفا. وفي الطريق، كنتُ أفكر في كلّ ما يمكن أن يكون قد سرقه اللص من أشيائي، فأنا، مقارنةً بكل زميلاتي في السكن، تركتُ أشياء غاليةً على قلبي هناك.
سرق اللصّ شالاتي كلها، ومعظم إكسسواراتي، تاركاً زوجَين من الحلق، والعود المعلق على الحائط، ومسجّلة قديمة وبعض الثياب. حملتُ كل ما تبقّى في البيت، وعدتُ مع أبي في السيارة، ألعن إسرائيل واللصّ طوال الطريق إلى عكا.
مات أبي بعد ثماني سنوات. وكان عمّي الأكبر قد مات قبله بعشرة أشهر.
بين الموتين، تعرّفنا أنا ورصيف22 على بعضنا بعضاً. كان الموقع في بدايته. تزامنت دعوتي للكتابة من الداخل الفلسطيني مع هذا الحزن وانشغالي لسنوات بطقوس الجنازات، خصوصاً المسيحية منها، و"التناويح". عندها، اقترحت أن أكتب تقريراً عنها، يرتكز على حوار مع المرأة التي "نوّحت" في جنازة عمّي. عموماً، من غير المحبّذ أن تبدأ تعاونك مع جهة ما بالحديث عن الموت. يقولون إنّ هذا "فأل سيّئ"، كما هو حال كل ما يحيط بالحديث عن الموت من خرافات.
رصيف22
لكني دخلت الصحافة لأنّي -والحمد لله- لم أستمع إلى من قالوا لي إنّ "الصحافة ما بتطعمي خبز". دخلتها لأني أؤمن بالحكاية، حتى من داخل مقارّ الحزن، كالجنازات، والأهم، تفاصيلها التي تقاوم التغييب والقمع.
منذ هذا التقرير الذي نُشر آنذاك (تاريخ النشر في الموقع غير دقيق، إذ تغيّرت مواعيد النشر مع انتقال الموقع بين هيئات عديدة)، استمرت رحلة الكتابة مع رصيف22. بعد سنةٍ من موت أبي، قررت أن أترك فلسطين باتجاه برلين. أردت في هذه الهجرة أن أحقق أحلاماً كثيرةً، منها أن أتعرف ربما إلى صديقة ليال التي هاجرت من طرابلس إلى برلين، أن أتذوّق صينية كفتة من صديق وصل من دمشق وعلّمته أمّه الطبخ عن طريق الـ"فيديو كول"، وأن أجلس في المترو ويسألني غريب باللهجة المصرية عن الكتاب الذي أقرأه. أردت أن أعيش حياةً كان يمكن أن تحدث تحت شبّاك غرفتي في عكّا.
هذا النصّ يُنشر بينما لم أعُد جزءاً من فريق رصيف22 التحريري. جاء القرار بعد تفكير طويل تزامن مع حرب الإبادة على غزة، والجرائم في حقّ الدروز في السويداء، والعلويين من قبلهم في الساحل، والحرب في السودان، ومقتل المئات من الصحافيين الفلسطينيين أمام صمت وتواطؤ العالم الغربي والعربي… ومؤخراً موت زياد الرحباني، الذي شكّل نهايةً لحقبة ما
وهاجرت أيضاً كي تتوسع جغرافيا الحكايات التي أريد الكتابة عنها. من حظي أيضاً، أنني عرفت في برلين أنه يمكن أنّ تكون "الصحافة بتطعمي خبز" (مش كثير يعني بس بتطعمي)، وتحقق الحلم الأكبر بألا أعمل شيئاً بجانب العمل الصحافي. أصبحت محررةً في رصيف22.
توسّعت الرحلة مع الوقت إلى رئاسة التحرير مشاركةً مع زميلي حسن عبّاس. وبعدما عشت "الاحتراق الوظيفي"، وهي نتيجة طبيعية لأيّ عمل صحافي في بلادنا، أضف إليه الأمومة، خرجت في إجازة مؤقتة عدت بعدها إلى وظيفة محرّرة.
لكن مع كثير من الأسف، هذه الرحلة انتهت. هذا النصّ يُنشر بينما لم أعُد جزءاً من فريق رصيف22 التحريري. شعرتُ مؤخراً بأنّ الوقت قد حان لطيّ هذه الصفحة. لم يكن القرار سهلاً. فيه الكثير من الحداد، لكنه يحمل في طيّاته الكثير من السلام والقناعة.
يأتي هذا القرار بعد تعب كثير، ذاتي ومهني. ويأتي بعد تفكير طويل تزامن مع حرب الإبادة على غزة، والجرائم في حقّ الدروز في السويداء، والعلويين من قبلهم في الساحل، والحرب في السودان، ومقتل المئات من الصحافيين الفلسطينيين أمام صمت وتواطؤ العالم الغربي والعربي… ومؤخراً موت زياد الرحباني، الذي شكّل نهايةً لحقبة ما، سيحكي كل من أحبّه عنها بطريقة مختلفة.
في فيديو شاهدته بعد خبر وفاته، يتحدث زياد عن موسيقى "البلوز"، فيقول ما معناه:
"البلوز هي موسيقى السود. هي موسيقى بنوحوا (ينوحون) عليها".
ويتابع: "إذا ضفت نغمة واحدة عليها بتصير حجاز. والحجاز هي الموسيقى اللي نحنا مننوح عليها".
لديّ الكثير من الأسباب للنواح. جدّتي سلمى التي توقفت عن الغناء في الأعراس بعد أن فقدت أخاها الأصغر، بقيت أسمع صوتها وهي "تنوّح" في الجنازات حتى آخر عمرها. أتخيّل اليوم أنّ تلك كانت المساحة الوحيدة للتشافي.
أجدني اليوم أهرب إلى النواح، وأنا في البيت وحدي، وبعيدة عن بلادي. أراقب المقتلة المستمرة في حقّ ناسي في غزّة. مساحة للتشافي؟ لا أعرف. لكن في النواح جرأة الأسئلة وعلنية الحزن.
منذ موت زياد، أجدني أهرب إلى ترتيلة "قامت مريم بنت داود"، بصوت فيروز، وتحديداً إلى مقطع:
"حبيبي حبيبي يا ولد خاطبني
كيف أراك عيران ولا أبطيك يا ابني؟
أوجاعك حرقت أكبادي
آلامك خرقت فؤادي
أحياة لوالدتك
يا ولد بعد موتك؟".
يتقاطع الألم الشخصي مع العامّ، كما تتقاطع الحكايات. الأغنية لمريم وهي تغنّي ليسوع، وتنفع في هذه اللحظة لأن تكون من فيروز لابنها زياد. تختلف ظروف الموت، والفراق، والقصص، والشخصيات، والمآسي، لكن الحزن واحد، والحبّ واحد. وإن أردتُ أن أتمسك بإيماني بالحكاية، فلأنّها تؤكد أنّنا في النواح والحبّ نشبه بعضنا بعضاً.
سأكون ممتنةً لرصيف22 كثيراً، لأنّ في تجربتي في فريق التحرير بأدوار مختلفة، لمست بيروت من شبّاكي في عكّا، على الرغم من أنّي في أوروبا. وما تعلّمته خلال تجربتي لسنوات في رصيف22 مع العديد من الزملاء والزميلات، الصحافيين والصحافيات، الكتّاب والكاتبات، من بلاد أردتُ الانتماء إليها برغم أنف إسرائيل وسلطات القمع، هو أنني انتميت إلى الناس قبل البلاد، إلى ليال قبل طرابلس، إلى علاء قبل القاهرة، إلى زينة قبل الشام… وهذا ما تفعله الحكاية والانحياز إليها.
شكراً قرّاء وقارئات رصيف22 على المحبّة والثقة. سأعود إلى الكتابة الآن من بيتي في أمستردام، الذي يطلّ شبّاكه الغربي على النهر، لا البحر.
نلتقي على صفحات الموقع وأماكن أخرى.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.