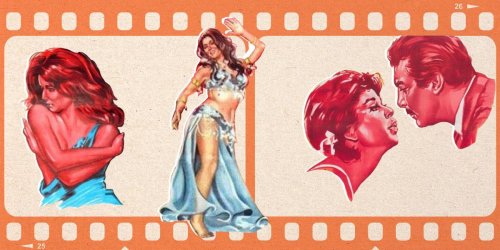مع بداية عرض فيلم "6 أيام"، للمخرج كريم شعبان، في كانون الثاني/ يناير 2025، برزت موجة من ردود الفعل التي أشادت ببساطة الفيلم، عادّةَ إياها أحد أبرز عناصر قوته.
ولم يكن الأمر غريباً في ذلك، فالتوجه العام للفيلم يقدّم بالفعل سرداً رقيقاً وعاطفياً بعيداً عن الزخارف البصرية أو الحبكات المعقدة. إلا أنّ هذا التفاعل الشعبي مع "6 أيام" أو "بساطة 6 أيام"، يدفعنا للتساؤل: هل هذا ما تعنيه البساطة في السينما؟ أم أنّ لمفهوم البساطة في الفن السابع أبعاداً أعمق وأكثر تعقيداً؟
انطلاقاً من هذه الملاحظة الأولية، تبدو المقارنة بين فيلم "6 أيام" وفلسفة السينما لدى روبرت بريسون، أحد أبرز منظّري البساطة السينمائية في القرن العشرين، أداةً مثاليةً لاختبار حدود هذا المفهوم.

البساطة جزء من مقاربة واقعية
يروي فيلم "6 أيام"، قصة يوسف (أحمد مالك)، وعلياء (آية سماحة)، اللذين يلتقيان مجدداً بعد سنوات من الفراق، ليحاول كل منهما استكشاف مشاعره تجاه الآخر في سياق حياتهما الجديدة.
ويقدّم تجربةً إخراجيةً أولى للمخرج كريم شعبان، الذي اتخذ خياراً واعياً، مخاطِراً بالاتجاه إلى البساطة في السرد والعرض، دون اللجوء إلى محاولات استعراضية لإثبات امتلاكه مهارات تقنيةً فائقةً أو قدرات إخراجيةً لافتة.
بينما تبدو قصة "6 أيام" بسيطة ظاهرياً، يعتمد الفيلم على الفراغات والتلميحات غير المباشرة لخلق تجربة عاطفية مشحونة. بساطة السرد ليست استسهالاً، بل استراتيجية ذكية لدعوة المشاهد إلى إكمال الصورة بنفسه، مما يحقق تواصلاً حقيقياً مع الشخصيات والمشاعر المتأرجحة بينها
وبينما تبدو الحكاية في ظاهرها بسيطةً، بتفاصيلها وحواراتها، فإنّ هذه البساطة تحمل في طياتها عمقاً بليغاً يتمثل في الفراغات المتعمدة التي يتركها الفيلم للمشاهد، لتصبح جزءاً أساسياً من بنائه السردي، فالفيلم لا يسعى إلى الإفصاح المباشر عن كل شيء بوضوح، بل يعمد إلى تقديم إشارات غير معلنة تفتح الباب للتأويل أو لإشراك المشاهد في بناء الأحداث وتوقعها، ويمتدّ إلى العلاقات بين الشخصيات، حيث يظلّ غموض طبيعة العلاقة بين يوسف وعلياء -التي هي أساس الحكاية- عنصراً مهماً في خلق المسافة التأويلية.
ما يميز أسلوب كريم شعبان، هو نضجه البصري برغم بساطته، فالفيلم لا يسرد القصة بالكلمات وحدها، بل هو مدفوع بشعور مرهف بالفراغات والتكوينات البصرية، ولا سيّما في توزيع العناصر داخل اللقطات، مثل التناظر بين الكراسي والطاولة في لقاءات يوسف وعلياء، والتي لم تكن أسلوباً جمالياً أكثر من كونها انعكاساً للعلاقة المتشابكة بينهما: توازن في المشاعر مع غياب كامل للتطابق.
في هذا السياق، يشبه الفيلم أعمالاً سينمائيةً مثل Columbus وPerfect Days، التي تؤكد على قيمة التكوين البصري، حيث تتحدث الفراغات والصمت أكثر من الحوار ذاته.
الكاميرا
يستخدم شعبان، كاميرا ثابتةً في أغلب أجزاء الفيلم، ويعتمد على أداء تمثيلي متقشف يتجنب المبالغة، ما يجعل المشاهد يتعامل مع الانفعالات كما هي، دون تدخل درامي مفتعل. هنا تصبح البساطة جزءاً من مقاربة واقعية واعية تُظهر الشخصيات وهي تخوض حالات عاطفيةً متذبذبةً بطريقة مألوفة وغير متكلفة.
في هذا الجانب، يتميز "6 أيام"، بعدم التركيز على العديد من الشخصيات أو الحبكات الثانوية، حيث نادراً ما تظهر شخصيات أخرى على الشاشة سوى يوسف وعلياء، ما يعزز الإحساس بالعزلة والحميمية بينهما، ويعكس رغبة شعبان في تقليص الفوضى السردية، وتالياً إرساء نوع من البساطة الإخراجية التي تركز على الجوهر العاطفي والتفاعل بين الشخصيات الرئيسية فحسب.
في "6 أيام"، تتحدث الفراغات والتكوينات البصرية أكثر من الكلمات، مما يخلق عالماً حميماً ومفتوحاً للتأويل، ويعزز شعور المشاهد بالمشاركة في بناء القصة.
وبرغم نجاح هذه البساطة في بناء تواصل عاطفي مع المشاهد، إلا أنها تبقى ضمن إطار سينما "واقعية" لا تتجه نحو طرح أسئلة فلسفية كبرى أو الغوص في أعماق الوجود الإنساني، بل تكتفي بتقديم تجربة حميمة ملموسة، تلامس مشاعر المشاهد عبر رصد تفصيلي للعلاقات.
أما على مستوى البناء الزمني، فيتبع "6 أيام" هيكلاً غير تقليدي، حيث يقسم السرد إلى ستة فصول تمثّل محطات زمنيةً فاصلةً في حياة يوسف وعلياء. اللقاءات المتكررة في تاريخ محدد من كل عام (19 كانون الأول/ ديسمبر)، تتحول إلى خيط سردي ينظم الفيلم، ويعزز بساطته، ويساعد في فهم تحولات العلاقة بين يوسف وعلياء عبر الزمن.

البساطة أداة للوصول إلى الجوهر الإنساني
في المقابل، يمكننا أن نتأمل في فلسفة البساطة التي حملها روبرت بريسون، في أفلامه، وهي نوع مختلف تماماً عن البساطة التي نجدها في فيلم "6 أيام"، ولو اشتركت في ما بينها ببعض النقاط السطحية.
بريسون، كان يرى في السينما أداةً للتجريد، وسعى إلى إزالة كل عنصر قد يشتت الانتباه عن جوهر الفكرة، حيث كان يعتقد أنّ السينما يجب أن تتخلى عن الزخرفة البصرية، وعن المبالغة في الأداء، وحتى عن الموسيقى التصويرية التي يرى أنها "تضغط" على المشاعر، وعن المونتاج الذي يُستخدم لخلق تأثيرات درامية، وبدلاً من ذلك كان يترك ما يمكن أن تتيحه تلك المؤثرات والأدوات للصمت أو الحركة البسيطة والحوار المقيد، حتى أنه في بعض الأحيان كان يعتمد في أفلامه على صوت خطوات أو نفس خفيف كعناصر رئيسة، في محاولة منه لتجريد عميق جداً للواقع وتبسيطه.
البساطة عند بريسون، لا تعني تسهيل الحكاية أو التقليل من الأحداث، أو حتى التخفيف من الإبهار في السرد والعرض، مثلما هو الحال في فيلم "6 أيام"، بل هي دعوة لتجاوز المظاهر والذهاب إلى عمق التجربة الإنسانية.
في أفلامه، لا يوجد مكان للعبث أو التفصيلات العاطفية التي تستهلك الانتباه؛ كل شيء في أفلامه خاضع لسؤال جوهري: كيف يمكن الوصول إلى الجوهر الإنساني دون أن نُشوّش عليه بأيّ أداة سينمائية "زائدة"؟ بريسون كان يعارض حتى استخدام الممثلين المحترفين، مفضلاً استخدام "موديلات"، أي أشخاصاً عاديين، لأنّ أداءهم البسيط يعكس صدقاً بعيداً عن أي تصنع برأيه.
تباين بين البساطتين
في المقارنة بين فيلم "6 أيام" وأفلام بريسون، يظهر بوضوح التباين بين النوعين من البساطة. ففي "6 أيام"، البساطة هي وسيلة للوصول إلى مشاعر الشخصيات بشكل غير معقد، حيث تُستخدم اللحظات الهادئة والصمت الطويل لنقل القلق، والخوف، والأمل بين يوسف وعلياء، وهي تخدم الهدف الواقعي للفيلم، الذي يهدف إلى تقديم مشاعر حقيقية وبسيطة تُشبه الواقع كما نعرفه.
أما في أفلام بريسون، فالبساطة ليست مجرد غياب للمبالغة، بل هي وسيلة لإزالة كل المؤثرات التي قد تُخفي الحقيقة العميقة للفيلم، وليس الهدف هنا عرض الواقع كما هو، بل البحث عن "الجوهر"، أي عن معنى أعمق لما يعنيه أن تكون إنساناً في هذا العالم. بريسون كان يرى أنّ السينما لا يجب أن تكون مرآةً للواقع بل وسيلة للبحث عن الحقيقة غير المنطوقة، ومن هنا تأتي بساطته التي لا تترك مجالاً للأدوات التقليدية التي يمكن أن تحجب هذه الحقيقة.
الموسيقى…
من الملامح اللافتة في فيلم "6 أيام"، أنّ الموسيقى لا تُستخدم كخلفية عاطفية تزيينية، بل تؤدي دوراً عضوياً في بناء العالم الدرامي للشخصيات، وفي تعميق معنى الزمن والمكان الذي تنتمي إليه، حيث يعتمد الفيلم على مجموعة مختارة من الأغاني التي تعود إلى الجيل القديم، مثل "موعود" لعبد الحليم حافظ، وغيرها من أغنيات الجيل الأحدث، ما يعكس المزاج العاطفي لجيلٍ عالق بين ميراث الماضي وضياع الحاضر.
يقدم "6 أيام" بساطة تخدم الوصول إلى الحياة الواقعية والعلاقات الهشة، بينما تذهب بساطة بريسون إلى أبعد من ذلك: تجريد كامل للواقع من زخارفه بحثاً عن الجوهر الإنساني العميق. في الحالتين، البساطة ليست هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لكشف ما لا يُقال بسهولة
هذه الأغاني ليست مجرد وسيلة لإثارة الحنين أو لتجميل المشهد، بل هي امتداد صامت لما لا يُقال في الحوارات: الألم، الحنين، والتيه العاطفي، ما يجعلها تصبح بهذا لغةً دراميةً قائمةً بذاتها، تكشف عن طبقات خفية من شخصية يوسف وعلياء دون الحاجة إلى حوار صريح.
في المقابل، حين ننتقل إلى سينما بريسون، نكتشف فلسفةً مغايرةً تماماً في التعامل مع الصوت والموسيقى. بريسون كان يرى في الموسيقى عنصراً خطراً قد يطغى على صدق الصورة والصوت الطبيعي، ولذلك استخدمها بحذر شديد إن لم يكن بالامتناع التام. وعندما لجأ إليها، كما في بعض أفلامه مثل "مذكرات كاهن ريفي"، كان يستخدم مقطوعات كلاسيكيةً جاهزةً وفي مواضع محددة لا تمنح الموسيقى استقلاليةً تعبيريةً عن الصورة، بل تحاصرها وتُبقيها خادمةً لنسق السرد.
بالنسبة لبريسون، الموسيقى الزائدة أو التكوينات البصرية المزخرفة كانتا خيانةً للبساطة التي أراد أن يحققها، والتي تُبنى بشكل أساسي على تقشف التعبير لا على إثرائه بالعناصر التجميلية.
بهذا المعنى، يصبح استخدام الموسيقى في "6 أيام"، خياراً واعياً ومنسجماً مع رغبة كريم شعبان، في خلق تجربة وجدانية حميمية تنتمي إلى الواقع العاطفي للشخصيات، لا إلى طموحات تقنية استعراضية، وعلى العكس من بريسون الذي كان يقاوم كل ما يهدد نقاء الصورة والصوت الطبيعيين، نجد أنّ كريم شعبان يحتضن الموسيقى بوصفها جزءاً من بنية السرد نفسها، مضيفاً طبقةً شعوريةً تغني الفجوات الصامتة بين الشخصيات دون ابتذال.

البساطة ليست تكراراً لمفهوم واحد
في تأمل هذه المسافة بين بساطة "6 أيام"، وبساطة سينما بريسون، يتضح أن الحديث عن "البساطة" في الفن ليس تكراراً لمفهوم واحد، بل مقاربة لرؤى متباينة للوجود الإنساني ولجوهر التعبير السينمائي.
في "6 أيام"، يعمل التبسيط على ملامسة نبض الحياة الواقعية، وعلى التقاط تلك اللحظات أو التفاصيل أو الأحداث الصغيرة التي تصنع التجربة الإنسانية والعلاقات، بكل هشاشتها وصدقها العاطفي. أما عند بريسون، فإنّ التقشف البصري والسمعي ينقلب إلى عملية تجريد كبرى، تسعى إلى اجتثاث كل ما هو عرضي للوصول إلى لبّ لا يُقال، وإلى ما هو أبعد من الحكاية والمشاعر الظاهرة.
ليس الفرق بينهما في حجم الزخارف أو عدد التفاصيل، بل في طبيعة الغاية من هذا التبسيط: بين من يريد للسينما أن تهمس بما نشعر به ولا نقدر على قوله، ومن يجعل منها مساحةً للصمت التأملي الذي يستنطق الأسئلة الكبرى حول المعنى والعزلة والخلاص.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.