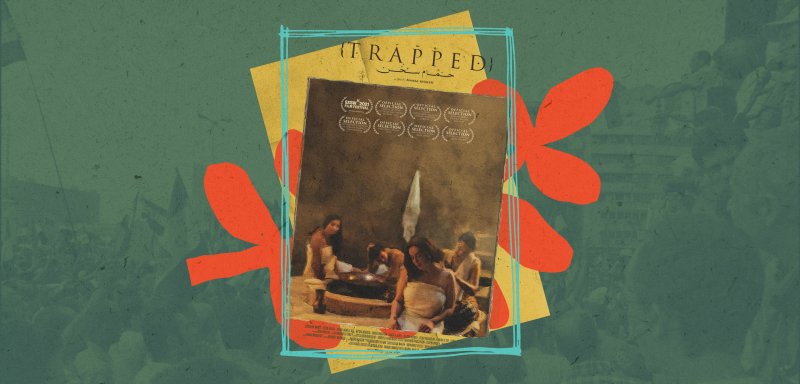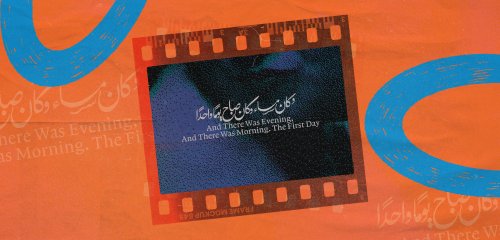كيف فاتني الفيلم المصري "حمام سُخن"؟ عدم انتباهي إليه يفسّر لماذا لم تنجح الثورة، ولعله دليل إحباط على سرعة انطفائها، ووقوعها فريسة موجتين من القوى المضادة للثورة.
شاهدت كل الأفلام التي اقتربت من زلزال كانون الثاني/يناير 2011، بداية بـفيلم "18 يوم" الذي عرضه مهرجان كان عام 2011. أغلب تلك الأفلام يمكن وصفها بأنها "عن" الثورة. أما فيلم "حمام سُخن"، تأليف وإخراج منال خالد، فهو مختلف في بساطته وعمقه وشاعريته الجارحة، إنه باختصار فيلم "في" الثورة.

لا تقاس جودة أفلام الحروب، أو واقعيتها، بكميات النيران وتأثير شدة الانفجارات في تفتيت البنايات، وتناثُر الأطراف المبتورة. وكذلك أفلام الثورات تتحول أحياناً إلى منشورات ثورية وبيانات انفعالية، ما لم تستند إلى دراما تمنح العمل صدقاً وحياة تتجدد كلما شاهده جمهور محلي أو أجنبي يجهل تفاصيل الثورة، ويغنيه الصدق الدرامي ويثري وعيه.
"حمام سخن" فيلم ذكي، تدور وقائعه في الأيام الأولى لثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، خرجت بطلاته ببراءة وحماسة ينشدن الحرية والعيش الكريم، فوقعن في فخاخ قبضة بوليسية قاهرة
نجحت الثورة وفشل ممثلوها. نجحت لأنها تسلحت تلقائياً بقواعد جماهيرية لم تجد لها ممثلين. في كتابي "الثورة الآن"، كتبت أنه في يوم 8 شباط/فبراير 2011، جلست على رصيف شارع شامبليون، امرأة تبلغ نحو الأربعين، تبدو عليها أمارات جمال مغدور، ينقصها ربيع كهذا يزيح سحابات الهموم وأدخنة الغاز المسيل للدموع والأسى، ويعيد إلى روحها البريق. كان حولها طفلان ينظر أكبرهما إلى السيارات في شارع عبد الخالق ثروت، ويتناول الصغير بعض الكشري. قدّرت أنها زوجة شهيد، أو أمّ شهيد من أولئك الذين لم يتجاوزوا العشرين.
أسند الطفل الكبير قطعة من الورق الكارتوني المقوى إلى سيارة خيّل إليّ أن صاحبها تركها على جانب الشارع منذ اندلاع الثورة، وتناول من أخيه طبق الكشري، واللافتة مالت وانكبّت على وجهها، فعدلها ولم يسندها، وظلت تنظر إلى السماء، وهما لاهيان عنها بلقمة ربما لا يجدان مثلها في الميدان.
كانت الكلمات مكتوبة بخط متواضع، ولم أسأل الطفل الكبير هل كتبها؟ أمْ أملاها على عابر سبيل؟ أم تطوع جار لهم بكتابتها واقتراح هذه الجملة: "هتنخلع هتنخلع ولو من غير بنج". وفي زحام ميدان التحرير رأيت فتى يحمل لافتة كارتونية، مكتوبة بخط غير متقن: "نصف ثورة يساوي هلاك أمة". قلت لنفسي إن الثورة نجحت؛ فهذا شاب يتمتع بذكاء فطري، ولو كان مثقفاً لذكر المثل الصيني: "أنصاف الثورات أكفان الشعوب"، ولكن الفتى بلغ الحقيقة بنفسه.
نجحت الثورة وفشل ممثلوها، خصوصا مَن يجيدون اللغات، وفضّلتهم الفضائيات الأجنبية في ميدان التحرير، وتكلموا كلاماً كبيراً عن قضايا كبرى، على طريقة عمرو حمزاوي، فاستنكروا السياسيات الاقتصادية التي شكلتها اللّبرلة، وانتقدوا الاقتصاد الريعي وعلاقة الطغم المالية الإمبريالية بالرأسمالية المافياوية، وبشّروا بنهاية حكم الأوليجاركية، وزوال الاستبداد المترتب على زواج المال والسلطة.
في الانشغال بحظّاظات الأيدي، لم يروا المرأة وولديها في شارع شامبليون، ولا الفقراء الذين دفعوا محمد أبو الغيط إلى صيحة: "الفقراء أولاً يا أولاد الكلب"، ردًّاً على انشغال النخبة، بعد خلع حسني مبارك، بسجال سياسي حول الدستور أولاً، أمْ الانتخابات أولاً.
هم الفقراء الذين عانوا التهميش والإفقار، وانتبه إليهم الكاتب البريطاني جون آر برادلي في كتابه "ما بعد الربيع العربي"، وكان أكثر وعياً بالفقراء وقود الثورات، من مستشرقين محليين وغربيين فرحوا بالثوار "القريبين من الثقافة الغربية الذين نشروا تغريداتهم بالإنجليزية على تويتر. تهافتت البرامج التلفزيونية الغربية على المتظاهرين الذين يتحدثون الإنجليزية؛ إذ تفتقر معظم هذه البرامج إلى المترجمين، فضلاً عن إدراك أطقم العمل بها نفور المنتجين من الاستعانة بالترجمة المكتوبة. لكن اللافتات والتغريدات والتعليقات الصوتية التي أدلت بها النخبة لم تكن تعبر عن صوت الشعب. فالجموع العربية لم يكن همها الرئيسي انعدام الحرية السياسية، وإنما انعدام الوظائف". (ترجمة شيماء عبد الحكيم طه، مؤسسة هنداوي بالقاهرة، 2017).
فيلم "حمام سُخن" يحنو على هؤلاء ويحبهم. لا يكتفي بالتعاطف معهم. التعاطف يملكه القريب والغريب والمستشرق. وهذا الفيلم يختلف عن أفلام مصرية صنعت بعين استشراقية، تستعمل الفقراء والمهمشين جسراً لجذب الانتباه، وإثارة الشفقة والأسى. الجسر يمتد حتى المهرجانات الدولية. وهذا فيلم ذكي، تدور وقائعه في الأيام الأولى لثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، خرجت بطلاته ببراءة وحماسة ينشدن الحرية والعيش الكريم، فوقعن في فخاخ قبضة بوليسية قاهرة.
ثلاث حكايات كتبتها رشا عزب ومنال خالد، متوالية سينمائية تعزف نغمة تستهدف الفرار من القبضة الغاشمة، والخروج من حالة الحصار. في الفنون لا يكفي ماذا جرى؛ فالوقائع تتشابه، الأهم من الواقعة هو كيف تحكيها؟ والحصار المكاني والنفسي لا يستدعي كارثة لكي نصدقه، الحصار هنا مركّب يجري تصويره ببساطة آسرة، بتضافُر عناصر الفيلم، ومعظم المشاهد ليلية داخلية، في أماكن مغلقة، خانقة، في ديكور صممته سلمى صبري بإشراف محمد العبد، والمونتاج اللاهث المشدود لرانيا المنتصر بالله يجعل من الفيلم، بحكاياته الثلاث طوال 76 دقيقة، مشهداً واحداً لاهثاً.
يبدأ الفيلم بصاحب محل للهواتف (الممثل أسامة أبو العطا) يستعد للإغلاق، يطفئ الأنوار إلى الحد الأدنى، على خلفية مطاردات ونفير سيارات الشرطة في الشارع، وأغراض متناثرة على الأرض، سقطت ممن تطاردهم قوات الشرطة.
كاميرا مدير التصوير محمود لطفي تتجاوز هذه الأشياء، تعبُرها دلالة على أن أصحابها لم ينتبهوا لسقوطها، أو فضّلوا التضحية بها إنقاذا لحياتهم، إلا لافتة صغيرة كتب عليها "ثورة في تونس. ثورة في مصر" وعليها محفظة، والكاميرا تعود إليها، تتوقف ثواني، تتردد وتبتعد. الكاميرا هنا عين صاحبـ/ـة المحفظة، وقد فكر/ت في التقاطها فاقتربت الشرطة، وفرص النجاة تنعدم.
تعدو الكاميرا فلتلقط لافتة ملونة تحدد طبيعة المظاهرة، "سلمية"، بثلاث لغات منها العربية، ثم فتيان يتحصّنون في الظلام بهيكل سيارة، وخيال بشري مهزوز ينعكس على باب مغلق لأحد المحال مكتوب عليه، بخط مهتز، "عيش حرية عدالة"، وعلى الباب المغلق للمحل المجاور لافتة "التغيير"، وفوارغ قنابل غاز مسيل للدموع (كان يجب أن تكون حديثة واضحة الحروف؛ لأنها استعملت قبل لحظات)، وتمضي قدَما الشبح المطارد، مع سعال يوضح أن صاحبته امرأة، قبل أن تقتحم المحل الموشك على الإغلاق.
يفاجأ صاحب المحل بالشابة المطاردَة (الممثلة ريم حجاب)، تلجأ إليه، ومن التليفون الأرضي تتصل بأمها وتطمْئنها أنها بخير، وتطمَئِن على ابنها. تعتذر إليه لأنها فقدت الفلوس، يبدو أن المحظفة تخصّها. ولا تجرؤ على الخروج، وتستأذن في البقاء قليلاً، فيسألها: "أنت مسلمة ولا مسيحية؟". يدهشها السؤال، فلا تجيب، وليس للاجئ المستضعف حق الغضب والانفعال. يتلقى اتصالاً من زوجته ويسجل قائمة بالمطلوب شراؤه للبيت ولابنته الرضيعة التي تحتاج إلى حفاضات ولبن نيدو علبة متوسطة، وهدير القوات يخيم على المكان، ثم يدخل أمين شرطة. في الفيلم لا تظهر وجوه رجال الشرطة، في المواجهات لا نرى وجوه الأعداء، الرعب تقذفه الأسلحة لا العيون ولا الملامح.
فيلم "حمام سُخن"، تأليف وإخراج منال خالد، فهو مختلف في بساطته وعمقه وشاعريته الجارحة، إنه باختصار فيلم "في" الثورة
تدخل مخبأ يشبه القبو، وتنصت إلى أوامر يتلقاها أمين الشرطة، يأتيه أمر يسمعه صاحب المحل بألا يغلقه. ولأن أمين الشرطة الشاب فشل في القبض على ثوار في سيارة، فهو أيضاً محاصر بالتعليمات والتوبيخ، ناقم على قائده الذي يستمتع بالطعام والدفء، ويتركه في البرد. أمين الشرطة مقهور يعيد إنتاج القهر. والمرأة رهينة العتمة وضيق المخبأ تحاول النظر، فلا ترى شيئاً. نصف الكادر أسود، الظلام في الخارج حيث يقعد أمين الشرطة. صاحب المحل يبدو غير مشغول بالشأن العام، حتى إنه يسأل أمين الشرطة عن مناسبة عيد الشرطة. وفي الصباح، قبل أن تتأهب لمغادرة المحل تسأل صاحبه إذا كان يريد معرفة ديانتها، فيسألها عن اسم ابنها. لقد تغير، أدركته روح الثورة.
مشاهد مكتنزة، غنية بالتفاصيل والمشاعر، تورّط المشاهدين في الحدث، تجعلهم "في" الثورة، لا مجرد متفرجين عليها. وتبدأ الحكاية الثانية بمشهد لامرأة في شرفة شقتها، على خلفية اتصال هاتفي من امرأة الحكاية الأولى، الخارجة من ضيق المحل إلى رحابة النهار، تتصل بأمها. كما يتصل صاحب المحل بزوجته يحكي لها عن ليلته العجيبة، ويعدها بإكمال القصة حين يرجع.
شريط الصوت ينهي الحكاية الأولى في حين يتصل المشهد البصري بالحكاية الثانية للمرأة تترك الشرفة، وتستعد للذهاب إلى عملها ممرضة في مستشفى قصر العيني، وتغلق الباب على بنتها الصبية. وتهرب من المطاردة امرأة (الممثلة منى مختار)، وكأن رجل الشرطة لمحها، ويتأكد له أنها في الداخل، فيغلق عليها باب البناية بالقفل، فتصعد وتطرق أبواباً لعل أحد السكان يفتح لها الباب، ولا تجد إلا الطفلة الحبيسة. وتقضي المرأة ليلتها على السلم الذي يتحول، بزوايا تصوير كاميرا طارق حفني، إلى سجن من وراء الدرابزين الحديدي.
الفيلم، الأجمل من الكتابة، تعرضه نتفليكس، وأدعو القراء إلى مشاهدته، ولا أودّ الاسترسال في سرد تفاصيله.
بقيت إشارة إلى الحكاية الثالثة، وفيها تندفع اثنتان (الممثلة كارولين خليل والصحفية حبيبة عفت) إلى حمام تديره امرأة تتمتع بقدر من الصلابة (الممثلة زينة منصور). اختلاف الوعي والإدراك للعالم الخارجي يؤدي إلى سوء التفاهم، حتى يؤلف الحصار قلوب خمس نساء في الحمام، لا يستطعن الخروج. وبمرور الوقت تدرك صاحبة الحمام ما يدور في الخارج، إنها الثورة، فتستدعي عمراً من القهر والحصار النفسي، وتستعد لملء الزجاجات بالوقود. بدأت التمرد سوف تشارك بالمولوتوف. لقد أدركتها روح الثورة.
ما أشبه نساء الحكايات الثلاث بمصر بعد صعود القوى المضادة للثورة. يصدق عليها قول ولي الدين يكن (1873 ـ 1921): "مساكين هم أنصار الحرية، يأتون ليفكوا عنها إسارها، فيقعون في الأسر".
إذا كنا في الأسر، فالرهان على الوعي الذي تغير. لقد أدركتنا الثورة.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.