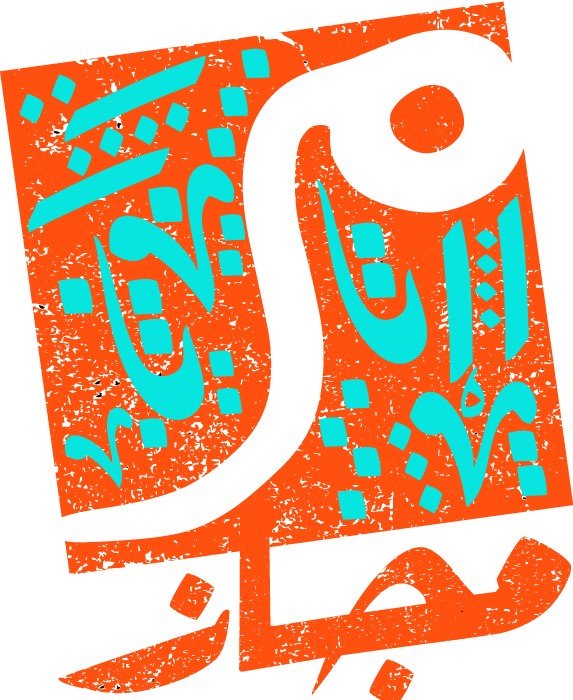 تصميم حروفي لكلمة مجاز
تصميم حروفي لكلمة مجاز
يقول كارل ساندبيرج: "الشعر حقيبة التذكارات اللامرئية"؛ لذا كل مرة أشرع في الكتابة عنه أرتبك، فعلى الدوام كان هو الشاهد على خبري وسرّي، السراب الوحيد الذي سقاني ماءً، وحجر العقيق الملقى في بئري العاطلة.
واللغة هذه خائنة، خائبة، تماماً كالحب؛ لا يخلف كل وصل بها سوى الفقد ذاته، فتبيت القصيدة اعترافا غير دوري بألا ضفة في مستوى النظر.
في ذاكرتي عشرات الصرر لحاويات الكراكيب؛ زوائد خشبية لأسقف البيوت القديمة، الأحجار الملساء، الرمل البرونزي، أعواد الحطب، وحدات قصب السكر، الورق المقوى، قصاقيص اللفائف وبقايا الدمى، الطين الحرام، ريش الديوك الرومية، قوالب الطوب، دانتيلا فساتين الأعراس وعشرات الأغاني.
كنت أنفخ فيها من روحي فتولد عناصر فردوسية، كالتي أرانيها أبي ثم مات آخر الحلم، لولا أن يدي كانتا أخيب من أن تمنحهم صفة فوق الكراكيب.
يداي هاتان ليستا مما يحبهما الله ورسوله؛ تكرهان العمل، وتلومان الله يومياً لأنه لم يثبت أرجوحة في منتصف العالم، لكن ثمة يدين أو جناحين آخرين، كانا يعبثان دائماً داخل الكراكيب المباحة للغة، لتتحرر الفجيعة.
والكراكيب كلمة مناسبة، عندما يتعلق الأمر بقصيدة النثر، حيث يتولى الهامش، كمعادل للحقيقة، إزاحة المتون التي كرّست الزيف لقرون، واستعبدت الخيال وسجنته بين ضفتين أو إيقاعٍ براني يعرج.
وأنا إذا ما مزقت قصائدي المدرسية، يصير إرثي وانتمائي كله ضمن هذه القصيدة.
يداي هاتان ليستا مما يحبهما الله ورسوله؛ تكرهان العمل، وتلومان الله يومياً لأنه لم يثبت أرجوحة في منتصف العالم، لكن ثمة يدين أو جناحين آخرين، كانا يعبثان دائماً داخل الكراكيب المباحة للغة، لتتحرر الفجيعة... مجاز
*****
قبل خمسة وثلاثين عاماً، كان الخوف كلباً أعلى دولاب أمي، أراه كلما أغمضت، يلهث فيبتلع صراخي. أزيز عصا شيخ الكتَّاب الملاصق على جلد أبناء الفقراء يفزعني والكلب يلهث.
أشباح حواديت زوجة عمي، نواح أمي على أبيها الذي مات شاباً وغناؤها الأسيان، عدودات جدتي على زوجها وأخيها اللذين يتشاركان الاسم، فلا نعرف على أيهما تنتحب كلما قرّرت تخضيب شعرها، وكأنها تكفر عن ذنب، و...
وسط هؤلاء ولد الشعر، وربما أسبق؛ منذ مغادرة الرحم كما يعتقد سرفانتس.
وكم دهشت عندما اكتشفت مؤخراً أنه كان لدي ما أحكيه، وأن أكثر قراءاتي، قبل واﻵن، سرد؛ وأن الشعر لم يكن -كما ظننت طويلاً- خياري الوحيد... لماذا إذن تعلقت به وحده؟!
أظنه الصوت: تقاطع غناء أمي، مع عدودات جدتي التي لا تنتهي، وأنين كورال عيال الكتاب الملاصق، الذين تسمع بعددهم آيات مختلفة من القرآن، وحروف الهجاء، وبعض الكلمات قليلة الأحرف تصل بين المرحلتين.
من هذه الأصوات جاء الشعر، كان صوتي الذي أريد أن أسمعه، او أسمعه ﻵخرين، ولعبتي عندما لم يكن متاحاً المشاركة في لعب الصغار سوى بالمشاهدة عبر حديد الشباك. كان دمية من طينة، خلاف التي يصنع منها أطفال القرية دماهم.
مجهولٌ بالنسبة لي أيهما يلتقط الآخر أولاً، الشعر أم الشاعر؟ الأكيد في المسـألة حتمية اللقاء، وإن بدت أسبابه فانتازية او غير كافيةٍ في البداية.
تماماً كاللحظة "صفر"، الحاجة الشديدة، لأشياء يشكلها لحظتها الآن والمرحلة، و هيئة الطير، و أنماط الكوابيس.
أنا مثلاً بنتٌ بفستان أقصر من الذي تبدو عليه جلابيب الريفيات، وزوج عيون تبادل إحداهما الأخرى على البقعة المتاحة من حديد البوابة، أراقب سعادة بناتٍ لن يرحن المدارس ولن يؤنبهن أحدهم على عرائس من طينٍ ومقاعد تراب، فيكتشفني الغناء.
أنا بنتٌ بلا رجل أغلق وراءه البوابة ولصق ابتسامةً مضللةً بالبرواز، بعد أن أحضر خضروات الأسبوع؛ إيزيس بلا قدرة على استجماع الآخر، الذي لا تتأكد تماماً من ملامحه، وتيهٌ رمليٌ يملأ فجوات البدن.
أنا جاهزة، تماماً، أيها الشعر؛ ضائعة بما لا يناسب الموت في هذه اللحظة، جديرةٌ بمحالفة الخيبة، والوحدة بياض يأخذ وضع الكتابة.
*****
أحياناً أظن أن الشعر كان ضرورة، وأظن البداية كانت أسبق من القصائد المدرسية التي جهزتها للإذاعة المدرسية آنذاك، وللحفلات؛ إذ بدأت منذ أن تكلمت وربما منذ سمعت، لكن البداية الحقيقية، الكتابة، جاءت في وقت أبعد؛ ونتاج ضرورة أيضاً، إثر وفاة أبي المفاجئة، تلك المفارقة التي لم أكن أتصور أن للقدر الجرأة على صنعها.
وقتها كنت مرتبكة لا أزال بين ملحمية القصيدة الموزونة وطزاجة قصيدة النثر، والتصقت باﻷخيرة، بعدما لمست هشاشتها وكثافتها، واتساعها لتأريخ الكون ولو عبر ذرة بخار ضلت السرب، وهكذا كنت أرى نفسي وقتها.
لم أكن قد قرأت بعد جملة ريلكه: "لا تكتب الشعر إلا عندما تشعر أنك ستموت إذا لم تفعل"، لكن هذا ما حدث؛ يومياً بعد رحيل أبي كنت أفكر في الانتحار، وعندما أُشتت أو أفشل أكتب، وبهذه الطريقة اكتمل ديواني الأول "على كرسيٍ هزاز" عام 2010.
وبعد قراءتها استوقفتني كثيراً متسائلةً: "هل كان ريلكه يدرك أنه يقترح، على تلميذه، الشعر كحياةٍ بديلة، كنجاةٍ، أو وصفة شفاءٍ مجربة؟".
أذكر أنني امتثلت، ضمنياً، لتلك النصيحة قبل عشرين عاماً، لم أكن قد قرأت – بعد - ريلكه ولا التقيت أحداً من مريديه، ولم تكن مدارس التداوي بالفن والرقص والكتابة مطروحةً بشدة كما هو الحال الآن، ولا أعرف كيف نبت الشعر كخيارٍ منافس للانتحار، وكيف صمد، حتى اكتمل بين يديّ ديواني الأول في قصيدة النثر "على كرسي هزاز"، والذي كان مشبعاً بالجنائزية في بنيته وقاموسه الفجائعي، واكتنازه بالاستعارات.
ومن ورائه جاء الديوان الثاني "مالم يذكره الرسام" متخفّفاً، إلى حدٍ ما، من سمات وتيم الديوان الأول، وكأنه كتب برأسٍ أبرد، أو كمحاولة للتأمل ورؤية الذات معكوسةً في مرايا الآخر، عبر استلهام صور وأساطير ونصوص سردية عربية وعالمية.
بين الديوانين كانت ثمة مسافة ومساحة من اختلاف الرؤى للذات وللعالم، هذه الذات التي ظنت الكون ورقة بيضاء على طرفيها هي والله، وبينهما يقين طائش، اختارت الظهور في القصائد التالية من مناطق أكثر رمادية، ملتحفة بالسؤال الدائم، واعتناق الشك، ورفض السرديات جميعها واستبدالها ببعضها يومياً، و تشاركت مع الآخرين ارتباكها، وتلك المساحة القلقة المسماة بالقصيدة.
أما الديوان الثالث "من شرفةٍ موازيةٍ لشريط قطار" فكنت قد كتبت جلّه، عندما فوجئت برحيل أخي الأصغر، بلا مقدمات أيضاً، وتلبستني فكرة أنني أٌتبع كل فجيعةٍ بديوان، وكان هذا كافياً لكراهية الشعر والانصراف عنه؛ تباطأت كثيراً في نشره، تركته لأعوام قبل الدفع به للنشر.
رغم كل شيء، أحمل لهذا الديوان مشاعر خاصة، وأعتبره الأكثر نضجاً وتمثلاً لجوهر الشعر من بين الدواوين الثلاثة، وأعترف بنفس درجة الإنكار السابق، أنني لم أخبر طريقةً للشفاء سوى الشعر.
فعندما يتصادف أن أعاود قراءة ديواني الأول أو بعض قصائده، وأدرك أو أتذكر كيف كنت أفكر أو أشعر وقت كتابتها، أوقن أن بإمكان الشعر أن يجعلك تتأمل حياتك كناجٍ.
المشكلة هي عندما تؤمن أنت بذلك، عندما تتأكد أن الشعر/ الإبداع عموماً، هو نفسه الألم الذي لا معنى للحياة بدونه، كما يقول شوبنهاور، فلا تطيق وجودك في غيابه، خاصةً إذا كنت من هؤلاء الذين لا يكتبون إلا إذا شعروا أنهم سيموتون إن لم يفعلوا!
للأسف الذين اقترحوا الكتابة كعلاجٍ، لم يقترحوا علاجاً لحبسة الكتابة "Writer's block"، حيث تنتظر من كل صفحةِ بيضاء أن تمنحك الأمل بنجاة جديدة.
كلما ازداد السعار الذي يعتري العالم أفكر في الشعر؛ في أكثر ما يعيبونه عليه ويعتبرونه كليشيه بشأنه، وهو اهتمامه بالعادي واليومي والفردي، لأنه في رأيي أجلى طرق الانحياز للإنسانية وإنقاذها... مجاز
أخشى أن تشبه هذا الكلمة الكليشيه؛ لكن الكتابة طموح بحد ذاتها، أتعلق بها تماماً لدرجة التهرّب منها، خشية ألا تشبه كتابتي ما أطمح إليه من كتابة. لا طعم يشبه ثانية الرضا عن استعارة أو فكرة مكتوبة للتو، أو مصادفة كلمة كنت تقصد أن تقولها هي بالتحديد، أو مصافحة الصدق للحظة.
لذا سأظل مدينة للشاعر الكبير وديع سعادة بأن كسر مرآتي المشوشة التي ظننتها العالم، وتفريغ رأسي من كافة الأوهام اللزجة عن دقة الوزن وفخامة الشعر والشاعر.
عبره اكتشفت واعترفت كم أن الإنسان مسكين وضائع كرقيقة فخار، سقطت في الطريق. أن الطريق بالأساس سراب، وأننا يجب ألا نكف عن الثرثرة مع عناصر الكون.
عرفته في الأشهر القليلة الفاصلة ما بين المدرسة والجامعة، وكم أنا ممتنة لتلك اللحظة، كانت ومضةً وكشفاً؛ كنت أقرأ شعره يومياً، وأستمع لقصائده المسجلة بصوته، كوردٍ يوميٍ وخلفيةٍ لكل قراءةٍ أو معرفةٍ جديدة. ولا أعلم إذا ما كانت روح وديع سعادة التي تسكن شعر جيل التسعينيات وبعض شعراء الثمانينيات، كما اعتقدت وقتها، هي التي جعلت هذين الجيلين الأقرب لوعيي وذائقتي، فالتهمت أشعارهم وحفظت أغلبها رغم صعوبة ذلك مع قصيدة النثر، حتى أنه جمعتنا صداقة من طرفٍ واحد.
أما الشعراء العالميون فقد طويت المسافة بيننا وبين إنتاجهم عبر الترجمة. وفي رأيي كل قصيدة مترجمة مكتسب وأرض جديدة؛ فأنا أشهد كيف جعلت الترجمة أسماء كبودلير وويتمان وبوكوفسكي وراسل إدسن وآخرين تنافس شعراء العربية المكرّسين على حوائط ومنصات التواصل الاجتماعي طوال العشر سنوات الأخيرة.
كما جعلت الترجمة شاعرات مثل سيلفيا بلاث وآن سكستون وفسوافا شمبورسكا وفروغ فرخزادة صديقات مقرباتٍ لشاعرات جيلي؛ الشعر النسائي تحديداً له خصوصية يصعب استحضارها في أي فن آخر، بما في ذلك السرد، كما أن عذاباته كثيرا ما تتقاطع رغم تناثر أصحابها.
أيضاً كانت ترجمة الشعر دعماً غير مباشر لقصيدة النثر، إذ أكدت الترجمات الشعرية الجيدة أن شحنة الشعر التي تصمد بعد عبور النص للغته الأم بموسيقاها وأثر احتكاكات أصواتها، أكبر دليل على أن الأوزان والقوافي التاريخية التي تطارد القصيدة كشبح كانت على الدوام حلى ماضوية ابنة زمانها وزوائد على الشعر.
وفي رأيي أفضل ما جرى للشعر في عقوده الأخيرة هو التخلص من كل ما هو غير شعري؛ التخفّف من زعيق الإيديولوجيا، وتقشير اللغة من زوائدها، واستنبات الجمال من الفردي والعادي واليومي والحقيقي، ليس بهدف الانسلاخ عن العالم وقضاياه كما يدعي من لا يملون المطالبة بإعادة الشعر إلى خندق الأغراض القديمة بحلاها المصطنعة وأفخاخ الرطانة والادعاء، ولكن انتصاراً للإنسان الفرد، الذي لا يُرى ضمن أغراض الفن القديم سوى كرقم ضمن قبيلة أو جماعة أو أمة أو حزب.
لذلك كلما ازداد السعار الذي يعتري العالم أفكر في الشعر؛ في أكثر ما يعيبونه عليه ويعتبرونه كليشيه بشأنه، وهو اهتمامه بالعادي واليومي والفردي، لأنه في رأيي أجلى طرق الانحياز للإنسانية وإنقاذها.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


