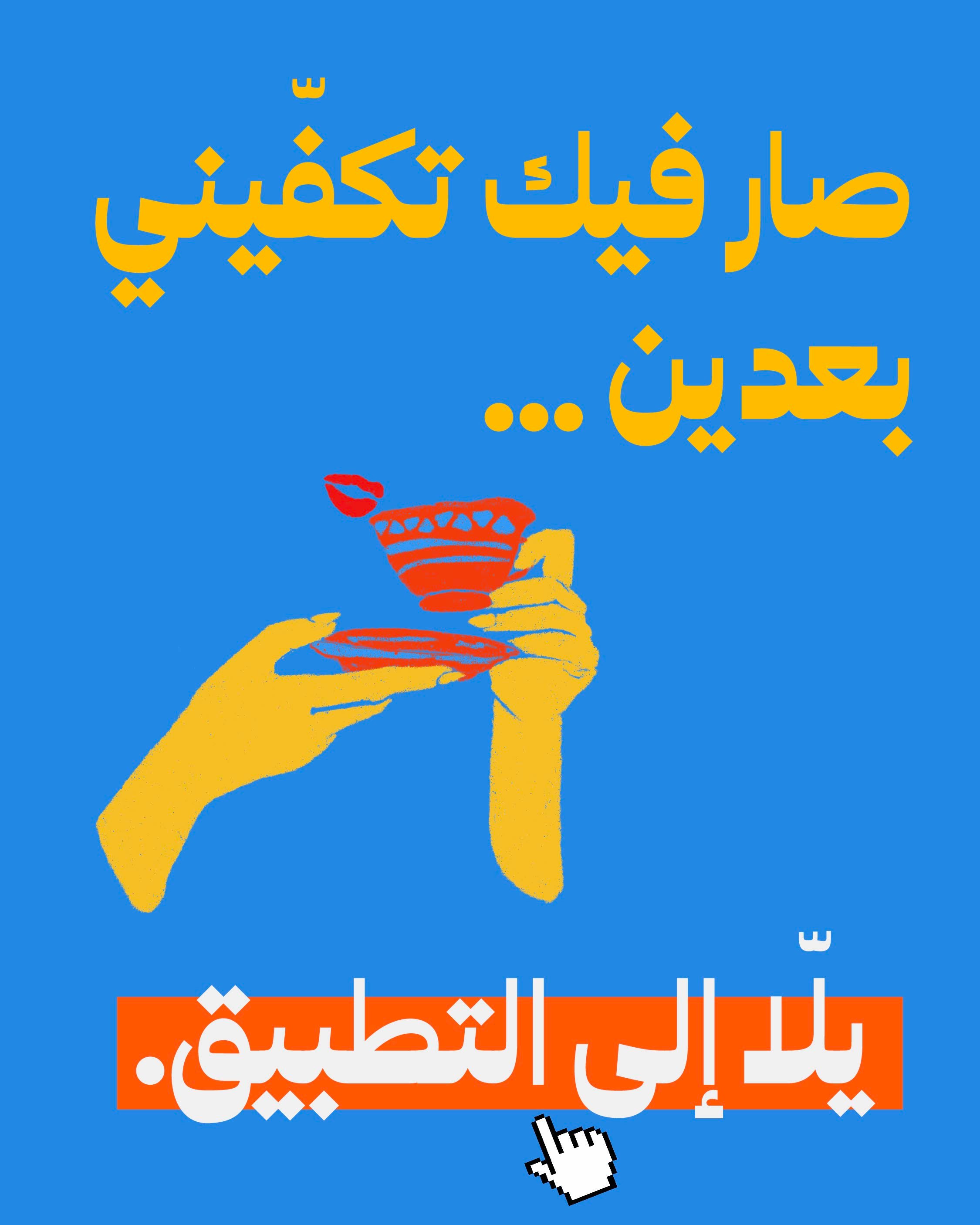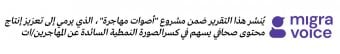
ليست الهجرة مجرد انتقال جغرافي بالمعنى الفيزيائي، بل هي تحوّل شامل يطال طريقة التفكير والتفاعل النفسي مع كل ما يرافق هذا الانتقال: المكان والزمان، اللغة وإيقاعها، المفردات ودلالاتها، والتفاصيل اليومية التي تُعيد تشكيل الهوية والرحلة لاكتشاف الذات في فضاء أوسع وأكثر رحابةً.
لكن هذا التحوّل ليس دائماً بالبساطة التي نتصوّرها. فحين يغادر البعض أوطانهم بحثاً عن مساحة شخصية آمنة، يجدون أنفسهم أحياناً في مواجهة شكل جديد من الرقابة؛ رقابة لا تأتي من الخارج، بل من الداخل، من مجتمعهم الذي رافقهم في الذاكرة، وفي السلوك، وفي نظرة العين الرقيبة.
صحيح أنّ الإقامة في بلد غربي تمنح شيئاً فشيئاً مساحات أوسع للفرد، حيث تُصان الخصوصية ويُحتفى بالاختلاف، لكن المفارقة أنّ التماس مع الجالية العربية قد يُعيد كثيراً من المهاجرين والمهاجرات إلى تجارب ظنّوا أنهم طوّوا صفحتها، أوّلها: الرقابة الاجتماعية.
ففي شوارع باريس وبرلين ولندن، تتكرر الحكاية: أفراد من الجالية العربية ينصّبون أنفسهم "حرّاساً للفضيلة"، يراقبون السلوك واللباس، يصدرون الأحكام، ويتدخلون في ما لا يعنيهم. فهل هذه الرقابة امتداد لسلطة اجتماعية هربنا منها؟ أو أنها حنين لا واعٍ إلى نظام مألوف في غربة مربكة؟ وهل يمكن أن تحمل جانباً إيجابياً، أو أنها عبء إضافي يُثقل تجربة الاغتراب؟
حرّاس "الفضيلة"
"لم يكن هذا ما توقعته"؛ هكذا تبدأ ثريا (35 عاماً)، حديثها إلى رصيف22، وهي تستعيد ما وصفته بـ"خيبة الأمل الأولى" التي واجهتها في شوارع باريس.
هذا النوع من الرقابة دفع ثريا إلى الابتعاد عن الجالية. توضح الأمر في حديثها إلى رصيف22، قائلةً: "لا أحب التعامل معهم أبداً، لأنهم يجيدون الحكم على الناس، وينصّبون أنفسهم حُرّاساً للفضيلة".
رغم أنّ الإقامة في الغرب توسّع للفرد مساحات الحرية وتصون خصوصيته وتقدّر اختلافه، إلا أنّ الاحتكاك بالجالية العربية قد يعيد إليه رقابة اجتماعية ظنّها من الماضي
ويشارك ثريا في تجربتها عماد (37 عاماً) -اكتفى بذكر اسمه الأول- وهو مصري يقيم في ألمانيا، حيث يؤكد أنّ احتكاكه بالجالية العربية جعله يفضّل تجنّبها قدر الإمكان. ويعلّل ذلك قائلاً: "أفكارهم وسلوكهم لا يشبهانني".
ويستعيد عماد موقفاً كان الدافع الأساسي الذي جعله يحدّ من اختلاطه مع الجاليات العربية في المهجر، وذلك أنّ زملاءه في العمل كانوا يتحدثون عما وصفه بأنه "قلّة احترام إلى حد الألفاظ الجارحة"، بحق الأسر العربية التي لا تلزم نساءها بارتداء الحجاب، وفي مرّة "تجاوز التجريح الحدود إلى حدّ دفعني للدفاع عن إحدى الأسر، ودافع المتطاول عن نفسه بالقول إنه 'يتحدّث بدافع ديني'، ورددت عليه حينها: 'وهل الدين يشجّع على النميمة والطعن في شرف الآخرين من وراء ظهورهم؟'. منذ ذلك الحين، صار هذا الشخص يتجنّبني، وهذا من جهتي كان أفضل بكثير".
أما الدكتورة إسراء منتصر (35 عاماً)، التي انتقلت من مصر إلى إنكلترا عام 2017، فقد حملت معها تصوراً لمعيشتها في الغربة سرعان ما تلاشت. تقول لرصيف22: "تخيلت أنني سأستطيع تكوين دوائر آمنة كما في بلدي مصر؛ مجموعة أصدقاء يشبهونني، أستند إليهم في الغربة، وتصبح الحياة أقل قسوةً".
لكن تلك التوقعات سرعان ما اصطدمت بواقع مختلف. توضح منتصر: "معظم العرب هنا يعيشون بعقلية القطيع؛ علينا جميعاً أن نرتدي الملابس نفسها، ونأكل من المطعم ذاته، ونعيش في حياة بعضنا بعضاً، ونتدّخل في اختيارات الآخرين الشخصية".
وتضيف: "أنا لا أسمح لأشخاص يفكرون بهذه الطريقة أن يدخلوا حياتي أصلاً، لكنني ألتقيهم في العمل والشارع، ولا يجدون أي حرج في التدخل في شؤوني، وطرح أسئلة شخصية جداً، أو إعطائي تعليمات حول كيف ينبغي لي أن أعيش". وتشير إلى أنّ "هذا التشدّد أحياناً يفوق ما كنت أواجهه في المجتمع المصري ذاته".
"المختار" والشيخ" و"الواعظ"
هناك مجموعة من الأسباب المعقدّة المتشابكة ذات الأبعاد النفسية والاجتماعية التي تدفع بعض أفراد الجالية العربية في الغرب إلى تبنّي دور "حرّاس القيم والتقاليد"، برغم انتقالهم إلى مجتمعات أكثر تحرراً، بحسب ما يرى حازم معيوي، الباحث الفلسطيني المتخصص في علم الاجتماع السياسي والاقتصادي والمقيم في برلين منذ سبع سنوات.
ويوضح معيوي، أنّ هناك مجموعةً من العوامل النفسية والاجتماعية تتشابك على نحو يصعب فصله، وهي من أبرز الدوافع التي تعيق على الاندماج، ومنها الخوف من الذوبان في الثقافة الجديدة وفقدان الهوية.
فالبعض يرى في الاندماج الكامل تهديداً لذاته وانتمائه، لذا يتمسك بهويته الأصلية بشكل متطرف، أحياناً على حساب التفاعل الطبيعي مع البيئة الجديدة. كما تلعب العنصرية والتمييز الثقافي دوراً كبيراً، موضحاً أنّ "كثيرين ممن شعروا بأنهم غير مرحب بهم في المجتمع الجديد بسبب لونهم أو دينهم أو لهجتهم، يجدون في التمسك بالهوية سلاحاً دفاعياً، ويحوّلون هذا الدفاع إلى رقابة داخل مجتمعاتهم الصغيرة".
كما يرى أيضاً أنّ هناك بعداً عاطفياً لا يمكن تجاهله، يتمثل في الحنين إلى الوطن وتحويله إلى نوع من "المثالية الثقافية"، حيث تُقدّس العادات القديمة وتُفرض كما لو كانت قيماً مطلقة. عامل آخر يرتبط بـالخوف من تأثير الثقافة الغربية على الأبناء، ولا سيما داخل المدارس.
من جانب آخر، وبحسب معيوي، فإنّ الكثير من الآباء يشعرون بأنّ عليهم حماية أولادهم من قيم يعدّونها دخيلةً، ما يبرر في نظرهم التدخل في حياة الآخرين أيضاً.
كما أنّ هناك زاويةً مهمةً جداً، تتمثل في رغبة البعض في إعادة استحضار بعض الأدوار الاجتماعية بشكل رمزي داخل الجالية، مثل لعب دور "الشيخ" أو "المختار" أو "الواعظ"، وهو دور يمنحهم شعوراً بالقوة، خاصةً في ظل غياب النفوذ داخل المجتمع الأكبر. ويضيف حازم: "لا يمكن تجاهل أثر ثقافة الرقابة الاجتماعية الموروثة من المجتمعات الأصلية، والتي تُنقل إلى المهجر سواء عن وعي أو من دون وعي. كأنّ البعض لا يستطيع التكّيف في مجتمع لا تراقبه فيه سلطة، فينصّب نفسه سلطةً بديلة".
ويرى معيوي، أنّ إعادة إنتاج أدوات "السلطة" وفق المفاهيم الاجتماعية السائدة في الحواضن العربية، يعيق بشكل كبير في الاندماج.
بعض أفراد الجالية يسعون لاستحضار أدوار رمزية كالشيخ أو المختار أو الواعظ، بحثاً عن شعور بالقوة
ويتقاطع هذا الرأي مع دراسة بعنوان "معالجة عدم المساواة في الصحة والهجرة في أوروبا: رعاية صحية حسّاسة لاحتياجات المهاجرين"، نشرتها مجلة "لانست" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، إذ تشير إلى أنّ الضغط المجتمعي الداخلي والرقابة الأخلاقية التي يفرضها بعض أفراد الجالية على غيرهم تؤدي إلى شعور بالعزلة وتعيق مهارات التكيّف، ما ينعكس سلباً على الصحة النفسية، ويقلّص من فرص التعليم والعمل والاندماج المؤسسي.
تكيّف تكتيكي
تروي "ثريا"، لرصيف22، مواقف متراكمةً أسهمت في اتخاذها قرار الابتعاد عن الجالية العربية، ففي إحدى المناسبات، عاتبتها أمهات زملاء ابنها في المدرسة لأنها تسمح له بتناول الطعام المدرسي، برغم خلّوه من لحم الخنزير. ردّت بهدوء: "أحبّ أن يندمج ابني مع أقرانه، وكلٌّ حرّ في قراراته". وفي موقف آخر، استغربت هؤلاء الأمهات عدم إرسالها ابنها إلى محفّظ قرآن. علّقت ثريا: "أفضّل أن يتعلّم الدين من مصدر أثق به، وأمام عيني، لا من شخص لا أعرفه".
لكن الضغوط لم تأتِ فقط من المتديّنين. تروي ثريا عن زيارة إحدى النساء العربيات لمنزلها، وحين دخلت غرفتها للصلاة، سخرت الزائرة منها قائلةً إنها تعاني "انفصاماً" لأنها تصلّي، لكنها لا ترتدي الحجاب وتشرب الكحول أحياناً.
تقول ثريا: "الإيمان علاقة شخصية. هذه الأحكام المتناقضة مرهقة، وكأنّ عليّ تبرير كل شيء لا يعجبهم". وتختم: "كل ما أطلبه هو الاحترام، لا أفرض أفكاري على أحد، ولا أحب التنظير، فقط أريد أن أعيش كما أنا، في مساحتي الخاصة، دون أن أُحاسَب أو أُبرر اختياراتي كل يوم".
تستذكر إسراء مع رصيف22، تجربةً مشابهةً دفعتها إلى تجنّب الجالية العربية تماماً، عادّةً إياها مصدراً للرقابة والتطفّل، بل دفعتها لاختيار مكان للسكن بعيد عن مراكز تجمعات الجاليات العربية، وتجنّبت الإشارة إلى أصولها حتى في المظهر كي لا يتم التعرّف إليها كـ"عربية"، تفادياً لما تصفه بـ"الرقابة غير المرئية".
تحكي عن موقف في حفل تخرّج إحدى صديقاتها، حين كانت محاطةً بزوجات أطباء عرب، وفور معرفتهنّ بأنها مطلّقة، انطلقت الأسئلة باستغراب، ومن بينها سؤال صادم من امرأة لا تعرفها: "هتفضلي كده من غير جواز؟".
تنتقد إسراء ما تعدّه هشاشةً في الهوّية لدى البعض: "التمسك المبالغ فيه بالهوية يدفعهم للتدخل في حياة الآخرين. الهوية الحقيقية لا تعني مراقبة الناس أو التحكم في اختياراتهم".
أما عماد، فيلجأ إلى ما يصفه بـ"التكيّف التكتيكي" بحسب محيطه: "لكل مقام مقال"، كما يقول. يعيش بحرّية بين الأوروبيين، لكن حين يكون بين عرب، يحرص على الحذر. حتى أنه يطلب من زوجته ارتداء ملابس محتشمة أكثر في تلك المناطق، فقط لتجنّب التعليقات والنظرات.
"انفصام" ثقافي
بحسب حازم معيوي، فإنّ الأفراد الذين هاجروا أساساً بحثاً عن مساحة شخصية أوسع، هذه الرقابة قد تولّد مشاعر الذنب أو الخجل لدى من يخرج منهم عن التوقعات الثقافية، فيشعر وكأنّه خان مجتمعه أو تخلّى عن هويته، ما يخلق صراعاً داخلياً مستمراً بين رغبته في التحرر وتمسّكه بجذوره.
ويضيف أنّ هذا الضغط الاجتماعي كثيراً ما يدفع الأفراد نحو العزلة أو السرّية المفرطة، إذ يتجنبون التعبير عن معتقداتهم أو أنماط حياتهم خوفاً من النبذ أو الفضح داخل الجالية. ويؤكد أنّ الكثير من المهاجرين يعيشون ما يُعرف بـ"الانفصام الثقافي"، حيث يرتدون قناعاً اجتماعياً يرضي محيطهم، بينما يُخفون هويتهم الحقيقية، ما يخلق حالةً من التوتر النفسي الدائم. في حالات أخرى، يؤدي هذا التوتر إلى مشاعر الإحباط أو حتى إلى عدائية كامنة تجاه الجالية بأكملها، إذ يشعر البعض أنّ الحرية التي سعوا إليها باتت مهددةً مجدداً، لكن هذه المرة من أبناء جلدتهم.
وقد يترجم ذلك إلى سلوكيات متطّرفة، مثل الانسحاب الكامل من المحيط العربي، وتجنّب استخدام اللغة الأمّ، وقطع الصلة الثقافية بالبيئة الأصلية.
وفي هذا الصدد، تشير دراسة كندية بعنوان "العوامل المساهمة في اضطراب الهوية لدى المراهقين من عائلات مهاجرة"، نُشرت عام 2023، إلى أنّ الكثير من المراهقين ذوي الخلفيات المهاجرة في كندا يختبرون ما يُعرف بـ"الخجل الثقافي" (cultural shame)، حيث يشعرون بعدم الارتياح أو حتى الحرج من الإفصاح عن أصولهم، ما يدفعهم إلى إنكار أو إخفاء هويتهم الأصلية في السياقات الاجتماعية والتعليمية.
كما توضح الدراسة المنشورة في "مجلة الدراسات النفسية للمراهقين والشباب"، أنّ هذا الانقسام بين "أنا الذي أنتمي" و"أنا الذي أخجل من الانتماء"، يولّد صراعاً داخلياً يؤدي إلى عزلة نفسية، وتراجع في تقدير الذات، وسلوكيات تهرّب من اللغة والرموز الثقافية الأصلية.
وتلفت الدراسة إلى أن هذا الشكل من الانفصال الهويّاتي لا ينبع فقط من ضغط المجتمع المضيف، بل أيضاً من الرقابة والتوقعات الصارمة التي تمارسها الجاليات نفسها، ما يعزز حالة "الانفصام الثقافي" ويدفع الأفراد إلى الانغلاق أو التمرد، دون مساحة آمنة للتوازن أو التعبير الصادق عن الذات.
لكن هذا التمرّد، كما يوضح حازم معيوي، يمنح شعوراً مؤقتاً بالتحرر، ويترك في المقابل فراغاً نفسياً ناتجاً عن فقدان أحد أعمدة الهوية.
على الجانب الآخر، يختار بعض المهاجرين الخضوع التام لضغوط الجماعة، حتى إن تعارض ذلك مع قناعاتهم الشخصية، ويعيدون إنتاج الأنماط التي هربوا منها، فقط لتجنّب الصدام أو الشعور بالعزلة.
يشير معيوي إلى أنّ الرقابة الاجتماعية، برغم آثارها السلبية، ليست شرّاً مطلقاً؛ فهي، في بعض الحالات، تؤدي دوراً وقائياً، وتحمي الأفراد من الوقوع في مسارات قد تكون مدمّرةً، مثل الإدمان، أو الانفلات السلوكي، أو الانخراط في أنشطة غير قانونية. في هذا السياق، تصبح الرقابة شكلاً من أشكال "الرعاية الاجتماعية الذاتية".
ويضيف: "الرقابة الاجتماعية في المهجر سيف ذو حدّين: قد تحمي وتقي، لكنها أيضاً قد تعيق وتعزل"، وهي تطرح تساؤلات ضروريةً حول التوازن الدقيق بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على العالم الجديد، وبين الانتماء والحرية.
إعاقة الاندماج
يرى معيوي، أنّ الرقابة الاجتماعية داخل الجاليات العربية في أوروبا تُخلّف آثاراً عميقةً ومعقدةً على مسار اندماج الأفراد في المجتمعات المضيفة، خصوصاً على المدى البعيد، إذ تخلق لدى الفرد نوعاً من الانقسام الداخلي، ولا سيّما لدى أبناء الجيل الثاني والثالث الذين يجدون أنفسهم في حالة شدّ دائم بين هويتين متعارضتين.
هذه الازدواجية تُولّد توتراً نفسياً مستمراً، وتؤدي إلى نوع من الاندماج السطحي أو الانتقائي، حيث يختار الفرد من الثقافة الأوروبية ما لا يتعارض مع قيمه الأصلية، دون أن ينتمي بالكامل إلى أيّ من الهويتين. بصورة أوضح: "تسهم هذه الرقابة في خلق عزلة ثقافية شبه كاملة". فبعض الجاليات تعيش داخل "فقاعات اجتماعية" مغلقة، كما يصفها معيوي، تعيد إنتاج ثقافتها بشكل مفرط، ما يحدّ من تفاعلها الحقيقي مع المجتمع المحيط. هذا الانغلاق يُعيق تعلّم اللغة، ويضعف أدوات التفكير النقدي، ويقلّص من قدرة الأفراد على فهم القوانين والقيم الجديدة، ما يؤثر سلباً على فرص العمل والتطور الاجتماعي.
بعض المهاجرين يرضخون كلياً لضغوط الجماعة، رغم تعارضها مع قناعاتهم الفردية، فيعيدون إنتاج أنماط اجتماعية سبق أن فرّوا منها، وذلك تجنباً للصدام وخشية من العزلة القاسية
ويحذّر معيوي أيضاً من تأثير الرقابة على العلاقات داخل الأسر، حيث تتصاعد التوترات بين الآباء المتشبّثين بالقيم التقليدية، والأبناء الذين نشأوا في ثقافة مختلفة وأكثر تحرراً. هذا التنافر يؤدي أحياناً إلى صراعات حادّة قد تصل إلى القطيعة، مخلّفاً آثاراً نفسيةً عميقةً على كلا الطرفين.
ويتوافق رأي معيوي مع ما ذهبت إليه دراسة أعدّها باحثون في جامعة "أوتريخت" الهولندية عام 2021، بعنوان: "الصراع في الهوية الثقافية والرفاه النفسي لدى الشباب ثنائيي الثقافة"، إذ كشفت الدراسة التي شملت 473 شخصاً من فئة المراهقين والشباب اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً من خلفيات مهاجرة يعيشون في هولندا، أنّ الصراع بين الانتماء إلى الثقافة الأصلية ومحاولة التكيّف مع ثقافة البلد المضيف غالباً ما يؤديان إلى حالة من التمزّق الداخلي.
وتوضح الدراسة أنّ هذا التمزّق يرتبط بانخفاض في تقدير الذات، وارتفاع في مستويات القلق والضغط النفسي، لافتةً إلى أنّ ما يعرف بـ"الاندماج الانتقائي" (أي الانتماء الجزئي أو المشروط لهويتين دون شعور بالانتماء المتكامل لأيٍّ منهما)، هو من أبرز العوامل التي تُضعف الصحة النفسية وتعيق بناء شعور مستقر بالذات لدى الشباب المهاجر.
ليست الرقابة الاجتماعية داخل الجاليات المهاجرة مجرّد بقايا ثقافة ماضية، بل مرآة لصراعات لم تُحسم بعد: بين التمسّك بالجماعة والخوف من العزلة، بين وهم الحماية وهشاشة الهوية. إنها رغبة خفيّة في السيطرة تُقنَّع بالحرص، لكنها كثيراً ما تقمع ما جاءت الهجرة لتحقيقه: المساحة الشخصية، والحرية، وإعادة تعريف الذات.
فالتحدّي الأكبر لا يكمن في "الحفاظ" على الهوية، بل في الاعتراف بأنها متحوّلة، تتشكلّ بالتجربة والتفاعل مع مختلفة الثقافات، ولا سيما ثقافة المجتمع المضيف.
ولهذا، فإن الخطوة الأولى نحو مجتمعات عربية أكثر توازناً في المهجر تبدأ من الثقة بالذات، ومن التخلّي عن الخوف من الاختلاف. فالحماية الحقيقية لا تنبع من فرض القوالب، بل من خلق فضاء يسمح لكل فرد بأن يكون حرّاً، مسؤولاً، وفاعلاً في مجتمعه.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.