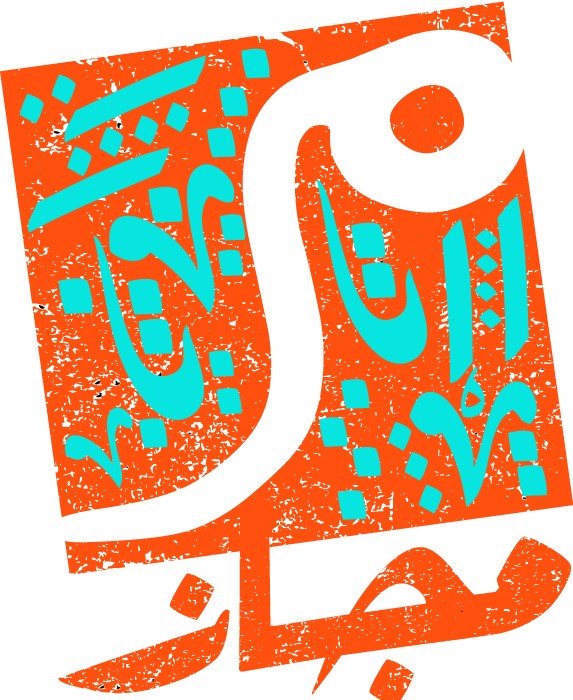 تصميم حروفي لكلمة مجاز
تصميم حروفي لكلمة مجاز
عرفت معنى أن أكون نازحاً. أركض من بيت إلى بيت، وأبحث عن الفراش الدافئ، وعرفت معنى أن أتهلوس بين زرقة السماء وبين المسيّرة، وبين الغيمة والطائرة. لا أنظر فوقي، ولا أنظر حولي.
أغلقت الهاتف المحمول واستسلمت لساعة التأمّل. في الحرب، ينتابني شعور وشوق خفيّ للحظة الحب، والحنين لأيّ شيء في مخيّلتي. في الحرب، لا أتوب عن لحظة الخشوع في نفسي: هل أكتب النار التي في داخلي لتشتعل أكثر، أم أكتب لأطفأها؟
حين أكتب في الحرب، لا أريد عواء الطائرات، فلتذهب الطائرات فوق البيت، أريد أن أنام على إيقاع الكتابة، هنا في المخيم الفائض باللاجئين القدامى والنازحين الجدد، تركت البيت وصرت أبحث عن مكان آمن كي أدفن خوفي فيه واستريح، من المركز إلى الشارع، إلى بيت الأقارب والجيران.
يقولون: إنّ مسيّرات العدوّ تحلّق في كلّ مكان في ساعات الليل، الكاميرات تصوّر الأمكنة بكامل تفاصيلها، لكي تستهدفها بكامل من فيها، ففي كلّ صباح نصحو على مجزرة، من المستهدف اليوم؟ هو السؤال الوحيد قبل القهوة الصباحية.
الحرب تتسع من الجنوب إلى الضاحية الجنوبية لبيروت حتى المخيمات، القصف يطال الجميع. العدوّ كسر الخطوط الحمر. أنظر من نافذة السيّارة على المدارس الفائضة بالنازحين، أجد الثياب على الشرفات، والملاعب مأوى للباحثين عن صفّ يتسع لعائلة من عشرة أبناء وبنات. مخيّمات الجنوب وأبناء الجنوب نزحوا إلى مخيم نهر البارد شمالاً، الشوارع ملأى بالنازحين، مخيّم يتكدّس فوق مخيّم، والكلّ يبحث عن الفراش والأغطية والطعام والشراب، وصوت الطائرات لا يهدأ، صوت الطائرات يجعلنا نعانق بعضنا بعضاً.
مخيّم يتكدّس فوق مخيّم، والكلّ يبحث عن الفراش والأغطية والطعام والشراب، وصوت الطائرات لا يهدأ، صوت الطائرات يجعلنا نعانق بعضنا بعضاً... مجاز
تكدّس اللحم البشري أمام طائراتهم المسعورة المتعطشة للدم، فمن يحمينا من عواء الطائرات؟ أفكّر وأنا على فراش النزوح القسريّ هذا، في الكنبة الدافئة في بيتي. أريد الكنبة، أحنّ إليها، ولا أفكّر في الحرب إلا بدفء الكنبة. أريد أن أجلس وأتمدّد على الكنبة، وأضع يدي على وجهي وأفكّر في هذه الحرب، في بيروت التي أصبحت مثل غزة، ولا تتوقف الانفجارات والقصف المسعور.
في المقهى، يجتمع الشباب كلّ مساء كي يأخذوا دور المحللين السياسيين، وأوّل الأسئلة: هل سيستهدفون المخيّم؟ ومن سيكون المستهدف الجديد غداً؟ السماء ليست كما هي، وضوء الأفق المعتم يبحث عن لحظة الفرح الضائعة، " ذهب الذين نحبّهم ذهبوا"...
في صباح يوم جديد، لا أمسك الهاتف المحمول ولا أفتحه، خوفاً من خبر قاتل. هناك أخبار تشبه قذيفة المسيّرة، هي أيضاً قاتلة، بصمت موحش، حتّى غدر المسيّرات بهدوء الوحش المختفي في التفاصيل. هو حولك لكنّك لا تراه. هو خلفك لكنّك لا تراه. هو معك، وربّما تكون أنت الضحيّة، ولكنّك لا تشعر بها إلا بسيّارة الإسعاف وهي تصرخ في الشوارع.
أتموت هنا؟ أتموت بال أم كا 35، هل جسدك الهش يحتاج لطائرة أم كا 35 كي ترديه شهيداً؟
نام الغد في كبسة زر الطائرة، إمّا حياة أو موت، كبسة زر واحدة، تحوّل مخيّماً بأكمله إلى رماد لا يصلح إلا لموقد نار مهمل. حين تسمع صوت الطائرات صباحاً، فاعلمْ أنّ ثمّة ضربة مضت أو ستمضي أو ستقضي عليك. إنّ أبشع الأصوات ليس صوت الحمير، بل أبشع الأصوات، صوت الطائرات، وللطائرات رمزيّة الحرب الدمويّة. هل جرّبت تبديل زقزقة العصافير بصوت الطائرات باكراً؟ هل جرّبت أن تنام وأنت تتشهّد" أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمداً رسول الله" كي يطمئنّ قلبك، من ليلة دمويّة، من جنون القتل المسعور، في أكتوبر الجديد؟
والحمد لله لم تنكسر النافذة فوق رأسي، ما زالت معلقة، وما زلت حيّاً، طالما أنّني أتنفس يعني أنّني ما زلت حيّاً، وطالما أنّني أكتب في هذه الساعة الليلية، يعني أنّني ما زلت حيّاً، ولكي أتأكّد أنّني حي، ما زلت أسمع صوت الطائرات تأتي وتذهب، وتضرب حمص من شمال لبنان، وكأنّها تتسلّى بالضربات القاتلة.
أجلس مع الشباب في المقهى على الشارع العام، الكلّ مشغول بوصف شكل الطائرة، حجمها، شكلها، لونها، رأسها، كيف تطلق الصواريخ، كيف تصيب، من شاهدها، ومن صوّرها أوّلاً، نوعها، أم كا 35، أمريكيّة الصنع... أصبح الحديث عن الحرب كالمقالات في الجريدة، الكلّ يسرد حكاية الحرب، وحكايته معها، قلت: "الله معنا، ويحمينا من جبروتهم".
كنت أتمنى لو أنّني في البيت كي أسقط في الحديقة على وردة الحوض المقابل، كي أسقيها من دمي وتبقى الأثر المقدّس لمولود جديد لم ير والده أمامه، بل رأى دمه وردةً في الحديقة... مجاز
خذوني... خذوني إلى هناك، أرجعوني واحملوني إلى ما لست أعرف، إلى ما ينتظرني خلف السور، قرب السور، أمام البحر. لا أعرف شيئاً عن الحرب، فقط، أريد أن أعود إلى ما لست أعرف. أعرف فقط، بأنّ الأرض على مرمى حجر من الجنوب، هذا الجنوب الذي يسيل دماً من أجل أن أرى الأرض أوضح، ولا أعرف شيئاً سوى ما أعرفه عن التصميم المقدّس على التأقلم مع فكرة البطولة، وفكرة التسلّح بالكتابة للخروج من قاع العجز إلى فضاء التأمّل، فهل من فضاء في عالمكم خال من القذائف الطائشة؟
يأتي في ذهني اختبار خيالي على كيفيّة قدرتي على تحمّل حرارة الموت بالقذيفة، كيف سيستقبلها جسدي؟ هل يأتي الشعور أم تسبقه لحظة الموت السريع؟ هل تدخل القذيفة من الشرفة أم تخترق الجدار لتقذفني من الفراش إلى الشارع؟
كنت أتمنى لو أنّني في البيت كي أسقط في الحديقة على وردة الحوض المقابل، كي أسقيها من دمي وتبقى الأثر المقدّس لمولود جديد لم ير والده أمامه، بل رأى دمه وردةً في الحديقة، فيسقيها ويعانق لونها الأحمر بذراعيه، ويقسم لها بأنّ الثأر قادم.
أتموت هنا؟ أتموت بال أم كا 35، هل جسدك الهش يحتاج لطائرة أم كا 35 كي ترديه شهيداً؟ يبقى المجهول مجهولاً هنا، في أكتوبر الجديد، وفي اتساع الحرب، حيث لا خطوط حمراء أمام قذائفهم النائمة في المجهول، والبحر أزرق قرب المخيّم، وشرفات النازحين في المدارس تطلّ على زرقة البحر الواسع، إلى أين نهرب قرب هذا الهروب؟ لا أستطيع التفكير أكثر ممّا فكرت، أصبت بهزة في الفكرة.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


