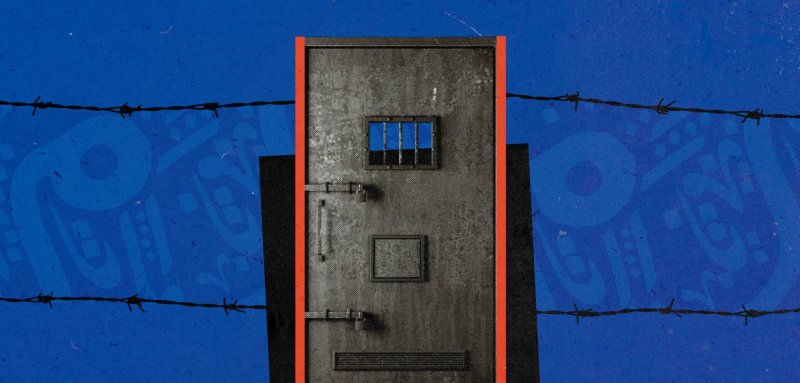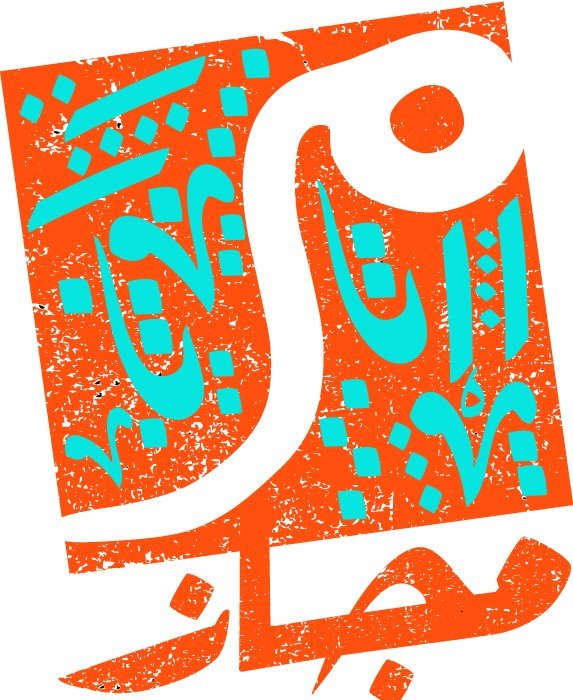
في أولى جلسات التحقيق والاستجواب في الجهاز السيادي المعروف، وقف المهندس محمود مغلول اليدين، معصوبَ العينين، عاري الجسد، مرتعد الحواس، مضطرب المشاعر، بعد أن اختُطِف من داره إلى هذا الوكْر المظلم بعد منتصف الليلة الماضية، وقبيل ساعات لم يعد يستطيع استيعاب عددها، بسبب وفرة القلق المهموم الذي يسيطر عليه وينتابه، والذي تشَرَّب طاقة روحه بسرعة وعنف ووحشية، كمخالب مصاصي الدماء حينما تتشبث بفريستها المذعورة، وتضخّ سمومها نحو أوردتها الضعيفة، قبل أن تنقضّ عليها بأسنانها الحادة المسمّمة. بَتَرَهُ قلقه عن عالمه الذي كان يعرفه، ودفع به إلى عالم جديد موحش وغير مألوف، لم يكن يعرف عنه شيئاً يوماً.
بدأت الجلسة بلطمة قاهرة على وجه المهندس وقور الطبع والطابع، مقرونة بعبارات سبٍّ طالت الأُم والأب والعائلة والمجتمع والدين، لتتهشم كل دلالات الرجولة والنخوة والمروءة أمام أعين محمود المكتوفة، الذي أصبح على مشارف الستين من العمر، وبدأت كل آيات الشيخوخة في السطوة عليه، بعدما قضى أكثر من نصف عمره في خدمة مشروعات هندسية عملاقة ببلده وخارجها، حيث امتهن الهندسة، وتخصّص واحترف تطوير دراسات إنشاء مطارات ومدن الجيل الرابع الحديثة.
انقصفت ما تبقي من صلابة ملامح وجهه الخائف، وتلاشت دلالات الأمل التي كانت تستمسك بأعلى جبهته، ارتعد صوته، وسالت دموعه من تحت وثاق عيونه الغليظ، قائلاً بهدوء الفيلسوف لمن لا يستطيع أن يراه، لكنه يستشعر روحه الوازنة، ويستدرك ماهيته السطحية: "لِيه كدا يا بني، أنا مهندس محترم وأستاذ جامعي!". لحظات قليلة باعدت بين آخر حروف تلفَّظَها بصوت متعوس مهزوم، قبل أن يطرحه المارد المُتَشيطن أرضاً، ويضع حذاءه الثقيل على رأسه، ويسحق تفاصيل وجهه الحزين بقوة وتلذذ ونشوة حمقاء، تنم عن قصور روحي ومرض نفسي بالغ، قائلاً: "انسي كل ماضيك يا ابن الـمرة الـ...... أي حد بيجي هنا يبقي تحت جزمتي دي".
منذ أن أخبرني زملائي في الزنزانة بقصة المهندس محمود الموجعة، والتفاصيل الدقيقة للحظات الأخيرة في حياته، وأنا لا أستطيع تجاوز خيالي الراكد بجوار جثمانه الممدد بجانبي، حيث يبكي ويصرخ قبل أن يضحك ويبتسم... مجاز
تقتدي شياطين الأنس دوماً بمسالك أربابهم من شياطين الجن، فيسيطر الغضب على سلوكهم كغول العقل، بعد أن يَهزِم جُنده، ويُخمد نور البصيرة في قلوبهم، وتهيمن الشهوة على تصرفاتهم، ويتحوّلون إلى مجموعة من المَردة، تفتقر إلى أبسط صفات الإنسانية، فتَحمرّ وجوههم، وتَبرز عضلاتهم، وتتنامي طاقات السوء في دواخلهم، حيث يعبّرون عبر أدائهم عن قدرة النار الشريرة من قوة واستمرارية ووحشية في السيطرة على التراب، بما يحتويه من هدوء وتفاعل وبحث عن أمور تتلاقى خلالها الأفكار، فتتبدل عناصرهم من حال إلى حال، وتتغير معها كل معاني ودلالات تلك العناصر.
بعد كل جلسة استجواب، يَمُّرُ أحد الحالفين بالزور على كل أقسام الوكر، يُقهقِه بصوتٍ مقيت: "أنا سمكري البني آدمين". يعتقد هذا السمكري البغيض أن ما يقدمه من إسعافات ظاهرية قاسية تعالج الجروح، لكنه لا يدرك أن جروح الروح تظل غائرة، ولا شفاء لها، فمهمته الدنيئة تتلخّص في إزالة الآثار الظاهرية للتعذيب من الأجساد المشوهة، تجهيزاً واعداداً لمرحلة ما بعد "السلخانة" التي يعيشها محمود ورفاقه، ممن يسمع أصواتهم بجواره، ولا يعرف أسماءهم، ولا يستطيع سؤالهم عنها، فالجميع هنا محرومون من أبسط الحقوق المكتسبة، وإن كان حق النداء بالاسم، فلكل واحد منهم رقم، واسمه هو رقمه، يسمعه عدة مرات باليوم من مزامير الشياطين التي لا تبرح تفاصيل المكان، فيعتاده ويتأقلم معه، رغم كراهيته المفرطة لذلك الاستسلام العقيم.
بعد انتهاء فترة الاخفاء القَسري التي امتدت لأسبوعين، بين "سلخانة" الجهاز، و"تلاجة" المباحث، حيث يتمّ تجميد المقبوض عليهم بعيداً عن أعين الأوراق الرسمية ولحين اتخاذ موقف أمني بشأنهم، بُعِثَ المهندس محمود حيَّاً أمام نيابة أمن الدولة العليا، وبعد جلسة تحقيق روتينية، لم يستمع خلالها وكيل النيابة الي توسلات الضحية الموجعة، وزَّعَته مصلحة السجون إلى ليمان طرة، وعقب مراسم استقبال الوافدين الجدد، التي تعتمد على ترسيخ سياسة الإذلال والخضوع في النفوس، وعدة أيام بالحجر الصحي، الذي يتم استخدامه عبر الإقامة في زنزانة جماعية حاشدة غير آدمية لتمكين نفس السياسات، تم تسكينه في أحد زنازين عنابر السجن، برفقة مجموعة من النزلاء السياسيين، حيث يتم فصل السجناء السياسيين عن الجنائيين.
مَكَث المهندس محمود في الزنزانة عدة أيام يعاني آلاماً بدنية ونفسية مريعة، من أثر ما تعرّض له طيلة فترة إخفائه، وفي أول زيارة له، تماسَك الرجل بصعوبة أمام زوجته، حتى لا تستشعر كمّ الألم والوجع الذي يؤويه، وفي محاولة للفرار من أسئلتها النهيرة حول أحواله وظروف حبسه وما تعرّض له منذ القبض عليه، أخبرها مُلاطفاً أنه يشتاق إلى وجبة سَمَك من يديها، يعرف السجناء السياسيون أن هذا يُسعِد زوجاتهم رغم ما به من مَشقَة نفسية بالغة لَهنّ، وبعد انتهاء الزيارة التي انتظرها كثيراً، حيث لا تسمح لوائح السجون العمومية بالزيارة الأولى للسجناء الا بعد انقضاء مدة تصل إلى خمسة عشر يوماً منذ يوم الوصول، عاد مُكبّلاً بالآلام والقيود إلى الزنزانة، واشتد عليه المضض والوجع، وظل يبكي ويصرخ ويصارع جدران الزنزانة دون توقف، حتى مات.
خلال دقائق، اكتظ العنبر بضباط المباحث والأمن والاستخبارات، حاوطوا العنبر بالعساكر والمخبرين، وفصلوه عن باقي عنابر السجن، وأجبروا النزلاء على دخول زنازينهم، رغم استمرار ساعات التريُّض، ونقلوا جثمان المهندس محمود ملفوفاً بفرشته التي كان ينام عليها فوق الأرض، وسط بكاء وصيحات استهجان النزلاء، وبعد تحقيق موسّع استمر لساعات طويلة، غادر الجميع طرقات العنبر، وصدرت الأوامر بوقف التريّض والزيارات لنزلاء العنبر، ولأجل غير مسمى.
تخشى الفلسفة الأمنية في السجون من نوبات الحزن والغضب الجماعية للسجناء، وبنهج قديم متجدّد، تستخدم قوات الأمن سياسة الاستباق والمنع واتخاذ التدابير اللازمة مع كل تخوّف يصل إليهم، يحدث ذلك الآن، تماماً كما حدث في كل مرة ينتشر خلالها بالسجن صدى إحدى وقائع الألم، التي تدفع بمؤشرات الغضب في الصعود لتهيمن على نفوس وتصرفات النزلاء، فيتجمهرون ويهتفون نصرة لموقفهم خلال ساعات التريّض، أو ينيرون شموع الرفض والاستهجان بخبط الأبواب الحديدية بحلل الطعام من داخل الزنازين وبشكل جماعي، أو يتخذون موقفاً حاداً بالإضراب عن الطعام.
بعد موت المهندس محمود بأيام، تم تسكيني في نفس الزنزانة. أشفق زملائي الجدد أن يخبروني بحكايته دفعاً للتشاؤم، خاصة أنني الذي حللت مكانه، وحصلت على "نمرته" حيث كان ينام بجوار دورة المياه، فعرف السجون أن يسكن الوارد الجديد بالزنازين بجوار دورات المياه قبل أن ينتقل إلى منزلة أفضل داخل الغرف. لم يخبروني بمأساته ولا بقصّته إلا في ذكرى الأربعين، عندما أرسلت زوجته المكلومة، بعدما ترمَّلَت، وجبة السمك التي طلبها منها مع إحدى زوجات النزلاء، أرسلَتها لكل زملاء الزنزانة بعد أن صرت منهم، بعدما طهتها بدموعها الحارة، وعلى نار قلبها المحترق، وفاءً لوعدها اليتيم له.
بعد كل جلسة استجواب يَمُّرُ أحد الحالفين بالزور على كل أقسام الوكر، يُقهقِه بصوتٍ مقيت: "أنا سمكري البني آدمين"... مجاز
قبل سنوات لفت احدي أصدقائي نظري لواحدة من روائع أدب السجون العالمي، رواية "ذكريات في منزل الأموات" للأديب الروسي الرائع دوستويفسكي، التي كتبها من واقع أربع سنوات قضاها في سجن أُمسك الفظيع في سيبيريا، وقد قرأت أكثر من ترجمة عربية لها، حيث يحكي في إحدى فصولها عن اثنين من عتاة الإجرام الجنائيين، الذين رافقهم في فترة سجنه الموحشة، كانت الصراعات والنزاعات والمعارك لا تنتهي بينهما على مدار اليوم، حتى مرض أحدهما مرضاً بالغاً، وتيقن الجميع أن روحه التعيسة تستعد لمغادرة الأسوار العالية، بعد سنوات عديدة قضاها من عمره داخل مختلف السجون.
وبينما يحتضر، إذ بغريمه يدخل زنزانته ليلقي عليه نظرة الوداع، وبرغم كمّ الجبروت الكبير الذي كان يتصف به الرجل، الا أنه حينما شاهد خصمه يحتضر، لم تستطع قدماه أن تحمل جسده، صُعِق وكأن سيفاً شجّ رأسه فجأة، فسارع بالانزواء في أحد أركان الزنزانة صريعاً، باكياً، متأثراً، وحينما تعجّب السجناء مما يفعله بسبب الخصومة الكبيرة بينهما، توجّه اليه أحد النزلاء وسأله مندهشاً: "كيف تبكيه رغم كم المعارك التي كانت بينكما؟"، فأجابه ودموعه كالسيل المنهمر على خديه: "وكيف لا أبكيه، وهو محروم من أبسط حقوقه في أن تكون بجواره أم تبكيه أو زوجة ترثيه وهو يموت؟!".
منذ أن أخبرني زملائي في الزنزانة بقصة المهندس محمود الموجعة، والتفاصيل الدقيقة للحظات الأخيرة في حياته، وأنا لا أستطيع تجاوز خيالي الراكد بجوار جثمانه الممدد بجانبي، حيث يبكي ويصرخ قبل أن يضحك ويبتسم، ينتفض قبل أن يسكن، "يمكن صرخ من الألم من لسعة النار في الحشا.. يمكن ضحك او ابتسم أو ارتعش أو انتشى.. يمكن لفظ آخر نفس كلمة وداع لأجل الجياع.. يمكن وصية للي حاضنين القضية في الصراع"... أحمد فؤاد نجم.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.