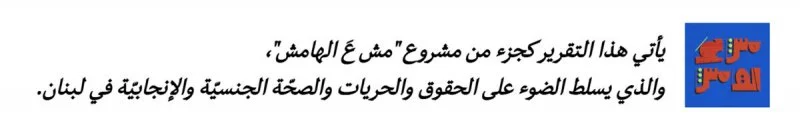
- "هاي الروبة... هاي الروبة"
كان ذلك نداء "هيلة" اليومي الذي يسبق حضورها، والذي كان يكرّر نفسه بإيقاع ثابت كل صباح، معلناً وصول اللبن الخاثر الطازج الى أيادي محبيه.
لم أكن أعي حينها مفاهيم المساواة وتساوي الفرص في سوق العمل والحريات، أو مصطلحات مثل "السترونج إندبندنت ومن"، حيث كان إدراكي أقلّ من استيعاب الفرق بين عمل والدتي في تعليم مادة اللغة العربية بدوامٍ كامل، وبين مسؤوليات جارتنا أم رائد، ربة البيت ومهامها، وبين عمل هيلة، أو "هيلاية" كما يحلو لنا نحن أطفال الحي تسميتها، عملها الذي يتطلب سيراً متواصلاً على الأقدام منذ الصباح الباكر حتى غروب الشمس وبشكل يومي، رغم وجود أخ عاطل عن العمل يشاركها منزل العائلة.
كانت هيلة في منتصف الثلاثينيات من العمر، رغم إنها كانت تبدو أكبر سناً، وكانت ترتدي على الدوام عباءة شاحبة السواد أرهقت الشمس تفاصيلها، مثلما أرهقت ملامح هيلة، وتركت على قسمات وجهها علامات أشبه بأدلة تروي، دون كلام، حكايتها وتفاصيل أيامها الطويلة.
وعلى ذكر الطول، فقذ كانت هيلة طويلة القامة. كنت أراها طويلة أكثر من اللازم، وكانت عباءة الرأس تمنح طولها، أو كما كان يتهيأ لي، بضعة سنتيمترات إضافية لسبب أجهله، لكنني أتذكر أنها كانت تبدو أقصر قليلاً كلما خلعت عباءتها في الأوقات التي كانت تحل ضيفة فيها على منزلنا. أقصر وأنحف.
لكي لا أبالغ، فهيلة كانت أساساً نحيلة القوام، وأعتقد جازمةً هنا أن للعقوبات الاقتصادية التي فُرضت على العراق مطلع تسعينيات القرن الماضي، الأثر الكبير في "نحت" قوام غالبية العراقيين، حيث ضعف الجسد والنحول كانتا السمة الغالبة بسبب النقص الحاد في المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، والذي أثّر وبشكل مباشر على جودة الحياة عموماً، ما دعا العراقيين لاستخدام طرق لا تخطر على بال فيما يتعلق بإعادة تدوير الطعام، أو استخدام بدائل غذائية من مصادر عجيبة!
كانت هيلة في منتصف الثلاثينيات من العمر، رغم إنها كانت تبدو أكبر سناً، وكانت ترتدي على الدوام عباءة شاحبة السواد أرهقت الشمس تفاصيلها، مثلما أرهقت ملامح هيلة
والحال أن الجيل اللاحق ما زال لا يصدق ما يُروى عن روايات التدبير تلك، ولا يستوعب مفاهيم الصراع من أجل البقاء التي دخلت منازل العراقيين بغتة، واستحال أسلوب حياةٍ افترس بأنيابه، إلا ما ندر، أجسادهم وأرواحهم، لا بل وبات يراها سرديات محدّثة بصبغة مبالغة، أقرب للخيال.
إضافة لكل ما سبق، هيلة كانت مدخنة شرهة، وهو فعلٌ لم يكن ليوصم بـالعيب أو العار، ولم يكن حالة تدعو للانتقاص من الأنوثة وضرب مفاهيمها، بل كان أمراً عادياً ومشهداً تألفه العين في ذلك الوقت، خصوصاً لدى النساء كبيرات السن، حيث كان لا يحلو الحديث حول مشاكل الكنّات والتراشق بأخبار نساء الحي، ولا تحلو المآتم التقليدية ولا جلسات السمر و"القبولات"، إلا بعبق التبغ الذي يأتي كجزء مكمل للضيافة، بعيداً عن مضاره وأبعاد تأثيراته الصحية. ربما لأن الوعي الجمعي كان مختلفاً عما هو عليه الآن، أو لأن هذا الفعل كان جزءاً من عادات فطرية ضلّت طريقها نحو التأويل.
كل هذه المقدمة عن السجائر كانت لإضافة صفة جديدة لصورة هيلة المتخيّلة لدى من يقرأ الآن، لأنني لا أبالغ حين أقول إن ازرقاق المبسم وصفرة الأسنان كانا ليكونا الثيمة الأبرز التي ستعلق في ذهنك فور رؤيتك لوجه هيلة الشاحب، بينما الثيمة الأخرى: جيوب جلابيتها العامرة بالقصص والحلو والرفاق المزيفين والضحكات الطارئة:
جيب أيمن يضم كيساً ورقياً مجعداً، تميّزه فور رؤيتك إياه، انسلّ منذ زمن بعيد وحفر مكانه عميقاً هنا، كان بمثابة رفيقٍ أمين، يحمل دوماً بين جعبته ما يسرّ رفيقه: سجائر رخيصة وعلبة ثقاب.
بينما يمتلئ الجيب الأيسر بالكثير من قطع الكاكاو محلية الصنع، والذي كانت كلما أغدقت به على صغار الحي، وأنا منهم، كلما منحتهم أحلاماً مجانية بتذوق شوكولا مستوردة أو فاكهة شهية، ووهبتهم أجنحة من ريش حكاياتها، نحن المُريدين الصغار، الجاهلين بصلة قرابتنا لها، المتلهفين دوماً لسردياتها الساحرة.
"حظي وحظ أختي مثل حظ أُمنا"
كانت هذه جملتها الأثيرة التي لم أستوعبها في صغري، وكانت تعكس- دون قصد- وجه لغز في عائلة هيلاية لم أفهمه حينها، مثلما لم أكن أفهم قدرتها المذهلة على إدارة الحوارات وخلق طرق ساخرة للسرد بحسّ فكاهي قلّ نظيره. كنت أشاهد كركرات أمي وهي تستمع بانتباه لقصص هيلة وبطولات شقيقها في التقاعس والكسل والخمول، ونصائحها الجادة حول الادخار والتنبيه للمستقبل وآليات الاستعداد لغدر الأقدار، في تضاد عجيب يكشف الفارق بين قشورها الخارجية الظاهرة للعلن، وبين ما تخفيه من فجوات تكبر وتتسع كلما تحدثت.
كانت هيلة متزوجة من ابن عمها الذي يكبرها بـ 28 سنة. كان زواجاً تقليدياً أجبرت فيه على الموافقة دون قيد أو شرط، كونها كانت أرملة، استشهد زوجها الأول في الحرب العراقية الإيرانية وهي ما تزال عروساً جديدة، غضّةً على المحن. بعد ذلك، أجبرت على زواجها الثاني بدافع "الستر" والمحافظة على شرف العائلة، فقد باتت من وجهة نظر غالبية المجتمع فريسة سهلة لأطماع الآخرين، ومشروعاً مؤجلاً لاستغلال المارقين.
ورغم سنوات الزواج الطويلة التي تجاوزت سبع سنوات، لم ترزق هيلة بطفل، ما دفع زوجها للاقتران بأخرى وهجْرها، بل وإطلاق لقب "عاجر" عليها، أي "عاقر".
"أنا لست ما حدث لي، أنا ما اخترت أن أكون"
ما يعني أنه كان على هيلة (ورفيقات مصيرها) احتمال التنمّر اللفظي للزوج وعائلته، والحرمان من الإنجاب، والحرمان من المعاينة الطبية التي كانت مكلفة وقتئذ، مكلفة وغير متوفرة، حيث كانت العيادات الطبية المدعومة التي كان يطلق عليها مصطلح (العيادات الشعبية) خالية إلا من مسكّنات رخيصة ومحاليل مغذية وأدوات تعقيم، والحال أن الوضع في الوقت الحاضر لا يختلف كثيراً عن تلك الحقبة.
كبُرتُ، واستوعبتُ ان معاناة هيلاية كانت تتمثل في حرمانها من اتخاذ القرار بالبقاء عازبة بعد وفاة زوجها الأول، الذي أحبته حسبما كان يقال، وفي حرمانها من مراجعة الطبيب لمعاينة مشكلة الإنجاب وفهم أسباب تأخره، وحرمانها الحق في الاعتراض على ارتباط زوجها بزوجة ثانية بذريعة الإنجاب، زوجها الذي لم يرزق هو الآخر بطفل من زيجته تلك!
"أنا لست ما حدث لي، أنا ما اخترت أن أكون"
أحياناً، تجد نفسك حبيس دورة كارمية، تكبّل فيها التساؤلات معصميك، وتتنكر بثياب الإجابات الزائفة، وتسبقك الخيبة دوماً بخطوة، فتحرمك حقك في معاينة الحياة واستكشافها.
والكارما هنا لعنة أن تولد من رحم جدار، فتكبر وتكبر جدرانك معك، وتبقى ملتصقاً بحبل ندوبك السري، فيغذيك بالصور ويمدّك بإشارات التيه.
أتذكر أنني عرفت حليمة متأخراً، وهي الأخت الكبرى لهيلة والتي كانت تعمل في "علوة" السمك، وهو مكان يجتمع فيه باعة السمك من كل أنحاء المدينة، ليعرضوا محصولهم السمكي على رواد المكان، بأسعار تنافسية أقل من سعر السوق.
حليمة كانت شخصية مسالمة، لا تتحدث إلا ما ندر، لا يمكنك تخمين ردودها، فهي هادئة الطباع، وتتمتع بقسمات وجه حادة، بذقن طويل وأنف مستقيم وجبين مشدود، لم تفعل التجاعيد العرضية فيه فعلها، وكانت تلتقي بنساء الحي من حين لآخر، كلما احتاجت لبيع و"تصريف" ما تبقى من "شروة" سمك تخشى تلفها بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي وغيابه لساعات طويلة، لذا فقد كانت تضطر لبيعه لبيوتات محددة في الحي.
كانت، وبحكم خبرتها التسويقية الفطرية، تعرف كميات احتياجهم من السمك وأنواعه: بني، كطان، سمتي، زوري، وغيرها من الأنواع التي تكثر في مدن جنوب العراق وتنتشر بحكم وجود الأهوار (قبل كارثة تجفيفها) ووجود نهر دجلة، الشريان الذي يشق قلب المدينة الى صوبين.
وهنا، فهمت لمَ كانت هيلة تكرّر تلك العبارة الأثيرة، فحليمة كانت هي الأخرى ملعونة لكن بلعنة مختلفة، لعنة المواليد البنات، حيث كان لديها 6 بنات ولم ترزق بصبي، ما دفع زوجها لتطليقها والزواج بقريبته التي أرضت نزعته الذكورية وأنجبت له قبيلة من المواليد الذكور.
بينما لم أعرف يوماً معلومة عن "حظ" الأم ولعنة حزنها التي أورثتها من حيث لا تدري.
أتذكر جيداً قصة "الطنطل" الذي وجدته هيلة في باحة منزلهم الخلفية والتي كانت مليئة بـ"السكراب"، وكيف أنها واجهته بشجاعة ودفعته للهروب (أو هكذا أخبرتنا) بواسطة يد "الهاون" الذي يستخدم لدقّ اللحم وطحن البهارات، حيث كادت أن تضيف إليه استخداماً جديداً: دق رأس الطنطل!
خسرت هيلة وشقيقتها حليمة حياتهما على يد شقيقهما الذي اتهمهما بارتكاب فعل مخلّ، وقتلهما ببندقيته المسروقة من مستودعات الفرقة الحزبية المنهوبة
والطنطل هنا، وبحسب المرويات الشفاهية الجنوبية تعود لقصّة إبان الاحتلال البريطاني لجنوب العراق، حيث اكتشف البريطانيون كائناً غريباً أقرب لوحش، له عشرة ذيول، أطلقوا عليه ten tail monester، وبعد عجن الكلمة ومطها ومدها وإدخالها مصنع اللهجة الجنوبية، كان النتاج: طنطل، والعهدة هنا على الرواة.
المهم أنها كانت واحدة من العديد من القصص التي كانت هيلة تسردها على مسامعنا الجوعى لفطائر المغامرات اللذيذة، ومرويات أشبه بريح تمنحنا الخفة، فنحلق ونذهل ونرتدي الدهشة لشجاعتها الاستثنائية، فنصوغ كلمات "عفية"، "بطلة، "سباعية"، كميداليات نمنحها لهيلة بالمجان، بينما تلتمع عيناها بالفرح والرضى وكأننا جائزتها الكبرى.
كثيراً ما تساءلت: هل كانت لتفهم لو أخبرتها اليوم، وبعيداً عن حكايات الطناطل والغيلان والذئاب، وبعيداً عن مذاق اللبن الخاثر الرائع بلونه الميال للأصفر، والأواني الفضية المصفوفة بعناية في صينية الأحلام التي تزين رأسها كل صباح كتاج ثمين، وبعيداً عن لعنة العقم والبنات وكارما الأجداد، أنها كانت شخصاً ملهماً؟ شجاعاً؟ مكافحاً؟ أيقونياً دون جهد؟
ترى ما الذي كانت تحلم به؟ وما هي الأحجية التي كافحت من أجل حلها؟ وكم مرة تدربتْ سراً على الابتسام وفي داخلها تكبر فجوة تبتلع ضحكاتها المؤجلة؟
أو: ما هي الكلمة التي علقت في حلقها منذ أكثر من 20 عاماً، وهو تاريخ آخر مرة رأيتها فيها؟
*****
ذات ليلة من ليالي 2003 انتصر الطنطل أخيراً، وخسرت هيلة وشقيقتها حليمة حياتهما على يد شقيقهما الذي اتهمهما بارتكاب فعل مخلّ، وقتلهما ببندقيته المسروقة من مستودعات الفرقة الحزبية المنهوبة، باتهام تبين لاحقاً وبعد مرور سنوات، أنه باطل.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.





