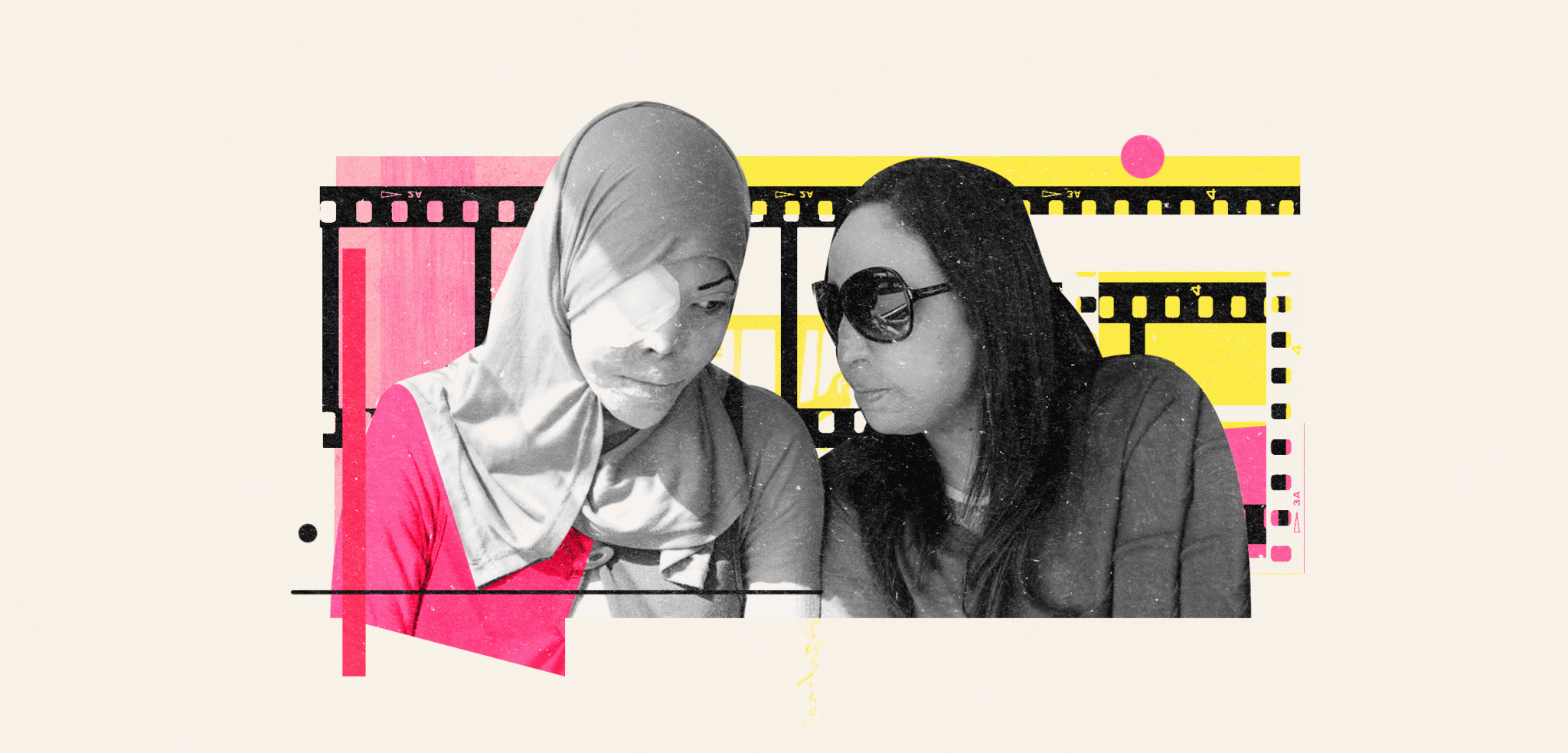في الغابة فقط، ينقضّ الحيوان المفترس على الطريدة التي سبقت لها النجاة منه بأعجوبة. أكاد أقول: "طريدة"، بهذا التنكير؛ فالوحش لا يتذكر إفلاتها منه، ولا ينتقم لكبرياء خدشتها غريزة البقاء، لا يفرق بين حمَل يتحسس عالم الغابة، وغزالة مرعوبة تمكنت من النجاة. لا تحرك الوحشَ أحقادٌ ولا عداوات، وإنما غريزة الجوع، إحساس اللحظة وليس تدبير العقل.
أما الإنسان المصرّ على إيذاء ضحية أفلتت من موت أراده لها، فيرتد بالإنسانية إلى ما قبل الاستواء، قبل استقامة الظهر واختفاء الذيل. شاهدتُ وقرأتُ عن الغابة ما لا أحصيه من قصص وأفلام، وبالفيلم المصري "سمر... قبل آخر صورة" أجدني في قلب غابة. أنا خائف.
فيلم وثائقي مدته 82 دقيقة، أخرجته آية الله يوسف، يحمل دلالات ومعاني ورسائل أكثر مما تضمنه من وقائع. ومن الظلم محاسبة الفيلم في ضوء المعايير النقدية الخالصة، لأنه صنع بإمكانات ذاتية محدودة، بحماسة المخرجة، كرسالة وقضية شخصية، منذ عام 2016 ولمدة ثماني سنوات، وبسبب نقص موارد التمويل، تخلى عنها من لم يحتملوا الاستمرار، وواصلت المهمة، وجاء الفيلم صرخة ربما لا تلبي الطموح الفني، في مشاهد طويلة يمكن اختصارها، وضبط درجات اللون، وشريط الصوت. وهذا لا يهم في أفلام تنطوي على بُعد سوسيوثقافي خاص بالسياق العمومي. والنقد الثقافي يعنى بعمل كهذا، يتخطى الخطاب الجمالي إلى إحالات اجتماعية مضمرة، مفتوحة على الجحيم.
الإنسان المصرّ على إيذاء ضحية أفلتت من موت أراده لها، فيرتد بالإنسانية إلى ما قبل الاستواء، قبل استقامة الظهر واختفاء الذيل. شاهدتُ وقرأتُ عن الغابة ما لا أحصيه من قصص وأفلام، وبالفيلم المصري "سمر... قبل آخر صورة" أجدني في قلب غابة. أنا خائف
تعرضت سمر مسعد، بطلة الفيلم، لاعتداء بمادة حارقة من شريكها السابق، وستتعرف إلى ضحية أخرى هي الفتاة سناء أحمد. تبدأ رحلة التعافي، النفسي والجسدي، بحضور قوي لمخرجة تجاوزت التعاطف مع الضحيتين إلى المحبة، والمشاركة في صنع مصير أكثر رحمة، ولو في دبي، حيث تسافر سمر للعلاج، وتثق بحماسة الطبيبة الإماراتية أشواق الهاشمي، واجتهاد الجراح الهندي موهن. وبفائض هذا الأمل، تتشجع الفتاة سناء أحمد على اللحاق بها، لإجراء جراحة تجعلها أكثر تصالحاً مع وجه لم تعد تحب النظر إليه بعينها السليمة. وتطول الرحلة، ولا يبقى إلا الرهان على نجاح الجراحة. إذا اشتعلت سفينة يلقي البعض نفسه في الماء، أملاً في النجاة.
العمل الأدبي أو الفني منتج ثقافي بالضرورة، يحمل جوانب من ثقافة مجتمعه. ومن زاوية النظر هذه، يكون فيلم "سمر... قبل آخر صورة" إضاءة على حالة لعلم اجتماع الفن، يفيد في تفسير ظاهرة استسهال العدوان، أو استئناسه.
نتفهّم، ونرفض بالطبع، استناد رجل مهووس إلى تراث ذكوري يدعوه إلى الاعتداء على امرأة ترفض مواصلة الحياة معه، فيشعر بإهانة لا يمحوها إلا جريمة الشروع في القتل. أما غير المفهوم فهو العدوى السامة لهذا التراث الذكوري، وإعادة إنتاجه لدى البعض من النساء، وأي نساء؟ تقول الفتاة إنها رفضت الزواج من ابن خالتها، فقالت له أمه، التي هي خالتها: "اقتلها أو شوّهها"، فجعلها سجينة التشوّه.
من يتظاهر مسلحاً بالصمت، أو بالهتاف، أكثر خطورة على النظام الهشّ من شخص يمارس إرهاباً اجتماعياً صريحاً. وبعد الشروع في القتل، بإلقاء ماء النار على الضحية، يُحكم عليه بخمس سنين حافلة بالراحة والعلف المجاني. ثم يخرج بعد التسمين ليتوعد الضحية. إذا لم يكن هذا هو الإرهاب فماذا يكون؟
المرأة، الخالة أو الغريبة، بهذه الدعوة الإجرامية شريكة في الجريمة، تقتل وتشوّه بيد ابنها. والقانون لا يمسّها. لم يبلغ الخيال بالمشرّع أن تنافس المرأة الرجل في الانتقام من فتاة بريئة. هذا خلل مجتمعي مزمن، وفي السنوات الأخيرة طعن شاب جامعي زميلة رفضت الارتباط به. أكثر من شاب فعلها. ولا أنسى جريمة وقعت في حرم جامعة القاهرة قبل تخرجي في كلية الإعلام بسنة، طعن طالب بكلية الآثار زميلته فماتت، تقريبا سنة 1988. لا هذا ولا ذاك فكر في احتمال حياة مع زوجة لا تريده، لعله جنون الاستحواذ. أما أن تشجع الأم ابنها على الاختيار بين القتل والتشويه فهذا تطور نوعي خطير.
لا ينشغل الفيلم بتقصّي دوافع إجرامية تحتاج إلى تعمّق رأسي متمهّل، بالحفر في أرض تنبت هذا الشر كله. انشغل الفيلم بمتابعة أفقية لرحلة الضحية التي ترفض مصيراً أراده لها المجرم، وتقرر التعافي. وهناك الكثيرات، أمثال سمر وسناء، بعضهن يفضلن الانتحار أو العزلة التامة، ينكرن وجوههن، ولسن محظوظات بتلقي العلاج الجسدي والنفسي، ولا بتصوير مأساتهن في فيلم. ولولا الإيمان بقضية سمر ما كان هذا الفيلم الذي قامت المخرجة آية الله يوسف بتصويره ومونتاجه، وإنتاجه بمشاركة سمر عبد الناصر.
وشارك الفيلم في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة في الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة (28 شباط/فبراير ـ 5 آذار/مارس 2024).
فيلم ملهم بالتغلب على مأساة طمس ملامح الوجه. ليس أقسى على الإنسان من النظر، بعين واحدة، إلى وجه لا يعرفه، ينكره ويحاول التكيف معه، وينسى ملامحه الأصلية. يقرر العزلة؛ فلا يراه أحد. لا يريد دفع الناس إلى تعاطف لحظي، مصمصة الشفاة سوف يليها تجاهلهم له كلما صادفهم في طريق. هذا العزل عقاب جديد للضحية، دعوة للاكتئاب والموت بين أربعة جدران. وإذا كانت إرادة الضحية قوية، مثل سمر بطلة الفيلم، فإن في انتظارها عقاباً آخر. قالت بعد عرض الفيلم إن الجاني قضى في السجن خمس سنين، وأفرج عنه، ويقيم في المنطقة نفسها، وإنها لا تخرج من البيت خوفاً من تكراره للجريمة.
هذا الرعب مأساة جديدة لفيلم آخر. الخوف من الأذى أشدّ قسوة من وقوعه. إخضاع الضحية لاعتداء متوقع، في أي وقت، قهرٌ يتجاهله القانون. في البداية قلت: :"أنا خائف"، وفي النهاية أعيدها. في غفلة من القوى السياسية في مصر صدر قانون، غير دستوري غير إنساني، يحظر التظاهر. تلك أجواء ملتهبة، حافلة بالفتن، عام 2013. عقوبة التظاهر السلمي مسخرة، لا أتذكر الآن عدد السنين، وقد يلي الإفراج مراقبة تفرض على الناجي من الاعتقال أن يوقع في قسم الشرطة يومياً، وأحياناً يبيت هناك وليس في أحضان أهله. كانت النكتة أن بإمكان من يقبض عليه متهماً بالتظاهر أن يدعي أنه يتحرش؛ لينال عقوبة مخففة!
تعرضت سمر مسعد، بطلة الفيلم، لاعتداء بمادة حارقة من شريكها السابق، وستتعرف إلى ضحية أخرى هي الفتاة سناء مسعد. تبدأ رحلة التعافي، النفسي والجسدي، بحضور قوي لمخرجة تجاوزت التعاطف مع الضحيتين إلى المحبة، والمشاركة في صنع مصير أكثر رحمة، ولو في دبي
من يتظاهر مسلحاً بالصمت، أو بالهتاف، أكثر خطورة على النظام الهشّ من شخص يمارس إرهاباً اجتماعياً صريحاً. وبعد الشروع في القتل، بإلقاء ماء النار على الضحية، يُحكم عليه بخمس سنين حافلة بالراحة والعلف المجاني. ثم يخرج بعد التسمين ليتوعد الضحية. إذا لم يكن هذا هو الإرهاب فماذا يكون؟
وفي عمى القانون، يحاسب المواطن على تغريدة، نفثة مصدور في مواقع التواصل الاجتماعي تجرّ بريئاً إلى محكمة تقذفه في السجن، في حين يتم تجاهل أسباب انفجار هائل، سيكون كطوفان من غير نوح، ولا أملك إلا أن أردد قول صلاح عبد الصبور في مسرحية "ليلى والمجنون":
يا أهل مدينتنا
يا أهل مدينتنا
هذا قولي:
انفجروا أو موتوا
رعبٌ أكبر من هذا سوف يجيء
لن ينجيكم أن تعتصموا منه بأعالي جبل الصمت أو ببطون الغابات
لن ينجيكم أن تختبئوا في حجراتكم
أو تحت وسائدكم، أو في بالوعات الحمّامات
لن ينجيكم أن تلتصقوا بالجدران، إلى أن يصبح...
كل منكم ظلّاً مشبوحاً عانق ظلّاً
لن ينجيكم أن ترتدوا أطفالاً
لن ينجيكم أن تقصر هاماتكمو حتى تلتصقوا بالأرض
أو أن تنكمشوا حتى يدخل أحدكمو في سَمّ الإبرة
لن ينجيكم أن تضعوا أقنعة القرَدَة
لن ينجيكم أن تندمجوا أو تندغموا حتى تتكون...
من أجسادكم المرتعدة
كومةُ قاذورات
فانفجروا أو موتوا
انفجروا أو موتوا.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.