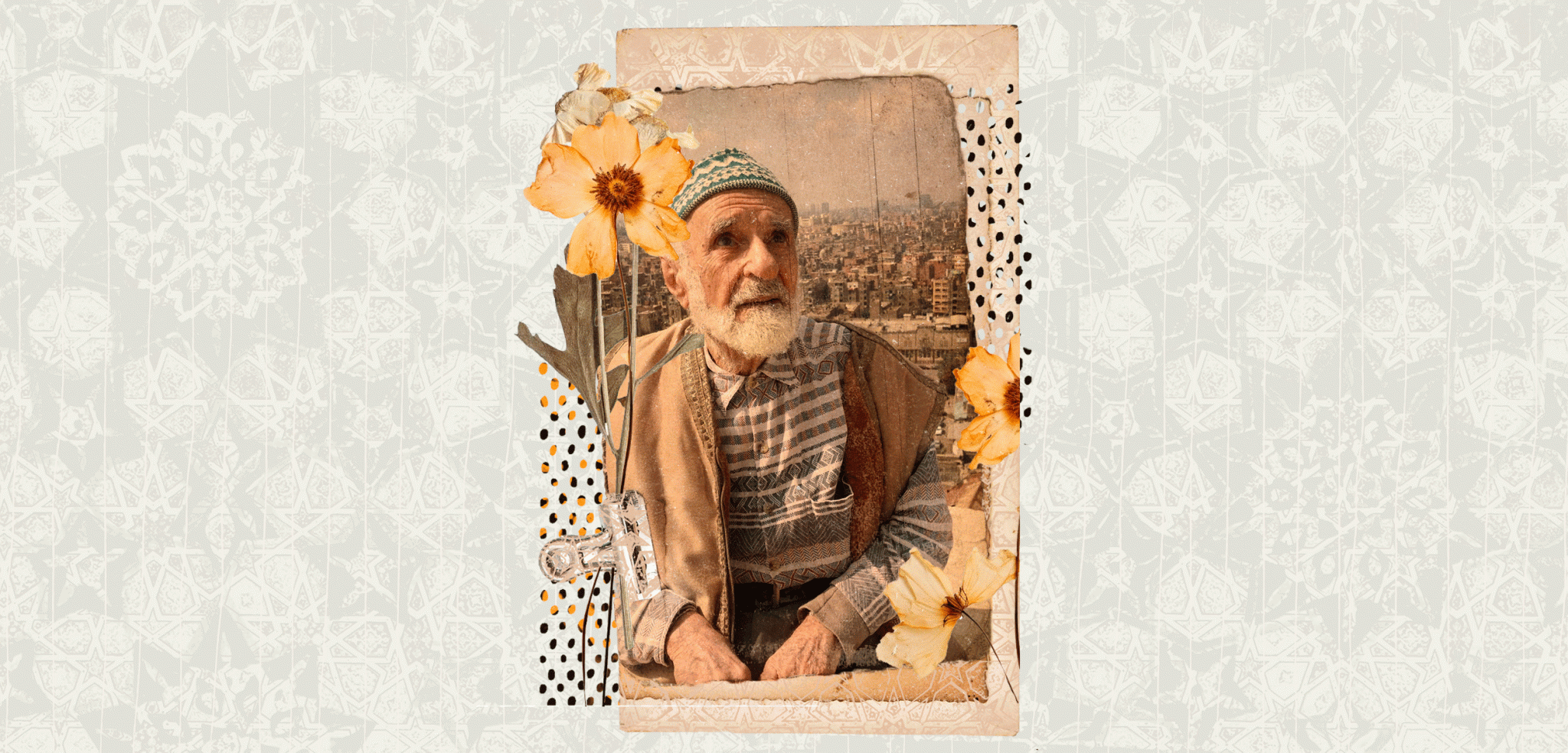اغتُصبت الأرض الفلسطينية من قبل العصابات الصهيونية، وأُفرغت البيوت من أصحابها، ثم تأسست الدولة العبرية في أعقاب نكبة 1948. وكان هذا العام الذي يُمثل جُرحاً دامياً للشعب الفلسطيني، بدايةً لفجائع أخرى عاشها أبناء هذا الشعب، على رأسها محنة التشرد واللجوء والشتات في بقاع الأرض. وهذا هو المصير الذي يحوم حول سكان قطاع غزة منذ ارتكاب الجيش الإسرائيلي، كارثة الإبادة الجماعية ضدهم، حيث بات شبح التهجير يلوح من جديد في الأفق المسدود، وهكذا يبدو الشتات الدائم، قدراً قاسياً يُطارد الفلسطينيين أصحاب الأرض ويحاصرهم، صانعاً ذاكرةً جريحةً.
المؤرخ والعلّامة الفلسطيني محمود إبراهيم الصمادي، أحد هؤلاء الفلسطينيين الذين حملوا على ظهورهم محنة شتاتهم من بلدٍ إلى آخر؛ بدأت محنة شتاته إثر تهجيره في زمن النكبة من قريته لوبية (تابعة لقضاء طبرية)، إلى مخيمات اللجوء في بيروت، ومنها إلى مخيم اليرموك في دمشق، حتى وصل في نهاية عمره إلى حي بولاق الدكرور الشعبي في العاصمة المصرية القاهرة.
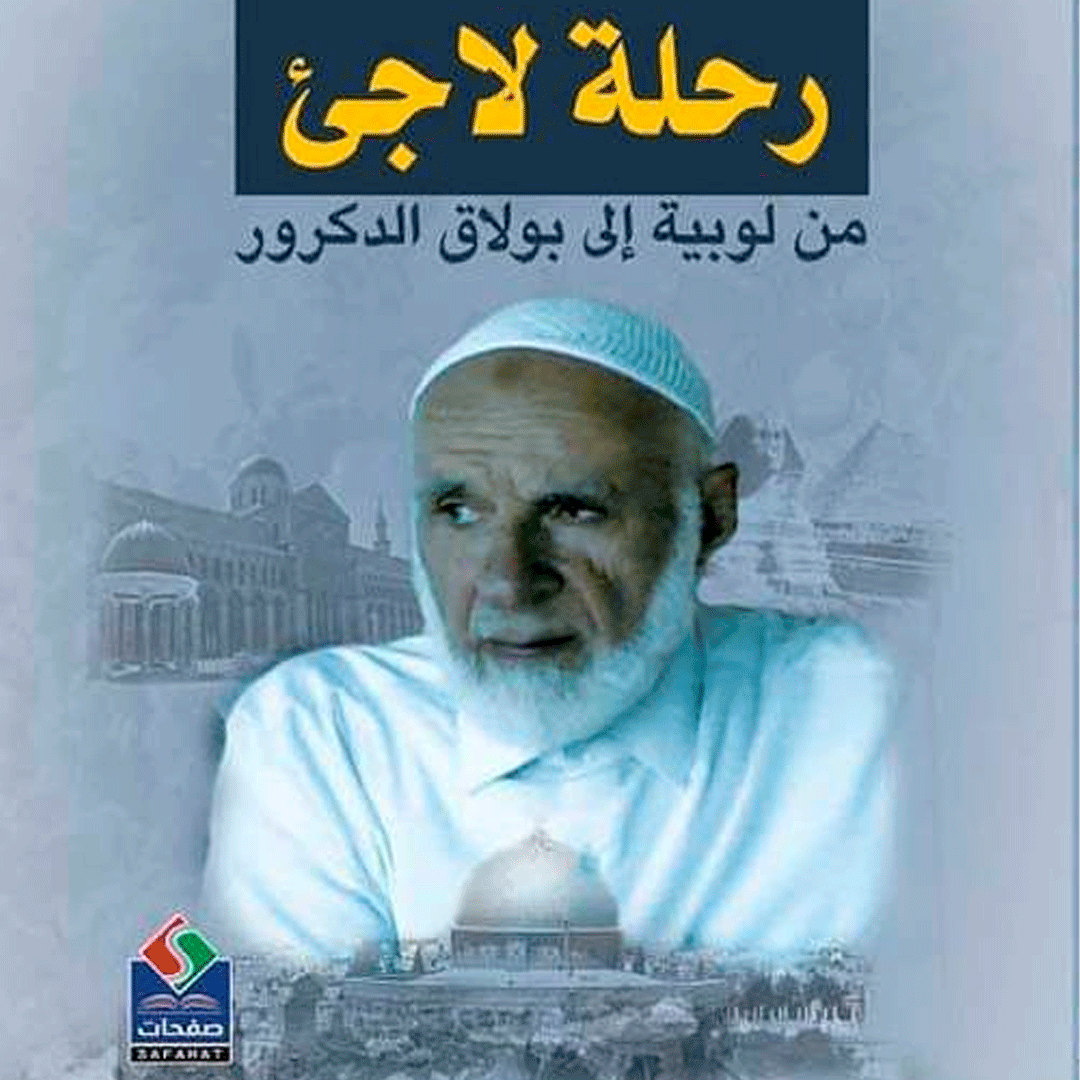 غلاف كتاب "رحلة لاجئ من لوبية إلى بولاق الدكرور"
غلاف كتاب "رحلة لاجئ من لوبية إلى بولاق الدكرور"
في 23 أيار/مايو عام 2013، وَدَّع الرجل المُسنّ دمشق المحترقة بنيران الحرب والصراعات، ليحط الرحال في القاهرة التي كانت هي الأخرى مشتعلةً بالأزمات السياسية، لكنه عاش وفق مبدأ "يا غريباً كنُ أديباً"، فلم ينخرط في أي نقاشات، بل قضى أيامه في هذا الحي الفقير، مستكملاً مسيرة غربته الطويلة التي لم تفارق روحه؛ استأجر شقةً صغيرةً في البناية التي تقيم فيها ابنته هدى مع زوجها المصري وأطفالهما، وكان يخرج لأداء فروض الصلاة في المسجد القريب، ويُمازح أطفال الحي، هؤلاء الذين اشتركوا في ثمن زجاجة من العصير، ليقدموها له هديةً، حين نُقل إلى المستشفى إثر سقوطه وهو ينزل الدرج، وكم كان تأثُّر الرجل كبيراً حين رأى عشرة أطفال وهم يتجمعون حوله ويقدمون له هديتهم البسيطة.
بدأت محنة المؤرخ والعلّامة الفلسطيني محمود إبراهيم الصمادي، إثر تهجيره في زمن النكبة، من قريته لوبية إلى مخيمات اللجوء في بيروت، ومنها إلى مخيم اليرموك في دمشق، حتى وصل في نهاية عمره إلى حي بولاق الدكرور في القاهرة
و"بمرور الأيام -كما جاء في الكتاب الذي يروي سيرته "رحلة لاجئ من لوبية إلى بولاق الدكرور"- أصبحت علاقتي مع الجيران وأهل حي شارع عبد القادر البغدادي في طوابق الديابة، على أحسن ما يرام، رجالاً ونساءً وشباباً وأطفالاً وطلاب علم منها ومن الأحياء المجاورة، وأطلقوا عليّ لقب الشيخ الشامي. كانوا يتفننون في إكرامي؛ يحملون الأغراض التي أشتريها ويوصلونها إلى البيت، ويقدّمون لي الكراسي كي أرتاح وأنا ذاهب إلى المسجد أو السوق، ويزورونني ويدعونني إلى مناسباتهم كلها. وأذكر أيضاً 'أم صلاح' وهي جارة قبطية لابنتي هدى، والتي عاتبتني وهي تجرّ قدميها وتبكي بسبب سقوطي على الدرج: 'يا بوي الرب موجود بكل مكان، سامعنا وشايفنا وبيقبل منا صلاتنا في كل مكان أنت راجل كبارة صلِّ في بيتك يا عم محمود'".
وهكذا شارك المؤرخ الفلسطيني أبناء هذا الحي الشعبي حياتهم البسيطة، فيما ظلت قصة شتاته، مطويةً في أعماق روحه لأكثر من سبعين عاماً، حتى قرر في صباح دافئ أن يروي حكايته لابنته هدى الصمادي، التي قامت بنشر أجزاء منها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث حققت انتشاراً ونالت تفاعلاً كبيراً، ما شجع الابنة على توثيق سيرة الأب في كتابٍ صدرت طبعته الأولى في عام 2019، عن دار "صفحات للدراسات والنشر والتوزيع". فمن هو محمود إبراهيم الصمادي؟ وكيف عايش النكبة وفجائعها؟
في الثالث من نيسان/أبريل عام 1928، وُلد محمود إبراهيم الصمادي في قرية لوبية التابعة لقضاء طبريا، لأسرة كبيرة وميسورة الحال، لها تاريخ متجذر في الأرض الفلسطينية؛ الأب المغرم بحفظ أبيات الشعر وإلقائها، يمتلك مساحات كبيرةً من الأراضي يزرعها بشتى المحاصيل، والأم تنتمي إلى عائلة عريقة تسكن في قرية مجاورة اسمها ترعان. أما الصبي الصغير فكان مغرماً بالتجول في أنحاء القرى الفلسطينية، يتسلل هارباً من مدرسته الابتدائية، تاركاً كتبه بين الأشجار، ليذهب إلى ترعان، قرية أمه، وما حولها من قرى.
هذه الرغبة المبكرة في اكتشاف الحياة وخوض غمارها، ظهرت تجلياتها الأولى حين كان في الثامنة من عمره، حيث شارك في الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936؛ ركض مع الثوار واختبأ معهم في الكروم والمغارات، ليعثر على رصاصة سقطت من أحد المجاهدين، فأخذها الغلام الصغير فرحاً بها، وراح يخفيها وسط مفارش لا تُستخدم إلا حينما يأتي الضيوف، لكن حظه العاثر، سيجعله سبباً في اعتقال أمه؛ ففي أثناء الثورة وما أعقبها من عمليات تفتيش أمني في القرى والبيوت من جانب الشرطة البريطانية، عثر أحد أفراد البوليس على الرصاصة، ولأن الأب كان على سفر، لبيع محاصيله، تم إلقاء القبض على الأم، لتظل في السجن لمدة ثلاثة أيام حتى جاء الأب وحل محلها في المعتقل لأشهر عدة.
يقول: "كنت شاباً قلقاً، ومتعطشاً لاكتشاف العالم. والعالم بالنسبة لي كان فلسطين. أنتهز أية فرصة للخروج والتجول في قرانا التي كانت وادعةً، قبل أن يغتصبها الغربان. وعندما أتذكر مرات هروبي، أقول لنفسي: حسناً فعلت. فهذا الجسد وهذه الروح، تسكن فيهما بلادي فلسطين، من أثر التجول في أنحائها".
وكأن الفتى الصغير، كان على علم بفجيعة النكبة واللجوء والشتات؛ إذ كان مسكوناً بالترحال والتجول في أرجاء فلسطين حتى حفظ قراها ومدنها عن ظهر قلب، وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره؛ كان يذهب مع أمه في أثناء زياراتها لشقيقها في بيت لحم، ثم ينتهز فرصة انشغالها عنه، ليتسلل إلى خارج البيت، ويتجول في الشوارع، ويزور الأماكن الشهيرة، ويصاحب المارة، ويقيم صداقات معهم، لأنه سيأتي بمفرده في المرة الثانية، دون علم الأسرة متحججاً بزيارة أخواله، ثم يلقي نفسه في الشوارع كعادته.
يقول: "كنت شاباً قلقاً، ومتعطشاً لاكتشاف العالم. والعالم بالنسبة لي كان فلسطين. أنتهز أية فرصة للخروج والتجول في قرانا التي كانت وادعةً، قبل أن يغتصبها الغربان. وعندما أتذكر مرات هروبي، أقول لنفسي: حسناً فعلت. فهذا الجسد وهذه الروح، تسكن فيهما بلادي فلسطين، من أثر التجول في أنحائها. فلسطين انطبعت على جلدي. وبرغم الألم الذي خلّفته النكبة، والعذاب الذي عشناه في الشتات، إلا أنني كنت أواسي نفسي: كيف كنت ستعيش في بلدك بعدما اغتُصبت وتحولت إلى مستعمرات صهيونية؟! عشتُ محتفظاً بصورة فلسطين التي عرفتها وعشقتها على أمل العودة كباقي أبناء شعبي".
منذ زمن بعيد، كانت القاهرة تحتل خيال الفتى ابن الاثني عشر عاماً؛ في هذه السن الصغيرة، قرر السفر إلى مصر رغبةً في تلقّي العلم في الأزهر الشريف. ادّخر ثلاثة جنيهات فلسطينية لمصاريف السفر، وتنقل من بلدة إلى أخرى، حتى وصل إلى حيفا ليلاً، وقضى ليلته في أحد الفنادق المتواضعة فيها، وفي الصباح ركب الباص المتجه إلى يافا ثم إلى غزة، ومنها إلى خان يونس ورفح.
وحين وصل إلى البوابة التي تفصل بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، تعرض للضرب من جانب رجال الأمن، ليفكر في خوض مغامرة محفوفة بالمخاطر، متجهاً إلى الطريق الجبلي، حيث وصل إلى صحراء النقب، ومنها إلى عوجة حفير قرب الحدود المصرية، وهناك طلب منه أحد المسؤولين عن عمليات التهريب أن يخلع حذاءه ليسير حافياً على الرمال الحارقة قرابة أربعة كيلومترات.
بعد هذا العذاب قرر العودة إلى قريته لوبية، وفي أثناء رجوعه، تعرف على مجموعة من البدو، وعمل معهم في الحفر للمدة شهر مقابل الأكل والشرب. هذه المغامرة الخطرة، لم تمنعه من التفكير في خوض مغامرة جديدة إبان الحرب العالمية الثانية، وكان آنذاك في الرابعة عشرة من عمره، حيث اجتاز نهر الأردن مشياً على الأقدام، وتجول في إربد، ووصل إلى عمان حتى نفدت أمواله وأكله الجوع، فقرر العودة مرةً أخرى إلى عائلته في لوبية، وكان هروبه هذه المرة لا يُغتفر، فاقترح على أهله أن يتطوع في الشرطة في حيفا (البوليس الفلسطيني الإضافي)، فوافقوا مرحّبين، وآملين في أن يحدّ ذلك من جنونه وتهوره.
قبل أن يُكمل محمود الصمادي العشرين من عمره، بدأت بوادر الفصل الدامي في حياته، حيث الحرب تطرق الأبواب، فقوات الهاغاناه الصهيونية بدأت باقتحام البيوت، ومهاجمتها لإخلائها من أصحابها. إنها النكبة، الحدث المفصلي في التاريخ الفلسطيني، الذي سيدفع بالآلاف من الفلسطينيين إلى الشتات واللجوء في أرجاء الأرض، في رحلة عذاب حُفرت تفاصيلها الأليمة في أعماق الذاكرة.
التحق الصمادي بقوات الجهاد المقدس في بداية حرب 1948، تاركاً طفلته سميحة بين ذراعَي أخيه، وكانت معركة "عرب صبيح" في منطقة الجليل، أولى المعارك التي شارك فيها، وبعدها معركة "طبريا" التي يتذكرها قائلاً: "بقيت طبريا تُقاوم حتى أن الإنكليز، عملوا هدنةً وأخرجوا أهاليها منها. قسم منهم اتجه غرباً إلى الناصرة، والقسم الآخر اتجه جنوباً نحو سمخ والأردن. وهكذا أُفرغت طبريا من العرب نتيجة تواطؤ الإنكليز مع اليهود، وكان سقوطها كارثةً كبيرةً فتحت الطريق ومهّدته للأعداء لأنها كانت حاجزاً بين المنطقة الشمالية والجنوبية".
 محمود إبراهيم الصمادي
محمود إبراهيم الصمادي
وتلا سقوط طبريا سقوط صفد في 12/5/1948، حيث انسحبت الحامية العربية فجأةً -كما يروي الصمادي- "وتركت أهل صفد يواجهون اليهود وحدهم ويا لهول ما رأيت: نساء صفد حافيات باكيات، يركضن في الشوارع وأطفالهن يصرخون جزعاً وخوفاً".
أما قريته "لوبية"، فقد استبسل أهلها في الدفاع عنها، حتى أن الإنكليز قاموا بالفصل بين الطرفين؛ العربي واليهودي. ولأن المخطط الصهيوني كان لا بد أن يُنفَّذ بحذافيره كما خططوا له منذ سنوات، فقد هاجم الصهاينة لوبية مرةً أخرى بقوات كبيرة ودبابات، واستمرت المعركة أكثر من عشرين ساعةً، استشهد خلالها أكثر من خمسة وعشرين شهيداً، وكان الشاب الصمادي مقاتلاً في هذه المعركة وأصيب بطلق ناري، خلّف جروحاً عميقةً في ساقيه، وحُمل ليتلقى العلاج، ليعود مرةً أخرى إلى المعركة. وكانت معركة لوبية أشهر معركة جرت في الجليل، وتم إجلاء أهلها في تموز كما أن الطيران اليهودي اشترك في قصفها مرات عدة.
استشهد "نمر"، خال الصمادي في معركة الشجرة، وكان ذلك في أثناء قتال الشاب العشريني على جبهات أخرى، أشهرها معركة معلول، وبعد أن ساد الخراب البلاد، وغطت نيران الحرب سماء فلسطين، عاد محمود الصمادي إلى قريته ليسأل عن أهله فقيلت له جملة ظلت محفورةً في ذاكرته، لم تمحها سنوات التشرد واللجوء: قريتك لم يبقَ منها أحد، كلهم هاجروا باتجاه لبنان، وهنا خاض الشاب رحلة عذاب أخرى حتى عثر على أهله في مخيمات بيروت. وبرغم الألم والمعاناة، إلا أن حدثاً مفرحاً كان في انتظاره، إذ وضعت زوجته طفلها سميح في المخيم، واستقبله أهله بهذه الفرحة: مبروك يا أبا سميح.
شارك المؤرخ الفلسطيني أبناء هذا الحي الشعبي حياتهم البسيطة، فيما ظلت قصة شتاته، مطويةً في أعماق روحه لأكثر من سبعين عاماً، حتى قرر في صباح دافئ أن يروي حكايته لابنته هدى الصمادي، التي قامت بنشر أجزاء منها
أمضت هذه العائلة مدةً قليلةً في مخيمات بعلبك، حتى شدّت الرحال إلى دمشق، وسكنت في أماكن عدة، وعمل محمود في مهن متواضعة كي يوفر لعائلته احتياجاتها، فاشتغل بائعاً في الأسواق ومنها سوق الهال، وعاملاً في البناء، إلى أن تم قبوله في وظيفة في وزارة التربية، بعدما سنّت الحكومة السورية قانوناً بموجبه يحقّ للّاجئين الفلسطينيين الإقامة والعمل في وظائف الدولة السورية، بعدها أصبح لعائلته منزل في مخيم اليرموك، وبدأ بتجميع مكتبته التي تضم ذخائر الكتب التاريخية والأدبية، وأشهرها كتب السيرة والتراجم، وانخرط في حلقات العلم مع المثقفين والكتاب، هو الذي قضى حياته العسيرة، نهماً في القراءة، والكتابة؛ ففي أحلك الظروف لم يترك الكتاب من يده، وكان متابعاً دؤوباً للحركة الثقافية في مصر والبلدان العربية، يدّخر المال لشراء المجلات الثقافية التي تصدر في القاهرة، وغيرها من العواصم والبلدان.
خصّه محمد بن محمد حسن شراب، بترجمة مطولة في سفره الكبير "معجم العشائر الفلسطينية" الصادر عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع في عمان، ونذكر هنا جزءاً بسيطاً من هذه الترجمة: "أبو سميح محمود إبراهيم الصمادي، الشيخ الحافظ الرحالة وعاء العلم، ومعجم تراجم الرجال. لو قيَّد ما يعرف وما رأى من الأماكن والبلدان والبقاع -في العالم العربي- وبخاصة بلاد الشام، لكان معجماً للبلدان يُقارب معجم ياقوت الحموي ويستدرك عليه". وللصمادي العديد من المؤلفات في التاريخ الإسلامي، وكذلك تاريخ فلسطين، نذكر منها: "أبطال النهضة العربية، عظماء وعظيمات، تحقيق كتاب: "نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان"، وسلسلة "عظماء الإسلام"، وغيرها من الكتب التي ما زالت مخطوطات لم تُنشر بعد.
كانت مصر المحطة الأخيرة في رحلة شتات الصمادي، وكذلك كانت الأرض التي احتوت جثمانه، حيث فارق الحياة في السادس من شباط/فبراير عام 2022، عن عمر ناهز 97 عاماً، إثر إصابته بداء الكورونا، ودُفن في شبين الكوم في محافظة المنوفية، ليستكين الجسد بعد رحلة شتات أليمة، يحوم شبحها الآن حول أبناء وطنه في قطاع غزة -الذي أُبيد ودُمّر على مرأى ومسمع من العالم الصامت- مهدداً إياهم بهذا المصير القاسي، أو كما ذكرنا في بداية المقال، بقدر "الشتات".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.