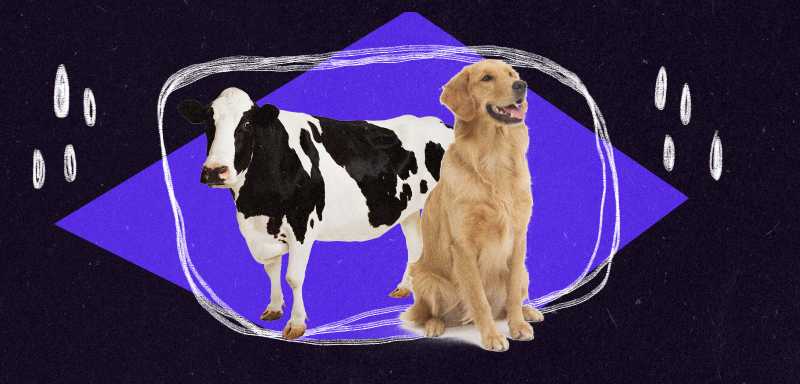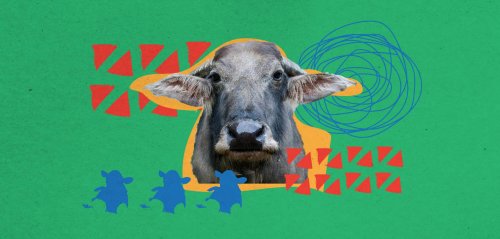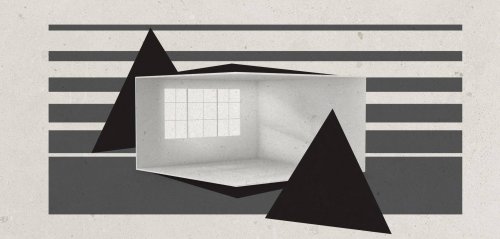كانت طفولتي سيئة، عندما أنظر إليها الآن. كنت أشعر أني مرفوضة دوماً من الجميع، شبح يمرّ مرور الكرام دون أن يراه أحد؛ رغم أن أفعالي كانت عكس ما كنت أشعر، لأني دوماً كنت أسمع الشكوى والتذمّر من طيشي. اتخذتُ غرفتي كياناً خاصاً بي وجمّعتُ بها بعضاً من الطعام والشراب كي لا أضطر لرؤية عائلتي كثيراً. تمرّدتُ على عائلتي ونفسي في الكثير من الأحيان، ولازمني الطيش والتصرفات غير المسؤولة في الكثير من أفعالي الطفولية التي كانت تُصنّفني كابنة (عاق). كبرت في بيئة تفرض على الإنسان فعل أشياء لا تناسبه أو ربما لا تعجبه، التربية الصارمة المصحوبة بإهانة الطفل وعدم احترام مشاعره، وفرض الأوامر والقوانين كانوا من شيم البيئة في المرتبة الأولى، والعائلة في المرتبة الأخيرة.
هذا الطيش، أو ربّما الاضطرابات الناتجة عن جهل التربية في ذاك الوقت، جعلت مني طفلةً منبوذةً في أغلب الأحيان، تذمّر العائلات مني وخوفهم على إفساد أطفالهم كي لا يُصابوا بعدوى الطيش والتصرفات الحمقاء، أودت بي إلى طفلةٍ متمردةٍ بشكلٍ لا وصف له، رسمت في مخيّلتي كياناً خاصّاً بي، عشتُ وعلّقت آمالي به، كوهمٍ يفصلني عن الواقع الذي عايشته في أغلب الأحيان.
أذكر يوماً حين كنت في العاشرة من عمري أني عقدت شعري ذيلين جانبيين، وعلقت على أذنيّ أقراط كبيرة تشبّهاً بالبقرة. في تلك الأيام كانت جبنة البقرة الضاحكة تكتسح الأسواق وشاشات التلفزيون وحتى لوحات الإعلان في الشوارع، فاتخذتها سبيلاً كوميدياً لإثارة ضحك والديّ. لحظة وصول أبي للمنزل، خرجت من غرفتي أركض وأفتعل حركات ظننت حينها أنها مضحكة. شاهدت أمي تبتسم رغم أن ابتساماتها كانت نادرة نوعاً ما، فبالغت بأفعالي وجنوني لأستمرّ في إضحاكها، وبقيت أصرخ قائلة: "أنا البقرة الضاحكة، أنا البقرة الضاحكة"، كأني أؤدي دوراً كوميدياً.
شاهدت أمي تبتسم رغم أن ابتساماتها كانت نادرة نوعاً ما، فبالغت بأفعالي وجنوني لأستمرّ في إضحاكها، وبقيت أصرخ قائلة: "أنا البقرة الضاحكة، أنا البقرة الضاحكة"، كأني أؤدي دوراً كوميدياً
شاركني والدي بعضاً من الرقصات الجنونية بعد قدومه من سهرته التي تخلّلت شرباً للكحول صحبة أصدقائه وهذا ما جعله في حالة "الزهزهة". بقيت على هذة الحالة لدقائق قليلة إلى أن أصبح الأمر سخيفاً، لم يعد شكلي مضحكاً ولا حركاتي ودودة كما كنت أظن، ابتسامة أمي المزيفة، أو ربّما ابتسامة الشفقة، سرعان ما انزاحت عن وجهها عند رؤيتها لأبي يُشاركني جنوني، دون أن تسأل نفسها عن سبب الجنون و ما وراءه!
عدت إلى غرفتي وجلست أبكي: ماذا عساي أن أفعل؟ أحاول جاهدة لفعل أي شيء يكسبني الشعور بمحبة والديّ لي، لكني أعجز مراراً و تكراراً، أيعقل أن يهون على أم تشاهد ابنتها بذاك المظهر من أجل ابتسامة فقط؟ أم من أب لا أراه إلا لساعاتٍ قليلة من اليوم، وفي أغلب الأحيان يكون "مزهزه"؟
تذوّقت طعم مرارة الذلّ لأول مرة في العقد الأول من عمري، الذلّ هنا ذلّ الطفولة لكنه رافقني إلى صباي. هو ليس ذلّاً بالمعنى الحرفي، إنما تعبير أو دليل على تعطّش الطفل للحب وحاجته للاهتمام؛ أراه في علاقاتي العاطفية الفاشلة وأراه أمراً عاديّاً و عابراً، المهم أن أكسب ابتسامة من أحبهم ولو كان على حساب كرامتي المدفونة آنذاك.
هذا التعطّش أخذ مني مراهقتي التي أمضيتها بجمع الحماقات، مرّة أحب جمع الدمى ومرّة أتخذ الدراجة الهوائية سبيلاً للمرح مع أبناء الحي، مرّة ألعب الشطرنج وأخرى أمارس الجودو والملاكمة، مرّة أصير مطربة وأدندن كلما أخبرني أحد أن صوتي جميل، وأخرى يخيم عليّ الصمت والبكاء والعزلة ولا شيء سواهم.
بعد عقدين من الطيش والحماقة، وصلت إلى إنسان متصالح مع نفسه مع القليل من الخدوش التي ستبقى تلازمني إلى وقتٍ لا أعلمه؛ أرى طفولتي تتكرّر أمامي دون استطاعتي تغيير شيء فيها، وكأنه كُتب عليّ أن أبقى في تلك السنوات ماكثة دون حراك.
تعاقدتُ مع مدرسة نموذجية، صُنّفت المدرسة بأنها الأولى من حيث التعليم والاهتمام، أغلب طلاب هذه المدرسة من عائلات مرموقة، أعلى طبقات المجتمع وأثراها و أكثرها ثقافة وعلماً، رأيتُ طفولتي تتكرّر عندما شاهدت أحد طلّابي بوضع حرج و مؤسف. عندما رنّ جرس انتهاء الفرصة ذهبتُ للصف كي أعدّ الطلاب و الطالبات و أهيئهم للقيام بدرس الرياضة المفضل عندهم، كان حيان يقلد الكلب بحركاته وصوته وحتى شكله، صنع من الأوراق عقداً ولفّه حول عنقه وعقد به رباطاً أزاله من حذائه.
وقفت عند باب الصف أتأمل حركاته وأفعاله، لو نظر أحد إلى عينيّ حينها لأدرك كمّ الدموع التي كنت سأذرفها لولا أني تمالكتُ نفسي وأطلقت صافرة بداية الحصة الدراسية، حتى جلس الجميع في مقاعدهم إلا هو. استمرّ على هذا الحال لمدة يومين، تزامناً مع سخرية زملائه منه، منهم من يرمي أوراقاً على الأرض ويناديه كي يحضر الأوراق بفمه تماماً كما يحضر الكلب العظام، ومنهم من يطلب منه أن يعوي كي يثير الضحك بين الجميع، وهو ينفذ الأوامر برحابة صدر كما لو كانوا يطلبون منه التربع على عرش الملوك.
لست غريبة عن حيان ذي الثماني سنوات، أحسست به تماماً وقدّرت مشاعره وتعاطفت معه تماماً كما يفترض أن يفعل الجميع. شقي، متمرّد، يثير الشغب كلّما أتيحت له الفرصة، ضحوك عند فرض العقوبات عليه ورياضيّ مبهر، لكنه مثال حيّ عن العقد النفسية التي أصادفها كثيراً بين الأطفال بحكم عملي واحتكاكي معهم لساعات طويلة، المؤسف هو عمرهم الذي لم يتجاوز العقد.
من يجبركم؟ لمَ تنجبون الأطفال إن كنتم غير قادرين على تحمل مسؤولية رعايتهم؟ ما دوركم في كل هذا؟
أسأل نفسي: من يجبركم؟ لمَ تنجبون الأطفال إن كنتم غير قادرين على تحمل مسؤولية رعايتهم؟ ما دوركم في كل هذا؟
الطفولة السيئة نفاخة من العقد النفسية، تتمدّد وتكبر وتنتفخ حدّ الهلاك، تلازم حياة الإنسان كما يلازمه اسمه في كل زمان ومكان. لا يكاد يخلو إنسان من عقد، لكن ذكريات الطفولة لا تُنسى، خصوصاً إذا كانت مليئة بالاضطرابات غير المفهومة.
بعد مضي يومين على رؤيتي لحيان بذاك المظهر، قصدتُ قسم الإرشاد النفسي لأشرح لهم ما يدور بذهني تجاهه، أو ربما لأجد من يشاركني حزني عليه أو لأزيح عني مشاعر القلق قليلاً. عند طرح اسمه قاطعتني المرشدة النفسية بأنه لا يوجد أمل من حالته المستعصية، وأن جميع المدرسين والمدرسات يشتكون من تصرفاته وأفعاله، وأخبرتني بأنها حاولت الاتصال بوالديه ودعوتهم لحضور جلسة نقاش لفهم حيان أكثر، أو لتشرح لهم ما يحصل معه في المدرسة، لكن الأهل كانوا يجيبون بالرفض دوماً بحجّة انشغالهم بالأعمال، إلا مرة واحدة، حضروا اجتماعاً لم يتجاوز عشر دقائق، وكان اجتماعاً عديم الفائدة وهدراً للوقت ليس إلا، لأن الأهل كانوا متيقنين بأنهم الأفضل مع طفلهم: "كيف يا أستاذة نحنا مقصرين معو؟ حاطينو بأحسن مدرسة و بيلبس اتقل لبس و بياكل أطيب الأكلات وشو ما بدو منجبلو، هلق اذا قلد الكلب مشان يضحّك رفقاتو صار بدها تعملولي فيها اجتماع".
تضيف المرشدة النفسية بأن أفضل حل للتعامل معه هو تجاهل أفعاله كلها وكأنه لا يفعل شيئاً كي لا يعاود تكرارها، وأن الأمل مفقود في حالته، لأن الأهل لا يتعاونون في إيجاد حل لإعادة حيان على ما كان عليه سابقاً، هذا لا يعني بألا نتعاطف معه، لكن إن أردنا أن نحدّ من أفعاله فالتجاهل أنجع.
عدتُ إلى القاعة مكسورة الخاطر، أفكر بالتربية، ولو كانت تقتصر على توفير الاحتياجات المادية فحسب، لكانت من أسهل الأدوار التي يقوم بها الإنسان. لا أدري لم يأخذ هذا الطفل حيّزا كبيراً من تفكيري، ربّما لأنني رأيتُ طفولتي في عينيه، أو ربّما لأني أدرك حجم المأساة التي سيواجهها بعد سنين قادمة.
وصلتُ القاعة و حيان كما هو. أطلقت صافرة بدء الحصة وهمّ الجميع بالتصفيق بحرارة شوقاً للرياضة المحببة إلا حيان، كان جاثياً على ركبتيه ويديه ولسانه للأمام يلهث تعبيراً عن الفرح، وكلما تكلمت معه وطلبت منه التوقف عن هذا الفعل، بدأ بمسح رأسه على قدمي تودّداً.
مسحتُ دموعي بطرف يدي كي لا يلاحظ تلاميذي بكائي، وجلست على قدميّ ووضعتُ يدي على رأسه، وقلت له بأنه سيقود التلاميذ للملعب لأنه بنظري أمهر رياضي بين زملائه، عاودت مسح رأسه بيدي لكن هذه المرة كانت المسحة أشد و بها حماس أكبر، حملته بين ذراعي وبحسّ فكاهي قلتُ له: "ما أثقلك! هذا الوزن وزن حيان وليس وزن كلب، الكلب خفيف الوزن أما حيان فثقيل وقوي وله عضلات كبيرة". وأخيراً ضحك وأضحك قلبي معه، أنزلته للأرض وطلبت من جميع التلاميذ أن يقفوا رتلاً وراء حيان كي يقودهم للملعب، لكنه سرعان ما جثا على الأرض، ومشى مشية الكلب دون أن يكترث لمن حوله أو حتى لي.
استسلمت، وشعرتُ بالعجز أمامه وانفطر قلبي حزناً عليه.
طلبت من جميع التلاميذ أن يقفوا رتلاً وراء حيان كي يقودهم للملعب، لكنه سرعان ما جثا على الأرض، ومشى مشية الكلب دون أن يكترث لمن حوله أو حتى لي
سيكبر حيان حتماً، وسيتمرّد أكثر ويغوص في العقد النفسية، أو سيدرك ذاته تماماً كما أدركت ذاتي، لكنه أمر نادر وخصوصاً في هذا الزمن الذي يجعلنا معقدين دون أسباب. شعرتُ بالاشمئزاز نحو ما كنت أعتقد أني عانيت منه في طفولتي التي تصنف بـ"المثالية" أمام طفولة حيان. شعرتُ بقيمةٍ جديدةٍ تسلّلت نحو قلبي دون إنذار تجاه والدي، مقارنة بأهل حيان. الاحتمالات كثيرة والنتائج كبيرة، لكن الأكيد أنه سيظل يرمي باللوم على والديه، بينه وبين نفسه، لحرمانه من العاطفة والإصغاء والاستخفاف به وبقدراته.
تعود بي ذاكرتي إلى الأقراط الكبيرة و الشعر المعقود بذيلين، رأيت جزءاً من طفولتي في عيون حيان، رأيت عطشه للحب والاهتمام، وأدركت أن الطفولة تعيد نفسها طالما أن البيئة التي نعيش فيها هي ذاتها لا تتغير.
يعزّ عليّ حيان وتعزّ علي طفولتي التي لطالما تمنيت أن تكون بريئة ومثالية. لا بد أن حيان سيخوض معارك الحياة بقسوة شديدة، وأرى مستقبله تماماً كما أرى شقاوته بأم عيني. اعتراني شعور الشفقة والخوف. أصبحتُ أُشفق عليه حتى وإن عاد لوضعه الطبيعي بعد زمن، لأني لن أستطيع تخيّله مرة ثانية إلا بذاك المظهر المؤسف، أما عن شعور الخوف الذي تخللّ أفكاري: كم حيان يعيش بيننا؟ و كم من إنسانٍ عانى من طفولة قاسية أو مضطربة، تحدّث عنها أو لم يتحدّث، ظهرت في أفعاله أو باختياراته الفاشلة أو ربّما بعلاقاته المضطربة؟
عدت إلى منزلي و طفلي، طبعت قبلات كثيرة على وجنتيه وغمرته بحب وشوق وخوف من مسؤوليتي تجاهه، نظرتُ في عينيه ورأيت الطفولة الحقيقية التي يجب أن تكون، تناولنا طعامنا معاً وحدّثته بأني صادفتُ طفلاً جميلاً ووسيماً ومهذّباً اسمه حيان.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.