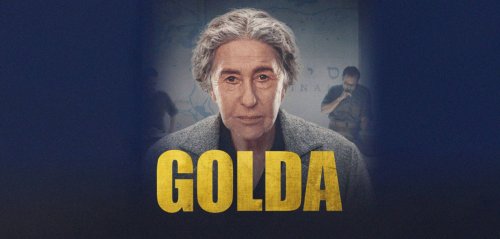باستثناء قُرص الشمس الضخم، لم يبدُ أن أحداً على وشك الغرق في ذلك اليوم، ولم يُظهِر البحر أية علامات خطرة.
على الرغم من ذلك، لم يتوقف حارس الشاطئ عن مطاردتنا بصفَّارات عصبية متلاحقة، أشاعت جوًّا من التوتر، فشعر كل واحد منَّا أنه المقصود بصفارة الحارس، فصرنا مشغولين عن نعيم السباحة؛ اللذة المُتقشِّفة والسماوية التي يوفرها البحر، بالتعديل الدائم لأماكننا، حتى لو لم نكن قد أخطأنا في شيء أو تخطينا الحد المسموح به.
لعلها مبالغات الذاكرة، ووحدي من كنت أشعر بطاقة التوتر والذنب مع كل صفارة.
كطفل في الحادية عشرة، كنت أنظر إلى حارس الشاطئ كشخص مُهاب الجانب؛ إذ يكفي أن يَرسم خطًّا وهميًّا عبر سلطة عينيه الخبيرتين ليصير لها وقع السياج، لكني كنت أعرف أن سلطته أيضاً تستند في نفوذها إلى شيء أكبر منه: البحر نفسه.
عهد الأمان مع البحر
أول ما نتعلمه جميعاً عن البحر عهدُ الأمان غير المكتوب بيننا وبينه، والذي يُشرِف حارس الشاطئ على تنفيذ بنوده؛ أن السبيل الوحيد للنجاة داخله هو احترامه، ينطبق ذلك العهد على الجميع؛ الأطفال وعتاة السباحين والبحارة والقراصنة والباحثين عن جزيرة الكنز.
كنت قد تعلمت السباحة في هذا الصيف، لكن بسبب الراية السوداء، التي لم تتبدل لأسابيع على شاطئ شهر العسل في العجمي، لم أتمكن من اختبار ما تعلمته، كنت أذهب كل يوم على أمل أن تتبدل الراية إلى منديل أمان أبيض، ربما كانت الراية في ذلك اليوم حمراء، وهو الأقرب إلى المنطق، لكنها لا تطل في ذاكرتي إلا بذلك اللون المقبض.
لم يتوقف حارس الشاطئ عن مطاردتنا بصفَّارات عصبية متلاحقة، أشاعت جوًّا من التوتر، فشعر كل واحد منَّا أنه المقصود بصفارة الحارس، فصرنا مشغولين عن نعيم السباحة؛ اللذة المُتقشِّفة والسماوية التي يوفرها البحر، بالتعديل الدائم لأماكننا
كانت إجازة الصيف -المحدودة مهما طالت- تنهزم أمام تلك الراية المرتبطة في ذهني بأحكام الإعدام، كما علمتني الأفلام التي كان أبي يستأجرها كل خميس؛ إذ ترفع السجون راية مماثلة عند تنفيذ حكم الشنق.
ما كان يقبض قلبي حينها في فكرة الإعدام ليس القتل في حد ذاته، بل تهاوي كل حجج الندم أمام الراية السوداء؛ التوبة، التوسلات والعهود بعدم تكرار الخطأ، حتى البراءة نفسها -في حال كان المتهم مظلوماً- تصبح دون طائل.
أي فكرة مريعة وأي قيمة تساويها الحياة؛ إذ كان يمكن لها أن تنتهي أمام خطأ يتعذر إصلاحه؟ وعند أي نقطة تتعقد فيها مسارات شخص إلى الدرجة التي تنعدم معها فرص التصحيح، إلى الحد الذي يجعل الجميع متفقين على شيء واحد: إعدامه؟
كطفل، ربما لم أتمكن من صياغة فكرة بهذا التعقيد، لكن شعوري الغامض برعبها كان ماثلاً أمامي، مُروِّعاً ولا أنساه. كنت قد تجاوزت المبادئ الأولية للطفو بجسدي، فصار بإمكاني أن أسبح لمسافة طويلة، دون أن أعتمد على عوَّامة، ودون أن تلامس قدمي الأرض. كنت أعرف أن بإمكاني أن أقف لفترة أطول في مياه عمقها يفوق قامتي القصيرة، فأقتنص عبر مهارتي الجديدة أمتاراً إضافية من البحر، لكني ما إن أشعر بذلك الفراغ يمتد أسفل مني حتى يتملكني الذعر، فلا أتحمل البقاء إلا لثوانٍ معدودات مشحونة باللذة والفزع، وأهرع عائداً إلى منطقة آمنة، تملك فيها قدمي أرضاً صلبة.
كيف يرانا حارس الشاطئ؟
في ذلك اليوم، كانت الغواية، التي شعرت بها لمغالبة الخوف، لا تُقاوَم، يشهد الله والبحر ومُنفِّذي الأحكام أني صارعتها بقوة، قبل أن أنهار أمام غوايتها، كخطأ يتعذر إصلاحه. لذا، في تلك اللحظة، لم أعد أرى حارس الشاطئ كملكٍ مُهاب، بل مجرد مجنون مزعج ينفخ من فمه سهاماً مسمومة، يُصوِّبها من فوق منبره الخشبي المرتفع، فيُغرِقنا في التعاسة والخوف. أما رايته السوداء، بعد بقائها على حالها لأسابيع، فلم تعد تعكس تقلبات البحر، بل قلب رجلٍ كسول، لا تتبدل غايته بتبدل الأهواء والظروف، كل ما يعنيه هو أن ينتهي يومه، لا يومنا، على نحو آمن.
كنت قد تعلمت السباحة في ذلك الصيف، لكن بسبب الراية السوداء، التي لم تتبدل لأسابيع على شاطئ شهر العسل في العجمي، لم أتمكن من اختبار ما تعلمته.
بعد أن تخطيت الأربعين، صرت أحترم هذا الرجل، وأشفق عليه أكثر، وصرت أفهم معنى أن يعيش المرء بقلب وقر فيه جرس إنذار ضخم، لا بد أن ذلك -كما يمنحه سرعة الاستعداد لتجنُّب المخاطر- يترك أيضاً ندبة في القلب تُشوِّه كل ما يتمثل لعينيه، فلم يعد ير السابحين في هناءة أجساداً تبحث عن السعادة، بل لحم غرقى مُحتمَلين وولائم للبحر.
ارتجلت خطة، بنيتها على مراقبتي لشلة من أربعة شباب أو خمسة صغار السن اخترقوا سياج الحارس غير المرئي، تبعتهم مفتونًا بثقتهم ومرحهم واستخفافهم بالمخاطر وبصفَّارة الحارس وإنذاراته المتكررة، قررت أن أكون على مقربة منهم، خلفهم بأمتار قليلة، ما زالت مزعجة لحارس الشاطئ، وبعيدة عن منطقة سباحتي الآمنة؛ سيكون قربهم مني كافياً لإنقاذي إذا ما خذلتني مهارتي المُستجدة في السباحة.
نجحت خطتي في إزالة الخوف، وتمكنت من الصمود لفترات أطول دون أرض. كأن كوة جديدة في جدار العالم قد انفتحت لعيني، مستشعراً لذة الحرية في السباحة دون خوف، وعندما كنت أروح وآجي بين منطقتي الآمنة ومنطقة اللاأرض، كنت أفعلها كي أختبر تلك اللذة من جديد، لحظة فك القيد وإغلاقه، بإرادتي الحرة تلك المرة، وقد طاشت صفَّارات الحارس عن أذني، فاختفى الذنب والتعاسة والخوف. كنت كمن حرر البحر.
"دَوْر" الأخ الأكبر
انتبهت أمي لما أفعله فأرسلت إليَّ شقيقي الأصغر، لينقل إليَّ تحذيراتها، وتطالبني بالخروج إن لم أمتثل للسباحة بالقرب منها. أخبرته بثقة أن لا داعي للقلق، وربما -بشرٍّ غير مقصود- كنت أثير غيظه بما اكتشفته: لقد عبرت لتوي إلى عالم الكبار. ونصحته أن يعود بمفرده إلى منطقة الصغار الآمنة. لكن -من طرف خفي- كنت أتمنى لو أظهَر إعجاباً بما أفعله، لكنه أشاح بوجهه بتعبير من يشعر بالأسف لحماقتي، ثم عاد بمفرده، وكذلك فعل شقيقي الأوسط، مع ابتسامة سخرية، عندما أرسلته أمي في تحذير جديد.
كأخ أكبر، ورغم كل أخطائي، كان الخيال أفضل ما بإمكاني منحه لطفولتهما المَصونة بعناية داخل الجدران. اخترعت من أجلهما الألعاب والعوالم، مبتدعاً إياها من اللاشيء، ومن كل شيء؛ لأجعل من كل لعبة مغامرة كُبرى، أجعل كل ما حولهما في حركة. أوقظ الجمادات من سُبات عميق: الكنبة تصير قطاراً أو سفينة، نقوش السجادة هي خريطة لكنز مفقود، خزانات المطبخ كهوف، الدواليب آلات زمن، السرير جزيرة، الشماعات تصبح سيوفاً، الوسادات دروعاً، وبلمسة أجعل المسدسات البلاستكية الرخيصة تطلق نيراناً حقيقية، أبطال الأفلام والقصص يتحولون إلى أشخاص مرئيين وبإشارة سحرية أحولهم مع أبناء عمومتي وأخوالي إلى قراصنة ومجرمين وضباط ومحاربين جسورين وعشاق.
انتبهت أمي لما أفعله فأرسلت إليَّ شقيقي الأصغر، لينقل إليَّ تحذيراتها، أخبرته بثقة أن لا داعي للقلق، وربما -بشرٍّ غير مقصود- كنت أثير غيظه بما اكتشفته: لقد عبرت لتوي إلى عالم الكبار. ونصحته أن يعود بمفرده إلى منطقة الصغار الآمنة
تحت قيادتي، امتطينا التنانين، وروَّضنا وحوشاً، وطردنا عفاريت، وأنقذنا الكوكب من الغزاة. حتى الألعاب البسيطة كالبِلي أو لعب الكرة أو الكوتشينة، كنت أبتدع حولها أجواء منافسة أسطورية تثير الحماسة، وتنهدم لأجلها جدران الشقة، لتصير باتساع العالم، لأصنع داخلها حارات وشوارع ومدناً. هكذا اخترعت ماراثون الصالة وأولمبياد الصالون وحروب الألف عام. وبفضلي حصدوا مئات الميداليات الذهبية، وصعدوا إلى منصات الشرف.
لكني فقدت سحري عليهما، ولم أعد بطلهما الخارق، بعد أن اكتشفا أن قوتي كأخ أكبر لم تكن مطلقة، وأن بإمكانهما، كلما كبُرا في العمر، أن يهزماني في الشجارات، وأني غير قادر على استحضار العفاريت كما ادّعيت.
رغم تعبيرات وجهيهما المحبطة/ المتحدية، تمسَّكت بالأمل: باختراقي للحدود الآمنة للسباحة، قد يستعيد حضوري في مخيلتهما شيئاً من السحر.
هكذا كنت في تلك البقعة من البحر؛ البرزخ القصير والمُحرَّم بين عالمين، سعيدًا وتائهًا، منتشيًا ومرتبكًا، أرغب في استعادة مكانتي كأخ أكبر، متمثلًا في شباب لا أعرفهم طيفَ أخٍ أكبر يسبقني إلى استطلاع الطرق والمتاهات، فلأنك تختبر لسعة النار في إصبع الأخ الأكبر لن تحترق، لأنك ترى كيف سقط في الحماقة ستكون أكثر حكمة، لأنه سبقك إلى خوض غِمار الماء فلن تغرق.
الغرق كما لو كان فناً
للبحر نذير وغواية، النذير هو الموج، إذْ يعيدك إلى الشاطئ ليذكرك بالعهد، أما الغواية فهي تيارات باطنية تسحبك دون أن تدري إلى جوفه، كأن تلك التيارات قد نوَّمتني، أو كأني تعثرت في نشوتي وتيهي، وجدت نفسي بعيداً عن الشباب الذين ارتكزَت خطة نجاتي عليهم، كنت أراهم، لكنهم لم يروني، أو لعلهم فعلوا وواصلوا لَهْوَهم، ولم يلاحظوا أني على وشك الغرق، صرخت عليهم فلم يسمعني أحد، لعل صوتي كان ضعيفاً، أو لعلي لم أصرخ، لا أتذكر بدقة، لكني أتذكر شعور الخذلان.
أخبرت نفسي أني قادر على السباحة إلى منطقة أماني، وأن تلك هي اللحظة المناسبة لاختبار مهارتي، ففردت جسدي لأسبح في اتجاه العودة، وبدأت في تحريك ذراعَيَّ وساقيَّ، كما تعلمت، لكن المسافة بدت بعيدة جدًّا. ثم فهمت، عندما اختفى السابحون من حولي، ووجدت نفسي بمفردي، أن البحر قد أمسك بتلابيب جسدي، وأنه يسحبني إلى الخلف، وأنه الأقوى.
تملَّكني الذعر، وصرت أضرب الماء بذراعَيَّ في حركات متشنجة، ثم توقفت، لم تخذلني ذراعي، ولم تعوزني المهارة، بل استولى عليَّ شعور بالندم. بدت لي صفَّارات الحارس وتحذيرات أمي حقيقية جدًّا، وأن ذلك العقاب مُستحَق، لقد تجاهلتهم بإصرار.
ثم طفا ذلك المشهد في عقلي، مشهد لغريقة رأيتها في أحد الأفلام، لا أتذكر من الفيلم سوى ما يرتبط بها، عن رجل يتأثر بوفاة زوجته غريقةً في البحر، لكنه يكتشف مع توالي الأحداث أنها كانت خائنة لَعوباً، فبدا مشهد غرقها مستحقًّا تمامًا، كانت المرأة اللعوب هي نبيلة عبيد.
بعد عدة محاولات لتقليد صورة غريق، حلَّ يأس تام، يأس مريح، وقد أدركت أن أحداً لم يظهر لينقذ نبيلة عبيد في الفيلم حتى بعدما ألقت بورقتها الأخيرة بالغوص والارتداد
الآن، عندما أتذكر أن مشهداً في فيلم هو كل ما استولى على تفكيري في تلك اللحظة المصيرية، أضحك بشدة من سذاجتي، لكن حينها لم يأتني المشهد بشكل مضحك ولا بشكل مأساوي، بل امتص ذُعري تماماً، وجعلني أركز على مهارة جديدة، لم أجربها من قبل، وهي كل ما تبقى لي من أمل: مهارة الغرق. فبدأت أفعل ما كانت تفعله نبيلة عبيد وهي على وشك الغرق: كانت تغوص بكامل جسدها، ثم يردها البحر إلى أعلى.
كررت حركاتها، لا رغبة في الغرق، بل في أن أُنقَذ. تلك هي العلامة التي ستخبر الآخرين أن هناك غريقاً؛ فكل محاولاتي السابقة للسباحة بشكل صحيح ربما تُفسَّر بأني أعوم بشكل عادي، ولست في مأزق. كان غرقي هو صرخة استغاثتي، لكن بعد عدة محاولات لتقليد صورة غريق، حلَّ يأس تام، يأس مريح، وقد أدركت أن أحداً لم يظهر لينقذ نبيلة عبيد في الفيلم حتى بعدما ألقت بورقتها الأخيرة بالغوص والارتداد، فأغمضت عينيَّ وقد اختفى الأمل والرعب. تبددت المخاوف كلها ما إن امتثلتُ لأمر اليأس ولأحكام راية البحر السوداء، أصبحت أمام خطأ أخير يتعذر إصلاحه، فغُصت دون نية للصعود. في تلك اللحظة، انتشلتني يد من أسفل لتصعد بي إلى السطح، يد قادمة من العدم، بمعجزة صاعدة من قاع اليأس، كأنها يد البحر نفسه.
لن أكره نبيلة
على الشاطئ، حظيت بكل شيء: التعاطف والإدانة، الحب واللوم، وكل ما يصاحب انتباه الجماهير. ومع أني لم أستعد مكانتي كبطل خارق في أعين إخوتي، فإني امتلكت تذكاراً من البحر، نُقِش في روحي كوشم عهد صداقة من نوع جديد.
لم تتعقد علاقتي مع البحر، وفي ما بعد سبحت فيه لمسافات أطول وأعقد، لقد غفرت له لأنه في اللحظة التي أمسك فيها بتلابيب روحي قد غفر لي، رأينا بعضنا بعض بنفاذٍ وعمق، ربما لا سبيل إليهما إلا عبر طريقته الصعبة الفظة، التي نكَّس فيها رايته السوداء وأحكامه النهائية بالموت، ليرفع منديل أمان أبيض في قلب تُغرِقه صفَّارات الحراس وشعور مقيم بالذنب لا يدري منبعه.
وكذلك لن أكره نبيلة عبيد التي ضللتني في لحظة فاصلة، وسترتبط في ذاكرتي بالشيئين معاً: الجمال والموت. ستكون معشوقة أحلامي التي سأُفتَن بها سرًّا في سنوات مراهقتي وشبابي، وإلى الآن، لا يسعني حين أتذكرها سوى أن أبتسم؛ فذات مرة كدت أن أغرق بصحبتها.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.