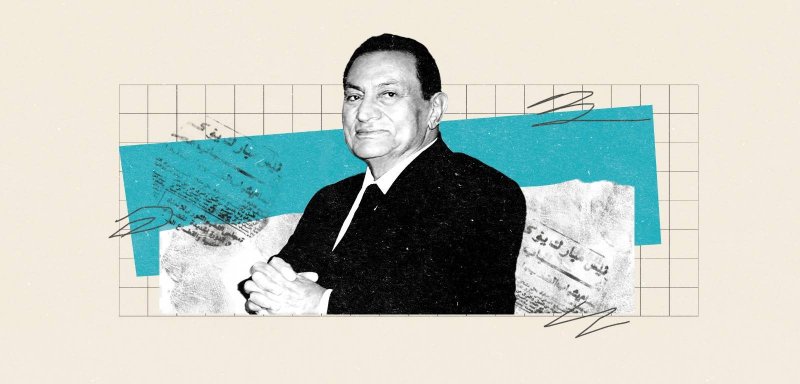كان مبارك يحب في حواراته مع الصحفيين الإسرائيليين، توجيه نقد لاذع بطريقة ساخرة للحكومة الإسرائيلية، لم يخلُ من تحميلها، بنبرة دبلوماسية حادة، مسؤولية فشل محادثات السلام مع الفلسطينيين. في حينها اعتُبِر الاكتفاء بهذه التصريحات عجزاً عن فعل المزيد، ولكنَّ غيابها اليوم يطرح الكثير من التساؤلات بشأن الكيفية التي ينظر بها النظام المصري اليوم إلى فلسطين وصراعها، وما الذي تغيّر من التسعينيات إلى اليوم.
لا يمكن وصف مبارك بأنه عدو لإسرائيل، بل على العكس تماماً؛ نجح الرجل خلال سنوات حكمه الأولى في حماية اتفاقية السلام التي تسبّبت في قتل سلفه، وعزّز التعاون الاقتصادي مع تل أبيب في مجالات عدة، أبرزها الطاقة والزراعة، ونجح في إقناع بقية الدول العربية بالتحول نحو خيار السلام بحلول التسعينيات.
كان واضحاً أنَّ السلام مع إسرائيل هو حجر الزاوية للسياسة الخارجية المصرية، باعتباره سيُنهي سنوات التوتر العسكري الدائم لحماية سيناء، وسيضمن عدم تكرار مشاهد 1967 القاسية. لذا ظلَّت الأولوية هي الحفاظ على المعاهدة بترتيباتها، ومن ضمنها الرعاية الأمريكية على شكل دعم سياسي ومعونات.
يمكن فهم التصور الرسمي المصري بشأن قضية فلسطين، والذي تحتلّ فيه الرغبة الأمنية في حماية سيناء من تدفق الفلسطينيين موقعاً مركزياً. وبينما يروّج "الأمني" لحلٍّ يضمن للفلسطينيين نصف دولة على الأرض، يدرك "السياسي" أنَّ هذا الحل مستحيل
ولكن في الوقت نفسه، كان مبارك يدرك أمرين؛ الأول أنَّ لديه ما يقدمه لإسرائيل والولايات المتحدة في مقابل تحييده عن الصراع، خاصة مع انطلاق دوامة السلام التي ابتلعت الجميع في مطلع التسعينيات، والثاني هو أنه لم ينسَ أبداً أنه شارك في الحرب الأخيرة مع إسرائيل وخرج منتصراً، بل إنه شخصياً من تسبب في تدمير مطارات إسرائيل وتعطيل قدرتها على صدّ الهجوم الأول، وحرص على تذكير الجميع بذلك طوال ثلاثين سنة.
طالما نظر مبارك إلى نفسه باعتباره أول زعيم عربي ينجح في تحرير بلده من كلِّ الأرض التي احتلتها إسرائيل، وأنه بفضل التزامات السلام التي تكبّله اكتسب اعترافاً دولياً بأهمية الدور الإقليمي الذي يلعبه في رعاية السلام، فكانت محطات الهجوم الساخر بانضباط على الحكومة الإسرائيلية، مثل حيلة دفاعية للتغطية على عجزه عن مواجهة عربدتها الإقليمية في فلسطين المحتلة ولبنان.
الربيع العربي والخريف اليميني
بدأ التحول الأول نحو تواري السردية السياسية المصرية تجاه فلسطين، وبداية "أمننة" الخطاب، مع سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في 2007، ودخول اللواء عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات العامة آنذاك، على خط جولات المصالحة الفلسطينية باعتبارها شأناً حدودياً مصرياً. تزامن ذلك مع تراجع كفاءة وزارة الخارجية في التعاطي مع هذا الملف، منذ إبعاد عمرو موسى إلى جامعة الدول العربية عام 2001.
في تلك الفترة، كانت آمال السلام تتبخّر بعد فشل جولات المحادثات، واحدة تلو الأخرى، ثم الانقسام الفلسطيني وتفكك السلطة، لتبدأ إسرائيل بالفعل خطتها للفصل الأحادي، في إعلان جديد عن موت اتفاقيات أوسلو. في هذا السياق ستتراجع أهمية "ميسِّر عملية السلام"، خاصة وأنّها لم تعد أولوية لدى الإدارة الأمريكية، التي صرفت اهتمامها في ذلك الوقت نحو تعزيز الديمقراطية لمكافحة الإرهاب، وهو ما وضع مبارك في مواجهة ضغوط أمريكية لم يعهد مثلها طوال فترة حكمه بسبب سجل مصر الحقوقي، وذلك في الوقت الذي كان يأمل فيه أن يمرّر الرئاسة لابنه.
انهارت عملية السلام وأطاحت ثورة 25 يناير بمبارك، وشهدت مصر سيولة سياسية تسبّبت في توتر العلاقات مع إسرائيل، انتهت بصعود دامٍ لقائد الجيش إلى سدة الحكم، في خطوة أثارت قلق الكثيرين حول العالم، باعتبارها انقلاباً قد يودي بديمقراطية وليدة.
وبينما أتى مبارك إلى السلطة بشرعية الانتصار العسكري على إسرائيل ثم تحرير أرضه منها، واستخدم هذه الأدوات في إدارة سلامه معها، فإن السيسي وجد نفسه في مستهل حكمه بحاجة إلى الدعم الدبلوماسي الذي تقدمه إسرائيل في الدوائر الغربية، "من أجل دعم الوضع السياسي الجديد في مصر، حتى لا يصنّف في خانة الانقلابات العسكرية"، وفق ما جاء في مقال نشره عام 2016، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي أسّسته لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية (إيباك).
وبينما بدأ القادة الأمنيون يحظون بالمزيد من الصلاحيات في الملف الفلسطيني، كان الدبلوماسيون المصريون يقضون الكثير من وقتهم في الرد على الانتقادات المتصاعدة لتردّي سجل مصر في حقوق الإنسان، ومحاولة تخفيف أثرها الضار على علاقات مصر بالعالم.
خلق ذلك حالة من التوتر السياسي مع الكثير من الدول التي طالما اعتبرت مصر "حليفاً استراتيجياً". ساءت علاقات مصر مع إيطاليا ومن ثمَّ دول الاتحاد الأوروبي، ومع إدارتي أوباما وبايدن، وشيئاً فشيئاً، لم تعد مصر تلعب أيَّ أدوار إقليمية، إلا عند التنسيق الأمني بشأن يتعلق بقطاع غزة. وقد نجحت مصر بالفعل في إثبات كفاءتها في لعب هذا الدور، خلال جولات الصراع السابقة في غزة.
لا يعتبر هذا النظام نفسه ممثلاً للمصريين ولا مُعبّراً عن طموحاتهم، بل كسلطة أمنية إدارية تتخذ القرارات منفردة، لأنها تعرف المصلحة العامة التي تحددها عادة الأولويات الأمنية وتسهيل إدارة الحياة اليومية للسكان، الذين لا يُمثلون أبداً في هذه القرارات
حضر الأمن فغابت السياسة
فور اندلاع الحرب الأخيرة في غزة، نشطت القاهرة على الفور في مسارين اثنين؛ الإنساني والأمني. بكفاءة مذهلة جرى تنسيق جمع الكثير من المساعدات وحشدها إلى معبر رفح لتنتظر الإذن الإسرائيلي بالمرور. وبلهجة حاسمة، أكد السيسي رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لكيلا تتحول شبه الجزيرة إلى منصة إطلاق صواريخ ضد إسرائيل.
غير أنَّ ما غاب عن الخطاب المصري في هذه الحرب هو السردية السياسية. لم تشتبك مصر على الإطلاق مع السردية السياسية الإسرائيلية، بل تحدّث الرئيس مثل خبير أمني؛ يردّد المستشار الألماني أكاذيب إسرائيل بشأن ضرورة القضاء على وجود حماس في غزة، فيرد السيسي بأنَّ مثل هذه الحروب التي تستهدف "التنظيمات المسلحة" تأخذ وقتاً، وذلك في معرض حديثه عن ضرورة المدنيين الفلسطينيين من الموت أو الهرب الحتمي إلى مصر، دون أن يعلن موقفاً سياسياً مؤيداً أو رافضاً لاعتبار حماس إرهابية من عدمه، أو لأحقية إسرائيل في ما تسميه "الدفاع عن نفسها".
وعندما استُدعي خيار "نقل الفلسطينيين"، اقترح السيسي صحراء النقب كمثال تعجيزي، وللأمثلة التعجيزية دلالاتها. فحتى "الخطاب التعجيزي" لا ينبغي أن يجاري المحتل في "تشييء" الفلسطينيين أو اعتبارهم شعباً قابلاً للتهجير. المنطق الأمني منزوع السياسة سيقترح "نقل الفلسطينيين" إلى النقب، أما المنطق السياسي فسيعارض التهجير مبدئياً.
ما غاب عن الخطاب المصري في هذه الحرب هو السردية السياسية. لم تشتبك مصر على الإطلاق مع السردية السياسية الإسرائيلية، بل تحدّث الرئيس مثل خبير أمني
منذ بداية الأزمة، تتحدث البيانات الرسمية المصرية عن حق إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ولكنَّ الرئيس أكدَّ مرتين أنها ستكون دولة "منزوعة السلاح". وهو ما لم يعلن الفلسطينيون يوماً موافقتهم عليه رسمياً، وإن كان متسقاً مع ما جاء في مقترح "صفقة القرن" التي أطلقها ترامب قبل خمس سنوات وأيّدها السيسي.
بشكلٍ ما، فإنَّ تصورات السلطة المصرية عن الدولة الفلسطينية باعتبارها سلطة إدارة منزوعة السلاح، أكثر منها كياناً يمثل الفلسطينيين ويعبّر عن آمالهم وطموحاتهم، تتشابه بدرجة ملحوظة مع طريقة الحكم والإدارة في مصر، حيث جرى شيئاً فشيئاً تهميش المواطنين وتحويلهم إلى مجموعة من السكان الذين من الممكن تهجيرهم أو نزع ملكياتهم أو تغيير ملامح مدنهم وأحيائهم دون أن يؤخذ رأيهم حتى. ويتجلى هذا كله في خطاب رسمي يتنصل علناً من السياسة.
لا يعتبر هذا النظام نفسه ممثلاً للمصريين ولا مُعبّراً عن طموحاتهم، بل كسلطة أمنية إدارية تتخذ القرارات منفردة، لأنها تعرف المصلحة العامة التي تحددها عادة الأولويات الأمنية وتسهيل إدارة الحياة اليومية للسكان، الذين لا يُمثلون أبداً في هذه القرارات.
في ضوء ذلك، يمكن فهم التصور الرسمي المصري بشأن قضية فلسطين، والذي تحتلّ فيه الرغبة الأمنية في حماية سيناء من تدفق الفلسطينيين موقعاً مركزياً. وبينما يروّج "الأمني" لحلٍّ يضمن للفلسطينيين نصف دولة على الأرض، يدرك "السياسي" أنَّ هذا الحل مستحيل، وأنه لا يؤسس صيغة تعايش اجتماعي مستدامة وقابلة للاستمرار، سواء في فلسطين المحتلة أو في مصر نفسها.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.