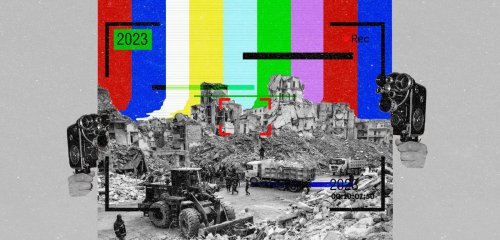ما من عدوان على العالم الإسلامي من دون غطاء أخلاقي، أسباب للغضب الجماهيري والنفير العسكري تغذي المحاربين بخيال الشهادة، وتضمن لمشعلي الحروب تمويلاً باسم الله. إغارات لا تجبر المهزومين على التخلي عن الإسلام، واعتناق غيره. كانوا واضحين في استهداف ثروات العالم الإسلامي، وإن ادّعوا نشر الحضارة، وتقويض مساحة شرور مستقرة، مبكراً في الصورة الذهنية، عن الإسلام ورسوله. الدليل الأكبر في هذا المسار الدامي قدمه البابا أوربان الثاني، بمجمع كليرمون بفرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 1095، معلناً انطلاق الحروب الصليبية: "يا له من عار، لو أن هذا الجنس الكافر، المحتقر عن حق، المجرد من القيم الإنسانية وعبد الشيطان، تغلب على شعب الله المختار".
هكذا استدعى فرسان أوروبا لتحرير قبر السيد المسيح. في الحملة الصليبية الأولى، عام 1099، استطاعوا إنشاء مستعمرات في فلسطين. نجاحٌ أغرى جيوشاً أوروبية أخرى بالاشتراك في مجد باتساع الأحلام البابوية. وشيطنة الإسلام ورسوله، آنذاك، ليست شيئاً طارئاً ولا نخبوياً، وإنما هي حصاد تاريخ من مرارات وانكسارات وهزائم توارثتها أجيال، وامتزجت بلبن الرضاعة؛ فنشأوا يحلمون بالثأر من غزاة خيّروا الأسلاف بين الإسلام والجزية والقتل. ميراث أثقل ذاكرة الأجيال، وفي فترات القوة ينتصرون لدينهم ولآبائهم. تبادلٌ بين جبهتين حضاريتين لثنائية القوة والضعف، الخشونة والترف. حتى بعد إنهاء الحقبة الصليبية في العالم الإسلامي، بقي في النفوس شيء من ماضٍ يطل برأسه حين يستطيع.
هل كانت الحروب الصليبية الأولى، والجديدة المتمثلة في الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، من نتائج الفتوحات العسكرية الإسلامية؟
لا علاقة للحروب الصليبية بدين جوهره المحبة والسلام. لم يحمل المسيح سيفاً، ولا قاد الرسل جيوشاً. حملوا الكلمة وبشروا، فصارت المسيحية الآن الأكثر انتشاراً
هذا حقل ألغام. لعبوره يجب الفصل بين مبادئ الأديان وسلوك معتنقيها. لا علاقة للحروب الصليبية بدين جوهره المحبة والسلام. لم يحمل المسيح سيفاً، ولا قاد الرسل جيوشاً. حملوا الكلمة وبشروا، فصارت المسيحية الآن الأكثر انتشاراً. يذكر الدكتور عزيز سوريال عطية في كتابه "تاريخ المسيحية الشرقية" أن القديس مرقص مؤسس الكرازة في مصر، تنقل بين فلسطين وبلاد الشام وقبرص وروما وشمالي إفريقيا، واستشهد سنة 68 ميلادية في الإسكندرية التي ستكون مسرحا لمأساة الفيلسوفة هيباتيا "المهذبة وهي في طريق عودتها إلى دارها... قام الرهبان الأقباط بجرّ هذه المعلمة الفاضلة إلى حي القيسارية التي حولوها إلى كنيسة، وهناك قاموا برجمها بالحجارة حتى ماتت".
إدانة القتلة لا تمسّ الدين
تاريخ المسلمين حافل بوقائع ذات دوافع سياسية. بأمر عبد الملك بن مروان قاد الحجاج جيشاً ضرب الكعبة بالمنجنيق، وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه. وفي سنة 120 هجرية أنهى والي الكوفة خالد بن عبد الله القسري خطبة العيد قائلاً: "أيها الناس اذهبوا وضحوا بضحاياكم، تقبل الله منا ومنك، أما أنا فإني مضحٍّ اليوم بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً، تعالى الله عما يقول الجعد علّواً كبيراً"، وذبحه أسفل المنبر. ويذكر ساويرس بن المقفع في "تاريخ البطاركة" أن مروان بن محمد رد على راهب توقّع زوال حكمه بأن "أحرقه بالنار وهو حي".
لعلك لاحظت أنني أؤجل دخول حقل الألغام. وللسلامة، سلامتي، أؤكد أهمية الفصل بين مبادئ الدين وسلوك أتباعه.
لنتخيل أن واقعة السقيفة انتهت بمبايعة عمر بن الخطاب. كان التجرد والنزاهة والعدل والقوة ستقترن ببناء الدولة. لا معارك هجومية لتلك التي سميت بحروب الردة. لا فتنة لواقعة قتل مالك بن نويرة، من دون أن يتأكد لخالد بن الوليد أنه ارتد. ولن يتباهى شيخ سلفي الآن بأن خالداً "اصطفى" زوجة مالك، بعد أن "أمر بقتله، وفصل رأسه، فسيدنا خالد عمل إجراء لإرهاب المرتدين، فأخذ الرأس بتاع خالد بن نويرة... وولع النار، وجاب قدر، وفيه لحم يستوي على النار دي... ييجي له نفس يأكل من اللحمة دي؟ آا، ييجي له نفس... سيدنا خالد شخصيته قوية جداً، ونفسه حلوة... النار قعدت قايدة في شعر مالك بن نويرة، لحد اللحمة ما استوت، وأكل سيدنا خالد".
ما اختلف فيه الشيخان، أبو بكر وعمر، ليس من أركان الدين ولا مبادئه. وقد اختلفا في شأن الحرب على من امتنعوا عن أداء الزكاة. كانت الحروب اجتهاداً سياسياً. بدأ الدم. ومن الجزيرة امتد الزحف ليشمل أمما أنهكتها حروبها، وجاءهم المسلمون ليفرضوا الخيار الثلاثي، الإسلام أو الجزية أو الحرب. ومن ثماره جنى المسلمون والعرب ما جنوه حين تراجعت قوة الدولة، وتنعّم حكامها والطبقة المستفيدة من الغنائم وثروات البلاد الأخرى.
في القرن العشرين انتقل السم النازي من الجلاد إلى الضحايا، فأعاد الصهاينة إنتاج القهر على الفلسطينيين. ولعل سموم الحملة الصليبية تسربت إلى جيل سابق من اليهود؟ كلا النوعين من السم كان ضحاياه الفلسطينيين.
المهزومون لا ينسون الثأر، ولو قبلوا الإسلام، ورفضوا اللغة العربية. إيران مثلاً. أجهز المسلمون على حضارة عظيمة، وظل الجرح القومي ينزف، فاختاروا الإمام الحسين، رمزاً للشهادة والمظلومية، تجسيداً للوجع. لا فرق في ذلك بين إيران الشاه وإيران الخميني. إلى اليوم يصرّون على تسمية الخليج "الفارسي"، حتى بعد أن غيّر رضا بهلوي اسم البلاد من فارس إلى إيران. وينددون بمجلة ناشيونال جيوجرافيك إذا وصفت الخليج بالعربي. ويستشهدون بغناء عبد الحليم حافظ "من المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي".
لو أغنانا أبو بكر عن هذا كله. لكن "الخليفة" قضى فكان. وأمام السيف يتراجع الاحتكام إلى النص. وفي سياق آخر، تشمل آية/ مبدأ "لا إكراه في الدين" المؤمنين به أيضاً، إذا اختاروا الردة. والدين المتين أقوى ممن يرتدون عنه، ومن المتشنجين بالدفاع عنه. ولا ينص القرآن على عقوبة للمرتد، وقد حسم الأمر بآية قطعية الدلالة: "إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً". فلو اقترنت الردة بقتل المرتد، فكيف يتمكن مسلم من تكرار الكفر بالدين، لو عوقب بالقتل على كفره للمرة الأولى؟
كان عمر بن الخطاب بصيراً. لا يحتاج القوي الواثق إلى وسائل يثبت بها جدارته. خشي الفتنة على الصحابة، الذين عاشوا في ظلال الوحي 23 عاماً، وأراد إعفاءهم من الخروج. يروي أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري في "الأخبار الطوال" أن عتبة بن غزوان حين دخل البصرة كتب إلى عمر أن الله "أغنمنا ذهبهم وفضتهم وذراريهم، وأنا كاتب إليك ببيان ذلك". وجاء نافع بن الحارث بالرسالة إلى عمر ليبشره. وقال له: "يا أمير المؤمنين، إني قد افتليت فلاء بالبصرة، واتخذت بها تجارة، فاكتب إلى عتبة بن غزوان أن يحسن جواري". يقول الدينوري: "فتباشر الناس بذلك، وأكبوا على الرسول، يسألونه عن أمر البصرة؛ فقال إن المسلمين يهيلون بها الذهب والفضة هيلا، فرغب الناس في الخروج".
تركت الغزوات، خصوصاً البعيدة عن العالمين العربي والإسلامي، ندوبا عابرة للأجيال. وحملت الأدبيات طرفاً من ذلك، بأقلام الذين عانت بلادهم ظلم المسلمين. يسهل الرجوع إلى سيرة نيكوس كازانتزاكيس "تقرير إلى جريكو"، ورواية إيفو إندريتش "جسر على نهر درينا"، لمعرفة بعض جرائم العثمانيين في كريت ويوجوسلافيا. ذلك إرث سياسي حمل الدين أعباءه، حتى إن كارين أرمسترونج في كتابها "سيرة النبي محمد" تصف الإسلام بأنه "لا يزال خارج دائرة النوايا الطيبة... ما يزال يحتفظ بصورته السلبية في الغرب... فلدينا في الغرب تاريخ طويل من العداء للإسلام... وهو العداء الذي شهد صحوة تدعو للقلق في أوروبا"، في الآونة الأخيرة.
المهزومون لا ينسون الثأر، ولو قبلوا الإسلام، ورفضوا اللغة العربية. إيران مثلاً. أجهز المسلمون على حضارة عظيمة، وظل الجرح القومي ينزف، فاختاروا الإمام الحسين، رمزاً للشهادة والمظلومية، تجسيداً للوجع
كارين أرمسترونج تعيد العداء إلى أصوله التاريخية، حين امتدت الفتوحات على حساب العالم المسيحي، وأمام ما رأوه خطرا داهماً، تساءلوا هل تخلى الله عنهم، "وأبدى رضاه عن الكفار" الذين وصلوا إلى قلب أوروبا. وظل هذا الخوف يتغذّى على هجوم علماء الغرب على دين يرونه "عقيدة تجديف في الدين، ويصفون محمداً بأنه المدّعي الأكبر، ويتهمونه بأنه أنشأ ديناً يقوم على العنف، ويمتشق السيف لفتح العالم. وأصبح اسم محمد (الذي حُرّف إلى ماهوميت) بمثابة البُعْبع الذي يخيف الناس في أوروبا. وكانت الأمهات تستعملن اللفظة في تخويف أطفالهن العاصين. وكانت مسرحيات الإيماء تصوّره في صورة عدو الحضارة الغربية الذي حارب قديسنا الشجاع سانت جورج". ولا يزال التصور الاستشراقي يؤثر في النظر إلى العالم الإسلامي، والإسلام يخلو جوهره من العنف والتعصب، فهو "دين عالمي ولا يتصف بأي سمات عدوانية شرقية أو معادية للغرب".
انطلق هؤلاء، في سبابهم للنبي، من رؤيا لاهوتية. وزعموا أنه "دجال كاذب، نصّب نفسه نبياً ليخدع العالم... وانتهت هذه الأوهام إلى القول بأن الإسلام ليس ديناً مستقلاً منزّلاً، بل بدعة، أو صورة مشوّهة من صور المسيحية، وأنه دين عنف يؤمن بالسيف ويمجد الحرب والقتل". هكذا صار النبي "العدو الأكبر للهوية الغربية الناشئة"، وأصبح يرمز لكل ما "نتمنى" أن ننفيه عن أنفسنا. وما تزال آثار الوهم القديم قائمة حتى يوما هذا. إذ ما يزال من الشائع عند أبناء الغرب أن يسلموا دون نقاش بأن محمد ليس سوى رجل "استغل" الدين في "تحقيق الفتوحات وسيادة العالم".
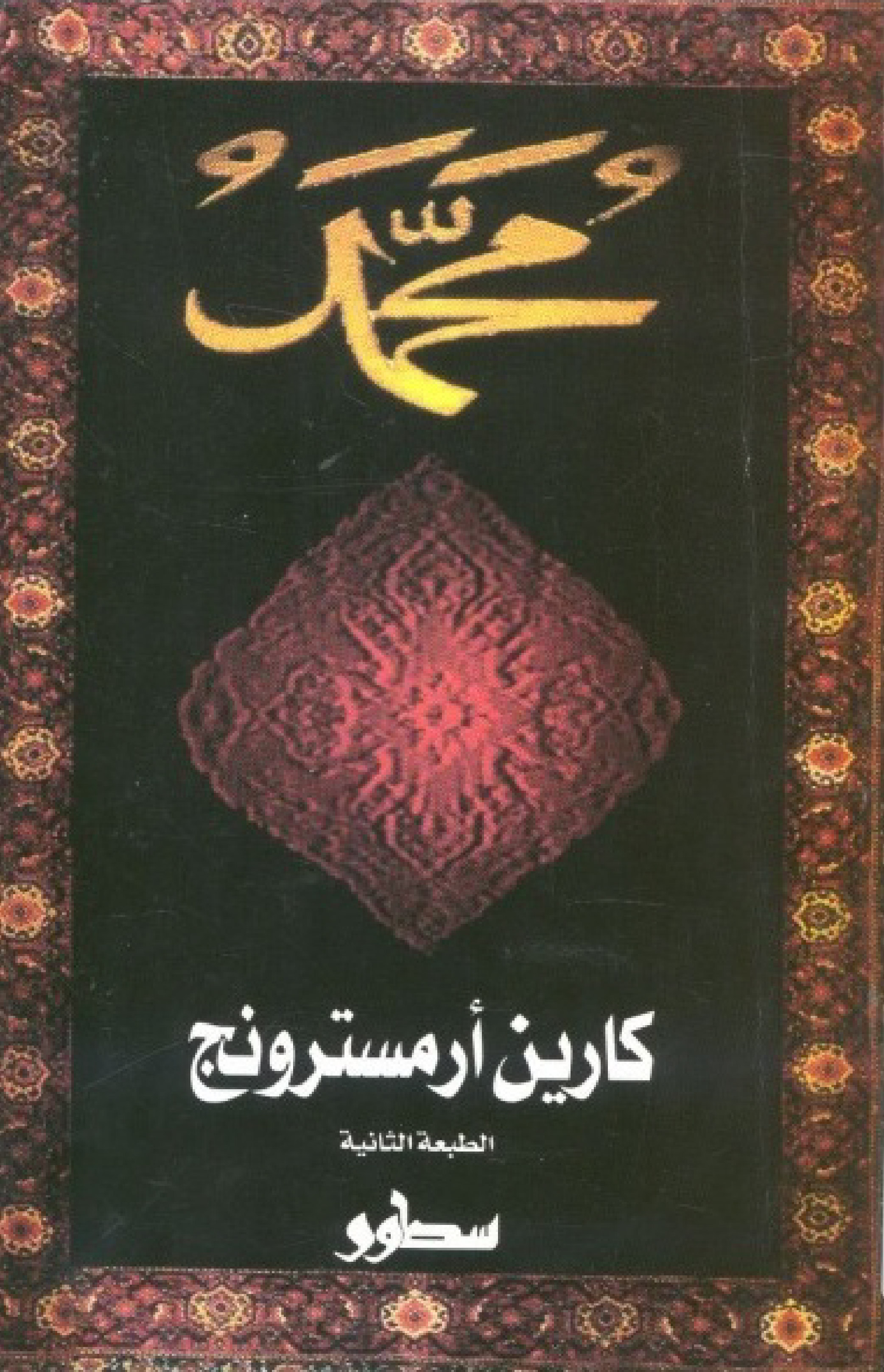 كتاب "محمد" لكارين أرمسترونج
كتاب "محمد" لكارين أرمسترونج
تقول كارين أرمسترونج إن الأساطير أرجعت سرّ نجاح النبي إلى تدبيره معجزات زائفة، ولم يجد المسيحيون الغربيون "سبيلاً إلى تفسير الرؤية الدينية الرائعة والمقنعة التي أتى بها محمد، وإلى تفسير سرّ نجاحها، إلا بإنكار الوحي"، ورؤية الإسلام كبدعة، وأتباعه كفرقة خارجة على المسيحية، بل إن البعض تصيبه "دهشة حقيقية حين يسمع أن المسلمين يعبدون الإله الذي يعبده اليهود والمسيحيون".
وتسجل أن رجال الحملة الصليبية الأولى ذبحوا الجاليات اليهودية في وادي نهر الراين، "وكانت تلك أولى المذابح الجماعية في أوروبا. وكُتب العداء للسامية أن يصبح مرضاً أوروبياً عضالاً أثناء الحملات الصليبية"، ونسج المسيحيون في رواياتهم عن اليهود أوهاما مرعبة، فزعموا أنهم يقتلون الأطفال، ويمزجون دماءهم بخبز عيد الفصح، وأنهم يدبرون مؤامرة كونية للقضاء على المسيحية. وهنا ينتهي كلام كارين أرمسترونج.
في القرن العشرين انتقل السم النازي من الجلاد إلى الضحايا، فأعاد الصهاينة إنتاج القهر على الفلسطينيين. ولعل سموم الحملة الصليبية تسربت إلى جيل سابق من اليهود؟ كلا النوعين من السم كان ضحاياه الفلسطينيين.
أعود إلى السؤال الذي حمله عنوان المقال، وأضيف سؤالاً آخر: ماذا لو بلغهم الإسلام بالدعاة لا الجيوش؟
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.