في 305 صفحات (قطع متوسط)، يستدرج الكاتب العراقي المقيم في السويد وليد هرمز، أبطال عمله الروائي الأول "جروح غوتنبرغ الرقيقة"، إلى المكان نفسه الذي يحمل عنوان الرواية.
منذ السطور الأولى، يكتشف القارئ أن المكان السويدي الذي يعجّ بشخصيات متناقضة، وعلى عداء مستتر، هو بطل أيضاً، بالرغم من تعددها، وركونها إلى هدنات غير مرئية، وكأنه ليس أمام أبطال هذه الرواية إلا أن يذعنوا بالتدريج للراوي (هرمتس)، إذ يقتحم المكان، ويتسيَّد عليه.
وما تشابه الأسماء لفظياً (هرمز، هرمتس)، إلا للدلالة على سخونة هذا الاقتحام السردي في هندسة أرواح أبطاله، وبالطبع كما سنلاحظ في أثناء التوغل في القراءة أنه لا يتخلل هذه الهندسة الأليفة أي تجريح على السطح، لأنه هنا يستهدف العمق، ما يعطي ميزةً إضافيةً لهذه الرواية، التي تكشف عن دأب هرمتس في البحث عن ذاكرة جديدة، وان غدت تائهةً ومتبطلةً في الوقت نفسه بين ثنائية شرق-غرب التي يرنو إليها كثرٌ.
في كل فصل من فصول الرواية، سيعثر القارئ على شيء مخفي من جروح كل شخصية على حدها، وكأن الجروح الرقيقة التي تظهر على وجوه مدينة غوتنبرغ المتعددة، هي جروحهم أولاً، وعليهم مداواتها قبل أن يسردوا علينا بقية قصص لجوئهم وهروبهم من بلدانهم
المكان بطل متعدد الطبقات هنا أيضاً، وفي كل طبقة يندرج صوت موزَّع على شخصية من هذه الشخصيات التي تتدافع للظهور على السطح، وقول كل ما صادفته من أحداث، سواء تلك الشخصيات المهاجرة مثل ريباز ومحسن وسارا، أو السويدية الشقراء أليسيا، التي تخضع المكان -خاصتها- لشروطها كمقيمة أصيلة، ولرواياتها، وأصدقائها السكارى المقيمين دوماً في حانة دبلن، وهي التي لا تتخفى وراء الماكياج مثل إناث الشرق، وسبق أن فقدت حبيبها في أرض الإغريق انتحاراً، وها هي تعيد اكتشاف شيء منه في شخصية الراوي هرمتس، الذي "يفوح الشبق والجنس حتى من حاجبيه"، وكأنه القادم للتو من الأساطير الإغريقية ذاتها، و"يحمل رسائل تفاهم وديةً بين البشر".
وإن كانت غير مضمونة وجهتها، ولكنها رسائل للمهاجرين أيضاً في الأرض الجديدة التي يجب أن يتكيَّفوا معها، في معاركهم مع العتمة، وقسوة الطقس، وبرودة العلاقات الاجتماعية، وربما النزعات العنصرية المنفلتة من عقالها بأقل قدر ممكن من الخدوش، والجروح. فريباز القادم من الجبال يريد أن يختبر تهجين التبغ الكردي مع التبغ الإسكندينافي، إن وُجد في هذه البيئة القاسية، لا ليصنع تبغاً خاصاً به، وإنما ليتسلح بذاكرة هجينة "مباركة" قبل أن يلمّ شمله إلى فتاته التي خُطبت إليه، ولكنه ينتظر أن تبلغ السن القانونية حتى يتمكن من ذلك، فالسويديون، "الفايكنغ"، لا يعترفون بالزواج من القاصرات بحسب القوانين السارية، والمعمول بها.
نستطيع -مثل سوانا- أن نتلَّمس شعوراً مستفحلاً بالأذى لدى الشخصيات الرئيسية في كل فعل من أفعالها، من خلال تصوير ذكرياتها بالشكل الذي ظهرت عليه في الرواية. هي شخصيات توَّاقة إلى الحنان، وتسبغ الألم على سلوكياتها بشيء من المازوخية المتبادلة، وتبحث في الوقت نفسه عن الحب، والمغفرة تالياً، بطرائق غير معهودة، وكأن كل ما حدث في سنوات حياتها السابقة.
وبغض النظر عن انتماءاتها الأولى، يوحدها جميعاً شلال الرعب الآدمي الذي مرَّت فيه بمسميات مختلفة، وكأنه مكتوب على الراوي هرمتس، وريباز، ومحسن، وسارا، وإن جاءت هذه الأخيرة من مكان مختلف نسبياً أن يظلوا أهدافاً للديدان نفسها التي دأبت تطاردهم في أوطانهم بالقسوة نفسها، وربما بأشد منها في المنفى، إذ تتحوَّل إلى عصف ذهني مقيم.
إنها ديدان "مستحلبة" من بطون الديكتاتوريات التي لا يفلت من زحفها أحد. لطالما شعر هرمتس في كوابيسه بأن صدام حسين قد جاء شخصياً ليطلب من ملك السويد ومؤسس مدينة غوتنبرغ، أن يسلمه له ليعاقبه، حتى أنه لا يفوته أن يطالب بعرش السويد مكافأةً له على حماقاته "الحربية" التي ارتكبها في سنوات حكمه الجائرة.
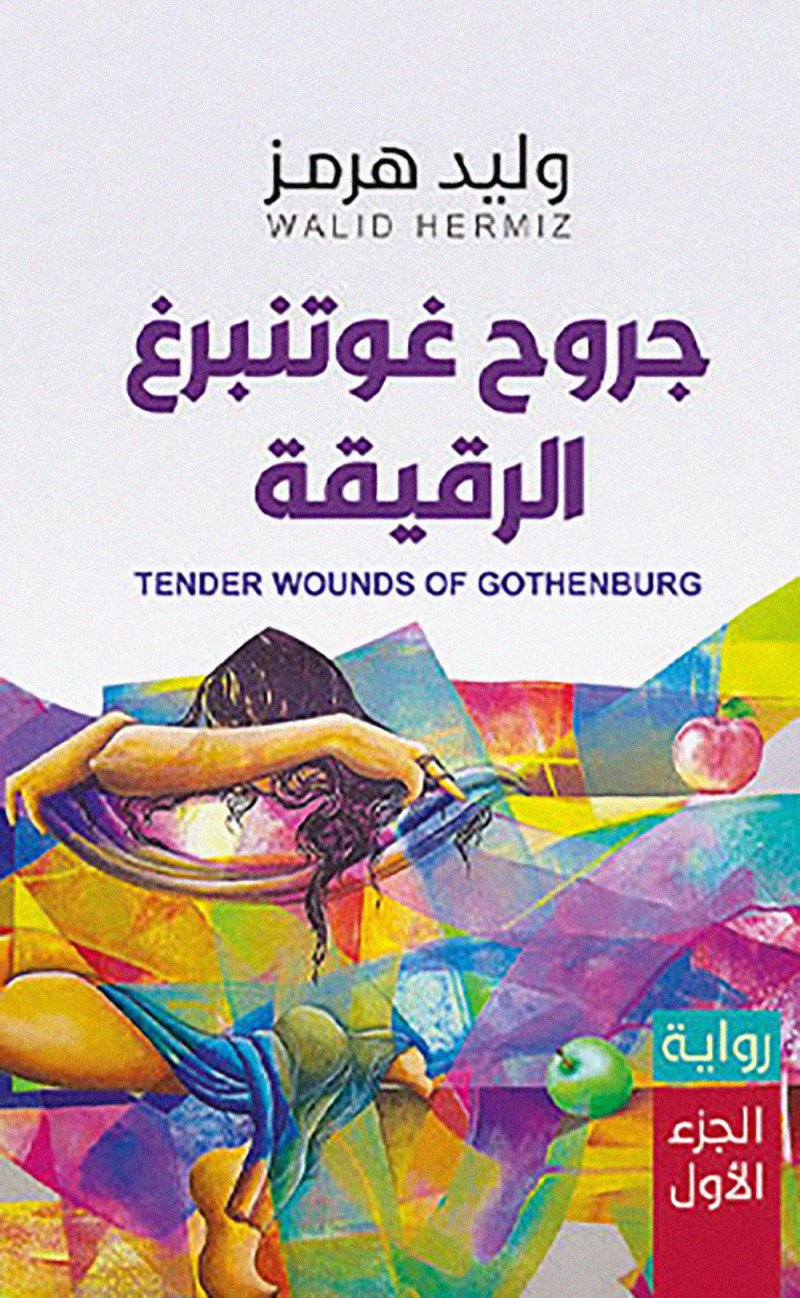 رواية "جروح غوتنبرغ الرقيقة"
رواية "جروح غوتنبرغ الرقيقة"
في كل فصل من فصول الرواية، سنعثر على شيء مخفي من جروح كل شخصية من هذه الشخصيات على حدة، وكأن الجروح الرقيقة التي تظهر على وجوه مدينة غوتنبرغ المتعددة، هي جروحهم أولاً، وعليهم مداواتها قبل أن يسردوا علينا بقية قصص لجوئهم وهروبهم من بلدانهم، وكيف أن الرعب الذي يحملونه معهم، إنما يتحوَّل إلى كوابيس لا يمكن التداوي منها بسهولة، وليس أمام هذه الشخصية أو تلك سوى أن تكشف عما هو مستور في عالمها، وكأن نقل هذه العوالم من مكان إلى مكان كفيل بالتعريف بها.
التورية الملغزة في السرد التي يلجأ إليها الروائي العراقي وليد هرمز، مصدرها لغته الشعرية الثرية، فهو شاعر شاعر، ومحاور أثير للشاعر الكردي السوري المعروف سليم بركات، إذ سبق له أن حاوره في كتابه المثير للجدل "لوعة كالرياضيات وحنين كالهندسة" (2020)، وليس أمامنا سوى التساؤل بعد كل هذا البوح، هل يجوز للشاعر أن يصبح روائياً؟ وإن كان ذلك ممكناً في بعض الحالات، هل يجوز العكس؟ لا تبدو الإجابة مهمةً، وإن نصّ تطور الأحداث على ذلك، فهي يمكنها أن تحمل من الرموز ما لا يمكن تحميله واقعياً، كما في حال ريباز مثلاً الذي جاء من كردستان إلى إسكندنافيا ليبحث عن جبل شبيه بالجبل الذي عاش فيه، ويعيد تعريف ذاكرته الأولى من خلاله، بعد إدراكه أن الذاكرة الثانية التي يبحث عنها مجرد وهم لا يمكن التعويل عليه في حروبه الشخصية مع المنفى العتيد.
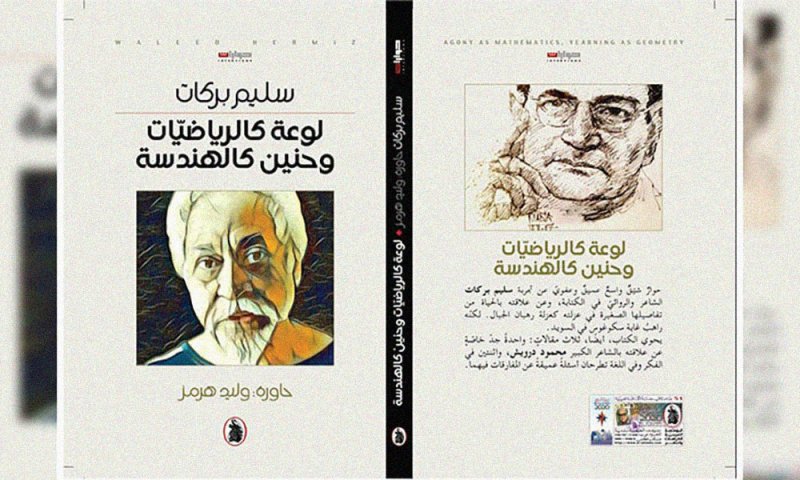 كتاب "لوعة كالرياضيات وحنين كالهندسة"
كتاب "لوعة كالرياضيات وحنين كالهندسة"
خطيبته القاصر هي من خططت لهذه السكنى في سفح جبل، وهو يسعى لاهثاً، إلى تنفيذ الخطة، وكأنه في حرب أخرى مع ذاته المهزومة، حرب لم تكن مقيَّدةً في دفاتره، قبل أن يكون في حرب مع الآخرين، فهو لا يحلو له "الجنس" إلا على سرير تحت جبل، وسوف يعمل حين يستقر في بلاد "الفايكنغ"، على نقل خبرة أجداده في زراعة التبغ إلى هذه البلاد، فعَلَم الأكراد في المنفى حين يُراد له أن يخفق ويرفرف عالياً ليس إلا ورقة تبغ.
صحيح أن ريباز يحتل مساحةً كبيرةً (إلى جانب الآخرين)، حتى تظهر رواية "جروح غوتنبرغ الرقيقة"، وكأنها روايته هو، وأن هرمتس الراوي والروائي، ومحسن مجرد ضيفين عليه، إلا أن الشخصيات الأخرى التي تعبر من خلال فصول الرواية تخلق نوعاً من التوازن السردي الضروري الذي لا يمكن تجاهله أبداً، حتى لو جاء كل ذلك في سطر واحد أو سطرين.
ما يفعله الروائي هرمتس في كتابته، وإن كانت روايته الأولى، التي تعد بجزء ثانٍ كما هو مكتوب على غلافها، يكشف عن حرفة واضحة في تحريك شخصياته، وأن ظهور أليسيا وسارا على طرفي نقيض إنما يكملان بعضهما في حياة الراوي.
نكاد نجزم أن كل واحد منَّا، كقارئ مفترض لهذه الرواية، قد يأخذ استراحةً له تحت تمثال الملك-المؤسس لمدينة غوتنبرغ الذي لم يبادل عرشه مع الديكتاتوريات المهزومة الوافدة إلى مدينته بحثاً عن ضحاياها الجدد من المهاجرين
سارا هي ذاكرته من المرحلة اللبنانية (المقاومة)، التي انقضت بأحلامها وتطلعاتها وانكساراتها وانتقلت إلى جبهة أخرى بذريعة دراسة الفلسفة علَّها تجد ملاذاً آمناً لها بعد أن فقدته في مكانها الأول. هنا الذاكرة بتقلباتها الأنثوية تأبى أن تفارق هرمتس أو هرمز، فأليسيا، الروائية السويدية السكيرة التي تخترع تعريفات كثيرة لعالم لا يستبدل أدواته بالسهولة التي يعتمدها المهاجر الجديد في عزلته، وهي قد تكون المرآة الغبشة لذاكرة أخرى مستحيلة تتعمَّد أن تخلط في الأساطير، والواقع المعيش الذي يقصده الكاتب في منفاه حين يسطّر لذاكرة شخصياته التي هاجرت معه، وقد تكون أليسيا اخترعت انتحار عشيقها غوستاف على شاطئ يوناني، لأنها تهوى اختراع أسطورة جديدة في بلاد باردة تفتقد أساطيرها، وقد تصبح بطلةً مطلقةً للجزء الثاني.
من يدري؟! نحن الذين نعيش هنا في مدينة غوتنبرغ الرقيقة (لندن الصغرى)، استمتعنا بقراءة الجزء الأول، وليس أمامنا إلا أن نتكهَّن، كيف يكون شلال الذكريات الذي يجيء من أغنية "وحدن" للسيدة فيروز المرتبطة حصراً بـ"سارا".
نكاد نجزم أن كل واحد منَّا، كقارئ مفترض لهذه الرواية، قد يأخذ استراحةً له تحت تمثال الملك-المؤسس لمدينة غوتنبرغ الذي لم يبادل عرشه مع الديكتاتوريات المهزومة الوافدة إلى مدينته بحثاً عن ضحاياها الجدد من المهاجرين الهاربين من زنازينها ومقابرها الجماعية، ليكتشف فيها حكايته، وهي حكاية لا بد أن تتكرر مع كل طاغية يرغم ناسه على الاندحار أمامه، فيلجؤون إلى مدن مجروحة ورقيقة علَّها تداوي عندهم شيئاً من جراح مزمنة.
تنويه لا بد منه: سألت الكاتب وليد هرمز، عن أصل اسم هرمتس في الرواية، وهو يحيل إليه دون أدنى شك، فقال إن شركة السكن السويدية التي استأجر البيت منها قد كتبته بهذه الطريقة على الباب الخارجي، فوجد فيه الأسطورة التي غذَّتها مخيلة أليسيا، وهي تبحث عن موضوع رواية شيّقة تخلط فيها الجنس والفودكا والأشباح الموتى على الشواطئ الإغريقية.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


