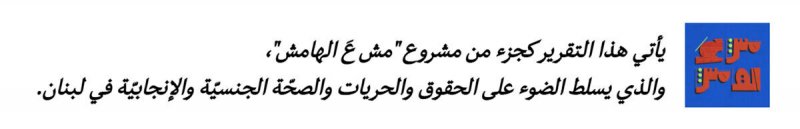
كنت في السيارة مع أبي. المشوار طويل، ومحطات الراديو لا تساعد. توقفنا لنملأ السيارة بالوقود، وقلت في نفسي: هل أبقى على عادتي أتواجد في المكان نفسه مع أبي ونحن ننظر في جهات مختلفة؟ دفعني الملل، فسألته: "بابا، هل تحب رائحة البنزين؟"، جاوبني بالنفي. تابعت، "أي رائحة تذكرك بطفولتك؟".
‑ "رائحة زبل البقر".
وإذ بي أفتح حواراً طويلاً مع أبي عن طفولته وصباه، لأكتشف أن أول سنين له في المدرسة كانت في عمر الثانية عشر، حيث كان يجتمع بعض الصبيان مع أستاذ في غرفة واحدة في بيت الرعية في الضيعة. لم أكن أعلم أين سيقودنا الحديث، فبعكس طريق الشمال الذي كنا نسلكه، المزين بأشجار الزيتون الرمادية في منطقة الكورة، لم يكن لدي أي هدف. إلى أن قال كلمة السر، لم أعلم أنه كان هناك كلمة، إنما التلفظ بها جعل كل الباقي تفاصيل: "كنّا نتزعرن".
وهنا، فُتحت أبواب مغارة علي بابا، وبدأتُ أغرف الأسئلة والأجوبة والمواضيع.
في عمر الخامسة عشر، كان أبي يمضي من القرية يومياً للعمل في بيروت، ما جعله يبتعد عن العائلة، ليجني المال ويحصل على استقلالية معينة. كان يذهب مع رفاقه إلى بيوت عاملات الجنس، وتكلّم عن بيت معين في ضواحي ساحة البرج: "آه يعني، أول مرة ما كانت مع ماما؟!"
كما نقول في علم النفس، السيارة "تحتوي"، بفضل بنيتها وشكلها وإمكانيتها، على عزل الصوت والحرارة والرطوبة بين الداخل والخارج. فتشكّل، كما نرى في الأفلام، مكاناً للاعتراف والتحدث والمشاركة، ولكن لطالما وجدت أن السيارة هي مكان حميم وخاص لا سيما في لبنان، في بلد نعيش فيه مع أهلنا حتى الزواج. فينتقل التعايش والانصهار معنا من بيت العائلة الى بيت الشريك/ ة والأولاد، ونتشارك أحياناً السقف نفسه مع الجدة أو مع العمة التي لم تتزوج (في لبنان، في كل بيت عمّة لم تتزوج). فتبقى أماكن قليلة تشعرنا بالحميمية والحصول على الوحدة، كالسيارة.
إذن، وبكل فخر، نتوّج اليوم السيارة بجائزة موريكس دور، عن فئة أفضل مكان حميم وخاص في الأماكن العامة في عالمنا العربي (تصفيق حار).
ونتوّج أيضاً الحمام في البيوت المكتظة، الذي وبفضل القفل على بابه، جعل عملية العزل عن باقي العائلة أمراً بديهياً، لا بل محبذاً (تصفيق أكثر حرارة).
ومن على هذا المنبر، أود أن أشكر أهلي، كل من دعمني، وطبعاً لجنة الموريكس دور المنظمة، على هذا التكريم وهذا الحفل الفخم... فهم مهما حاولوا، الحميمية في بيوتنا العربية لن تموت!" (تصفيق أكثر حرارة كمان وكمان).
‑ "شو يعني "تتزعرنو" يا بابا؟".
وإذ بي أغتنم الفرصة وأنقضّ على معرفة حياة والدي الحميمة في مراهقته.
في عمر الخامسة عشر، كان أبي يمضي من القرية يومياً للعمل في بيروت، ما جعله يبتعد عن العائلة، ليجني المال ويحصل على استقلالية معينة.
كان يذهب مع رفاقه إلى بيوت عاملات الجنس، وتكلّم عن بيت معين في ضواحي ساحة البرج.
‑ "آه يعني، أول مرة ما كانت مع ماما؟!"
‑ "لا!"
‑ "هل كانت أول مرة لك مع عاملة جنس أم بدون تبادل مادي؟"
‑ "مش ذاكر".
صمت.
هل فعلاً لا يذكر بابا أول مرّة له؟ حتى ينسى، يعني هناك العديد من "المرّات" قبل أن يتزوج، وزيارات كثيرة إلى بيوت عاملات الجنس، وصديقات كثيرات أيضاً، جعلن الأمر اعتيادياً جداً، فهل تنسى المرأة مرتها الأولى؟
أخبرني أيضاً أنه نفّذ مع بعض الأصدقاء مقلباً برفيقين لهم. كانوا يتلاقون للعب الفوتبول، وإذ بهم يطلبون من هذين الأخوين الذهاب إلى عنوان وراء الساحة، حيث بقيت الطابة. ذهب الأخوان، واكتشفا أن البيت لا يحتوي على طابات فوتبول، إنما على عاملات الجنس.
لا يقهقه أبي عندما يخبرني بهذه القصة، فقط يرويها مع ابتسامة على وجهه، كمن يذكر حدثاً بعيداً لم يعد له صلة به.
إذن، لأبي خبرات جنسية كثيرة قبل الزواج. هل أخبر ماما عنها؟ هل شعرت ماما أن زوجها كان عالماً ماذا يفعل في ليلة الدخلة؟ هل علّمته عاملات الجنس كيف يرضي المرأة؟ أو ربما كان ببساطة ينهي حاجته ويذهب دون إتمام أهداف پيداغوجية؟
نعود من رحلتنا إلى الشمال، وأشارك معلوماتي مع أخي. نبتسم ونستغرب، فلا أحد قد تجرّأ وسأل بابا عن حياته قبل هذا الحين، ولا سيما خصوصياته. فمنذ بضع السنين فقط، كنا لا نزال نخاف من بابا، من جبروته وقوته. ورغم كوننا "مخوّلين"، طويلي القامة والبنية كعائلة أمي، بينما أبي قصير القامة، نحيفاً وعصبياً، كنا لا نزال نرتعب من صوته العريض وكف يده الخشنة الذي تمرّن بي وبأخي بضع مرات في طفولتنا ومراهقتنا.
في أواخر التسعينيات، ذهب أبي برحلة إلى مصر، وعند عودته، أخبر بعض الأصدقاء عن امرأة زارت غرفة الفندق التي كان يتشاركها مع صديقه. كانت تبلس نقاباً أسود يغطيها كلها ما عدا العيون. وحسب ما أذكر من قصته، عندما دخلت الغرفة، خلعت اللباس وظهرت شبه عارية.
لا أعلم ما إذا كان هدف النقاب إخفاء هوية المرأة، أم كان لتحقيق فانتازم معيناً؟ ولكن في الحالتين، أنهى أبي القصة باشمئزاز، مستغرباً المظهرين المتتاليين، قائلاً إنه طلب منها الرحيل. من بين الأصدقاء الموجودين، أحد الرجال الذي ضحك متطلعاً بأمي قائلاً: اقفريه! (اكتشفت لاحقاً ماذا تعني هذه الكلمة: انبشي وأوقعي به واعرفي حقيقة ما جرى). وبدأت أفكر: كيف يتم "القفر" في هذه الحالة؟ ولماذا ضحكت أمي بخجل؟ هل يهم أمي ما إذا كان بابا قد رأى امرأة أخرى؟ أم هي لا تبالي؟ هل هنالك طريقة "للقفر" تعرفها ماما؟ وهل استخدمتها؟ والأهم، هل فعلاً طلب بابا من هذه المرأة أن تخرج دون أن يحصل أي شيء؟
للرجال في مجتمعاتنا امتياز، فهم يستطيعون الذهاب والمجيء كما يحلو لهم. يجنون المال، ويتعبون، ويعملون لساعات طويلة، فإذا غابوا لساعة أو ساعتين بعد دوام العمل، متحجّجين بكثرة الشغل، أو بالزحمة، لا أحد سيطلب منهم أي تبرير أو تفسير.
يستخدم الفرنسيون عبارة "من الخامسة إلى السابعة بعد الظهر"، دالين على علاقة جسدية خارج إطار الزواج، تحصل بين هاتين الساعتين، حيث يمكن للشريكين التحجّج بالتأخر في العمل
يستخدم الفرنسيون عبارة "من الخامسة إلى السابعة بعد الظهر"، دالين على علاقة جسدية خارج إطار الزواج، تحصل بين هاتين الساعتين، حيث يمكن للشريكين التحجّج بالتأخر في العمل.
أتمنى أحياناً لو تسنّى لي أن أمضي المزيد من هذا الوقت مع أبي. أقول "هذا الوقت" لأنني قسمت مراحل العيش مع الأهل إلى ثلاثة:
الطفولة، عندما يكون الأهل مسؤولين عن الولد، فليس بإمكانه العيش دون سلطة أبوية تؤمن حاجاته وتضمن سلامته.
الرشد، عندما يكون الأهل والولد في عمر بالغ، متمكنين من التحاور والتواجد كأصدقاء راشدين، غالباً، في هذه المرحلة يكون كلا الطرفين ينتجان ويجنيان الأموال باستقلالية تامة.
الشيخوخة، عندما يصبح الأهل بحاجة إلى أولادهم للبقاء على قيد الحياة.
انتقلتُ بسرعة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة، ولم يسمح لا الوقت ولا السفر ولا طبيعة العلاقة مع أبي، أن نتشارك بلوغنا كشخصين راشدين، فتحول أبي، بغمضة عين، من رجل جبار ذي سلطة مطلقة، إلى كائن ضعيف تعب، يقع إذا ما تعكّز على عصاه. واليوم، كلما جلت البيت، أراه ينظر لساعات متأملاً الأرض. وأسأل نفسي: بماذا يفكر بابا كل هذا الوقت؟
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


