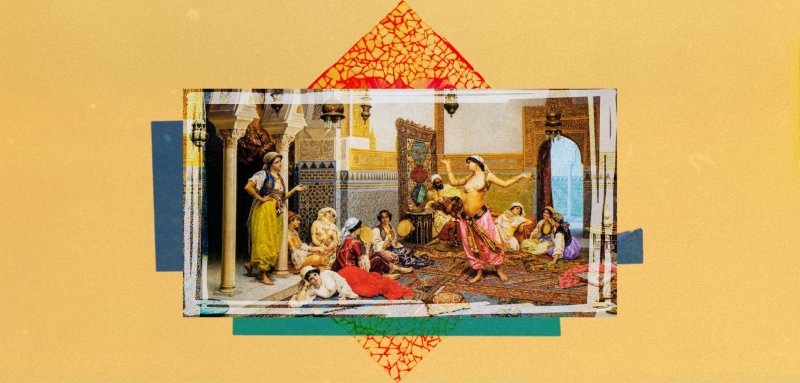الخليفة العباسي المتوكل وطئ أربعة آلاف امرأة، والخليفة الأموي هشام بن عبد الملك تمتع بالنساء حتى ملّهن، فقال: "أتيت النساء حتى ما أبالي امرأةً أتيت أم حائطاً"، حسب ما نقل أستاذ الفلسفة الدكتور صادق جلال العظم.
صورة راسخة في أذهاننا تفيد بأن الجواري كنّ دائماً مجرد وسيلة للمتعة، وبالتبعية يتبادر إلى أذهاننا أن تلك الجارية لا يمكن أن تعشق سيدها، فهي بالنسبة له مجرد لعبة جنسية (sex toy) بمصطلح عصرنا، وبالتأكيد لا توجد لعبة تُحِبّ، إذ كيف تحب وهي منتهكة بلا شخصية ولا وجود إنساني؟
كتب التراث الإسلامي تخبرنا بغير ذلك، فهناك إماء أحببن أسيادهن، ومنهن بِشْرَة التي عشقت سيدها الشاعر الشهير الأحوص الأنصاري (ت 105 هـ/ 723 م). فحين خرج الأحوص إلى دمشق ومعه بِشْرَة، مرِضَ فأخذت الجارية رأسه ووضعته في حجرها وبكت حتى قطرت دموعها على خدّه، ثم مات، فظلت تبكي عليه حتى شهقت في أثناء بكائها وماتت.
واللافت أن الجارية كان يمكن أن تفرح وتفكر في الهرب وتتحرر من العبودية بعد أن مات سيدها، ولكنها بدلاً من ذلك حزنت عليه حتى الموت.
في الكتب التي تورد حكايات متفرقةً، ومنها حكايات عن الجواري والحب، نجد قصصاً شهيرةً لجوارٍ عشقن أسيادهن؛ منهن مثلاً تَتْريب جارية الخليفة المأمون التي بكت حتى الموت بعد أن وصلها خبر موته
بالتنقيب في كتب التراث العربي، بالإضافة إلى الكتب الأدبية الموسوعية التي تورد حكايات متفرقةً، ومنها حكايات عن الجواري والحب، سنجد قصصاً شهيرةً أخرى لجوارٍ عشقن أسيادهن؛ منهن مثلاً تَتْريب جارية الخليفة المأمون التي بكت حتى الموت بعد أن وصلها خبر موته، وأنشدت قبل أن تموت:
إن الزمان سقانا مـن مرارته/بعد الحلاوة أنفاساً فأروانا
أبدى لنا تارةً منه فأضحكنا/ثم انثنى تارةً أخرى فأبكانا
حتى النخّاسون الذين كانوا يشترون الجواري ويبيعونهن، نشأت بين بعضهم وبين جواريهن قصص حب، ومنهن غُصن، جارية بن الأحدب النخاس، إذ ظلّت جاريةً له ولم يبِعها، بل أنجب منها، وتحرّرت بعد وفاته.
والسؤال الأعقد والأهم هنا، والذي لا ينطبق على الإماء والعبيد فقط، بل ربما يطال كل علاقة إنسانية يخضع خلالها إنسان لسلطة استبدادية: كيف يُحِب فاقد الحرية سيّدَه، الذي سلب حريته؟
هناك إجابة تقليدية متعارفة، تنبع مما عُرف بمتلازمة ستوكهولم، والتي تفيد بأن الإنسان قد يتعاطف أو يحب من انتهكه، في ظروف معينة، ولكننا في هذه المقالة نتناول المسألة من اتجاه فلسفي أشمل، هو قدرة الزمان على جعل الضحية تتكيف مع سالبِ حريتها، وينشأ بينهما حب، بعد مرور وقت.
الزمان يمنح التكيف فيأتي الحب
الزمان قادر على تغيير الأحوال، لأنه يعطي الفرصة للتكيف وتغيير الأفكار والعواطف، بفعل المواقف والسلوك والانطباعات التي تحدث في مجرى الوقت.
الثقافة الشعبية تأثرت بهذا المعنى، ويبدو ذلك في غناء شادية من كلمات عبد الوهاب محمد: "الزمان لمّا صالحنا، غيّر الدنيا لصالحنا"، ثم بيّنت لنا السرّ في هذا التصالح والحب وتبدل الأحوال، حين قالت: "بس لو نصبر ننول". والصبر سلوك ومعنى ممتد يطول زمنه.
العالم وُجِد بفضل ما له من حدود "زمانية" مكانية، بحسب النظرية الفيثاغورثية.
والزمان هو شكل تجربتنا الداخلية -الانفعالات والأحاسيس والتصورات- وهو أعمّ وأشمل من المكان الذي يشمل التجربة الخارجية فقط -الأشياء المادية الملموسة- لأن العالم الخارجي لا ينفصل عن الشروط الداخلية في العقل الذي يتصوره، برأي الفيلسوف الألماني كانط، حسب ما توضح أستاذة الفلسفة يمنى طريف الخولي. والحب من أهم تجاربنا الداخلية، إن لم يكن هو التجربة الأهم، وتالياً فإن الزمان عامل أساسي مهيمن عليه.
وفي رأي المفكر وأستاذ الفلسفة صادق جلال العظم، فإن "الزمان" هو أحد بعدين رئيسيين للحب، بجانب ما وصفه بـ"الاشتداد" أو الفعل الذي يتجلى في التهاب المشاعر؛ فهذا البعد الزماني أو التسليم للوقت، يضم بين ثوانيه وأيامه تغيرات نوعيةً إنسانيةً تدريجيةً، تتراكم وتؤثر على الحالة العاطفية، وتضمن نشوء الحب أو موته، أو امتداده واستمراره، أو ازدياده ونقصانه.
وعلى هذا المقياس نعدّ أن الجارية التي قد تبدأ علاقتها بسيدها بخوف أو بإحساس بالقهر، قد تتدرج مع الوقت إلى الحب!
المؤرخ والفيلسوف الفرنسي جول ميشيليه، انتبه أيضاً إلى دور الزمان في الحب، ورأى أن دراسة الحب لا يمكن أن تقتصر على نشأته، بل لا بد من تدوين تاريخه الطبيعي، لكي تنضبط الدراسة. والسبب في رأيه أن الحب هو مقدرة نفسية وتكيّف شخصي متبادل يستلزم وقتاً، وهذا الوقت كفيل بتنقية عاطفة الحب؛ لأن تجارب الحياة، تساعد على إكساب القلب رقةً وحنوّاً.
التكيف الذي أشار إليه ميشيليه، معناه تآلف شخصيتين مختلفتين، بعد نفور في نفسيهما أو نفس أحدهما من الآخر، كأن تنظر الجارية إلى سيدها كسالب لحريتها، بعد أن سباها جيش في حرب، أو سرقها لص، ثم بيعت لنَخّاس، حتى أصبحت من نصيب هذا السيد الذي دفع ثمن الجريمة، وبسحر الزمن تتكيف الجارية مع واقعها، وتتهيأ لحبّه.
والسبب في هذا التكيف برأي الكاتبة الإنكليزية نينا إبتون Nina Epton، أن الأخطار الحقيقية التي يواجهها الحب هي عوائق داخلية في نفوس المحبين، وليست خارجيةً، عادّةً فن الحب دراسةً سيكولوجيةً لتطور عملية التكيف النفسي التي تتحقق بين طرفين عبر الزمان.
أي أن في استطاعة الإنسان أن يحب حتى ولو كان الواقع الاجتماعي لا يدعم هذا الحب، طالما أن شيئاً في داخله يدفعه إليه، ولكن عليه مواجهة عوائقه الداخلية، لا العوائق الخارجية، فالعوائق الخارجية قد تمنع الاستمتاع بالحب أو جني ثماره، ولكنها لا يمكن أن تمنع الحب نفسه في قلب المحب، حسب ما نفهم من إبتون.
حتى النخّاسون الذين كانوا يشترون الجواري ويبيعونهن، نشأت بين بعضهم وبين جواريهن قصصُ حبّ.
هذه العوائق النفسية سمّاها أستاذ الفلسفة زكريا إبراهيم، "الصراع الودّي" الذي يتم بين طرفين في نطاق العالم والتاريخ والزمان.
ويُعلي زكريا من دور الوقت في تهيئة النفوس للحب ومن ثم نشأته وإنضاجه، إذ عدّ الزمان شرطاً ليصبح الحب إنسانياً، قائلاً: "إننا على استعداد لأن نسلّم بأن الحب ليس ظاهرةً إنسانيةً إلا لأن له تاريخاً!".
ويؤكد أن شخصيات المحبين نفسها في تطور مستمر، وأن حياة الحبّ تمرّ بأطوار الحياة الطبيعية نفسها التي يجتازها كل كائن حي؛ فتمر بمراحل وتغيرات كما العالم الذي لا يكفّ فيه كل شيء عن التغيير.
ويُشبّه إبراهيم علاقة الحب بالزمان، بنظرتنا إلى النور والنظرة والابتسامة، كأفعال لا تكفّ عن الظهور والاختفاء، وبرغم أنها صادرة عن الشخص نفسه إلا أنها تحمل في كل آنٍ معنى مختلفاً، وتبرز في كل مناسبة سحراً لم يكن في الحسبان.
وهكذا الحب؛ فالمحب يرى في محبوبه كل يوم مخلوقاً جديداً، وإن كان هو بعينه ذلك المخلوق الذي كان بالأمس يكنّ له مشاعر مختلفةً.
بين التكيّف والمواجهة... التخلص من الاستعباد بحبّ المُستَعبِد
لماذا نصف العلاقة بين مقهور وسيده الذي يقهره بالحب، حتى ولو سلّمنا بقدرة الزمان على تغيير الواقع؟ ألا يمكن أن يكون المحب المقهور يكذب على نفسه ليرضيها، فيطلق على ما يفعله أنه حبّ؟
هناك رأيان متضادان هنا، فالدكتور زكريا إبراهيم يرى أن التكيف قائم حتى مع الألم، حيث يعد الهوية الإنسانية الحقيقية هي التي تتقبل كل ما يُعرَض لها من تغيرات، وتدمجها في نفسها، في صميم وحدتها الأصلية، وكذلك الحب يحاول أن ينسج لنفسه من خيوط السأم والألم والصدفة والزمن والحياة المشتركة نسيجاً متيناً رائعاً، كما الطبيعة بتناقضاتها.
وفي مقابل ما يقول به زكريا إبراهيم، يرى عَلَم الفلسفة الدكتور عبد الرحمن بدوي، أن التألم يزداد مقداره ونوعه تبعاً لازدياد الرقي في سلم الكائنات، حتى أن أدناها بمراتب التطور أقلها تألُّماً، وأعلاها هو أكبرها شعوراً بالألم.
والرقي في التطور ينطبق على النوع الواحد من الكائنات؛ فالإنسان يتدرج شعوره بالألم وفقاً لتطوره الحضاري، لأن الملاحظ أن الشعوب البدائية قليلة الشعور بالألم -قياساً بالمتحضرة- وأفرادها مبتسمون حتى في الأوقات الصعبة، وحتى مع الموت هم قليلو الاكتراث.
أما الإنسان المتحضر فهو سريع التأثر بالألم، مع أنه أقل تعرضاً للأخطار الخارجية من البدائي المهدد من عوامل الطبيعة والحيوانات مفترسة، بحسب بدوي.
ونتيجةً لرؤية بدوي، يصحّ لنا الاستنتاج بأن داخل المجتمع الواحد من يشعر بالألم تجاه الحدث نفسه أكثر من غيره، وفقاً لعلو إحساسه بوجوده وتحضره أكثر من غيره، وبالتبعية قد يتفاوت القبول أو الرفض للعبودية وسلب الحرية بين إنسان وآخر، والنتيجة هي قبول حب المُستعبِد أو رفضه وفقاً للمخزون الحضاري داخل الإنسان.
وبالمقاربة بين فرضيتي بدوي وزكريا، عن التكيف وخلق الحب، في مقابل الرفض تحضراً وتأثراً بالألم، قد يجوز لنا القول بأن الجارية التي قُهِرت وتألمت لسلب حريتها، قد تشعر بعد حين من الوقت بأنها تحولت إلى كائن أقل رتبةً في التطور الحضاري، فبدأت تتكيف مع واقعها الجديد.
ولكنها استغلت ما بقي في أعماقها من نزعة إنسانية طامحة إلى الوجود، سواء بوعي أو من دونه، لتُحِب وتمارس وجودها الذي قد يتطور إلى اكتساب سلطة، ولكن في إطار العبودية في بيت سيدها!
ويدعم ما توصلنا إليه ما يُفهَم من الفيلسوفة الوجودية سيمون دي بوفوار، وهو أن الضعيف حين لا يجد وسيلةً أمامه للتغلب على قهره، قد يسعى إلى امتلاك القويّ، ومن خلاله يحقق قوته.
وربما يقترب ذلك مما قال به عبد الرحمن بدوي نفسه، وهو أن الحب بالمعنى الوجودي بمثابة امتصاص الذات للغير وإفنائها له في داخلها، والدافع إليه تملك الغير كأداة لتحقيق الممكن.
ورأت دي بوفوار أن المرأة الضعيفة الخاضعة للذكر في المجتمعات المتدينة، تسعى إلى اتحادها بالرجل كوسيلة للهيمنة، ولذلك تستسلم لحبه، وبعدها تصبح لديها رغبة في امتلاكه، لأن امتلاكها له هو امتلاك لقوّتها المفتقدة.
وهنا نتذكر قائمةً طويلةً من الجواري اللواتي استطعن بالحب امتلاك القوة في بيوت الحكم العربية في القرون الوسطى، ومنهن الخيزران التي خطفها اللصوص وأصبحت جاريةً، واشتراها الخليفة العباسي المهدي، فأحبّته وأحبّها وأنجبا الهادي وهارون، حتى صارت صاحبة نفوذ عظيم داخل قصر الحكم العباسي، في عهود زوجها المهدي وولديها موسى الهادي ثم هارون الرشيد، خاصةً في عهد الأخير.
وهناك أيضاً شَغَب، زوجة الخليفة المعتضد وأم الخليفة العباسي المقتدر، وصبح البشكنجية، زوجة الخليفة المستنصر في الأندلس وأم الخليفة هشام المؤيد، وغيرهن كثيرات.
حنين إلى ماضٍ لم نعشه… الحب الإيحائي
ولكن، هل كانت الجارية المحبة لسيدها تمتلك قلبه دائماً، ومن خلاله تمتلك قوتها المفتقدة؟ أم أن الحب قد يأتي من طرف واحد يتوهم الحب، أو يحنّ إلى شيء لم يتحقق في الواقع بالصورة التي يتصورها؟
الخليفة المتوكل الذي وطئ 4 آلاف امرأة كانت له جارية تُسمى محبوبة، عشقته بقوة، فلما مات الخليفة ضمها وصيف التركي، القائد العسكري العباسي القوي، إلى ممتلكاته، ولكن محبوبة ظلت مخلصةً للمتوكل تبكي عليه باستمرار حتى تأثر وصيف لحزنها وأعتقها.
بعد العتق لبست محبوبة الصوف، وهامت على وجهها تبكي المتوكل حتى ماتت كمداً عليه، برغم أن ما ذكرناه عن ولعه بالجنس والنساء لا يشير أبداً إلى أنه كان حبيباً مخلصاً لها، ويجوز أنها كانت تتوهم حبه لها، أو أنها أحبته لأنها تحب أن تحب!
وتفسير ذلك أن الحب في أحد أوجهه "تَذَكُّر" لشيء كان وفُقِد في عالم عُلوي، وعلى النفس أن تحنّ وتشتاق إلى هذا الشيء الماضي المثالي، الذي قد تكون النفس لم ترَه مادةً ملموسةً، بل إيحاءً ميتافيزيقياً أو وهماً، حسب ما نفهم من عبد الرحمن بدوي.
ويشير بدوي إلى الحب في المسيحية كمثال على هذا التذكر؛ فالمؤمنون لم يروا الله مادياً، ولكنهم بفعل الإيمان العميق عرفوه وحياً وأحبوه، بعد أن عرفوا أن الله هو الحب الذي نتجت عنه الروح القدس، فنتج عنها المسيح الابن، ولذلك يحنون إلى هذه الصورة المثالية للحب. والمعنى نفسه للحب الماضوي العلوي ينطبق على الصوفية الإسلامية وإن وفق تصوّر آخر.
لعل السرّ في الولع بالحب حتى ولو لشخص لا يبادلنا القدر نفسه منه، أن هذا الفعل الممتد والمتضخم عبر الزمن يمثل لذةً في ذاته، لذة منح الحبّ للحبيب حتى لو لم نرَه
هذا المعنى الإلهي للحب عكسه الفيلسوف الروماني لوكريتيوس، على البشر، حيث قرن اشتداد الحب الإيحائي بالمعبود الذي لا نراه، وقال عن متوهمي الحب: "يجهلون تماماً السرّ المشؤوم للحب، هذا السرّ الفظيع المتخفي بعناية عن الأعين، إنه هذا المعبود، إنه حبيب غير موجود".
ولعل السرّ في الولع بالحب حتى ولو لشخص لا يبادلنا القدر نفسه منه، أن هذا الفعل الممتد والمتضخم عبر الزمن يمثل لذةً في ذاته، لذة منح الحب للحبيب حتى لو لم نرَه، أو رأيناه ولم نتلقَّ منه القدر المناسب من الحب، حسب ما نفهم من عبد الرحمن بدوي.
فالحب عطاء، والعطية تستلزم شيئاً من الإيثار والتضحية؛ سأخرج مما أملك لأعطيك، وبرغم ذلك يشعر المُحب بالمتعة بعطائه، لأنه في أعماقه يحتاج إلى دفق هذه الطاقة المحتقنة في داخله، فيَستَمني الحب متوهماً حضور محبوبه.
وما سبق قد يفسر الحب لشخصيات تاريخية رحلت عن عالمنا، وتناسينا خطاياها مع مرور الزمن وبقي الحنين إليها في داخلنا، وكأننا نحِنّ إلى أيامنا التي عشناها في وجودها، أو إلى الصورة المثالية التي رُسِمت لها فرغبنا لو عاصرناها، أو ربما لأن في داخلنا طاقة حب محتقنةً ونحتاج إلى دفقها في أي اتجاه، فوجهناها إلى هذه المثالية الوهمية، التي رسمتها بعض كتب التاريخ أو وسائل الإعلام والمعرفة زيفاً لصالح هذه الشخصيات.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.