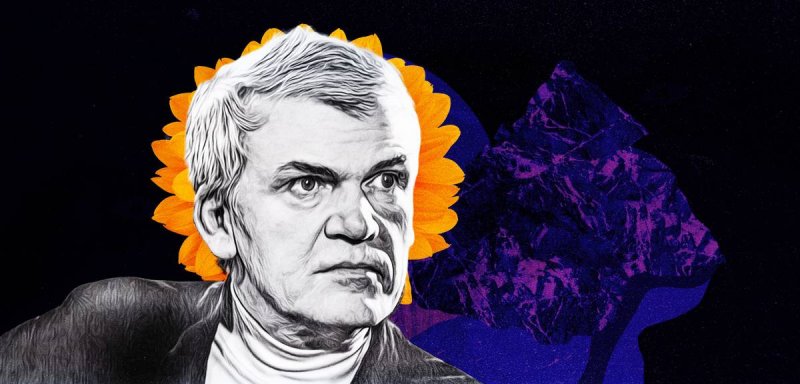تناول ميلان كونديرا (1929- 11/7/2023) تاريخ الرواية، الأوروبية والغربية أولاً وأخيراً، على وجه يكاد يكون هجاسياً. وكان كتب معظم رواياته البارزة في 1986 حين نشر فن الرواية، وجمع بين دفتيه سبعة نصوص كتبها بين 1979 و1985، وضمّنها أفكاره وأحكامه في الفن الذي عدّه علامة فارقة على هوية الغرب، الثقافية بداهة، و "الوجودية" الحميمة من قبل ومن بعد، وعلى هوية الأزمنة الحديثة، الغربية تعريفاً.
ويلازم تأريخه هذا- وهو يستهلّه بخروج سرفانتيس (ثيربانتيس) من منزله ومكتبته الأليفين إلى عالم حياة وسعي لا يتعرفه، وانقلبت معالمه وشاراته، ولا يختمه بطغيان الثرثرة على "وسائط التواصل الاجتماعي" ونزول الغرب عن شطر منه إلى روسيا "البيزنطية" على قوله- يلازم هذا التأريخ سؤال عن هوية الرواية الخاصة وغير المتقاسمة. ويتناول السؤال أطوار الفن إلى حين بلوغه ذروته، مع فرانتزكافكا وروبيرت موزيل وهيرمان بروخ، و "فروعهم" المعاصرة غداة الحرب العالمية الثانية. ويفضي التأريخ الموضوعي والمحموم معاً، إلى اليوم.
ويتوسط اليومَ، الحاضرَ التاريخي والروائي، ميلان كونديرا، الروائي والوسط أوروبي من غير تمييز ولا انفكاك. وهو رتّب كتابه في الفن، وتأريخه، على هذا. فصرف القسم الأول إلى التأريخ، ويلم بالقرون الأربعة الماضية. وقدّم للقسم الثاني، وهو محاورة مع ناقد أدبي فرنسي، بموجز عن تأريخ الفصل الأول. ودخل من هذا الباب، الروائي والمسرحي، إلى رواياته هو. ويتناولها على المثال الذي تناول عليه روايات أعلامه، سرفانتس ومعاصره فرنسوا رابليه الفرنسي، وريتشاردسون الإنكليزي، ولورنس شتيرن، وديني (س) ديدرو وبلزاك وفلوبير وكافكا.
ويوسط بينه وبين الحلقة الأخيرة من السلسلة، وهي كافكا وثلاثيته، أميركا، والمحاكمة، والقصر، الواقعة الكبيرة والفاصلة، الحرب "العالمية" الأولى. فيقول إن كافكا الروائي يسأل عما عساها تكون قدرات المرء ومستطاعاته في عالم تتمتع العواملُ الخارجة عن الفرد، والمستقلة عنه وعن علمه ومتناوله، فيه بقوة ساحقة. وتستبعد هذه العوامل الجدوى الروائية، والمنطقية التعليلية، من قص الحوادث الخاصة وسرد وقائع من مواضي الشخصيات- جواباً عن الملاحظة على كافكا إغفاله تعريف جوزيف (ك) أو (ك) من طريق سيرتيهما أو وصف خلقتيهما أو لباسيهما... على ما فرض التقليد الروائي البلزاكي منذ القرن التاسع عشر.
مركب الروح
ومن الجمع هذا بين جوهر التجربة التاريخية العامة والمشتركة (ثقل العوامل الخارجية، عموميتها، طغيانها على الفرد ومحقه، استغلاقها على الفهم...) وبين معالجة الشكل الروائي وبعض تقنياته وأفكاره لها، يدلف كونديرا إلى قصة قصيرة من مجموعة غراميات مضحكة (1959- 1968)، إدوار والله. فغداة قضاء ليلة أولى مع حبيبها، إدوار، تتأمل أليس، العشيقة، في الحادثة، وفي نفسها و"قدرها". فلا ترى علاقة أو رابطة بين أفكارها وبين وقائع حياتها. فهذه الأفكار مقحمة على سيرتها المتقطعة والمبعثرة. وسيرتها، أو أقدارها، مقحمة على جسدها الذي تتنازعه رغبات وانفعالات لا علم لأليس بمصادرها ولا بعُقَدِها أو تحولاتها وارتداداتها.
وعلى هذا، يروي كونديرا ويعقّب على ما يروي، فليست أليس إلا "ركاماً غير عضوي (من جسد وأفكار وأقدار)، اعتباطياً ومضطرباً". وفي ختام القصة تنظر أليس إلى وجهها في المرآة وتردد: "أنا أنا، أنا أنا، أنا أنا...".
وعلى نحو قريب وبعيد معاً، تجلس تيريزا، في خفة الكائن المحالة الاحتمال (1984)، إلى المرآة عارية وتحدق في صورتها. ولم تعجب بما كانت ترى. ولا قارنت بين جسمها العاري وبين أجسام عارية أخرى في صور فوتوغرافية كثيرة. كانت تنتظر أن تطفو على جلد الجسم الثقيل، الشبيه بجسم الأم الذي ذوت نضارته وخلف ذواؤها وقاحة ومرارة، (صورة) روحها. فلا يرى الناظر إليها وجهاً أو جسماً يحجبان الروح. وكانت تمثِّل على انتظارها، وموضوعه، بخروج بحارة مركب من بطنه إلى سطحه هازجين، هاتفين حين يبلغ أسماعهم خبر عن ارتسام اليابسة من البعيد.
في المزحة (1967) يشهد لودفيغ على إجماع أصدقائه على إقصائه وطرده برفع الأيدي من غير تردد، فيخلص إلى تعريف الإنسان بالكائن الذي لا يمتنع من رمي قريبه إلى الموت
ويقودها هذا- ويقود الروائي كونديرا، الحاضر على وجهين: وجه الراوي الغفل الخفي والمفترض، ووجه المراقب المعلن والفاحص مجرى التجربة التي أعدَّ عناصرها ونص على علاقات هذه العناصر بعضها ببعض- إلى السؤال عن هويتها وهوية وجهها. فإذا انفك وجه تيريزا من الشبه بنفسه، وهذا احتمال لا يطعن في حقيقته دوام الشبه الذي لا نعلم علته، هل تبقى تيريزا على شاكلة "أنا أنا" أليس.
شخص غير واحد
وتأمُّلُ توما، الطبيب ومضيف تيريزا وصاحبها و "خائنها" وشريكها في الموت، "الفلسفي" في المسألة يتفتق عن أسئلة أخرى أكثر تعقيداً وأقل تهويماً تجريبياً، مثل: ما الوجه غير النفساني لتناول الأنا وإدراكها؟ فإذا ترك الروائي- وهو في هذه الحال كافكا في المصف الأول، وجايمس جويس على نحو آخر، وموزيل من وجوه كثيرة- تناول شخصياته على مثال الوجدان وطويته المتصلة والمتماسكة، ما هي اللحمة التي تتولى توحيد الشخصية، وضم "أجزائها" (الأفكار والجسد والأقدار والصورة في المرآة...) بعضها إلى بعض؟
ويجيب كونديرا: يدور الشخص الروائي المعاصر على كلمات أو ألفاظ يترجح أو يتنقل بينها، وتخط مسارات تفترق أو تلتقي على أنحاء تعرِّف الشخص (الروائي) تعريفاً رجراجاً ومجتمعاً في آن. وهذه الألفاظ، وإيحاءاتها المركبة، في حال تيريزا، هي الجسم، الروح، الدوار، الضعف، الفردوس...
وياروميل (أو جاروميل، أو زاروميل، على ما تذهب إليه ترجمات مختلفة إلى العربية أو مقالات نقدية)، في منازل الحياة هنالك، (أو "الحياة لا تنزل هنا"، على تأويل لوسم الكتاب)، ياروميل البكر هذا، يلتقي صديقته وحبيبته في الحديقة، وهما يمنيان النفس بتقاسم الفراش والمجامعة، وتستعجل الصديقة الأمر. وبينما هما في الحديقة، تميل الصديقة برأسها على كتف ياروميل. يسعده الأمر ويثيره، فينتبه إلى أنه يرغب في عريها، ومجامعتها على هذه الحال، "في ضوء وجهها على كتفه".
فما اسم هذا؟ يسأل كونديرا. هل هو الحنان؟ وما هو الحنان؟ أهو الرعب الذي يبعثه فينا سن الرشد، فنحجم عن طلب ما يمليه، وما نحمله على الطبع؟ أم هو إنشاء حيّز مصطنع يبيح للمرء (الراشد) أن "يرجع" إلى الطفولة من غير أن يحمل رجوعه على المرض أو الارتكاس. وما الذي يصنعه الروائي حين يقلِّب حال ياروميل، أو تيريزا أو توما أو أليس... على وجوهها؟ هو لا يحاول النفاذ إلى رأس ياروميل، يجيب الروائي مستبقاً الاعتراض والمقارنة بين صنيعه وصنيع روائيي "الحياة الداخلية". فهو يحاول الدخول إلى رأس الروائي، وإلى قلب موقفه وفهمه وتسميته ما يروي. وما يرويه يجري مجرى استنباط "أنا تجريبية"، وتصور احتمال من احتمالات الوجود.
الأصول
وهذه التأملات في ولادة الرواية من صورة أو جزء من صورة، ومن جرس لفظة وظلالها، وإيقاعات قراناتها الكثيرة الفعلية والمحتملة بألفاظ وصور، ومن فكرة مجردة- تؤيد استيلاد كونديرا الرواية الحديثة، و"نقيض الحداثة" (على معنى النزول عن التفكر والاسترسال مع العمومي السائر، وهو تعريفه للـ "كيتش")، من موزيل النمساوي.
ويماشي هذا نازعاً إنشائياً وفكرياً جوهرياً من منازع الحداثة هو ازدواج صنائعها "مستويين": مستوى أول، مباشراً وساذجاً، وآخر أو ثانياً موضوعه هو الأول، والتفكير فيه، واستخراج ملابسات إنشائه ومنهاج هذا الإنشاء، على نحو ما يصنع كونديرا في مقدمات خفة الكائن... وهو ما لم ينفك يفعله في رواياته الأخيرة: الخلود (1990)، والبطء (1994)، والهوية (1998)... فيصحب العمل، على شاكلة بطانته التي لا تفارقه، بيان صنعه و"أسباب" الصنع وكيفيته.
وفي هذا الموضع تقترب مقالة كونديرا من مقالة إدموند هوسرل الفينومونولوجية (علم تظاهرات الوجدان) اقتراباً يتخطى الشكل والمصطلح إلى المعنى الجوهري، من غير أن يتخلى الروائي عن صناعته (على نحو القول "صناعة الشعر")، قيد شعرة أو أنملة. فالتجريب في "الأنا التجريبية"، يحمل على استعراض صيغ الحال (الحنان، الدوار، الشاعر، البطء، الغنائية...) المثالية، في الذهن وفي الحس أو القص، قبل الخلوص من الاستعراض إلى "جوهر" خاص- والكلمة هوسرلية بامتياز، شأن الصيغ أو "التنويع المثالي"-، أو فريدٍ، يسمي "إمكاناً" أو "احتمالاً وجودياً" عاماً وتاريخياً.
وعلى الرواية، وهي تستحق الإسم حين تسمي ما لا يسع غيرها تسميته وتناوله، أن توفق بين التنبّه على تاريخ المجتمع وبين فحصها عن الاحتمال الوجودي. ولتناول التاريخ في الرواية من داخل مزدوج، هو داخل التاريخ وداخل الرواية، أصول ملزمة، على ما يقول كونديرا. وأول هذه الأصول الاقتصار على خطوط عامة أو أشياء يتوكأ عليها العمل، وثانيها هو اختيار ما يدل على "حال وجودية": في المزحة (1967) يشهد لودفيغ على إجماع أصدقائه على إقصائه وطرده برفع الأيدي من غير تردد، فيخلص إلى تعريف الإنسان بالكائن الذي لا يمتنع من رمي قريبه إلى الموت، من غير التطرق إلى دور الحزب والهيئات البيروقراطية والأيديولوجية، إلخ.
وثالث الأصول أن "تاريخ الإنسان" الذي يكتبه الروائي يتناول وقائع يغفلها "تاريخ المجتمع" الذي يكتبه المؤرخ. ففي منازل الحياة هنالك (1969)، وفالس الوداع (1972)، يتناول التأريخ الروائي الذي يكتبه التشيكي حادثة تكاد تكون خفية هي تدبير السلطات المحلية والموالية للغزو السوفياتي، غداة صيف 1968، مجازر "رسمية" قتلت مئات الكلاب الشاردة وربما الآلاف منها في أنحاء تشيكوسلوفاكيا (يومها).
والحادثة كناية حقيقية، يصفها كونديرا بـ "الإناسية" (الإنسانية العامة أو الأنتروبولوجية)، تُشهد على إرهاب الاحتلال الأخوي، وعموم عنفه البشر والحيوان والحجر من غير تمييز. فيَمْثُل، بـ "لحمه وعظمه" (والمثول "اللحمي" من استعارات هوسرل الأثيرة)، جموحُ السلطان وسعيه في التفلت من حدود الحياة العادية وإجماعاتها الأليفة، على ما لاحظ أوائل من تناولوا صيغ الكليانية بالتحليل والتأريخ. ويتصدرهم ربما توماس مان، الألماني المنفي، وأحد كبار الروائيين الذين يحصيهم كونديرا في تاريخه الروائي.
الشخصيات الروائية (الغربية) هي ختام أو عصارة تاريخها الفردي، وختام تاريخ المغامرات الأوروبية على وجهها الوجودي. والختام يعني التكثيف والجمع على صور بعضها مسرحي، وبعضها كاريكاتوري
والحادثة الضئيلة الأخرى التي يستشهدها صاحب منازل الحياة...، على اقتباساته التاريخية والروائية، هي تلك التي تسوغ "هرب" ياروميل من مضاجعة حبيبته. فهو، ياروميل، يخجله التعري، وإظهار لباسه السفلي الداخلي (كيلوته)، "القبيح وغير الأنيق"، الذي درجت آلات الصناعة "الاشتراكية" على إنتاجه وتسويقه. وهذا مرآة فظاظة ذوق الطبقة الحاكمة الجديدة، وحسبانها أن "البروليتاريا" لا تحتاج إلى ما يفوق موارد الحياة البيولوجية.
ويدعو رابع الأصول إلى تناول التاريخ وفهمه على وجه حالٍ وجودية. وذلك نظير إيجاب التاريخ "الكبير"- الظرف التاريخي أو العصر الذي يرسي وجود البشر وعلاقاتهم بالعالم الاجتماعي والطبيعي على أركان مختلفة- حالاً وجودية جديدة. فدوبتشيك، أمين عام الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي (1968- 1969)، في أثناء "ربيع براغ" وسحقه، يختار خفة الكائن... من حوادث الربيع السياسية كلها رواية خطبته في الراديو، بعد خطفه وسجنه ثم ردّه إلى منصبه بعض الوقت قبل عزله. ومن الخطبة "السياسية" تختار الرواية التنبيه إلى فواصل السكوت الطويلة والمرهقة التي تتخلل جمل الزعيم العائد قسراً، وتشي بضعفه.
والضعف الروائي، الماثل في صورةٍ (إيقاع) وفي حسٍّ (سمع) أقوى (إذا جاز القول) عبارةً وجودية من الضعف الاستراتيجي الذي تخلص مقارنة موازين القوى "على الصعيد الدولي" إلى تقريره. ومن هذا الباب تطل الرواية على صور ضعف أخرى. فالدوار، دوار ياروميل ودوار تيريزا...، وهو "انتشاء بضعف النفس" و"إرادة انهيار في الطريق العام على رؤوس الأشهاد"، من صور هذا الباب. ويحمل تيريزا ضعفُها على ترك براغ، عاصمة "بلاد الضعفاء" وتعيدها خيانات توما إلى هذه البلاد جراء فعل "مادة" الضعف.
وراثة الآباء
فالشخصيات الروائية (الغربية) هي ختام أو عصارة تاريخها الفردي، وختام تاريخ المغامرات الأوروبية على وجهها الوجودي. والختام يعني التكثيف والجمع على صور بعضها مسرحي، وبعضها كاريكاتوري. وهما يتناولان التاريخ الثوري الأوروبي، والفن الشعبي "الألفي"، والمثالات الغرامية والإيروسية (دون جوان، شأن الدكتور هافيل في غراميات...)، ووجوه الشعر والشعراء، والحياة اليومية النثرية التي تسودها الحماقة، أو تردد صدى ماضٍ أسطوري متوارٍ، وتنبعث فيها غنائية فتية تلد الأعياد والمجازر، وتنحل في حاضر يفتت الأنا شظايا تعصى "(الجمع) في صدر رجل واحد"، وتشيع الالتباس الداعي إلى الضحك والتشكك الأليم في ما تتناوله.
ويريد ميلان كونديرا لنفسه، وهو روائي على نحو وجودي، ألا يشذ عن سنن "آبائه" الروائيين الذين "ولدوه"، ولا يكف عن رواية أيامهم وأعمالهم وأنسابهم، وبسط أواصره بهم. وعلى هذا، حمل نفسه وعمله (جملة أعماله) على مكان، معنوي وأرضي، من الجغرافيا الأوروبية الغربية، هو أوروبا الوسطى، وليس "الشرقية"، وعلى وقت تاريخي، هو ما بين الحربين العالميتين ثم غداة الحرب الثانية واستيلاء ستالين على الوسيط بين الإمبراطورية الروسية وبين الغرب، و "التهامه" هذا الوسيط.
وهذا الوسط تأهله أمم صغيرة ومتوسطة، مساحةً وعدد سكان وأدواراً سياسية وعسكرية. وهي، على خلاف روسيا، صورة عن "أقصى التنوع في المكان الأضيق"، على قوله في الستارة (2005). وجمع معظم هذه الأمم في باب السلافية خُلف تاريخي وثقافي فادح. والسمة الفارقة التي تخالف بها الأمم الصغيرة الأمم الكبيرة، والعادِيَة أو العدوانية غالباً، هو ضعف يقين أهلها بوجودها وجوداً راسخاً وبدهياً.
فوجودها، في وجدان سكانها، سؤال أو رهان ومغامرة. وتضطر هذه الأمم إلى التحوط من التاريخ، وهو قوة قاهرة تتجاوز الأمم الصغيرة، والمحاماة عن نفسها من قهره. فالبولنديون يستهلون نشيدهم الوطني بالإنشاد: "بولندا لم تمت بعد". وينزع الوسط أوروبيون إلى العالمية الثقافية. وذروة ما أخرجوه إلى العالم في الموسيقى، والرواية والمنطق والفلسفة، بين الحربين، اشترك في هذه الصفة، وخالف نزعة العالم البيزنطي، الروسي، إلى الخصوصية المحلية والتاريخية.
روسيا البيزنطية/ الغرب
فالعالم البيزنطي يدين بالأرثوذكسية، حين يمزج وسط أوروبا الغربي، مذاهب مسيحية متفرقة. وكان يان هوس (1369- 1415)، البوهيمي التشيكي، ومعاصر إيفان الرهيب، آذن بالإصلاح البروتستانتي وسبق كبار رواده إلى مخالفة الكنيسة الكاثوليكية. والعمارة البيزنطية لا تمت بقرابة إلى العمارة الغوطية الوسطى وغرب أوروبية. والألفباء الكيريلية، اليونانية المصدر، غير ألفباء أوروبا الوسطى، اللاتينية الغربية.
بل إن شيوعية بلدان وسط أوروبا، رغم فرضها قسراً وعنوة وفتحاً عسكرياً، شيوعيات "وطنية" ومحلية، على ما تبيِّن محاولات المجريين والبولنديين والتشيكوسلوفاكيين، مع كادار وغومودكا ودوبتشيك، ونقابة "سوليدارنوسك" (ليخ فاونسا، "فاليسا") في آخر المطاف. وعصر النهضة الأوروبي، وهو منعطف في سياق تاريخ القارة، لا نظير له في التاريخ الروسي. والعلاقة الوثيقة بألمانيا والعالم الجرماني من ثوابت تاريخ البولنديين والسلوفاكيين والكرواتيين والسلوفينيين والمجريين... بينما يسم النفور والعداء (إلى اليوم "الأوكراني"، ووسم "زد" Z على الأسلحة الروسية ومعناه: "إلى برلين"!) العلاقات الروسية- الألمانية.
ولم تحاول هذه الأمم إنشاء إطار مشترك. ولم تُشعرها السلافية بآصرة جامعة. وهي أقامت على حدود مضطربة وملتوية تعصى الترسيم الدقيق. ويقرب بينها تشاركها قواسم ثقافية وتجارب تاريخية في إطار أبنية ومؤسسات مختلفة وحدود متحركة وغير نهائية. فكانت هذه الأمم مهد إصلاح ديني عميق آذن برفع السحر والألوهة من العالم. وأنشأت جامعات "أوروبية" قبل إنكلترا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وقاومت الغزو التركي العثماني طوال قرنين. وثوراتها على الإمبريالية السوفياتية صفحة متناغمة آلت إلى تصديع الإمبراطورية من الداخل، وإلى انهيارها المستمر والمتناسل.
آية التخلي الأوروبي الغربي، على قول كونديرا المرير، أن الغرب لم ينتبه إلى سلخ أوروبا الوسطى منه، وماشى تسميتها الروسية بـ "أوروبا الشرقية"، غافلاً عن هويته ولحمة تاريخه المشترك
ويذهب كونديرا، في مقالة كتبها ونشرها في لوديبا الفرنسية، 11/1983، غرب مختطف أو مأساة أوروبا الوسطى، إلى أن "الشيوعية" السوفياتية كانت أداة "روسنة" وسط أوروبا، ودمج الأوكرانيين والبلاروس والليتوانيين.. في "شعب سوفياتي" لا سند له في شيء تاريخي أو وجودي. والشيوعية (السوفياتية) هي نفي لشطر راجح، الدين، من التاريخ الروسي، من وجه، وتمام الوجه الإمبراطوري والمركزي، القيصري، من هذا التاريخ.
ولا يحتفل كونديرا بتحرير وسط أوروبا من الشيوعية السوفياتية الروسية، وبعودة هذه الأوروبا، على ما كان شاعرنا (اللبناني) قال، إلى الحضن والحمى الغربيين، وإن استقبل الانهيار السوفياتي بالترحيب، وعدّه تقويماً عادلاً لانحراف واعوجاج قسريين ومتعسّفين. وإذا كان اجتياح روسيا تشيكوسلوفاكيا رمى أوروبا الوسطى وزجها في "حقبة ما بعد الثقافة"، وهي حقبة "ما بعد أوروبا" و "ما بعد الرواية"، فالغرب كله، من غير اجتياح سوفياتي عسكري أو سياسي، دخل هذه الحقبة- المريضة بالحمى الإعلامية، و "الالتزام" الإيديولوجي، وخسارة وجدان الهوية الثقافية- من تلقائه. وآية التخلي الأوروبي الغربي، على قول كونديرا المرير، أن الغرب لم ينتبه إلى سلخ أوروبا الوسطى منه، وماشى تسميتها الروسية بـ "أوروبا الشرقية"، غافلاً عن هويته ولحمة تاريخه المشترك.
وعلى هذا فلرواية الضعف والشتات والوجوه المتنافرة من أنا طيفية والتشكك في متانتها، مستقبل أسود.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.