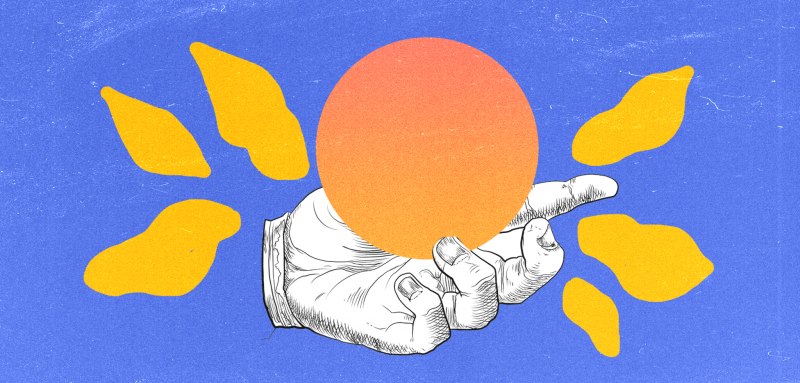تقول القاعدة: لكلّ شيء في الحياة والواقع صناعة يدويّة حتّى في أغرب حالات الحبّ وأكثرها عِتهاً أو جنوناً. ومن هنا اكتسبت تلك اليد الجميلة السيّئة التي تعمل هذه السمعة الجميلة السيّئة التي تبقى.
أيضاً قاعدة ثانية: لكلّ تجربةٍ غراميّة مُعيّنة أو وَلهٍ مُعيّن، مُعادل جسدي تُقيّدُ إليه، كما ذلك السّرج على ظهر حمار، أو كما ذلك الشِّراع على ظهر قاربٍ شراعيّ، لا فرق كبير.
قاعدة ثالثة احتياطيّة: يبقى ذلك الضّحك مِرآة تلك العنزة التي تصل أوّلاً إلى رأس النّبع، والحمار والكلب آخر من يصل!
***
في بداية صيف عام 1992، وبالتّحديد عندما تخطّت مهنتي الموازية ‑ كعاشق ‑ سنّ المراهقة بقليل، أي فيما يُقارب الثلاثين من عمري آنذاك، وعندما كنتُ خارجاً للتوّ من أداء خدمتي الإلزاميّة اللّعينة بآثار نفسيّة بليغة، حيث قضيتُ نصفها تقريباً في معسكرات التأديب والسّجن، وكان عليّ البدء مرّةً أخرى من تحت الصفر لإعادة هيكلة حياتي، أخذتُ قراراً بالعودة إلى عملي المعتاد في فنّ الديكورات لكسب مصدر رزقي، تلك المهنة اللّعينة الأخرى، والتي رافقتني منذ سنواتي الأولى في الجامعة.
لا يمكن بالطّبع إحصاء ذلك العدد من المرّات التي قالت لي فيها أحبّك، مع تلك المتواليات الهندسيّة المنخفضة والمرتفعة الخاصّة بكل آهة في كل حديث تبادلناه على الهاتف
وفي إحدى الليالي، وبينما كنتُ أعمل في دمشق في إحدى الورش المسكونة لأحد الميسورين، والتي اؤتمنتُ عليها بما فيها من حواش منزليّة، لكوني ثقة من طرف ثقة، حيث سُمح لي بالإقامة في البيت طوال فترة العمل، شرط أن أُسلّم البيت في الوقت المُحدّد دون تأخير، جاءني هاتف من امرأة في الثانية عشرة ليلاً تسال عن شخصٍ ما كان يسكن سابقاً هنا، وعلمتُ منها أن هذا البيت كان يقطنه طلاّب مستأجرون، لكن نبرة صوتها المخمليّ حرّكَ فيّ شيئاً غريباً. كنتُ قد فرغتُ للتّو من كأسي الثالثة وأتهيّأ للرابعة ، ما جعلني أكثر استعداداً للّعب والمغامرة، فتبادلتُ معها حواراً شخصيّاً ظريفاً خفيفاً قصيراً طليقاً، التقط كلٌّ منّا جانبه الخفيّ بخفّةٍ شديدة، كصيّادٍ ماهرٍ يُريد أن يُوقع الآخر في شباكهِ من أوّل رمية.
وحدث ما حدث
قد يحدث في الحياة، أو في أدبيّات الحبّ، الكثير ممّا يُطلق عليه "الحبّ من أوّل نظرة"، لكن من أوّل صوت كان من الأمور النادرة بالفعل... نعم... هناك أصوات مشغولٍ عليها بعنايةٍ فائقةٍ لأنّها ذات جاذبيّة خاصّة أقرب إلى الموهبة، ويجب استثمارها جيّداً في الحياة، وهي كانت تعي ذلك على وجه الدقّة، وتذهب في نبرة الإغراء الخاصّة بها إلى حدِّ المبالغة المُضحكة أحياناً.
كنتُ أنتظرها يوميّاً في الثانية عشرة ليلاً لنتابع ما بدأنا به من أحاديث، وبعد خروج زوجها إلى عمله اللّيليّ، وفي الوقت الذي أكونُ فيه أيضاً بأشدّ حالات سكري، أو تلك الحالات التي يشعر بها المُنتشي بقدرته الكبيرة على فرض إيقاعه الخاصّ.
لكن لم يكد يمضي يومان أو ثلاثة ‑ وبعد أن أخذت منّي تقريباً كلّ الأشياء الضروريّة التي ينبغي عليّ قولها لكسب ثقتها ‑ حتّى أسرّت لي بدورها أنّها هي أيضاً تكتب الشّعر، وترغب بشدّة لو استطاعت أن تنشر شيئاً من نتاجها في إحدى الجرائد أو المجلّات. هنا بالطّبع جاءت فرصتي لإثبات قدرتي أيضاً في هذا المجال.
طلبتُ منها أن تُملي عليّ إحدى قصائدها لكي أنشرها في مُلحق جريدة الثورة الثقافي. لم تُصدّق في البداية، لكن عندما أكّدتُ لها أني أمون على أكثر من صديق حمار يعمل بها فرحت بشدّة، لكن للأسف الشّديد ما أملتهُ عليّ ليس فيه شيء من الشِّعر، بل عبارة عن بعض الجمل الملطوشة من هنا وهناك بطريقةٍ مُفكّكة، مُضحكة، مُثيرةٍ للشفقة والسخرية معاً، والآن ماذا عليّ أن أفعل؟ يجب أن أنشرها بأيّة طريقة وإلّا فلن تدعني أراها قريباً، وقد تطول هذه الحالة التي نمرُّ بها، وأنا لم أعد أحتمل أكثر من ذلك!
فعلتُ ما كان ينبغي لي فعله. أخذتُ ثلاث جُمل من القصيدة بدت لي معقولة، وكتبتُ عليها قصيدة "إيروسيّة" مُحكمة لن يرفضها أيّ "حنش" في مُلحق جريدة الثورة الثقافي، وعلى وجه الخصوص عندما يرى اسمها الثلاثي تحت القصيدة.
تناولتُ الهاتف واتصلتُ بصديقٍ لي يمون بشكل مباشر على جريدة الثورة. قلتُ له: "أريد منك أن تنشر لها هذه القصيدة". ضَحِك بشدّةٍ وقال لي: "لكن يا علي سيعتقدون أنّها لصاحبتي!". قلتُ له: "الأمر ضروري جدّاً بالنسبة لي". ثمّ أمليتها عليها عبر الهاتف.
بالفعل لم تمض ثلاثة أيّام حتى نُشرت القصيدة التي كانت تسألني عنها بإلحاح شديد، وعندما قلتُ لها إنّ القصيدة ستُنشر غداً في الملحق، طار عقلها من شدّة الفرح، وفي صباح اليوم التالي بعثت زوجها لكي يشتري لها خمسة أعداد من المُلحق الثقافي لتوزّعها على صديقاتها.
على ما أذكر قلتُ لها في ذلك اليوم: "والآن عزيزتي. ألم يحن الوقت بعد لنلتقي؟ أريد أن أعرف فحسب إن كنتِ جميلة بحقّ كما تدّعين، أو كما بدوتِ لي في صوتكِ على الأقلّ!".
قالت: "لا تخف أبداً. أنا أجمل من صوتي بكثير. حسناً. أراكَ غداً في الحادية عشرة في مقهى الهافانا. هل استرحت الآن؟!".
نعم استرحت. إلى الغد إذاً!
إلى الغد!
***
كأيّ عاشقين أنهكهما الوجد والانتظار لمدّة سبع ليال بكاملها، لا يمكن بالطّبع إحصاء ذلك العدد من المرّات التي قالت لي فيها أُحبّك مع تلك المتواليات الهندسيّة المنخفضة والمرتفعة الخاصّة بكل آهة في كل حديث تبادلناه على الهاتف، وأعتقد جازماً لو قُيّض لي جمع تلك الآهات في كيسٍ الآن، لملأت كيساً كبيراً، من ذلك النّوع الذي يضعون فيه الطحين، ومن ثمّ يحملونه على الأكتاف ويذهبون به إلى الفرن مشياً على الأقدام.
كان الأمر بالفعل جنونيّاً إلى حدٍّ كبير، ومُثيراً للشفقة والضحك في آن؛ حاجة كلٍّ منّا للآخر... هي لأسباب خاصّة ستتضح لي شيئاً فشيئاً فيما بعد، وأنا بدوري مع تلك الغيابات القهريّة القادمة من مجاعة ثلاث سنوات. أنا الخارج للتّو من أداء خدمتي الإلزاميّة والتي كادت أن تودي بثلاثة أرباع عقلي.
سأذكر بلا ريب ما حييت تلك اللّحظات التي لا تُنسى عندما التقينا لأوّل مرّة، كيف ضممنا بعضنا كأطفالٍ صِغار، وتبادلنا تلك القبل على مرأى من الجميع في المقهى، ثمّ صعدنا بسرعة إلى الطابق الثاني من أجل بعض الخصوصيّة... يا لها من امرأة! فيما يخصّ جمالها، لم تكن تَكذِب أبداً.
في تلك اللحظات لم تكن لقوّةٍ أن تفكّ يدي المُلتفّة حول كتفها. وأنفاسنا التي كانت تمتزج مع كلّ قبلة لم يكن ليقطعها سوى ظهور ذلك النادل الذي تنحنح فجأة وهو يبتسم ابتسامته المُلغّزة تلك ليسألنا عن طلبنا... انتبهت إليه بشيء من العصبيّة والارتباك وقلت: "قهوة... قهوة من فضلك!".
عندما استدار النادل ليحضر القهوة انتبهتُ إلى نفسي قليلاً، سحبتُ القميص من تحت البنطلون وأرخيتهُ فوقه كيلا يُفتَضَح أمري. نظرتُ يمنةً ويسرة في المقهى، ولحسن الحظّ لم يكن أحد في المكان سوى ذلك النادل الذي غادر للتّو. ضَحِكتْ هي وقالت: "لن ينام أيركَ أيضاً هذا اليوم". يسعد ألله! تلك الجملة التي أعرفها جيّداً والأثيرة على قلب أيّة امرأة في حالات مُماثلة. ثمّ وضعت يدها عليه لكي تتحسّسهُ، فأزحتُ يدها عنه بهدوء وقلت: "هذا ما كان ينقصنا الآن. لا تفضحينا أكثر من ذلك".
ثمّ عدّلتُ من جلستي قليلاً لكي أهدأ قليلاً أو يهدأ هو، وما كان ليهدأ!
***
‑ أووو، أهذا أنتِ! لم أنتبه لقدومكِ. منذ متى وأنتِ هنا؟
‑ طرقتُ الباب فلم يستجب أحد. رأيته نصف مفتوح فدخلت، ثمّ سمعتُ صوت الدوش فعلمت أنّكَ في الحمّام!
‑ ما هذا الذي في يدكِ. أليس دفتري؟
‑ نعم. رأيته على الطاولة وقرأتُ ما كتبت بدافع الفضول... هل هذا فصل من رواية؟
‑ لا. مجرّد تمرين فقط من الذّاكرة!
‑ نعم. لقد حكيتَ لي عن هذه المرأة من قبل. لِمَ لا تتابع لي سرد الحكاية من حيث توقّفت الآن. أنا أسألك وأنت تُجيب. اعتبر الأمر مجرّد تمرين على الكتابة!
‑ ومن سيكتب؟
‑ لا أحد. هات آلة التسجيل. سأسجّل لك. انتظر قليلاً. هل أنت مستعدّ الآن؟
‑ حسناً... لِمَ لا؟!
‑ سأبدأ بهذا السؤال: ألم يعلم زوجها بعلاقتكما الغراميّة؟
‑ بالتأكيد كان يعلم، لكنّه كما قال أحد الروائيين ذات يوم عن حالة مُماثلة: "كان يتجاهل الأمر ويحرص على ألاّ أعلم أنّه يعلم، وأنا كنتُ أتجاهل أنّه يعلم وأحرص على ألاّ يعلم أنّي أعلم".
‑ كيف؟
‑ حسناً سأقول لكِ. لقد قدّمتني في البداية إليه كشاعر صديق يُريد أن يعطيها بعض الدروس في اللّغة العربيّة، كونها نصف أميّة ولا تحمل سوى شهادة ابتدائيّة و...
‑ وشاعرة!
‑ إذا كنتِ ستغارين وتقاطعينني هكذا لن أُكمل!
‑ أغار؟ لا... لا... تابع من فضلك. لكن ماذا حدث لتلك الورشة التي كنت تعمل بها؟ ألم تأخذها إليها؟
‑ لا قطعاً. لكن صاحب البيت أعطاني مهلة أسبوع إضافي آخر لأنهي عملي الذي طال كثيراً، وكان عليّ مُضاعفة العمل لإنجاز بقيّة التشطيبات... كنتُ بأمسّ الحاجة لما تبقّى من المبلغ الذي سحبتُ ثلاثة أرباعه من أجور عملي، كما أنّنا كنّا قد اتفقنا أنا وهي على قضاء ثلاثة أو أربعة أيام في اللاذقيّة، لذلك كان عليّ، بمجرّد وصولي إلى اللاذقية، طباعة دعوة وهميّة لها للمشاركة في أمسية شعريّة، وذلك لإقناع السيّد زوجها بالسماح لها بالذهاب... ذلك الرجل البسيط اللطيف، والذي كذبتْ عليه وقدّمتني إليه كصديق تعرّفت عليه في مكتب جريدة الثورة، أنا الذي يُريد مساعدتها بشكلٍ جدّي لتحقيق طموحها في الكتابة والنشر إلخ... والذي بدوره استراح لي بالفعل لما رآه من حديثي الّلبق ذي النبرة الخجولة الهادئة، المُتضمّن حصراً في ذلك المُحيا البريء الذي كان تبدو على هيأتي، كما على هيئة تلك الشياطين التي اعتمدت فجأة العودة إلى هالتها الأولى لضرورة السّياق الذي كان لا بدّ منه لتنفيذ غاياتها ومآربها.
كان واضحاً أنّ الرّجل يُحبّ زوجته وأسرته الصغيرة حدّ الجنون، وأنّ هناك مشكلة نفسيّة كبيرة لدى زوجته يُريدها أن تتغلّب عليها، وأنا كنتُ ذلك المُنقذ. كان يريد أن يطمأنّ إلى فكرة أنّ هذا العاشق لن يؤذي زوجته قطّ، ولم أكن يومها من الغفلة لكي تمرّ عليّ تلك التواطؤات السّريّة لكلّ منهما، بل كنتُ أبتسم في سرّي وأعي بدقّة دوري هذا.
كان لكلٍّ منّا شياطينه الخاصّة التي تعمل بهدوء وفق ما تمليه عليها الضرورة البحتة. لذلك عندما أنهيتُ عملي في الورشة وقبضتُ ذلك المبلغ المُستحقّ من أجري غادرتُ بذات اليوم إلى اللاذقيّة، وبعثتُ لها في اليوم التالي دعوة مطبوعة على الكمبيوتر للمشاركة في أمسية شعريّة، إضافةً إلى وعدي باستضافتها لمدّة أربعة أيّام في فندق مُحترم على نفقتي الخاصّة، وكان عليّ تثبيته بالفعل لكي يُتاحُ لزوجها التحقّق منه باتصالٍ هاتفيّ.
‑ لحظة، لحظة. هل كانت ستنام حقّاً في ذلك الفندق؟
‑ نعم بالطبّع. وهل كانت لتُضيّع على نفسها تجريب كل أنواع الشّامبو الفاخر؟ كما أنّه كان لديها النهار بأكملهِ إلى العاشرة ليلاً لقضائه معي... أنتِ تعلمين البقيّة!
‑ كم قصيدة نشرتَ لها في ملحق الثورة؟
‑ واحدة فقط. أمّا البقيّة فكانت تنشرها بنفسها. كان الأمر بسيطاً جدّاً، وكانت تتعلّم بسرعة كبيرة كلّ شيء إلاّ كتابة الشعر الذي تركته على عاتقي، وكنتُ قد أوضحتُ لها سابقاً انّها تستطيع أن تقتحم بحذائها مكتب أيّ مجلّة أو جريدة سوريّة، وسيكون جميع العاملين فيها، من صحفيين وكتّاب وشعراء، تحت تصرّفها، وهذا ما حدث بالفعل!
‑ هل كانت هي المرّة الأولى التي تزور فيها اللاذقيّة؟
‑ لا ربّما المرّة الثانية على ما أذكر. لكن عندما أتيت إلى الكراج لاستقبالها، نزلت من الباص وفي حضنها دبدوب أحمر كبير جدّاً لدرجة مضحكة. كانت من النّوع الثرثار، لا ينطبق لها فم ولا تختفي لها ضحكة، وعلى ما يبدو قد تعرّفت في الباص على امرأة وزوجها، كان واضحاً عندما اقتربتُ منها لآخذ حقيبتها من الدرج الجانبيّ للباص، أنّه كان لها تأثيرٌ شديد عليهما بما يُشبه السّحر، فأرادت زوجة الرجل أن تأخذها معها إلى البيت أوّلاً، ولا أعرف حقّاً ماذا همست في أذنها عنّي، ثمّ نظرت إليّ تلك المرأة نظرة احتجاج وريبة واضحة، لكنّي كنتُ قد خطفتُ تلك الشنطة ووضعتُ يدي حول خصرها وابتعدنا مُسرعين غير مُكترثين بها، وسط دهشتها الشّديدة، والتي جعلت منها حشريّتها تِلك مجرّد مُغفّلة كبيرة، وربّما كانت تُريد حمايتها منّي، أو بإيعاز خاصّ من زوجها الأحمق هو الآخر، والذي وقف على بعد خطوات منها وهو يرمقني بنظرة لئيمة تملؤها الغيرة، وكأنّه يقول لي: "يا لك من محظوظ يا ابن العاهرة!".
كان الأمر بالفعل جنونيّاً إلى حدٍّ كبير، ومُثيراً للشفقة والضحك في آن؛ حاجة كلٍّ منّا للآخر... هي لأسباب خاصّة ستتضح لي شيئاً فشيئاً فيما بعد، وأنا بدوري مع تلك الغيابات القهريّة القادمة من مجاعة ثلاث سنوات. أنا الخارج للتّو من أداء خدمتي الإلزاميّة والتي كادت أن تودي بثلاثة أرباع عقلي.
أخذت تاكسياً إلى الفندق، انتظرتها في البهو لتوضيب أغراضها، ومن ثمّ إلى الضيعة مباشرة إلى غرفتي المنفردة في وسط الطبيعة، العارية إلّا من سرير وكنبة وطاولة، وعدّة مطبخ صغيرة، إضافةً إلى حمّام ومرحاض خارجي. تلك الغرفة الشهيرة عند أصدقاء الثمانينيات "الخَرَوَات"، والتي كتب بعضهم قصّة رديئة عنها وعنّي، وعن حبيبته التي ما زال يعتقد إلى الآن أنّها ربّما تكون قد خانته معي، مع أني أصلحتُ له الأمر لاحقاً، لكن لا أحد يعلم ماذا كانت قد أوحت له لتنتقم منه!
‑ كم مجموعة كتبت لها؟
‑ اثنتان فقط... الأولى طبعتها على حسابي مع لوحة الغلاف التي رسمتها بنفسي، إضافةً إلى كلمة الغلاف، مع خطأ بنقطة أصرّت وهي تضحك على عدم تصحيحه؛ فبدلاً من كلمة "قصائد ساخرة" أصبحت ساحرة، ما جعل الناشر صديقي يُعاتبني بشدّة على هذه الكلمة فيما بعد، لكن كان قد فات الأوان وطُبع الكتاب... ذلك الكتاب الذي تركتُ لها منه خمسين نسخة فقط لتوزّعها على أصدقائها ومعارفها، ثمّ اشتريتُ منها الباقي ورميته دفعة واحدة في السّاقية المجاورة لغرفتي، كَمَن يتخلّص من جريمة قتل ارتكبها ولا يُريد لأحد أن يعرف شيئاً عنها!
‑ والثانية؟
‑ تلك قصّة ومهزلة أَخرى... كنتُ قد يَئِستُ منها تماماً، إذ إنّ مجموعة الرسائل والقصائد التي كانت تبعثها لي بالبريد لأنتشل منها شيئاً مُمكناً وأبني عليه كانت من الرداءة بحيث أصبح مصيرها حاوية القمامة قطعاً، إضافةً إلى أن نصفها قد ضلّ الطريق إليّ مع دستة كاملة من رسائل الغرام التافهة التي كانت تبعثها، وذلك لأنّ صندوق البريد الذي أعطيتها رقمه كان لطبيبٍ صديقٍ لي، والذي كنتُ أعرجُ إلى عيادته كلّ فترةٍ لآخذها منه، كان يناولني إيّاها ويقول لي وهو يُقهقه: "أنا آسف... لقد وجدناها مفتوحةً هكذا، ولم نستطع أن نمنع أنفسنا من قراءتها أنا وفُلان".
وفُلانٌ هذا صديق آخر وشاعر معروف، كان لا بدّ سيحصل على مزيد من المتعة في التجسّس عليّ، وربّما ليُقارن ذلك بما كان سيفعله معها لو كان مكاني، أو ربّما فعل ذلك قبلي مع نساء أخريات كما كان يُشاع عنه. من يدري! ناهيكِ عن أنّ عناصر الأمن السياسي كانوا يفتحونها ليقرؤوها وأحياناً كثيرة لا يُعيدونها إلى الصندوق. لقد فاجأني أحدهم إلى حدّ العظم بعد سنوات من ذلك، عندما كنتُ أعمل في ورشة بعيدة في أحد الأرياف، بقوله: "لقد كنّا نفتح رسائلك في البريد وننسى أحياناً أن نُعيدها. على فكرة... ماذا حدث لتلك المرأة التي كانت تُحبّك إلى هذا الحدّ؟!".
ضحكتُ يومها لشدّة المُباغتة وقلتُ له: "هذا كان أنتم يا عرصات!".
لذلك كلّه كان عليّ أن أتصرّف بسرعة كي أرتاح من ذلك الكمّ الهائل من الرسائل التي كانت تبعثها بالبريد، والتي كانت تأتي لي بنفسها كل شهر تقريباً بمجموعة كبيرة منها، بعد أن جعلتها تكفّ عن إرسالها... ولذلك، وعلى وجه السرعة، قرّرتُ أخيراً ان أكتب لها مجموعة ثانية كي أرتاح من إلحاحها الشّديد، وهكذا من "قفا يدي" هذه كتبتُ لها مجموعة "إيروتيكيّة" مُحكمة، من الزنّار وما تحت، وطلبتُ منها أن تضعها في وزارة الثقافة السوريّة، وأنا على ثقة مُطلقة بأنّها ستُنشر، وهذا ما حدث بالضبط، مع مُقدّمة طويلة بارعة كتبها لها أحد الأدباء الموظّفين في وزارة الثقافة، والذي تعرّفتْ عليه عندما ذهبت إلى الوزارة، والذي أصبح الآن واحداً من ضباع الثورة كما يُقال عنه.
بعده تتالت الكتابات عنها من قبل شعراء سوريين في الصحف السوريّة، تمتدح على وجه الخصوص جرأتها الشديدة، وأكثر ما أضحكني نصّ نقدي في جريدة "الديار" اللبنانيّة لشاعر قصيدة نثر لبناني معروف، أثنى بشدّة على تجربتها هذه، واعتبرها فريدة من نوعها في الوطن العربي... لكنّ المسكين توفّى بعد أشهر من ذلك!
‑ كم استمرّت علاقتكما معاً؟
‑ إلى أقصاها. حوالي سنتين ونصف. كنتُ كلّما أنهيتُ ورشة وقبضتُ مبلغاً جيّداً من المال، أتصل بها لتقضي أسبوعاً عندي... كان العمل جارياً على قدمٍ وساق آنذاك، ولم أكن لأنهي ورشة حتى أبدأ بأخرى... كان لديّ طاقم عمل من مجموعة طلاّب في الجامعة، يحلفون برأسي لكثرة ما كنتُ سخيّاً معهم، ولم يكونوا ينادونني إلاّ بالريّس علي... يا لها من أيام!
‑ ألم يكن لديها حبيب آخر غيرك آنذاك؟!
‑ حبيب! قولي صاحب قولي أيّ شيء آخر غير هذا. لا أعرف بالطّبع. وهل كانت لتدعني أعرف؟! على ما أذكر، آخر مرّة زارتني فيها في اللاذقيّة، لحقها بعد يومين شابّ نحيل وطويل، كان قبيحاً لدرجةٍ لا تُصدّق، لديه عينان ضيّقتان وأنف طويل معقوف كطائر أبو منجل. رأيتهما في بهو الفندق عندما كنت قادماً لآخذها إلى الضيعة، كانا جالسين على الكنبة بطريقة أقرب إلى الحميميّة، قدّمته إليّ كصديق جاء ليطمئن عليها. جلستُ لدقائق معدودة، ثمّ تركتهما معاً وخرجتُ ولم أتصل بها مرّةً أخرى. كان من الواضح أنّ علاقتنا قد بدأت تلفظُ أمعاءها منذ فترة، أيضاً بدأتُ أنتبه إلى رائحة فمها الكريهة أحياناً، حيث لم أكن لألحظ ذلك سابقاً، وأشياء أخرى أُفضّلُ عدم ذكرها الآن. نعم... كان كلّ شيء يتفسّخ كجثّة حقيقيّة، فذهب كلٌّ منّا في حال سبيله!
بعده تتالت الكتابات عنها من قبل شعراء سوريين في الصحف السوريّة، تمتدح على وجه الخصوص جرأتها الشديدة، وأكثر ما أضحكني نصّ نقدي في جريدة "الديار" اللبنانيّة لشاعر قصيدة نثر لبناني معروف، أثنى بشدّة على تجربتها هذه، واعتبرها فريدة من نوعها في الوطن العربي
‑ أووه... كم الساعة الآن؟ يا إلهي... لقد تأخّرتُ كثيراً عن عملي... أمّا قصّة غريبة بالفعل، تصلح لكتابة رواية! بالمناسبة، ماذا حدث لمجموعتي التي تركتها لك في المرّة الماضية؟ أريد أن أنشرها في هيئة الكتّاب المصريّة، لي صديق شاعر هناك وعدني بنشرها!
‑ أيّة مجموعة؟
‑ تلك التي تركتها لك... هل رميتها أيضاً في السّاقية المجاورة؟
‑ آه تذكّرت. لا شكّ أنّك تمزحين! هل تعتقدين حقّاً أنّي أستطيع بعد هذا العمر أن أُكرّر ما فعلته؟! هي هناك بالمكتبة الصغيرة بجانب الباب. خُذيها وأنت خارجة. لقد كتبت لك بعض الملاحظات في ورقة صغيرة داخل المجموعة. أعيدي كتابتها بنفسكِ أو دعي صديقكِ الشاعر ذاك يكتبها لكِ من جديد!
‑ حسناً حسناً لا تغضب. لم أكن أريد أكثر من ذلك!
‑ بالمناسبة، ألم يبعث لك دعوة للذهاب إلى مصر؟
‑ نعم قريباً سأسافر إليه. ماذا تريدني ان أجلب لك من هناك؟
‑ سلامتك، سلّمي لي فقط على هيئة الكتّاب المصريّة فرداً فرداً... بالتوفيق الدّائم!
‑ إلى اللقاء إذاً.
‑ إلى اللقاء.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.