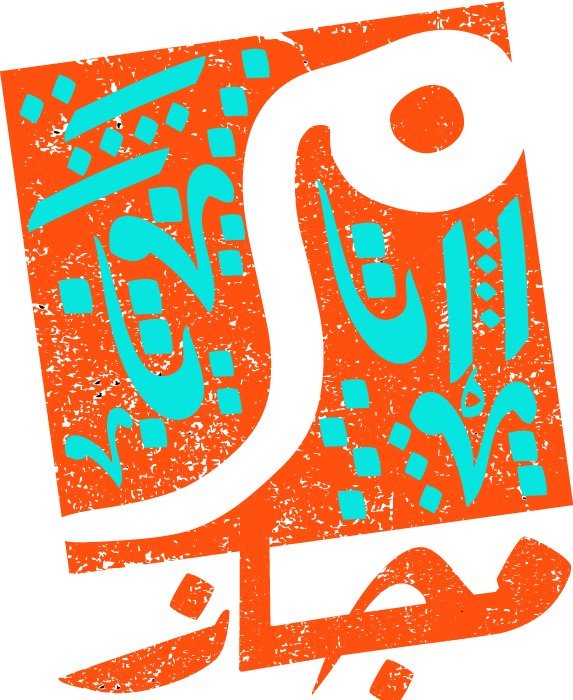
كان عبقرياً أول شخص فكر في إنشاء مقهى. لكن ربما لم يتوقع ما يمكن أن يفعله بعد أن صار المُتنفّس الوحيد للنميمة في أحوال السياسة والمجتمع، حتى أسقط الإمبراطورية العثمانية وأيقظ الأوربيين من حالة الثمالة، وانطلقت من عليه الثورة الفرنسية.
يمكن للمقهى أن يغير العالم. فماذا يمكن أن يفعل بإنسان؟
وانا قلبي لسه صعبان عليه
في المقهى، في شارع محمد محمود بوسط القاهرة، يبدو كل شيء جيداً. مكان متواضع يحتلّ ناصيتين، تشعر فيه بالهدوء والألفة. مع الوقت يتحوّل جلوسي هناك إلى طقس يومي.
أغلب روّاده من النشطاء السياسيين من الدرجة الثانية والثالثة، والفنانين البسطاء مثل سيد رجب، ويجلس عليه أيضاً كل من ضلّ الطريق أثناء سعيه وراء حلمه في القاهرة، مثل صابر.
شاب عشريني، طويل البنية ورفيع، يعشق كرة القدم ويتمنى أن يظهر في أحد البرامج الرياضية. وقف أمام طاولتي وسألني الجلوس كأنه يعرفني منذ زمن.
جلس، وقبل أن يعرّفني بنفسه، سألني في انبهار: "دول كلهم بنات بيشربوا شيشة؟! يانهار ابيض!".
لم أستغرب سؤاله؛ جاء صابر من قريته في الشرقية بعد أن وعده أحدهم بالظهور في أحد البرامج على قناة "الصحّة والجمال" ليتحدّث عن كرة القدم. لكن الشخص الذي وعده لا يردّ على هاتفه، فقرّر أن ينتظر على المقهى حتى آخر النهار، وإن لم يرد عليه سيعود إلى بلدته.
لم أفهم علاقة "الصحّة والجمال" بكرة القدم. كان حماسه أقوى من تساؤلي، رغم أن الشخص الذي وعده لا يجيب على هاتفه.
كان أيضاً سريع الكلام وسريع الانتقال من موضوع لآخر. ومعظم أسئلته عن التحرّر الذي يبدو عليه الناس هنا، وعن جمال الحياة هنا.
لوهلة أوجعني الفتى. لا الناس هنا متحرّرون ولا الحياة هنا جميلة. كانت سذاجته توقظ إحساساً بالشفقة تجاهه. ربما ضحك عليه أحدهم وداعب مخيلته وأوهمه أنه يستطيع مساعدته بالظهور في أحد البرامج.
لكنه رغم ذلك كان متحمساً. كان حماسه يشبهني في وقت ما من حياتي، وتمنيت للغريب الساذج أن يظهر في أحد برامج كرة القدم.
آمين.
جلس، وقبل أن يعرّفني بنفسه، سألني في انبهار: "دول كلهم بنات بيشربوا شيشة؟! يانهار ابيض!"... مجاز
لسه فاكر قلبي يديلك أمان
لاحظ صاحب المقهى في وسط البلد بالقاهرة أنني لم أشرب القهوة، فاعتقد أنها لم تعجبني. لم يستوعب منطقي بأنني أردت فقط الجلوس دون تناول قهوة أو فعل أي شيء، وكلما اعتقدت أن الأمر انتهى أتفاجئ بأنه يتصاعد أكثر فأكثر، حتى أحضر الصبي لتوبيخه.
ليس هناك ما يدور في رأسي لأدافع به عن الصبي، سوى أن أردّد: "القهوة عجباني، بس أنا عايز أقعد من غير ما اشرب حاجة". كنت أشعر بالغرابة لأنني أضطرّ لشرح الأمر.
لكنه لم يسمعني؛ كان منغمساً في فكرته عن سوء المشروب وخطأ صبي القهوة، وكأنه لا يرى إلا نفسه. ورجل لا يرى إلا نفسه لا يستحق الالتفات إليه.
وضعت حسابي على الطاولة وانسحبت بهدوء. ظللت فترة لا بأس بها أفكر في الجهد الذهني الذي بذلته لمحاولة إقناع صاحب المقهى أن يتغاضى عن الأمر. يُفترض أنه عادي أن شخصاً لم يتناول القهوة لأنه لا يريد تناول القهوة، لكنه جهد يعادل ربما يومي عمل كاملين.
وشعرت بالسوء أيضاً، لأن صاحب المقهى في النهاية كان يبحث عن رضائي. تمسكت به مثلما تمسك بي. عدت ثانية، لكن صبي القهوة أمسك تذكاراً أهداني إياه صديق، كنت أضعه أمامي على الطاولة، ثم بدأ في المزاح: "السلسلة دي بتاعتي خلاص!".
لم أستطع مجاراته كثيراً في مزحته. توقفت أنا، واستمر هو في مزحته. لم يظهر تذكاري ولم أعد إلى هناك ثانيةً أبداً.
لا بأس أن تضحي بتلك التفاصيل الصغيرة التي آلفتها. مكان طاولتك ومحيط الرؤية الذي توفّره والوقت بين جلوسك ونزول قهوتك واللحظة التي تبدأ فيها النسيان.
وإن كنت أقدر أحب تاني... أحبك أنت
رجل ربما جاوز السبعين، على أحد المقاهي في مدينة منوف. دوماً يمد يده إلى علبة سجائري ليأخذ سيجارة ثم الولاعة ليشعل السيجارة، وبعدها يعيد كل شيء كما كان. في كل مرّة أجلس على المقهى يفعلها، ثم يعود إلى طاولته ولا يقوم ثانية إلا حين وقت المغادرة، وأثناء جلوسه لا يتحدّث ولا يتفاعل مع أي شيء أو أي شخص، وكأنه يشبهني تماماً هذا المسن.
اعتقدت في البداية أنه ربما يعاني من خطب ما في عقله. مع الوقت لاحظت أنه لا يعاني من خطب ما. يبدو مظهره مُرتباً وملابسه نظيفة.
صار اقتحام الرجل لمساحتي الخاصة شيئاً مقبولاً، بل وأمسكت نفسي أفتقده في إحدى المرّات حين لم يأت إلى المقهى.
اختفى للأبد ولم يظهر ثانيةً. ربما هو الوحيد الذي كنت أراه هنا، وأيضا صبي القهوة.
شاب في نهاية عقده الرابع، ذو لحية غير مكتملة النمو، يلقبونه بـ "الشيخ أحمد". في المرّة الأولى على المقهى، كان هناك أربعة شباب يلعبون الطاولة. حتى بدأ أحدهم يسأل عن مائة جنيه كانت بجانبه منذ لحظات على الطاولة. بدأ صوته يعلو تدريجياً وهو يبحث عنها:
- الميت جنيييه يا جدعاااان، دي كانت لسااا هنا دلوقتييي
بدا أنه سينفجر بعد لحظات، غير أن الشيخ أحمد بادر بإخراج مائة جنيه من جيبه وأعطاها إليه.
لاحظ صاحب المقهى في وسط البلد بالقاهرة أنني لم أشرب القهوة، فاعتقد أنها لم تعجبني. لم يستوعب منطقي بأنني أردت فقط الجلوس دون تناول قهوة أو فعل أي شيء... مجاز
لم يكن هذا حقيقياً، رأيت الشيخ أحمد يلتقط المائة جنيه من على الأرض قبل أن يسأل عنها صاحبها، وبعد أن بدأ يسأل، أظهر الشيخ أحمد المائة جنيه. لكن ربما الانطباع الأول ليس عادلاً. كان صوته هادئاً. ولا تضطر لأن تناديه بعد أن تدخل. كان يبادر بالاهتمام بطلبك بمجرّد أن يراك. لم يحاول مرّة التحدّث معي، وأرى محاولاته الدائمة كيلا يلاحظني.
كان لديه طفل جميل وهادئ أيضاً، لا يتعدى عمره الـ 6 سنوات، يصطحبه دوماً معه إلى العمل. حاولت أن أتفاعل معه لكنه لم يكن يستجيب أبداً لتفاعلاتي، وكأن الطفل مثل أبيه، تدربا على ألا يلاحظا العالم.
بمرور الوقت، بات الشيخ أحمد جميلاً في نظري. يستقبلني بابتسامة وفي النهاية يودعني بابتسامة، وكأنه يعرفني تماماً هذا الشيخ.
قلب لا داب ولا حب ولا انجرح
مكاني المفضل مقهى في ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة، أجلس عليه في السادسة صباحاً قبل دخولي إلى العمل. في نفس الموعد يومياً يجلس 5 من سائقي التاكسي المُسنّين، يتبادلون النميمة والحكايات عن الركاب.
يبدو أنهم أصدقاء منذ زمنٍ بعيد. لأنهم متشابكون في كثير من التفاصيل. منطقة السكن والمهنة والعمر، ويضحكون دائماً. تشعر وأنت تستمع إلى حكاياتهم، أن سلوكياتهم التي تُزعجك في حياتك اليومية وخلال تنقلاتك معهم، تبدو خفيفة ولها غرض مقبول، كأن تضفي المزيد من المرح على ذلك اللقاء على المقهى.
مثل حكاية أحدهم عن محاولته إقناع راكب خليجي طلب تشغيل العداد، بأن تشغيل العداد ممنوع في مصر بأمر القانون، وفي النهاية اقتنع الرجل.
استغرقت في الاستماع إليهم إلى حد أنني نسيت أنني أنصت إليهم. كانوا يعرفون دائماً أنني اندمجت معهم منذ زمن، غير أنهم تجاهلوا وجودي، حتى قرّر أحدهم توجيه حديثه إليَّ في وسط حكايته عن السيدة الخمسينية التي حاول التعرّف إليها في التاكسي:
- كانت شاسيه!
ثم أخبرني أيضاً:
- شاسيه يعني مُزّة، عشان انت صغير وممكن تكون مش عارف!
ابتسمت ثم أخبرته في داخل عقلي فقط:
- ماشي ياجدو!
ربما هم سفراء التاكسي النبلاء، وكانوا في مهمة لتحسين صورة سائقي التاكسي الأبيض. ربما تدرك أن ما يُغضبك منهم هو في النهاية لغرض نبيل؛ لأجل صنع حكاية تُروى على المقهى. حكاية لن يرويها لك سائق أوبر لأنه يخاف من "التقييم".
وكأنهم أسروني تماماً هؤلاء المسنين. تمنيت أن أصير مثلهم حين أكبر. أدّيت كل ما علي من مسؤوليات ولا أفعل شيئاً سوى أن أضحك على العالم.
آمين.
وعايزنا نرجع زي زمان
ربما روادك ذلك الشعور مرّات، أن تترك عملك لتدير مشروعاً. ربما تحدّثت إلى صديق وأنتم تجلسون على مقهى عن رغبتك في ترك العمل وافتتاح مقهى. تظل فكرة مثيرة دوماً حين تحكيها، لكنها في النهار تتلاشى وكأنها لم تكن، لكن دوماً خطط الليل قد تكون قابلة للتنفيذ في النهار.
على نفس مقهى سائقي التاكسي الأبيض، بدأ الحاج أحمد، صاحب المقهى، في التقرّب مني. سألني عن عملي، وحين علم أنني صحفي، أخبرني أنه كان صحفياً في جريدة "الرأي" الكويتية، في أوائل التسعينيات، ثم ترك مجال الصحافة ليفتح مقهى في النهاية.
ربما هو الشخص الوحيد الذي حقّق حلمه بترك مجال العمل الصحفي لإدارة مقهى، وربما اتخذ القرار وهو يجلس على أحد المقاهي، يتناول قهوته وحيداً أو برفقة أصدقائه.
الحاج أحمد ربما هو التجسيد الواقعي للحلم الكلاسيكي لأي شاب مصري. حلم يذهب معي إلى قريتي. في قريتي الصغيرة في محافظة المنوفية مقهى، لو عرفه الناس سيحجّون إليه كل عام.
رجعوني عينيك لأيامي اللي راحو
حين مشينا على أربع لم نرى أبعد من أقدامنا وكانت عقولنا أقرب إلى الحيوانات، لكن حينما مشينا على اثنين، صار مستوى نظرنا أعلى وبات بإمكاننا رؤية الأفق، فتطوّرت لدينا القدرة على الخيال والحلم. تحديقنا في الأفق هو من يصنعنا كبشر. حب النظر إلى المساحات الشاسعة الفارغة يُشعرنا بالسكينة والهدوء ويحفز إبداعنا. تجربة كاملة وفريدة يوفرها المقهى.
لا تجلس على ضفاف النيل فحسب، بل أيضا أمام اللا شيء. المقهى والنيل والمساحات الخضراء اللامتناهية من ورائه. وأيضاً، لا شخص في العالم أفضل من صاحب المقهى، زياد، شاب ثلاثيني بملامح وجه هادئة، تعلوه ابتسامة لا تختفي، كأنه ولد بها.
يدرك زياد جيداً أنه لكي تكتمل أركان الراحة في المقهى، يجب أن يكون هناك حمام، كيلا يضطر أحدهم لمغادرة المقهى لأجل أن يدخل الحمام فقط. أنشأ حماماً مستقلاً بجانب المقهى، لكن لم تتركه "المهندسة أُمنية" مسؤولة المحليات، وشأنه. فرضت عليه إمّا أن يزيل الحمام أو يدفع غرامة تفوق قدرته.
المقهى كان آخر نقطة وصل إليها الاحتلال الإنجليزي، "أو البرابرة كما تسميهم جدتي". ربما لم ترد "المهندسة أمنية" أن تدنّس هذا الإرث.
لم يكن زياد هادئاً حين حكى لي الواقعة، وكذلك في حياته لم يكن هادئاً.
كانت سمعته عكس ما تُنبئ به ملامح وجهه. حتى أنه احتجز قريب صديق لي وأجبره على إمضاء إيصالات أمانة رغماً عنه، بسبب خلافات بينهم. كان زياد ذا سوابق، في واقعة سابقة ضرب فيها أحدهم برأسه وقضى 3 أشهر في السجن.
لكنه كان أيضا دؤوباً ونشيطاً؛ في فترة إغلاق كورونا حوّل المقهى إلى مركز لبيع الخضار، وبعد انتهاء الإغلاق أعاد المقهى كما كان. لربما رأيت فيه نفسي التي أردتها.
غفرت له ابتسامته، ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
آمين.
قرّر أحدهم توجيه حديثه إليَّ في وسط حكايته عن السيدة الخمسينية التي حاول التعرّف إليها في التاكسي: "كانت شاسيه"، ثم أخبرني أيضاً: "شاسيه يعني مُزّة، عشان انت صغير وممكن تكون مش عارف"... مجاز
كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله
في شارع القصر العيني، بجانب صحيفة روزا اليوسف، مقهى ضيق بتصميم يجعلك تتمنى أن يكون المقهى هو مساحتك من العالم. وأيضاً يوفر إطلالة على الجانب الهادئ من شارع القصر العيني وأشجار جاردن سيتي. مكان تموت فيه القلوب وتحيا كثيراً.
تجلس في المقهى فتاة، تبدو في العقد الثالث من عمرها. كانت عيناها تنظران دوماً في اتجاه واحد، كأنها ترى سرّاً في تلك الزاوية. لم أر أحد يتحدث إليها ولا تحدثت هي إلى أحد، اعتادت الجلوس يومياً في نفس الموعد في الخامسة مساء، ربما قبل ذلك بقليل، فأنا أدخل وهي موجودة.
تبدو من منطقة شعبية بسبب مظهرها، العباءة السوداء والطرحة، وهي جميلة أيضاً. فضّلت الجلوس وحيدة لكنها رغم ذلك كانت تلفت أنظار كل من يمرّ أو يجلس، لكنها أبداً لم تكن تبدي أي اهتمام.
"وحيدة مثلي تماماً"، سيبدأ عقل أحدهم في خداعه: "وأن أتعرّف إليها بلطف، هو أحد الخيارات المطروحة أمامي".
حتى رأيتها تذهب في مرة مع صبي القهوة، والذي تبيّن لي فيما بعد أنها خطيبته. ربما على كل من تحلى بالأمل، أن يحتضن خوفه وتردّده الكبيرين الآن، وإلا كان قد تورّط، ربما إلى الأبد، لأن صبي القهوة كانت له نظرة متحفّزة، كأنه ينتظر الانقضاض في لحظة على هدف ما غير معلوم.
في نفس الزاوية، ألهمتني صديقتي الساحرة عشرات المرات. بعد ليلة طويلة مع تذكرة LSD نجلس على نفس المقهى في السادسة صباحاً، نتأمل السماء فقط ولا نفعل شيئاً، وأحياناً نغفو.
وعليه تعرّفت على الغريبة التي فتحت محفظتي في أول لقاء، لتعرف كم من الأموال أحمل معي.
*****
كان عبقرياً بالفعل أول شخص فكر في إنشاء مقهى، ربما كان يحاول اكتشاف قصة تشبهه، لكن لم تنجح مساعيه. لكن يظلّ اختراعه هو الحاضن الأكبر لحكاية ذلك الغريب، ربما يصادف يوماً ما شخصاً يشبهه.
آمين.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.





