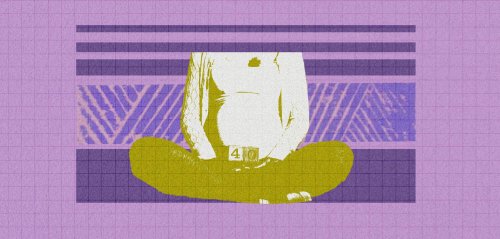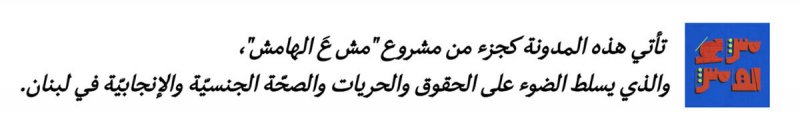
في منتصف التسعينيات، كنت أسمع العديد من أصدقائي يتحدثون عن تلك المحطة "اللي بتقْلُب بالليل". في النهار، هذه المحطة المتكلّمة باللغة الفرنسية كانت تعرض ريبورتاجات عن صيد السمك وصيد العصافير، أما بعد منتصف الليل، فكانت تعرض أفلاماً إباحية.
في اللغة الفرنسية، كلمة مخصّصة لصيد السمك "pêche"، وكلمة أخرى للصيد على البر "chasse"، فإذا أردت ترجمة حرفية لاسم المحطة بالعربية، سيكون "صيد السمك والصيد"، لكن لدواعي الخفة والاختصار، سوف نسميها هنا "صيد وصيد". إنما، كل الطرائف التي تتسلى بازدواجية الاسم تبوء بالفشل لو ترجمناها للعربية، مثلاً:
"شو؟ إنت عم تحضر chasse؟ أو عم تحضر pêche؟" (غمزة ثم غمزة ثم ضحكة عارمة)، وكأن اللغة العربية مع كل مفرداتها وغنى حقولها المعجمية، لا تستطيع أن تستوعب هذه المحطة ومحتواها المزدوج. كانت تسلّيني هذه الفكرة، كما تسلّيني فكرة كل سيدة تقوم صباحاً لتدير التلفاز، فتقع على أفلامٍ وثائقية عن الصيد والحيوانات، وتقول في نفسها: "بيحب الصيد، يقبرني رجّال".
"هل تعلمين يا مدام ما إذا كانت مشاهدة الأفلام الإباحية تجعل زوجك أكثر رجولة؟ أو ربما كنت تحبين لو تشاهدان سويةً برامج الصيد، فتتأكدين بنفسك من وقع المعلومات المفيدة على رجولته، لا بل تقدمين له حقل تجارب للتمرّن على فن الصيد والصيد؟" (غمزة ثم غمزة ثم ابتسامة).
لاحقاً، عندما أخبرت رفاقي الفرنسيين عن ازدواجية محطة "صيد وصيد"، ضحكوا، وفهمت أن هذا القرار كان لبنانياً عربياً فينيقياً بحتاً.
من كان أول شخص أخذ قرار تحويل محطة "صيد وصيد" إلى محطة إباحية؟ ولماذا لم يختر محطة "فتافيت" أو أي برامج مطبخية، ويحولها إلى محطة تعرض الممنوعات؟
ربما خاف من أن تفقد الأفلام من طابعها الذكوري، فبطبيعة الحال، في النهار يذهب الرجل مع كل تيستوستيرونه إلى صيد الحيوانات، ثم في الليل، يذهب إلى "صيد النساء". عادي. على كل حال، كان الصيد موضة في التسعينيات. نهاية الحرب أجبرتنا على وقف قتل بعضنا البعض، فلم يتبق لنا سوى قتل العصافير للشعور بالقوة والسلطة، ولِفشّ خلق الاحتقان الذي ترعرع بنا طوال سنين الحرب.
عندما كبرت، علمت أن القذف في البورنوغرافيا الذكورية هو أهم مقطع، وهو ما يحدّد نهاية الفيلم، فبعد ذلك، ترضى الممثلة ونفهم أنها وصلت أيضاً للنشوة، أو أن نشوتها هي من نشوته، أو أصلاً "مين بالو فيها"، فلا أحد يعلم ما إذا انتشت المرأة أو لا
لطالما حلمت بالحصول على هذا المحتوى لي فقط، ولكن عندما قام والداي بتركيب الدش، كنت في آخر سنين المراهقة، حين توقفت محطة "صيد وصيد" عن تغيير محتواها الليلي، فهل كان نفس الشخص الذي فتح لنا محتوى هذه المحطة هو من منعنا منه؟ أو هل هو شخص آخر؟ وفي الحالتين، ليس المهم السبب، إنما الأهم: لماذا يحصل هذا على دوري أنا؟
إلى أن حدثني ابن الجيران عن إمكانية مشاهدة أفلام إباحية على مدار الساعة ودون أي كلفة إضافية، وكل ذلك بواسطة غرض صغير عجيب غريب ذي اسمٍ غير مألوف، يتداول الحديث عنه مع رفاقه في المدرسة.
هذا الغرض كان موجوداً في الصندوق، يدخله المعدن، "طولو أطول من عرضو"، ولا يستعمله السنكري (أو ربما يستعمله ولكن ليس بالضرورة بهدف السنكرية)، اسمه "البومبونة". (بعد كتابة المقال، اكتشفت أن بعض الأشخاص يسمونها "البلوطة"، وهي عبارة عن ثمرة شجرة البلوط التي لا تؤكل، إنما، ولسخرية الموقف، هي متواجدة بكثرة في حقول وأحراش الصيد "غمزة ثم غمزة ثم ضحكة رنانة كضحكة مارسيل غانم")
تأتي كلمة بومبونة من كلمة فرنسية bonbon ومعناها حلوى. أحياناً، نستخدم هذه الكلمة للدلالة على جرة يُضغط فيها سائل أو منتج كالغاز، فبدل أن نقول "جرة غاز" كنا نقول "بومبونة غاز". كنت أحاول أن أحزر لماذا أطلق عليها هذا الاسم، هل يا ترى لأنها تذكرنا بالحلوى، أو لأنها أقرب لجرة غاز قد تنفجر بوجهنا؟ حتى نزل يوماً ابن الجيران إلى ديسكوتيك "روجيه" في أول الشارع، وبمبلغ 10 دولارات فقط لا غير، اشترى بومبونة.
اكتشفت أن البومبونة هي عبارة عن شيء معدني بحجم الإبهام، مستطيل يشبه البطارية، توضع بين شريط الدش والحائط، وتجعلك تتمتع بالحصول على محطة إباحية تعرض أفلاماً دون انقطاع، أو على الأقل، حسب ما أذكر. في يومٍ من الأيام، دعاني ابن الجيران كي نشاهد فيلماً سوياً، ولست أعلم لماذا لم نعد تكرار الجلسة، ربما لأن ظني قد خاب بما رأيت.
توقعت الكثير من الأشياء، ولم أرى سوى مشهداً بين رجل وامرأة يمارسان الجنس في ساحة قصر قديم، متنكرين بثياب من القرن السابع عشر، ولكنه أخبرني عن القاعدة الذهبية في هذه الأفلام، حسب دراساته المعمقة وساعات المشاهدة الطويلة، حيث يحرص الممثل على القذف على مرأى من المشاهد. فقال لي بالحرف الواحد: "بعتقد إنو ما بيدفعولو إذا بيجي معو جوّا".
عدت إلى بيتي وأنا أفكر بهذا الممثل الذي قد يحرم من معاشه إذا ما قذف دون أن يثبته لنا.
عندما كبرت، علمت أن القذف في البورنوغرافيا الذكورية هو أهم مقطع، وهو ما يحدّد نهاية الفيلم، فبعد ذلك، ترضى الممثلة ونفهم أنها وصلت أيضاً للنشوة، أو أن نشوتها هي من نشوته، أو أصلاً "مين بالو فيها"، فلا أحد يعلم ما إذا انتشت المرأة أو لا.
بالحديث عن الإباحية الذكورية، أذكر في عمر الـ 21 عندما أمضيت سنة في جنوب فرنسا لأول مرة وحدي، بعيداً عن أهلي وبلدي. اغتنمت الفرصة وذهبت إلى مهرجان الأفلام الكويرية، ودعيت رفاقي لمشاهدة عرض أفلامٍ قصيرة إباحية نسوية.
أذكر بعض اللقطات من هذه الأفلام، كمشهد تربط فيه الممثلة شريكها وتتلاعب بجسده كما يحلو لها، أو فيلم صُنع بتقنية الصور المتحركة، فيه امرأة عملاقة تبتلع رجلاً صغيراً في مهبلها.
سأمت تلك النساء من دور المرأة في البورنوغرافيا، والذي هو ببساطة إشباع رغبات الرجل، وتصويرها كغرض يجلب له النشوة، فقرّرن تصوير الإباحية من منظار آخر، يتحدّى كل ما قد اعتدنا عليه
في الحديث مع المخرجات بعد العرض، فهمت فحوى الأفلام. تلك النساء قد سئمن من دور المرأة في البورنوغرافيا، والذي هو ببساطة إشباع رغبات الرجل، وتصويرها كغرض يجلب له النشوة، فقرّرن تصوير الإباحية من منظار آخر، يتحدى كل ما قد اعتدنا عليه.
ذهبت إلى فرنسا، إلى صالة سينما في مهرجان كويري، كي أفهم أن البورنوغرافيا القليلة التي رأيتها، هي ذكورية. لمَ لم يقل لنا أحد ذلك من قبل؟ لمَ لم ينبّهنا أحد إلى أن الأفلام الإباحية هي كالمخلوق الفضائي، لا تمت بصلة إلى ما نعيشه في حياتنا الجنسية؟ لمَ لم يقل لنا أحد إن العضو الذكري ليس بهذا الحجم، والشعر والدهن على الجسد لا يشبه ما نراه على أجسادهم؟ لمَ لم يقل لنا أحد إن الإباحية لا تصوّر العطف والحميمية والحنية؟ وأن العلاقة الجنسية ليست إيلاجاً وقذفاً فقط، إنما يمكن أن تكون مداعبة لطيفة من البدء حتى النهاية؟ لمَ لم يقل لنا أحد إنه في العلاقة الجنسية نخجل من الآخر، نستحي منه، نعتاد عليه، نقول له ما نحب، يقول لنا ما يسعده فنقوم به؟ أننا لم نخلق متعلمين الجنس ولكن نكتسب القليل منه في كل مرة؟ والأهم، لمَ لم يقل لنا أحد إن العلاقة الجنسية فيها الكثير من الضحك والتسلية والمتعة والألاعيب؟ أين الحقيقة وفي أي مكان نراها؟ ولماذا كل هذه التساؤلات الغاضبة تتآكلني الآن؟
لمَ محطة "صيد وصيد" لا تستضيف عالماً يأخذ خمس دقائق ليشرح هذه الأمور لنا؟
وقعت منذ فترة قصيرة في تطبيق إنستاغرام، على مقابلة للكاتب والصحافي الفرنسي ألكسندر لاكروا، يقول فيها إن للعلاقة الحميمة سيناريو بسيط، نراه في الأفلام الإباحية، وفي مفهوم الجنس عند فرويد في 1905، وهو عبارة عن ثلاث مراحل: تحضير ثم إيلاج ثم قذف.
هذا السيناريو يقلّد فعل الإنجاب بين شريكين من جنسين مختلفين. مؤخراً، من خلال الجنس المثلي، بدأنا نكتشف سيناريوهات مختلفة، يسميها بـ"الأوقات الجنسية"، وليس العلاقة الجنسية. هذه الأوقات ممكن أن تدوم ساعات ويمكن ألا تنتهي بالقذف ولا تمر بالإيلاج، فربما قد تنجح سيناريوهات الأقليات بالتأثير على مفهومنا للجنس، وتغيير التنميط الذي اعتدنا عليه، وتلغي روح الصيد التي ترعرعنا فيها لتترك مجالاً للعبة الانجذاب والمداعبة والحنية.
وأقول في نفسي، إن الجيل الجديد يرى على شاشة تلفونه فيلماً إباحياً بمكوناته الذكورية البسيطة، ثم مقابلة تلفت النظر إلى قلة واقعية هذه الأفلام، فربما هذه الازدواجية تخلق جيلاً ذا مفهوم جديد، يتعامل مع الصيد بطريقة مختلفة، بعيداً عن البونبونات، أكانت حلوى ذات سكر زائد، أو جرة غاز تنفجر في وجوهنا.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.