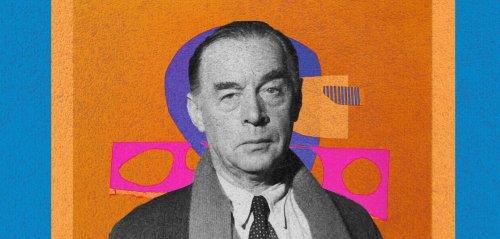يواصل فن الرواية السخرية من كل الذين أبّنوه وتوقعوا نهايته، فكلما بانت عليه ملامح تدهور أو انحطاط ينهض من جديد كطائر الفينيق منتفضاً من رماده. يجترح المتشائمون تنبؤاتهم عبر "القياس" ويستحضرون مقولات من نحو "موت الناقد" و"موت المؤلف" و"موت المقامة" و"موت الأسطورة" و"موت الفيلسوف" و"موت الفلسفة" و"موت المؤرخ"، إلا أنهم في ظل كل هذا الطابور من الموت يهملون أمراً مهماً، هو طبيعة الرواية نفسها، فهي ليست كياناً محدداً لكي يترهّل أو يسمّم أو يغتال برصاصة، وليست شيئاً محدداً لمحوه، بل وُصفت دائماً بالكائن العجائبي الذي يبقى دائماً في طور التشكّل، فيتمرد كل يوم على الخامات التي تشكّل منها ويبدلها بأخرى. فكيف للموت أن يهاجم خلايا غير معروفة تتجدد كل يوم؟
والحق أن الرواية شاركت في هذه اللعبة بذكاء وخبث، إذ ما زالت إلى اليوم توهم أعداءها والمتربصين بها بأنهم أدركوها عبر ما تنتجه من تجارب ضعيفة أو عبر تكرارها لتيمات وأشكال صارت معلومةً ومملةً قبل أن تسخر منهم من جديد عبر استحداث أشكال جديدة وأصيلة فتجبرهم على العودة بالتابوت الذي جهزوه لها فارغاً.
يمكن قراءة الرواية من زاوية الكتابة المشهدية، كما يمكن دخولها من نافذة التحليل النفسي عبر تفكيك خطابها، ويمكن سبر أغوارها عبر تمظهرات السرد البوليسي في رواية ما بعد الحداثة
ومن ألاعيب الرواية أنها تستعمل في بنائها أنواعاً أدبيةً وأجناساً أدبيةً تعاني من الهشاشة، ودُفعت إلى الهامش أحياناً لتبني بها نفسها كجنس قوي ومتوحش كوحش فرنكنشتاين نفسه.
ومن هذه الأجناس التي تستثمرها الرواية، القصة القصيرة، عبر ما صار يُعرف بالمقطع السردي المغلق والمفتوح استرداداً لألاعيب أول روائي في التاريخ ليكيوس أبوليوس، في رواية "الحمار الذهبي"، أو مؤسس الرواية الحديثة ميغال دي سيرفنتس في روايته "دون كيخوته"، أو جيوفاني بوكاتشو في كتابه "الديكامرون" الملقب بألف ليلة الإيطالية. فقد اعتمد كل منهم في تشكيل عمله على شظايا سردية تبدو كما لو كانت قصصاً قصيرةً تم تجميعها حسب نظام معيّن حتى تشكل جسماً سردياً أكثر تركيباً وقوةً هو الرواية.
ومن الأجناس الهامشية التي استند إليها الروائيون لتجديد خطاب الرواية وتحديث جمالياتها منذ بداية القرن العشرين: فن اليوميات، وهو الحقل الفني الذي تلعب فيه الروائية مي التلمساني في بناء روايتها "أكابيللا".

من محاكاة اليوميات إلى اللعب بها
تمثّل المحاكاة الطريقة الأشهر في الاستفادة من فن اليوميات، وهي أكثر الطرائق كلاسيكيةً حيث تبنى الرواية كما لو كانت يوميات، فيوهم الكاتب القراء بأن العمل يوميات خالصة وصادقة، وهذا النزوع نحو الإيهام هو عنصر أصيل في الكتابة الروائية، كما يقول كولن ولسن في كتابه "فن الرواية". والفكرة ذاتها يرددها أورهان باموق، في كتابه "الروائي الساذج والحساس"، عندما يقول: "أن تكون روائياً هو الإبداع في أن تكون ساذجاً وحساساً، أن تقدّم المصنوع على أنه مخلوق، وأن تحقق ذلك الشرط البدئي للكتابة الروائية في مفهومها الكلاسيكي: الإيهام بالواقعية، واقعية الحكاية فيتحقق ميثاق التلقي...".
ونمثل لذلك من الكلاسيكيات برواية "يوميات نائب في الأرياف" لتوفيق الحكيم، و"مذكرات الأرقش" لميخائيل نعيمة، ومن المعاصرة يمكن أن نستحضر "يوميات مطلقة" لهيفاء بيطار، ومن العالم نذكر رواية "يوميات خادمة" لأوكتاف ميربو، و"مذكرات جسد" لدانيال بناك، و"يوميات بريدجيت جونز" لهيلين فيلدينغ، و"يوميات" للتشاك بولانيك. وكلها أعمال نحتت عبر محاكاة فن اليوميات والسرد المتشظي ومقاطع الاعترافات اليومية للراوي والتي يثبّتها عبر التأريخ اليومي فتبدو أنها كتبت يوماً بيوم، وعبر تلك الاعترافات تتحرك الأحداث وتتشابك العلاقات وتترابط لتشكل حبكة الرواية.
لقد تجنبت مي التلمساني هذا التقليد، بل صنعت تلك اليوميات ووزعتها في الرواية بشكل فني كما يقوم الرسام بإدخال المواد والخامات الغريبة على لوحته بعد أن يمزقها أو يهشمها ويفقدها شكلها الذي عرفت به، ثم يعمد إلى محو حدودها داخل اللوحة حتى تكتسب هويةً أخرى، فتشكل لوحةً مركبةً ومعقدةً. لا يمكن أن يستعيد المتلقي تلك الخامات والأجسام المقحمة في اللوحة من دون تدمير ذلك الأثر الفني. وهذا الاختيار الفني يمكن أن نرجعه إلى الثقافة التشكيلية للروائية التي عُرفت بنقدها للفن التشكيلي مع منجزها في تحليل الصورة السينمائية، وكل تلك الثقافة تظهر في كل مفاصل العمل الروائي. لقد كانت مي تلمساني تتحدث عن مضمون اليوميات من دون أن تضعها. هي ترويها لتناقشها، ولذلك تزدحم الرواية بالتحليل النفسي وفلسفة السلوك وتحليل ردات الفعل.
الاستحواذ على اليوميات
تنطلق الأحداث بمشهد تتوهم فيه الراوية من خلال مشاهدتها لأفيش فيلم، أنها رأت عبر النافذة مشنقةً تتدلى من شجرة خارج البيت لتتذكر صديقتها "عايدة" التي قطعت علاقتها بها بشكل راديكالي مفاجئ ثم ماتت بشكل مفاجئ كما لو كان موتها انتحاراً لتتركها في حيرة: لماذا قررت فجأةً هجرها برغم محاولتها أن تفهم سرّ ذلك التغيّر؟
وهكذا تبدأ الراوية بجرّ خيط بكرة علاقتهما؛ كيف بدأت؟ وكيف توطدت؟ وكيف تأزمت؟ ونكتشف في أثناء السرد، ومنذ الصفحات الأولى، أن عائدة كانت شخصيةً غريبة الأطوار وجريئةً ومغامرةً وامرأةً جرّبت الزواج مرات، وأنها متمركزة حول ذاتها، وأن صديقتها الراوية اكتشفت بالصدفة أنها سرقت من بيتها شيئاً فشكّت في سلوكها، وقررت أن تبحث في بيتها عما خمّنت أنها سرقات أخرى، فأكثرت من زيارتها لكي تتلصص على ما في بيتها من أشياء. وفي أثناء بحثها عن مسروقات، عثرت على يوميات عايدة فاحتفظت بها وأقنعت نفسها في البداية بأنها استعارتْها قبل أن تقرر الاستحواذ عليها.
تقول الراوية مفلسفةً فعل السرقة:" ثم لا أدري كيف حدث ذلك ولا كيف واتتني الجرأة، لكن البحث، مثل كل بحث، أفضى بعد قليل إلى السرقة. شعور ملح يفرض على الباحث عن شيء لا يجده، أن يعثر على شيء لم يكن يبحث عنه. ولأن كل بحث يحمل في ثناياه وعداً بالسرقة فقد قررت في أثناء بحثي عن مسروقات متخيّلة أو افتراضية، أن أسرق شيئاً عينياً وملموساً. كان هذا الشيء هو كراس اليوميات. وجدته في درج خزانة الملابس. كان كراساً قديماً نسبياً. يرجع تاريخه إلى سنوات تسبق تاريخ استعارتي له. في البداية عددتها استعارةً لأني قررت إعادته والبحث عن غيره كلما سنحت الفرصة، غير أني احتفظت بكل ما وجدته على سبيل الاحتياط، يراودني إحساس غامض بأني سأحتاج إلى كراسات عايدة في ما بعد أو أنها ستحتاج إليّ. قررت منذ لحظة عثوري على الكراس، أن ألعب دور حارسة يوميات عايدة... تأكد هذا الدور بعد انقطاع علاقتي بها وازداد رسوخاً بعد وفاتها" .
وهكذا صارت اليوميات الحميمة لعايدة في بيت صديقتها التي شرعت تقرأ فيها وتكتشف حقيقة صديقتها لتصطدم بالكثير من الحقائق المؤلمة والمواقف المخزية لصديقتها وحقيقة نظرتها إليها.
تتواصل الرواية مراوحةً بين أفكار الراوية وهواجسها، وما ورد في يوميات صديقتها من اعترافات، فتتشكل هوية عايدة عبر ما ترويه عنها الراوية، وما كتبته هي في يومياتها، كما تتشكل صورة الراوية عبر ما تقوله عن نفسها وما تقوله عنها اليوميات.
يمثّل فعل الاستحواذ موضوعاً مركزياً في الرواية عبر صور مختلفة. فهذا الاستحواذ على اليوميات يقابله أيضا الاستحواذ على الآخر، وتحديداً على الصديق حيث يسعى بعض الأصدقاء إلى محو أصدقائهم عبر الالتهام والاستحواذ أو عبر لعب دور التابع فيخلع الواحد على الآخر صفة "سانشو بيزا"، أو عبر التحلل فيه. فالراوية تتوغل في شخصية عايدة عبر يومياتها في ما يشبه التماهي أو الحلول الصوفي شيئاً فشيئاً، لتترك طبقةً اجتماعيةً وتدخل أخرى وتترك حياةً لدخول أخرى، فتتحول من امرأة استحوذت على يوميات صديقتها إلى امرأة استحوذت عليها يوميات/ حياة صديقتها.
تقول الراوية: "الحقيقة التي أعرفها الآن هي أن الابتعاد عن عايدة أو تجاهلها لم يكن ممكناً، بل أصبح مستحيلاً بعد قراءة اليوميات ثم بعد موتها المفاجئ. صار حضورها في حياتي أكثر طغياناً... اكتشفت أني أحبها، صديقتي الكاذبة، السارقة، الأنانية، المدّعية. أحبها لأنها برغم شرورها هشة مثل سنابل القمح، غامضة مثل حقل في الليل. أبحث فلا أجد سوى تلك السنابل تتمايل مع الريح. أصغي فلا أسمع سوى حفيف الليل ورهافة أصواته".
أنتجت سرقة اليوميات في رواية مي التلمساني، ما يشبه لعنة الفراعنة في الأفلام والروايات، وتحول الاكتشاف أو ملامسة الأسرار إلى لعنة تلاحق هاتك سرّها. وهذا يجعلنا نتساءل عن الجدوى من معرفة الآخر الحميم الصديق والحبيب؟ هل فعلاً نحن في حاجة إلى معرفته كل المعرفة، كأن نجبره على التعرّي التام أمامنا لنرى حقيقته وموقعنا من تلك الحقيقة؟ ألا نحتاج إلى ذلك الغموض المستحبّ أو ذلك "الوهم لكيلا تميتنا الحقيقة" كما يقول نيتشه؟ لماذا نبحث عن ذواتنا في حميميات الآخر؟ وإذا آمنّا بعبارة ميلان كونديرا: "إنا نموت دون أن نعرف أنفسنا"، فكيف نطمح إلى معرفة أنفسنا من الآخر الخارج عنا، وما الجدوى من ذلك إذا كنا حتى في أثناء اكتشافنا لتلك الذات نعود من جديد لنكذّب ما قيل عنا؟
تقول الراوية: "كانت صفحات قليلة من كرّاس اليوميات تخصني. تشير إليّ مستخدمةً اسمي أحياناً، وأحياناً أخرى أعرف نفسي برغم غياب الاسم. تشير إلى حدث عشناه معاً. تتوقف عند حالة أو موقف أو عبارة قلتها. تعلّق عليها، تسخر منها، تستشهد برأيي فيها وتعتبره سليماً. ذات مرة أطلقت عليّ اسماً مستعاراً. سمّتني 'ماهي'... لكنها حكت قصصاً لا تخص أحداً غيري. عرفت ذلك من تفاصيل صغيرة نثرتها هنا وهناك. رحت أقرؤها وأعيد قراءتها كأني أراها تتجسد وتنمو وتتحول تحت نظري إلى فضيحة هائلة. كأن الكون كله يطلّ من فوق كتفي ويقرأ يوميات عايدة معي فيدرك أنها تتحدث عني وعن حكايتي. لم أغفر لها رواية هذا الحدث بالذات، وتصويري بشكل مخالف للحقيقة. لم أغفر لها أنها فضحت نقطة ضعفي، وأن رأيها المكتوب عني وعن زوجي كان نقيض رأيها المعلن الذي كانت تجاهر به في حضوري مشيرةً إلى انبهارها بصلابة علاقتنا الزوجية" .
الصداقة يوميات حميمة
تبدو علاقة الصداقة في رواية مي التلمساني، مثل دفتر اليوميات أيضاً؛ عليه أن يبقى مغلقاً، وفي درج سرّي بعيداً عن الأنظار، لذلك لا يجب أن يُكتب، وكتابته في دفتر اليوميات كما فعلت عايدة، هي فعل خيانة لمؤتمن وإعلان فضيحة: الصداقة. وهكذا تأخذنا الروائية إلى موضوع متشعّب هو الصداقة التي حبّر فيها الفلاسفة والأدباء الكتب الكثيرة من دون أن يصلوا إلى حد للمفهوم، ولا لطبيعة هذه العلاقة المركّبة، وليس غريباً أن تنشأ الرواية الحديثة مع ميغيل دي سيرفانتس، في هذه العلاقة المعضلة: صداقة دون كيخوته وسانشو بانزا.
ترى الراوية "ماهي"، أن الصداقة غير ممكنة مع الحب، فتقول: "أصبحت عايدة هي الصديقة التي لم أستطع أن أصادقها، وصاحبني بعد موتها شعور بعدم الاكتمال لم يغادرني حتى اليوم. كأن الصداقة لم تكن ممكنةً إلا خارج ميثاق الحب. كنت أحبها وأكره صداقتها... كانت قريبةً إلى قلبي مثل شخصية في كتاب، أعود إليها لأتأملها، لكني أختنق في حضورها لفرط ما تلاحقني عيوبها وزلّاتها المتكررة" .
إن البحث في الصداقة، هو بحث في الذات باعتبار تلك العلاقة تمثّل في واحدة من دلالاتها المرايا التي نرى فيها أنفسنا، ولذلك تتماهى "ماهي"، في شخصية عايدة، وظلت "متكتمةً على اسمها لأن هذا الاسم الذي وضعته لها صديقتها يعكس هذا السؤال عن الماهية وعن هوية الذات. فالذات لا يمكن لها أن تبرز إلا عبر هذا الآخر الضديد الذي يتشكل أحياناً في ما نسميه "الحميم". "ماهي" التي تعيد اكتشاف ذاتها عبر عايدة ويومياتها التي بدورها تعمل على تعريتها، وهذا سرّ التناقض الكبير في أحاسيس "ماهي" تجاهها، فهي لا تطيقها صديقةً، وتحبها في آن، وتعدّ خسارتها خسارةً كبرى جعلتها تعيش كل هذا الارتباك الذي دفعها لإعادة تمثّل حكايتهما عبر نسخ اليوميات وقراءتها في ضوء كل ما حصل لهما.
التفكير في فن اليوميات وبه
لم تكتفِ مي التلمساني في روايتها "أكابيلا"، باستعمال اليوميات لبناء النص الروائي، بل كانت طوال الوقت عبر بطلتها تفكّر فيه كنوع أدبي، مشيرةً إلى خصائصه الشكلية وخطابه وموقعه من السرد الواقعي والسرد التخييلي وقضية الصدق والكذب فيه، وكانت تتحدث عن اليوميات مرةً، وتقحم مقاطع منها مرةً أخرى، لتتعدد الأصوات المفردة كالأكابيلا، فنصغي إلى صوت عايدة من دون تدخل أو تأويل من "ماهي".
إن من أهم خصائص كتابة اليوميات؛ التكرار. فعادةً ما يعود كاتب اليوميات في كل مرة إلى الموضوع نفسه مدفوعاً بذلك التمركز حول الذات وقضاياها، وهو ما تشير إليه "ماهي" في قولها متحدّثةً عن الإجهاض وهاجسه عند عايدة: "في الكراس الثالث الذي أظن أنه الأقدم، كانت أيضاً تتكلم عن السقوط والفرق بينه وبين التسقيط، بين الفعل والتفعيل. كانت تعود إلى نفس الفكرة في مواضع كثيرة من اليوميات".
كما تشير في موقع آخر إلى ظاهرة نسيان التأريخ أحياناً عند بعض كتّاب اليوميات، فتقول: "لم أستطع التأكد أي العمليات المشار إليها في اليوميات هي التي أعطيتها المال اللازم لعملها، خصوصاً أنها لم تعبأ كثيراً بتدوين زمن كتابة اليومية". وتعود إلى الملاحظة عينها لتكتب: "كانت حكايات عايدة تزداد غموضاً مع الوقت، ربما لأنها حكايات بلا أسماء وبلا تواريخ" .
الكاتبة بهذا اللعب بهذه الظواهر الخاصة في فن اليوميات، تستثمر تلك المعارف للتقدم بالمشروع الروائي وحبكته، ذلك المشروع الذي يكتسب قوته، في رواية ما بعد الحداثة، باعتراف رواته دائماً بقصورهم وهشاشتهم أو تلك النسبية التي تحدث عنها ميلان كونديرا في تنظيراته لفن الرواية. وتلتفت مي التلمساني إلى خصوصية الأسلوب واللغة في كتابة اليوميات في نماذجها التقليدية، عندما تشير إلى البعد العفوي للغة اليوميات ونزوعها نحو محاكاة الكلام اليومي بعيداً عن التقعر والتكلف والتصنّع فتقول الراوية: "كانت تكتب مثلما نتكلم جميعاً عن أنفسنا، لا تفصل بين ذاتها وذوات الآخرين، أحياناً تستخدم ضمير المتكلم وأحياناً تشير إلى نفسها بضمير المخاطب، وفي أحيان أخرى تتكلم كأنها شخص ثالث لا يمتّ إلى المتكلم أو المخاطب بصلة".
ولم تنسَ الروائية الإشارة إلى أهم خاصية في كتابة اليوميات وهي الحذر من سقوط اليوميات بين يدي شخص قريب فيتحايل الكتاب على هويات الأشخاص عبر حجب أسمائهم أو الإشارة إليهم بأسماء مستعارة. تقول الراوية متحدثةً عن يوميات عائدة: "سمتني 'ماهي' في اليوميات كما أطلقت على الغريب الذي استقبلني في شقتها اسماً غير اسمه، سمّته 'حسام'، وحفاظاً على السرّ لم أشأ أن أعيد له اسمه الحقيقي في اليوميات المنسوخة. كانت تتوقع أن يقرأ أحد أصدقائها الكراسات يوماً ما، وتحتاط مثل ثعلب ماكر" .
ولأن فن اليوميات لا يكتمل إلا بتماسه مع فن الترسّل، إما بتضمين الرسائل أو مقاطع منها أو بالحديث عنها، فقد جعلت مي التلمساني من يوميات عايدة التي عثرت عليها "ماهي"، فضاءً لتسجيل رسائلها إلى عشيقها حسام. تنقل "ماهي" عدداً من تلك الرسائل حرفياً في دفترها: "رسالة القبلة"، "رسالة الماء"، "رسالة بيضاءـ أورلاندو"، "رسالة بطعم النعناع"، "رسالة الهجر"، و"رسالة الحنين إليك".
تأخذنا مي التلمساني عبر بطلتها "ماهي"، التي تعيد نسخ يوميات صديقتها "عايدة" والتحوير فيها عبر الحذف والزيادة، إلى عالم مخطوطات اليوميات، فتنقل لنا بحسّ بصري حاد كيف تبدو اليوميات المخطوطة مقابل اليوميات المحررة والمنسوخة، مما يذكرنا بحديث المنظر العالمي لفن اليوميات، الفرنسي فيليب لوجون، عن أن اليوميات "قطعة فريدة"، وليس منها مثالان بينما اليوميات المنشورة حتى لو صُوّرت تصويراً تظل نسخاً غير أصيلة.
تقول "ماهي": "صفحة اليوميات المنقولة لا تشبه في شيء صفحة اليوميات الأصلية المكتوبة بخط عايدة. كانت عايدة تهوى الشطب وتعيد كتابة بعض الجمل والهوامش، وتكمل الصفحة إلى آخرها، كأنها تقيس حجم وقيمة الكتابة بمدى اكتمال الصفحة وانتفاخها. وكانت تضع دوائر حول بعض الكلمات، أحياناً بقلم أحمر كأنها تذكّر نفسها بضرورة تغيير الكلمة أو إيضاحها. تطلق سهماً من الدائرة الحمراء صوب الهامش وتكتب بخط سريع غالباً غير مقروء ملحوظةً على كلمة أو الجملة التي أحاطتها بدائرة. يبدو خطها متعجلاً تميّزه الشرطات الحادة والنقط الطائرة بعيداً عن الأحرف..." .
ولعله السبب الذي دفع بـ"ماهي" إلى التوقف عن نسخ اليوميات في الدفتر وتعويضه بالرقن عبر الكومبيوتر، فالدفتر الذي يحاول أن يحاكي الأصل أو يوهم بذلك يعلن قصوره وعجزه لأن الأصالة كامنة في الأصل الفريد، خاصةً أن البطلة مولعة باقتناء الأفيشات الأصلية للأفلام.
يشكل هذا العمل الروائي دعوةً لكل قارئ/ة حتى ينتج/تنتج روايته/ا الخاصة عبر فهمه/ا الخاص للنص، لأنه نص معقّد في تركيبه من ناحية، ويبدو كما لو أنه طرس يحجب الظاهر منه خطابات وأفكاراً ونصوصاً وحكايات وخطابات أخرى
الالتفات إلى مدوّنة مي التلمساني الأدبية، والتأمل في عناوينها وأجناسها الأدبية، سيشرحان هذا الحضور الطاغي والواعي لفن اليوميات كمشكّل من مشكّلي العمل الروائي لرواية "أكابيلا"، لم يأتِ صدفةً، فقد سبق لِمي أن كتبت اليوميات بعنوان "للجنّة سور"، صدرت عن شرقيات، 2009، وهو ما يعزز فكرة أن الكاتبة أرادت من خلال هذه الرواية أن تختبر هذا الفن في بناء العمل الروائي، وأن تكتب الرواية على أنها الجنس الأدبي المهيمن و"الإمبريالي" بأجناس أخرى كاليوميات والرسائل.
يشكل هذا العمل الروائي دعوةً لكل قارئ حتى ينتج روايته الخاصة عبر فهمه الخاص للنص، لأنه نص معقّد في تركيبه من ناحية، ويبدو كما لو أنه طرس يحجب الظاهر منه خطابات وأفكاراً ونصوصاً وحكايات وخطابات أخرى يبقى ظهورها رهين استعدادات القارئ الثقافية والفكرية والأدبية. فتنهض الرواية بذلك رواية أحجيات لا متناهية، فهي لا تروي حكايةً بعينها كما يوهم سطحها، إنما هي دعوة للعب وهو لعب أشبه بدخول متاهة من الأحاسيس وردات الفعل اللا متناهية حول الوجود والصداقة والكتابة والإجهاض والأنوثة والذكورة والفن والحواس.
أما نقدياً، فإن هذه الرواية لمي التلمساني منفتحة على إمكانات جمة للتلقي، إذ يمكن قراءة الرواية من زاوية الكتابة المشهدية، كما يمكن دخولها من نافذة التحليل النفسي عبر تفكيك خطابها، ويمكن سبر أغوارها عبر تمظهرات السرد البوليسي في رواية ما بعد الحداثة، إذا رأينا أن الرواية كلها تقصٍّ لأسباب وكيفية موت عايدة، خاصةً أن الرواية بدأت بمشنقة وبخبر موتها.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.