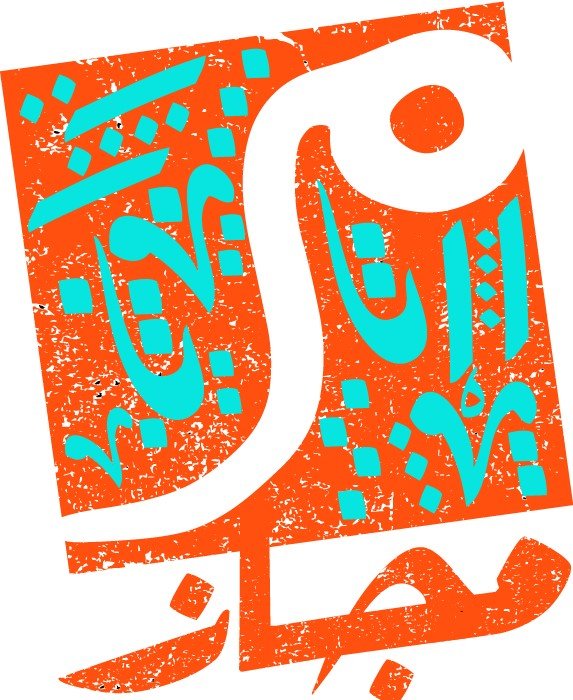 يعيش أهل بلدي
يعيش أهل بلدي
أنيق اللباس، عابس الوجه، مُنتشياً بمهام وظيفته التي لا أعرف ماهيتها بالتحديد، مُتكئاً بكف يده اليمنى علي مكتبه الفخم، ينظر في أوراق مبعثرة أمامه وكأنه غير آبه لدخولي حجرته الفاخرة:
ـــ "عبعزيز، أنت عارف إنت فين؟".
ـــ "أيوه، نيابة أمن الدولة العليا، شُفت اليافطة وأنا داخل".
ـــ "تمام، الاتهامات اللي هتواجهها هنا بتوصل عقوبتها للإعدام!".
وقع الصدمة ابتلعني كثقب أسود يعتصر ضحاياه التائهين، ويلقي بهم داخل نفق مظلم، تتلاشى بداخله كل حسابات الزمان والمكان، فيستنشقون زفير ذكرياتهم المحمومة، ولا يعرفون بين خباياه للعودة من درب.
*****
لم يحبني أبي، رغم أنه لم يدخر جهداً من أجلي، لكنه لم يحبني، فمنذ رحيله لم يسع للتواصل معي، بالرغم من أنه لم يتوان عن زيارة الأهل والأصدقاء. دعوته دوماً لزيارتي ولكنه لم يفعل. تخلّى عن رعايتي قبل زمن طويل، بعدما هيمنت عليه لعنات المرض، ثم تركني مرغماً دون أن يرشدني في حواري الدنيا، متجاهلاً حاجتي له، والآن يتركني مجدداً بكل إرادته، لأنه لم يحبني.
*****
في غرفة تبدو منمّقة للغاية ولكنها كئيبة، تُسدِل ستائرها على نافذةٍ ضخمة خلف مكتبٍ أنيق لتستر كل أضواء الشمس، وتحجب معها لافتة ذهبية ضخمة، تبقي كلماتها جلية رغم التغطية، لتبوح بأن "العدل أساس الملك". غرفة تستنير بشعاعٍ أصفر ماكر، مصوّب نحو عيني اللتين لم يعرف النوم طريق لهما منذ أربعة أيام، في مواجهة هذا الشاب اليافع ذي المشاعر المتجلّدة، الذي يبدو أنه قد جاء لإتمام دور تقتضيه الحاجة، وعلى اليسار كاتب تلوح عليه أسارير التعاطف، وبعد أكثر من عشر ساعات من اللا شيء، أصبحت بشكل رسمي متهماً بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ومروجاً للشائعات الكاذبة، وساعياً لتكدير السلم العام عبر إصدار بيانات، والتواصل مع جهات أجنبية لتشويه سمعة البلاد!
بعد أكثر من عشر ساعات من اللا شيء، أصبحت، بشكل رسمي، متهماً بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ومروجاً للشائعات الكاذبة، وساعياً لتكدير السلم العام عبر إصدار بيانات، والتواصل مع جهات أجنبية لتشويه سمعة البلاد... مجاز
*****
لم يحبني أبي ولكني أحببته، أحببته للدرجة التي جعلتني أفعل كل شيء بصخب: أسرق الأضواء، أعتلي مآذن الرفض، وأحمل مشاعل لفت الانتباه، حتى يشعر بوجودي، ربما يحرك ساكناً ويقرّر التواصل معي، حتى وإن كلفني ذلك تعنيفه المنقوش في ذاكرتي، أو نظراته النافذة التي تخضّ بواطني فتطرحني فزعاً، المهم أن يأتي!
*****
الآن فقط أستطيع أن أعي ما يدور، فالدلالات واضحة للغاية، بدلة بيضاء من أردأ أنواع المنسوجات، وأسوار شاهقة يعتليها عشرات الجنود المكلفين بالحراسة، وموالج عنابر مرَقَّمة تتراص على جنبيها الكلاب البوليسية الجائعة، وبناية ضخمة تحمل لافتة "المطبخ"، يتواجد بداخلها بضعة أناس يرتدون زياً أخضر اللون، يلوح كونهم مرغمين على طهي أطعمة خرساء دون رائحة، وأسلاك شائكة تحول دون الوصول إلى جنائن مغمومة تحتوي علي نباتات قبيحة للزينة، وبضعة رجال من الشرطة السرية، ولافتة تعتلي مدخلاً ضيقاً في نهاية زقاق ممهد: "عنبر 4 سياسي". نعم، أنا بالسجن.
يتكون العنبر من طابقين، حيث يلملم عشرات الزنازين التي تصطف على جنبيه، ويعكس الحديد القاسي المنتشر في كل مكان حولك واقع آلام النفوس التي تسكنه، لقد اختاروا اللون المناسب تماماً لطلائه: الأسود، فكل الأشياء هنا تم اختيارها بعناية فائقة لتقتل كل سبل التيمن، هنا، "ساحة معانقة الذكريات" كما أطلقت عليها، مساحة شاسعة خُصِّصت لممارسة الرياضة، تحيطها أعمدة حديدية ضخمة تحمل سقفاً صلباً يحجب أشعة الشمس، لماذا يكرهون الشمس ويسعون دوما لحجبها عنا؟ وهل يستهدفون حجب الشمس أم حجب بصيصها ورسائلها؟ تلك الساحة التي أصبحت بقوة الأمر الواقع ميدانٌ لاستدعاء الحياة خارج أسوار السجن، يبدو أنها مازالت لم تستسلم لرغبتهم في أن ننسى، ننسى الحياة وإن لم نعرف لها سبيلاً.
لا أعلم، هل تملك الأرواح حق اختيار ما تريد أن تفعله، لتزور هذا وتطمئن على ذاك وتضيء قناديل الأمل لهؤلاء، أم تستنظر الحصول على إذن بالسماح للتواصل معنا؟ كل ما أعلمه أنها تفعل، فزيارات أبي لمحيطنا العائلي والاجتماعي لم تتوقف منذ رحيله، لكنها لم تعرف لغرفتي يوماً سبيلاً، واليوم، وأنا في أشد الحاجة لمن يخفف من وجلي المتعاظم أعرف يقيناً أنه لن يحضر، لأنه لم يحبني.
أحمد الذي استقبلته في زنزانة "الايراد اليومي" للسجن، والذي فقد وعيه عدة مرات مع أول ساعة له في مسكنه الجديد، بعد أن تخطَّف الألم روحه كلما تأمل تفاصيل الزنزانة الكاسفة، ليقتات على ما تبقى لديه من جرعات الأمل، أحمد الذي اصطَحَبَته دموعه منذ القبض عليه إلى حقائق الفلسفة، حتى أدرك يقيناً أن الحزن لا يفيد، يقف هناك، معانقاً ذكرياته خلف نظارته الطبية، حيث تتلألأ حبات دموعه مع شعاع ضوء يتسلل نحو ذاته، بينما يسرق الحديد الموحش ما تبقي من روحه رويداً رويداً، يتلصص على وجوه الجميع، ربما تحمل إيماءات أحدهم ما يساعده على استكمال مشوار الوجع الذي لا يتوقف، قبل أن يدله قلبه علي وجودي، فيتجه نحوي منكسراً رغم ابتسامته، متسائلاً بصوت باهت: "هنرَوَّح إيمتى؟"، فتبادر يداي بالإجابة التي لا يتقنها لساني، ربَّتت على كتفه قبل أن تحتضنه في صمت مزعج.
*****
لم يخبرني أبي يوماً أنه يحبني، بالرغم من أنه كان منشغلاً طيلة الوقت لإثبات ذلك، لكن كل ثمرات الإثبات لا تستطيع أن تُعوض حاجتنا لأن نسمع، لذا، فقد اعتدت أن أخبر ابنتي يومياً بحبي لها.
لم يحبني أبي ولكني أحببته، أحببته للدرجة التي جعلتني أفعل كل شيء بصخب: أسرق الأضواء، أعتلي مآذن الرفض، وأحمل مشاعل لفت الانتباه، حتى يشعر بوجودي، ربما يحرك ساكناً ويقرّر التواصل معي، حتى وإن كلفني ذلك تعنيفه المنقوش في ذاكرتي... مجاز
"جنه، بحبك"، "جنه، انتي حبيبتي"، "جنه حبيبة بابا". لا أعرف من الذي أطلق اسم "جنه" على ابنتي، بالرغم من أن لساني هو من تفوّه بها حينما سألتني والدتي وأختي: "ناوي تسمي المولودة ايه؟"، لكني أدرك الآن حقيقة أن لكل شخص نصيباً من اسمه، بما يعني أن الاسم هو أول أقدار كل شخص، ولقد أخذْت نصيبي منها كاملاً، حينما استشعرت في ضمتها الأولى بالاستحواذ على كل شيء، فهي بلا أدنى شك جنتي، وبدونها، ها أنا ذا أسير الجحيم.
يقول شمس الدين التبريزي إن المرء مع من لا يفهمه سجين، لكن، هل يصبح المرء مع من يفهمه حُراً حتى وان كان سجيناً؟! يبدو أن التجربة هي وحدها التي تستطيع أن تجيب عن هذا التساؤل، خاصة أنني الآن في المكان الوحيد الذي يجمع رواد رابطة الحنين، من أبناء الوجع والحلم، ويبدو أيضاً، كما قال لي "أبو علم"، أحد الأصدقاء من النزلاء، قبل قليل، إن تجربتنا الحياتية كانت سوف تصبح منقوصة لولا دخولنا للسجن، فنستجلي جانباً عن الحياة لم يسنح للغالبية العظمى بلوغه، فالآن فقط أستطيع أن أشم رائحة القلوب، وأتذكر كلمات ابن القيم في "مدارج السالكين": "إن القلب يشم رائحة القلب".
*****
الجميع هنا باتوا يعرفون "جنه" كما أحبها، يدركون تماماً أنها هالة تعلّقي بالحياة، فهي دوماً سبب الابتسامة والشجن، ترافقني طيلة الوقت لتتلاعب بمشاعري، حيث تمتلك، رغم تغيبها الجسدي، كل مفاتيح الشغف، "جنه" ابنة الربيع السادس، التي رفضْتُ من أجلي وأجلها كل مناشدات أمي ألا تأتي لرؤيتي في هذا الحال الموحش، لأخبرها في لقائنا الأول بمسكني الجديد، أني هنا من أجلها وأجل مثيلاتها الذين يستحقون مستقبلاً أفضل من واقع عايشته، قبل أن تنهال دموعي حينما طلبَت مني أن أرافقها للمنزل وأستكمل ما أفعله لأجلها هناك!
"الرديني"، هذا الشاعر الموجوع الذي يرافق وجعي ويجاور فرشتي التعيسة بالزنزانة، ظل طيلة ليله يقظاً يتأمل عن كثب رسائل تنهيداتي التي تتجلى في ملامحي المنكسرة، خلال محاولاتي الخائبة للتسلل نحو عالم السكون المزعج، لأستفيق من سكراتي، فألمحه يدنو من رأسي ليلصق بمعجون أسنانه قصاصة ورق على الحائط أعلى هامتي:
ميت غمر أبوابها بتستنظر... تبعت مراسيل للجنه هناك
فـازاي تـتضـايــق وتكشــر... وقلوب الجنه معاك سكناك
إضحك للدنيا هتضحـك لك... واستنّي الفرحـة هـتستناك
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


