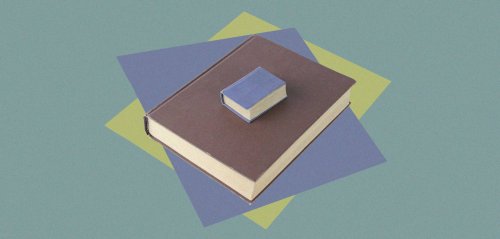قُبيل قراءتي رواية "من بيت الطين إلى عنّايا" (2023) المُغرقة في الذاتيّة، للروائي عمر سعيد، تابعت بعض أعمال الفرنسية آني إرنو الحائزة جائزةَ نوبل مؤخراً، ومن ضمن رواياتها "المكان"، وقد أطلقت العنان للذات المتكلمة لتسرد قصة والدها. إنما على الأغلب الأعمّ، قصة المكان أو الشخصية المحوريّة في أي عمل سردي، وإن اتخذت "الأنا" منطلقاً لها، فهي حكاية وعي جَمعي. وقبل هذه وتلك، قرأت رواية "ألواح" (2016) لرشيد الضعيف حيث كتب بحميميّة مماثلة، تعكس أحلام جيل وخيباته وحنينه ولا حنينه أيضاً، في قطيعة مُرهقة مع الماضي وسط حضوره. قد تكون مفارقة تمتاز بها الرواية اللبنانية في تفكيك الذات ما بعد الحرب!
رواية ما قبل الحرب اللبنانية أرهصت بها وتوجّست من ليل دموي طويل؛ وفي رواية ثالثة تضاف إلى النموذجين السابقين، تطالعنا "المَصيَدة" (2023) لعبد المجيد زراقط بسرد، وإن كانت متعدّدة الأصوات، إلا أننا نلمح انعكاس ذات الروائي في شخصية المثقّف المحاصَر والمنفي في حضور السلطان. ليبرز التقاطع بين الأعمال الثلاثة، على اختلاف المشارب الثقافية والسياسية، في جرأة القول بالتسمية والاعتراف والإدانة تارة، وتعرية قوى الأمر الواقع "المناطقيّة" تارةً أخرى، في حقبة عاشها لبنان، ولم يخرج من مفاعيلها.
البيت في بوح الرواية اللبنانية
جعل سعيد البيت حضن الذكريات كما ضمّت الذاكرة بيوتاً لها ما لها في الوجدان. في أسفاره المتعدّدة بين لبنان والعراق والسعودية والأردن وقبرص، وجد نفسه مسكوناً بالأمكنة، وأدرك معنى أن يُغلق خلفه باب الوطن؛ يقول: "لم يكن من السهل عليّ خلع الأماكن؛ لأنّني من الذين تزهر الأماكن في وجدانهم كلّما نأت عنّي أكثر فأكثر". وحين كان في زنزانة استعجب من ترك سجناء قبله رسوماتهم وكتاباتهم على جدرانها؛ إذ يرى أنّ الكتابة على جدران المكان تعبير عن الارتباط به فحسب.
جعل سعيد البيت حضن الذكريات كما ضمّت الذاكرة بيوتاً لها ما لها في الوجدان. في أسفاره المتعدّدة بين لبنان والعراق والسعودية والأردن وقبرص، وجد نفسه مسكوناً بالأمكنة، وأدرك معنى أن يُغلق خلفه باب الوطن
فكرة الاقتلاع من البيت والسيطرة عليه عنوة من "أسياد الحيّ" أو "حماة الديار" (الميليشيا الحزبيّة) تتكرّر في "المصيدة" و"ألواح". المسلّحون قادرون على الدخول إلى البيت ساعة يشاؤون، فهُم أسياد الليل والنهار؛ ولا فرق بين الخاصّ والعام في الحرب، بحيث يغدو الاستعطاف لغة المستضعَف رغم المذلّة، فيقول الضعيف حين هُدّد بإخلاء بيته في بيروت: "نعم استعطاف! كي أكره نفسي أكثر". أمّا نبيل عامل، شخصية "المصيدة" المحوريّة، فنفيه من المنازل مثلّث، ليمسي طريد الأمكنة جميعها.
بيت نبيل عامل في قريته الجنوبيّة حرقه المحتلّ الصهيوني، وبيته في أحد أحياء بيروت بعد أن هجّر إليها حرقته بعد نهب ممتلكاته، عصابات ميليشيويّة بزعامة تلميذه درويش الذي أصبح "أرقش"، وحالما انتقل إلى شقة بيروتيّة أخرى، طاردته قوى الأمر الواقع نفسها لتسيطر على مكان إقامته، تطويعاً له وتدجيناً لقبول ما يفرضون عليه من تعامل معهم. وحين عاد مرة أخرى إلى قريته اصطدم بقوى عميلة للمحتلّ بقيادة تلميذ آخر له يدعى سمعان وصار "ثعبان"، تحتلّ بيته، وسرعان ما تحرّره شريطة التعاون معها. ليجد نفسه مع عائلته في النهاية بغير مكان معلوم لدى القرّاء، خصوصاً حين يفصح بالقول: "يبدو أنّ الهرب قدري، منذ أن ارتضيت الهروب إلى الهامش".
يترك الضعيف، طيّ صفحاته من أدب الاعتراف، إشارات في وصف تعذيب الحيوانات مع رفاقه عندما كانوا فتية. ويتوقّف أمام مشهد تعذيب السلاحف التي لم تترك بيوتها، بل ماتت فيها، قائلاً: "إنّ هجر البيت بالانسلاخ منه بالقوّة أمر بالغ الصعوبة. إنّه مؤلم للجماد وليس للمخلوقات الحيّة فقط. والله لو كنت نبيّاً لأوحى الله إليّ بآية من هذا النوع: طوبى للمهجّرين من بيوتهم عنوةً، فإنّ لهم ملكوت السماوات. وأنا نفسي قد هجّرت من بيتي بالنار".
"الرجل الذي فقد ظله"، "وليد مسعود"، "المتشائل"، فنبيل عامل
تستحضر شخصيّة نبيل عامل، شخصيات إشكاليّة شهيرة في الرواية العربيّة. فهي تمثّل شخصية المثقّف العنيد في علاقته مع السلطة كيفما تبدّل وجهها؛ محاصر ليكون أداة لها. يختفي نبيل عامل مثلما اختفى وليد مسعود في منجز جبرا إبراهيم جبرا، وكاختفاء سعيد أبي النحس المتشائل لدى إميل حبيبي. وتحاول شخصيات متعدّدة عرفته أن تروي جوانب مختلفة من حياته لتكتمل الوقائع، ولعلّ الحكي يفضي إلى جلاء الحقيقة.
ترتسم شخصيّة نبيل مثقفاً كان يساريّاً، على خلاف شخصية يوسف عبد الحميد السويفي المتحوّلة في رواية فتحي غانم "الرجل الذي فقد ظله" (أنتجت فيلماً من إخراج كمال الشيخ، 1968)؛ بحيث لم يتبدّل تحت أي ضغط ولا يسعى لتأمين مصالحه بمخالفة مبادئ آمن بها، على الرغم من ابتعاده عن الإيديولوجيا الحزبية. نخاله بطلاً خارقاً، لا يتّصف بالضعف الإنساني في أي منحى من مناحي الحياة، وإن انسحب إلى الظلّ، فليحمي عائلته، ولانتزاع أي دور يقوم به. أما يوسف فقد اغترب عن نفسه، معترفاً بالقول: "عندما أهمس باسمي بيني وبين نفسي يخيّل إليّ أنّي أردّد اسم شخص آخر لا أعرفه، شخص غريب عني، لا أحبّه ولا أكرهه".
صورة المثقّف في صراعه مع الأنظمة الأمنية تحضر في سيرة عمر سعيد الرافض أن يكون امتداداً لعمّه البعثي ولأبيه الناصري في بيئة "تورّث الديانة والطائفة والخط السياسي وحبّ الزعيم الخالد والفشل".
وبين سامي الكاتب (المصيدة) والدكتور جواد حسني (البحث عن وليد مسعود) أوجه شبه في جمع سيرة الشخصية على لسان من عرفوها. وبالمثل تُروى حكاية يوسف على ألسنة أربع شخصيات، هو من ضمنها. وفيما تُكتب سيرة فرد، تُدوّن قطعة من تاريخ شعب. يقول نبيل لسامي قبيل اختفائه: "كتبت في هذا الدفتر فصولاً من حكايتي... كثيرون سيسألونك عن نبيل عامل. أضف ما يكتبونه إلى ما في هذا الدفتر من كتابات. واصنع رواية من ذلك كله... سمّها (المصيدة)".
وبالمثل يطرح حُسني تساؤلاته قائلاً: "عمّن هم في الحقيقة يتحدّثون؟ عن رجل شغل في وقت ما عواطفهم وأذهانهم، أم عن أنفسهم، عن أوهامهم وإحباطاتهم وإشكالات حياتهم؟ هل هم المرآة وهو الوجه الذي يطلّ من أعماقها، أم أنّه هو المرآة ووجوههم تتصاعد من أعماقها كما ربما هم أنفسهم لا يعرفونها؟... وهل كان وليد إلا حاصل حياته وحياة المحيطين به، حاصل زمانه الخاص وزماننا العام، في وقت واحد؟". هذا تماما ما تمثّله حكاية نبيل عامل وحكايا من ساعدوه ومن قهروه.
صورة المثقّف في صراعه مع الأنظمة الأمنية تحضر في سيرة عمر سعيد الرافض أن يكون امتداداً لعمّه البعثي ولأبيه الناصري في بيئة "تورّث الديانة والطائفة والخط السياسي وحبّ الزعيم الخالد والفشل". اتّهم في العراق لعدم انتسابه إلى حزب البعث، وحالما عاد إلى لبنان بسبب التضييق عليه، استضافته مخابرات النظام السوري المحتلّ في زنزانتها بتهمة انضمامه إلى البعث العراقي. وحين حمل "الإنجيل" وعلّق صليباً في عنقه اتهمه أقاربه بالكفر: "كل ذنبي أنّي لم أكن أريد أن أنتسب حزبيّاً... وإن كانت النوايا تكفي الله ليحدّد ولاء العبد، فإنها يستحيل أن تكفي المحقّق ليختم المحضر، ويغلق الملف".
إدانة البراءة: البحث عن الذات، أم جَلدُها؟
بين تفكيك الذات لمساءلة سرديات تبنّتها، وجلدها بالتعرية شعرة ينبغي ألا تُقصَم. فنحن أمام ثلاثة نماذج: رشيد الضعيف يعريّ نفسه فحسب بالاعتراف، وعمر سعيد يمعن في نقد بيئته والتنظيمات التي انضوت إليها وقاتلت شركاء لها في الوطن باسمها، ويفضح القادة الخالدين ومن يرفع صورهم ممجّداً: "نحن عشّاق الأنبياء والطغاة والولاة والصالحين والظالمين والكذّابين والصادقين والأموات". وبطل عبد المجيد زراقط يتنكّر لما كان عليه من فكر يساري، كأننا به يدحض تهمة، غير أنّه يبقى صاحب قيم يعمل وفقها في صراعه مع من خوّنه.
فهل الخطابان الروائيان الأخيران يتوجّهان إلى جمهور معيّن من قرّائهما؟ جمهور مؤمن أو مؤدلَج! ثمة تفسير يذهب بنا في اتجاه الإفلاس الحزبي والعودة إلى حظيرة جماعة دينيّة ما، أو إلى كنف روحي مطلق بعيداً عن أي إيديولوجيا، إلى رحابة السماء بغير تعقيدات وشوائب أرضيّة! "عنّايا" (بلدة حيث محبَسَة الراهب شربل) في أحد النموذجين، إشارة إلى صحة هذا التفسير.
من خلال المكاشفة والسؤال، تتبدّى "ألواح" متناثرة المشاهد؛ لوح يدين فيه براءة الأم، ويبتغي محاكمة البراءة المسبّبة للألم والمثيرة للغضب، وها هو ما زال يدفع ثمن الإنسانيّة القاتلة والقتيل. وألواح أخرى يخلع فيها أقنعة لم تخفِ سوى اغتراب مثقّف مصاب بأرق مزمن. وفي حين يتساءل: "أليست الحضارة ابتعاد الإنسان عن طبيعته؟" يغرق عمر سعيد في تمجيد بساطة الأم والصورة النمطية/ المثال لها. لكن كاتب "ألواح" سرعان ما يعترف بأنّ الأمّ في الشدائد والمرض تبقى، بعد أن ينسحب الجميع، لتمسح عنك ذلّ الحياة ورذالتها.
يبقى السؤال عن ذرائع الكاتب لتعرية الذات وإعادة تشكيلها على نحو آخر لعلّه يصبح أكثر قابليّة للوجود. لا تتأخر الإجابة لدى الضعيف فيرى أنها كتابة للتطهّر، كأن تكون شهادة، صرخة، أو وقفة عزّ، وقد تكون إذلالًا للنفس بالاعتراف. ومن يودّ الكتابة يحذّره من الموروث، إذ كثيراً ما يكون قاتلاً؛ فليبتدع كلّ منهم بلاغته الخاصة- بوصلة زمانه.
الرواية اللبنانيّة، هذا الوجع المرجأة قراءته، لا لشيء سوى الهروب من ثقوب الذاكرة. والقراء اللبنانيون إذ يهربون من قراءة تاريخهم المتخيّل ونخالهم لامبالين، يودّون أن ينسوا خشيتهم من المستقبل بقدر رغبتهم في نسيان الماضي
رشيد الضعيف المؤمن بقيام ساعة بلاغة جديدة، كان تفكيكيًّا بامتياز على غرار عمر سعيد. يودّ الأوّل زعزعة أيديولوجيا التقديس لدور الكاتب، في محاولة لزعزعة المركز. ومع تقدّم العلوم، كما يرى، تتغيّر الطبقات والسلطة، وتتبدّل المفاهيم بدورها. فالحقائق لا تؤنس بالضرورة، والسماء لم تعد مَبيت الألوهة حتّى نشبّه بها كل ما هو متعالٍ. أما الثاني فملجؤه هذه السماء ليس إلا، ليتساوى في المحبة الصديق والعدو "الإسرائيلي" على أرض لبنان! وهذا ما يترك غيرَ سؤالٍ حول خلخلة الحدود.
الرواية اللبنانيّة، هذا الوجع المرجأة قراءته، لا لشيء سوى الهروب من ثقوب الذاكرة. والقارئ اللبناني إذ يهرب من قراءة تاريخه المتخيّل ونخاله لامبالياً، يودّ أن ينسى خشيته من المستقبل بقدر رغبته في نسيان الماضي.
أنهي مقالي بتعقيب على ما يراه الضعيف في أنّ الثقافة تدخل في نسيج الحياة، بوصفها ابنة الواقع المعيش، وليست في بطون الكتب، وبأنّ وعينا بذاتنا يتشكّل على الرّصيف – وهو مجاز الحياة اليوميّة - لا عبر الرّواية. لكنّنا ما نقرؤه في هذه الروايات ليس إلا أرصفة الذاكرة الحقيقيّة والمجازيّة، وما هي سوى بيت أحلامنا وكوابيسنا وخيباتنا.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.