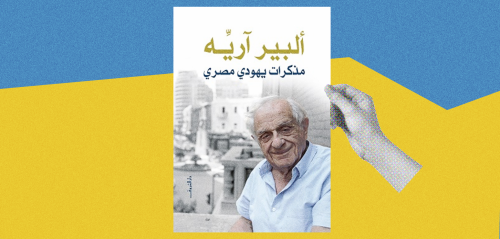"لا مفرَّ هنا مِن الإشارة إلى معلومة بَديهية وإن غابت أحياناً عن كثيرين، وهي أنَّ فؤاد ليس شخصاً حقيقيًّا، هكذا بكل بساطة. وعلى الرغم مِن هذا، فسوف نبذل، من جانبنا، غايةَ جهدنا، ليبدو حقيقيًّا، وموجوداً بالفعل في مكان وزمان مُحدَّديْن خارج مَصفوفة هذه السطور".
المتحدث هنا ليس "هو" بل "هم"، لذا يتخذ ضمير المتكلم صيغة الجمع، إنهم "فيلق فؤاد"، الأشباح الذين يسكنون جسده منذ زمن بعيد، جسده غير الحقيقي كما يزعمون، لكنهم، في مسعاهم لمساعدة فؤاد في استنقاذ بعض الفقرات من دفاتر يومياته قبل أن يحرقها جميعا، من أجل "إزاحة كراكيب الأمس جانبا وإفراغ مساحة لدخول الغد حراً خفيفاً"، في مسعاهم ذاك الذي جهزوا فيه الخطط ووزعوا المهام، ينجحون بشكل لا لبس فيه في أن يجعلوه حقيقياً وبرهان نجاحهم، أن كثيراً من القراء، كما يتضح من القراءات النقدية وتعليقات مواقع القراءة، استقبلوا رواية محمد عبد النبي الجديدة "كل يوم تقريباً" بوصفها أحد أشكال السيرة الذاتية، بغض النظر عما تدعيه أشباح فؤاد.
كاتب مثل محمد عبد النبي، هو كاتب من الطراز الذي لا يشكل الوصف على غلاف كتبه فارقاً في قرار القراءة، في زحام الكتّاب هو أحد من نقرأهم مطمئنين إلى كوننا أمام أديب حقيقي
خلال السنوات الماضية تكررت الكتابات التي تداعب الخط الفاصل بين الخيال الروائي والسيرة الذاتية وإن قُدِمت تحت لافتة واحدة من اللافتتين، ربما منذ "مولودة" نادية كامل وصولاً إلى أقفاص – فاطمة قنديل – الفارغة. وحتى كتاب إيمان مرسال عن عنايات الزيات. يستقبلها القراء كما يحلو لهم، بغض النظر عن الوصف المكتوب على الغلاف، والذي تحدده أحياناً الدواعي القانونية، وفي أحيان أخرى شروط الجوائز، وقبل كل شيء مساحة الاعتراف التي يمكن أن يقبلها المجتمع في إطار من الخيال المحض.
لكن لحسن الحظ، أن كاتباً مثل محمد عبد النبي، تماما مثل مرسال وقنديل، هو من الطراز الذي لا يشكل الوصف على غلاف كتبه فارقاً في قرار القراءة، في زحام الكتّاب هو أحد من نقرأهم مطمئنين بكوننا أمام أديب حقيقي، يقولون "ابحث عن الكاتب لا عن الكتاب"، ولهذا فإننا، في "كل يوم تقريباً" كما في غيرها من مؤلفات عبد النبي، نستمتع بفعل القراءة نفسه، بتذوق الجملة واستطعام الفقرة وتلمّس الشخصية، ثم نتفق أو نختلف كما يعن لنا حول الكتاب أو اتجاهات الحبكة ومصائر الشخصيات.
"كل يوم. كل يوم تقريباً. كل يوم لغز. كل يوم أحجية. كل يوم فرصة. كل يوم لعنة. كل يوم مرآة. كل يوم صفحة بيضاء تتلوث بمجرد اليقظة. كل يوم يتكرر، هو نفسه، تقريبا".
لا ترِد الفقرة السابقة مرة واحدة كذروة يكتمل بها المعنى الروائي، وإنما هي أقرب إلى لازمة موسيقية في أغنية، تتكرر بها العبارة "كل يوم تقريباً" في الكثير من المواضع، في حياة فؤاد، الوحيد رغم الأم والعائلة، رغم الأصدقاء، رغم العلاقات العابرة، فـ "الناس لا توحشني، ولا أعتقد أنني أوحشهم أبداً"، أو ربما تكمن الحقيقة في "أنَّه كان أشدَّ كسلاً وأنانية مِن أن يبذل جهداً مُخلصاً من أجل أي شخصٍ آخر غير نفسه، أو ببساطة لم يجد، بالمصادفة وهو سائر على طريقه، مَن يستحق مثل هذا الجهد". إنها الأسئلة التي قد تختلف من إنسان إلى آخر، لكنها تشترك في أننا نخوضها نفسها مع كل صباح، إذ نفاوض الوجود كل يوم، أو كل يوم تقريباً.
الكتاب الذي يبدأ بالعثور على جرو جاء إلى غرفة فؤاد بطريقة غامضة، لن يتضح سرها قبل مئات الصفحات، يبدأ حقيقة بموت الأب "هكذا فجأة بلا مقدمات"، وبالكلمات التي كتبها فؤاد عن أبيه بعد وفاة أبيه بأيام، كتبها دفعة واحدة "كأنه يبرىء ذمته". لكننا سرعان ما نلتقي الأب الآخر، الأب السماوي، مصدر الفرحة والغبطة، مصدر الشبع الذي طارده فؤاد على امتداد الرواية بين الأصدقاء وكذلك العشاق، فالمثلية الجنسية هنا ليست موضوعاً استثنائياً ينتمي إلى عالم صفحة الحوادث، كما في رواية عبد النبي السابقة "في غرفة العنكبوت" التي سردت قصة الباخرة كوين بوت، بل هي جزء "طبيعي" من شخصية فؤاد، الذي يمارس "بطولته" الروائية كأي بطل روائي آخر. لكن قبل الأصدقاء والعشاق، يبحث فؤاد عن اكتماله في في بيوت كبيت "السعدني" أستاذ المدرسة الإعدادية، الذي تمنى فؤاد أن يكون هو بيته، وأن تكون أسرة السعدني أسرته، وأن يكون السعدني نفسه أخاً له، أو أباً.
"كل يوم تقريباً" هي أقرب إلى لازمة موسيقية في أغنية، تتكرر بها عبارة "كل يوم تقريباً" في الكثير من المواضع، في حياة فؤاد، الوحيد رغم الأم والعائلة، رغم الأصدقاء، رغم العلاقات العابرة
لن يكون بيت السعدني آخر البيوت التي يعرفها فؤاد بعد بيته، سيكون بيت "ماما فيفي" ملجأ له، بين تكريم له باعتباره أحد أبنائها الروحيين العديدين، ومساعداتها المادية التي احتاجها كثيراً، وابتزازها العاطفي الذي استهلكه لسبع سنوات، اضطر عبره أن يجاريها في "موهبتها" الأدبية حتى "أحس كثيراً كأنه يمشي على حبل معلق في الهواء". لكن ثمة بيوتاً أخرى على امتداد الكتاب، بيوت في شبرا الخيمة وشبين القناطر، والوايلي التي نشأ فيها فؤاد، لكنها انتظرت سنوات طويلة كي تصنع النقلة الثانية في حياته، إلى عالم الشعراء "الضائعين، الأكبر سناً، مدمنو البانجو وناظمو القصائد العبثية غير المفهومة"، قبل أن تنقله "شلة شبرا"، إلى عالم السياسة والسرقات الصغيرة، وصولاً حتى إلى الجرائم الوحشية على يد أحد أعضاء صعاليك الشلة.
هل يمكن لمن لم يعش أو يجرب أو يحتك بتلك الفترة الزمانية والتجربة المكانية أن يستقبلها في "كل يوم تقريباً" كما استقبلها من عاشوها أو احتكوا بها؟ وهل ثمة طريقة أفضل أو أسوأ لاستقبال تجربة إنسانية ما؟
ليس هذا الدور الوحيد للشلتين، في شبرا والوايلي، وإنما هما أعادتانا من جديد إلى سؤال السيرة والرواية. تبدو حياة الشلتين، في هاتين المنطقتين في شمال القاهرة، أقرب إلى سيرة تتخطى فؤاد نفسه، أو لنقل أنه يمثل فيها جيلاً كاملاً وخاصاً من يسار التسعينيات، لا يسار أبناء المثقفين أو البرجوازية؛ بل اليسار الذي جاء عبر بوابات قصور الثقافة والأندية الأدبية ونشاطات الجامعة، من عائلات تنتمي بالكاد إلى الطبقة الوسطى "لعل الفقر أوثق ما ربطه بشلة شبرا الخيمة، قبل الأحلام والأدب"، يسار نشَط في تكوين المجموعات الشيوعية وتدخين الممنوعات وقراءة الكتب وسرقتها، أو سرقتها لقراءتها، وعرف أيام الجوع والنوم في البيوت الجرداء والصراعات الصغيرة وتبريرات الانتقام من البرجوازيين، العمل المضني من أجل القروش – بما فيه كفاح فؤاد وراء الجوائز الأدبية - والعمل السري من أجل السياسة، والغضب والمشاجرات ومحاولات الانتحار.
هل يمكن قراءة ما عاشه ذلك اليسار أو جانب مما عاشه، في صيغة روائية محضة، أم أن الشعور بقراءة السيرة يطغى هنا؟ هل يمكن لمن لم يعش أو يجرب أو يحتك بتلك الفترة الزمانية والتجربة المكانية أن يستقبلها في "كل يوم تقريباً" كما استقبلها من عاشوها أو احتكوا بها؟ وهل ثمة طريقة أفضل أو أسوأ لاستقبال تجربة إنسانية ما؟ وهل يمكن اعتبار حكاية فؤاد المتخيلة سيرة جماعية لـ شلل حقيقية؟ أسئلة لا يجيب عليها سوى كل قارىء على حدة. الأكيد أنها تجربة سردت عبر اللغة الجميلة لصاحبها، بأحداث تسارعت حيناً وتمهلت حيناً وتباطأت في الثلث الأخير، برغبة دائمة من صاحبها في التحرر عبر العيش كل يوم بيومه، أو كل يوم تقريباً، وبالتباهي بالقدرة على دفن جثث الماضي، محتضناً "بطاقة الدعوة التي وصلته من سنين، لا يدري متى تتحقق وعودها"، موقناً أنه "لا جدوى من النوستالجيا يا فؤاد، فالمذاق القديم مفقود للأبد".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.