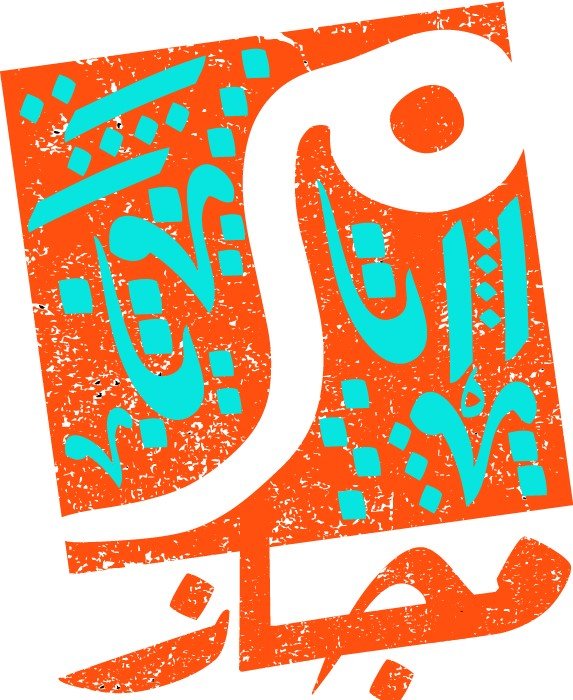 نوستالجيا خفيفة
نوستالجيا خفيفة
بطرف لساني ألعق ظهر الطابع البريدي الصغير؛ أتذوّق طعم الصمغ اللاذع فأضحك. بأطراف أصابعي ألصقه على واجهة الظرف الأبيض، وأدقّ عليه ببطن كفّي لأتأكد من ثباته، ثم أسلّم الخطاب لأبي.
تلك كانت مهمتي التي حاولت أن أجيدها كلّ مرة كيلا يغضب والدي ويعاقبني بالحرمان منها، فانتقاء طابع بريدي مناسب للخطاب المُرسل من بين دفتر الطوابع القابع في درج المكتب الخشبي الكبير؛ كان أمراً ممتعاً للغاية، لا يمكنني التفريط فيه مهما كانت المغريات.
طفلة صغيرة كنت، لم أتخط السابعة بعد؛ حينما جاء أبي بملامحه الجادة في ظهيرة حارقة وهو يتصبّب عرقاً، ليخبر أمي أنه قرّر أن يخدم أهل القرية، ويستقبل عُهدة مكتب البريد في منزلنا الصغير حتى "يحنّ المجلس المحلي للمدينة علينا ويخصص مكاناً للبوسطة". يومها لم أفهم نصف كلماته: "عهدة، مجلس محلي، مكتب بريد وبوسطة". كانت بالنسبة لي مفردات هاربة من صفحات كتاب عتيق اصفرّ لونها من فرط قدمها، كتلك الكتب التي ارتصت على أرفف مكتبة والدي الضخمة.
لكنني شعرت أنها تنبئ بأمر جلل، خاصة حينما قام أبي بإفراغ درج مكتبه من أوراقه ومحبرته وأقلامه البوص التي يعتزّ بها كثيراً، ويحذرني دوماً من الاقتراب منها أو العبث بها. فقد قرر تخصيصه "للعهدة" التي صار يوصينا بها كل يوم، فضياعها يعني خضوعه للمسائلة القانونية، وربما الحبس بتهمة "التبديد".
على مضض، تابعت أمي ما يحدث. وأظهرت بعض التذمر وهي تساعد أبي وتردّد: "كنا ناقصين البوسطة كمان". لكنني كنت على العكس تماماً، فقد تملكني الفضول لمعرفة تفاصيل تلك "العُهدة".
دفتر الطوابع
لم يمر وقت طويل حتى ضمّ درج المكتب ختماً بذراع خشبية قصيرة وختّامة بسطح أزرق استقرّت في علبة صفيح صغيرة، وأوزاناً نحاسية بأحجام مختلفة، تبدأ بكتلة لا يتخطي حجمها عقلة إصبعي الأصغر وتنتهي بكتلة أخرى أكبر من كفي الاثنين مضمومين معاً، وميزاناً حساساً كما وصفه أبي، يزن الخطابات بدقة، ليحدّد ما سوف يدفعه المرسل ويحصله، ثم يدون قيمته مع بياناته في دفتر بغلاف أخضر سميك، طُبع عليه شعار "هيئة البريد المصرية" بكتابة ذهبية مميزة، كانت تخطف عيني كلما فتح أبي الدرج، ومغلفات ورقية ناصعة البياض تزينت بإطار ملون بلونين لا ثالث لهما: الأزرق والأحمر. ودفتر طوابع بريدية بكل فئاتها، كان بالنسبة لي ألبوم صور صغير، أتحسسه بإعجاب كلما نسي أبي الدرج مفتوحاً.
لم أفهم نصف كلماته: "عهدة، مجلس محلي، مكتب بريد وبوسطة". كانت بالنسبة لي مفردات هاربة من صفحات كتاب عتيق اصفرّ لونها من فرط قدمها، كتلك الكتب التي ارتصت على أرفف مكتبة والدي الضخمة... مجاز
أتأمل أطراف الطوابع "المشرشرة" بإتقان فريد، وتفاصيل رسوماتها الدقيقة على صغر حجمها، فالطابع الذي لم تتخط أبعاده عقلة الإصبع طولاً وعرضاً يسع الأهرامات الثلاثة ونهر النيل وبرج القاهرة وقلعة صلاح الدين. يحمل بكل أريحية وجوه أم كلثوم وطه حسين وجمال عبد الناصر والملكة نفرتيتي والجميلة كليوبترا والخديوي اسماعيل، فصار ذلك الدفتر بمثابة البوابة السحرية التي عرفتني على الكثير والكثير، فقد كنت أسأل أبي عن تفاصيل كل صورة؛ فيحكي عن مكان أو شخصية، وصار ذلك الدفتر السحري محور حكاياتي لرفيقات المدرسة وجيران الشارع، أقصّ لهم حكايات طوابعه بكل شغف وانبهار.
كنت أتمنى لو أدعوهم لرؤيته والتمتع بصوره الصغيرة مثلي، لكن أبي كان يغلق الدرج بمفتاح خاص يتركه مع أمي إذا ما غادر المنزل لأي مكان؛ خوفاً على العهدة.
عم أمين البوسطجي
لم تكن تلك العهدة هي الضيف الجديد الذي عرف طريقه إلى بيتنا فقط. فقد صرنا أيضاً نستقبل ساعي بريد يأتي إلينا مرتين في الأسبوع، راكباً دراجة هوائية قديمة، مرتدياً بدلة زرقاء بأزرار نحاسية مميزة، حاملاً كيساً كبيراً صنع من قماش الدمور الأبيض الذي تغير لونه بفعل أتربة شوارع القرى التي يقطعها يومياً دون كلل.
يستقبله أبي بترحاب، فيعبر باب البيت بابتسامة اعتقدت لسنوات طويلة من فرط ثباتها أنها جزء من ملامحه، كحاجبيه وأنفه الكبير. يلقي التحية على أمي وهو يطلب منها بكل جرأة أن تعدّ له كوباً من الشاي الثقيل كأنه أصبح فرداً من العائلة.
يُفرغ ما بكيسه من خطابات على سطح المكتب الخشبي الكبير، القابع في غرفة الجلوس البحرية، بعد أن يخلع حذاءه عند بابها كيلا يطأ به على الحصير الخوص فيتسخ، كما توصيه أمي التي كانت تحرص على نظافته دوماً. يجلس على الكنبة الاسطنبولي، ثم يبدأ في فرز الخطابات. هذا عادي يمكن تسليمه لصاحبه في منزله، وهذا بعلم الوصول، لا يخرج من درج المكتب إلا بتوقيع صاحبه في الدفتر.
خطابات تحمل أخبارهن وأشواقهن التي لا تطفيء نيرانها رسالة تحمل كلماته ولا حتى شريط تسجيل يحمل صوته.
تعلم منه أبي وأمي طقوس استلام الخطابات وتسليمها، فصارا يعرفان جيداً أسعار الطوابع والأظرف، يكتبون الخطابات والعناوين بخط جميل إذا ما كان صاحب الخطاب لا يستطيع القراءة والكتابة، ويضعونه –إن كان خطاباً عادياً- في فتحة جانبية بصندوق خشبي أحمر، علقته المصلحة على حائط دارنا من الخارج بجوار الباب الكبير. مع صندوق خشبي أزرق كان يستقبل الخطابات المسجلة بعلم الوصول، ليفتحهما عم أمين بمفتاح خاص كلما أتي إلى دارنا، ويأخذها من الصندوق واضعاً إياها في حقيبة جلدية مهترأة تنام دوماً على بطنه.
كنت أسأل أمي وأبي بدهشة: لماذا نضع الخطابات في تلك الصناديق ثم يأتي عم أمين ليفتحها بمفتاحه ويأخذها. لماذا لا نسلمها له مباشرة؟ ليجيبا برد واحد في كل مرة: "هما قالوا نعمل كده يبقى نعمل كده".
ساعية بريد صغيرة
كان ظهور عم أمين البوسطجي على أول حارتنا أمر جلل يتهلل له وجهي، فظهور الرجل صاحب القامة الطويلة والشارب الصغير الذي لا يتناسب مع ضخامة ملامحه؛ كان إيذاناً لي بجولة حرة في شوارع قريتنا الصغيرة. فكما كانت مهمتي الممتعة لصق الطوابع البريدية على الخطابات؛ كانت مهمتي الأكثر متعة هي توزيع الخطابات العادية على بيوت القرية فور استلامها، وإخبار من أتاه جواب "مسوجر" (خطاب مسجل بعلم وصول) بأن يحضر لدارنا ليوقع باستلامه قبل أن يفوز به.
لم تكن تلك الجولات ممتعة بالنسبة لي فقط لأنني أنطلق حرة في شوارع القرية دون أن أخشى عقاب أمي التي كانت تقيد حركتي على عكس رفيقاتي، لكنها كانت ممتعة لأنني كنت أعود منها محملة بحبات الكراميلا، التي كان يهديها لي أصحاب الخطابات، تحية منهم لي لأنني "بشرتهم" بخطاباً من الغاليين بعد غيبة.
تلك الحبات التي كانت تتحول إلى قروش فضية إذا ما كان الخطاب يحوي "شريط تسجيل" يحمل صوت الغائب وسلاماته للأحبة.
كانت مهمتي الأكثر متعة هي توزيع الخطابات العادية على بيوت القرية فور استلامها، وإخبار من أتاه جواب "مسوجر" (خطاب مسجل بعلم وصول) بأن يحضر لدارنا ليوقع باستلامه قبل أن يفوز به... مجاز
فقد جاء مكتب البريد لمنزلنا في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، التي شهدت فيها قريتنا سفر أغلب رجالها إلى دول الخليج، للعمل في الإنشاءات أو التدريس. كانوا يغيبون بالسنوات لا تأتي منهم الخطابات ولا ترسل إليهم إلا كل عدة أشهر مرة، فقد كانت تستغرق الكثير من الوقت للإرسال أو الاستلام، لذلك ظل أهل قريتنا يدينون بالفضل لأبي لسنوات طويلة، لأنه يسّر عليهم التواصل مع الأحبة الغائبين.
أقولك إيه عن الشوق ياحبيبي
سنوات عدة ومكتب البريد في منزلنا، ازدادت فيهم مهامي بالتدريج، حتى أصبحت مع الوقت مسؤولة عن كتابة الخطابات وقراءتها لمن يجهل القراءة والكتابة من أهل قريتي، فصرت رغماً عني جزءاً من حكاياتهم وشريكة فعلية في أفراحهم وأحزانهم.
صبية كنت على بعد خطوات قليلة من عامها الثالث عشر، تملي عليها نساء القرية خطابات لأزواجهن المسافرين إلى الكويت والسعودية، خطابات تحمل أخبارهن وأشواقهن التي لا تطفيء نيرانها رسالة تحمل كلماته ولا حتى شريط تسجيل يحمل صوته.
نيران الشوق!
كيف تكون تلك النيران؟ وأين تشتعل في الجسد بالتحديد؟ وما الذي يطفئها؟ أسئلة عديدة عرفت طريقها لعقلي الصغير مبكراً، فصرت أتلمّس إجابتها من خطابات نساء القرية لأزواجهن. انتظر بلهفة أن يأتي لإحداهن خطاب يحمل كلمة غزل، أو إشارة خفية لشوق عارم من زوج عذبه البعد، أقرأها عليهم بصوت خافت يكسوه الخجل، فتحمر وجوههن وتلمع عيونهن فجأة، ويرتجف قلبي وتدب النيران في جسدي دون أن أفهم السبب، حتى لاحظت أمي فأصدرت فرماناً بتوقفي الفوري عن قراءة وكتابة الخطابات لنساء القرية، معلّلة ذلك لأبي بجملتها الشهيرة: "هايفتحوا عينين البت بدري"، فأصابني الحزن لأيام.
حتى عدت ذات ظهيرة من مدرستي لأجد عم أمين البوسطجي يخلع صندوقي البريد من مكانهما فوق الحائط، بينما يجمع أبي العُهدة في صندوق كرتوني ويحكم إغلاقه، ويذهب به مع عم أمين إلى مجلس المدينة، استعداداً لنقلها إلى مقر البوسطة الجديد الذي تم تجهيزه على مشارف القرية، وكأن الخطابات أبت أن يكتبها ويقرأها غيري فرحلت عن دارنا بهدوء.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


