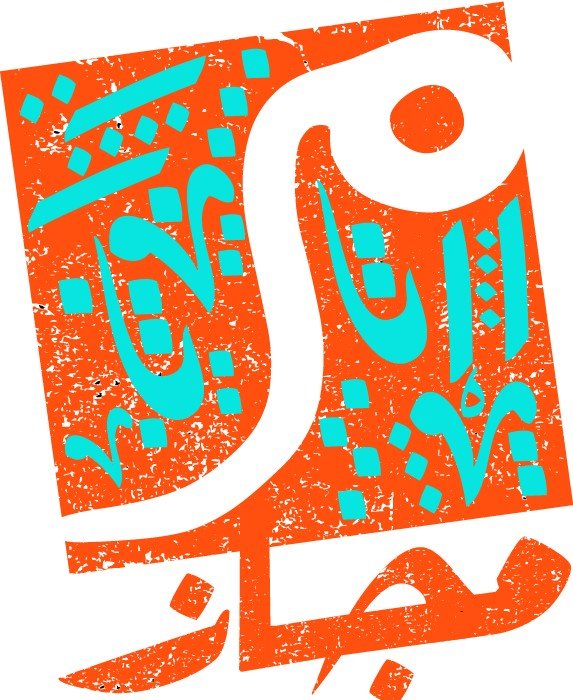"أصعب شيئين يمكن للمرء أن يعيشهما هو خسارة ما يريد، أو الحصول عليه"، لا أعرف أين قرأت هذه الجملة لكنّي دائماً ما فكّرت فيها، ما الصعب بأن تحصل على ما قاتلت لأجله طويلاً؟
اليوم، بعدما حصلت على معظم ما أريد، أعتقد بأن على الجملة أن تكون "والحصول على ما ظنّ أنه يريده".
منذ سنوات تتمحور كل أحلامي على فكرة الخروج منها، كنت أركض لسنين لهذا الهدف وحده "لأنجو"، لكنّي البارحة أمسكت جواز سفري بيدي للمرة الأولى، وتمنيت لو لم أفعل.
"شاهدت البارحة قطة تأكل رأس ابنها بعد أن ولدته مباشرةً، فارتعبت، وعندما سألت عن السبب، عرفت أن القطة إذا ما جاعت التهمت أطفالها، وأوّل ما فكرت فيه أن هذه البلاد لا تشبع أبداً".
كتبت هذا النص من سنتين، وحتى الآن ما زلت أذكر القطة ولا أذكر لماذا كنت حانقةً على بلادي إلى هذه الدرجة، فكلّما أصبح رحيلي عنها قريباً، رحلت عني ذكرياتها القاسية والمؤلمة وبقيت أصداء الضحكات في زواياها المعتمة تضرب على أعصابي، فأتمنى بجزء خفي عني ألا أذهب، لكنّ نسيانك للسكين الذي كاد يذبحك لا يعني تعافيك، فأرشي أحدهم ليعجّل بجوازي، وأفهم أنّي لم أرد الرحيل هكذا لكنّه صار بشكل ما.
أحلى المرّين
أكره المفاوضات وأكره أن أجبر عليها، أخبرني صديقي وأنا أودعه: "أكثر شي مزعلني إنه عم اضطر ضحّي بصداقاتي وضحكاتي هون لأقدر أحصل على كهربا ومي وأكل هنيك!"، وظننت حينها أني فهمت. على ما يبدو لا نستطيع فهم شيء إن لم تكوينا ناره.
بعد أن استلمت جواز السفر، خبّأته جيداً وذهبتُ لأرى أصدقائي، لكنّ أحدهم لم يأت، وقال لي: "جاي الأيام!"، فبكيت لأني الوحيدة التي عرفت أنها لن تأتي؛ كيف يمكن للإنسان أن يعيش آخر أيامه بسعادة إذا عرفت أنها كذلك؟
"شاهدت البارحة قطة تأكل رأس ابنها بعد أن ولدته مباشرةً، فارتعبت، وعندما سألت عن السبب، عرفت أن القطة إذا ما جاعت التهمت أطفالها، وأوّل ما فكرت فيه أن هذه البلاد لا تشبع أبداً"... مجاز
قررتُ العودة إلى البيت واستغلال التكنولوجيا عبر إجراء مكالمة فيديو مع الشخص الوحيد الذي أردتُ إخباره، فانتهت بطارية هاتفي، لكنّي اليوم عنيدة ولن أسمح لأي شيء أن يجعلني أكره هذا المكان، استعرت هاتف أخي فانقطع الاتصال وغفوت قبل أن يعود.
ليس كما يبدو
أعرف بما يفكر الجميع، أريد أن أخرج لأسباب سياسية ربّما واقتصادية بالتأكيد، لكنّي أعرف أنّي أستطيع الاستقرار اقتصادياً هنا أكثر من أي مكان آخر، وتوجد الكثير من الطرق السهلة حتى أتفوّق في عملي دون منافسة تُذكر، وبالطبع فالسياسة خارجاً ليست أفضل، من يعمل ما أعمل يعرف أنها جميعاً أوجه مختلفة لحقيقة واحدة لا يحبها أحد، لماذا إذن أترك كل هذا وأذهب إلى مكان لن يؤمن لي إلا بضع رفاهيات اعتدت على العيش دونها؟ لأبرّر شعوري الدائم بالغربة؟
لم تكن سوريا مكاناً مثالياً لأحب نفسي، لكنها مثل جنية طيبة ألبستني فستاناً ملوّناً
هذه الحقيقة التي هربتُ من مواجهتها طيلة الوقت، برّر مرّة صديقي تعلّقه بدمشق بأنها المكان الذي لا يشعر فيه أحد بالغربة، قالها بعفوية ثم سألنا -وكنا قرابة الـ 15 شخص- هل فيكم أحد يشعر هنا بأنه غريب؟ وعندما رغبتُ بأن أجاوب: أنا، إذا كان لا يوجد إلا شخص واحد يشعر بأنه غريب في دمشق سيكون أنا، ولو أردتَ تعريفاً حقيقياً وبسيطاً للشعور بالغربة والنفي فسيكون ما أحسّه هو الجواب.
أكبر من الصور البيانية
صبيحة كل يوم، أخضع نفسي لجلسة تنمية بشرية فاشلة، أقول إني لن أكون وحيدة ولا حزينة، سأعمل بجد في عمل أحبه وأكسب مالاً وفيراً، ثم أعود وأشرب متة ساخنة مع إخوتي وسنضحك كثيراً.
في الشارع، أبتسم لكل المشاة، للسائق الذي يكفر بربّ أزمة المواصلات، والشرطي الذي يكزّ على أسنانه من البرد، أبتسم للمرأة التي تجر قبيلةً من الأطفال بتعب ولا مبالاة كأنهم أكياس من الهمّ، إلى امرأة تُفاصل البيّاع الملول على البسطة وإلى البيّاع؛ لكنهم بلا استثناء يستغربون، بعضهم يحاول جاهداً رد الابتسامة فتخرجُ مرهقةً وسريعة الزوال، والآخرون يديرون وجوههم بسرعة أو يمتعضون، لذا أبتسم لنفسي وأخبرها بأننا فعلنا شيئاً جيداً لليوم.
في العمل أستغل أوقات فراغي لأكتب أو أقرأ عملاً ما – لأشعر بأني لا أعدم حياتي- كأن أكتب هذا النص الآن وأخبركم خلاله أني أريد السفر لأحزن بضمير مرتاح، وعندما أصل إلى البيت أغفو متعبةً قبل أن يسخن الإبريق.
ألف تبرير بلا داع
لا أدرك متى، لكن البلاد في لحظة معينة سبكت نقطة حبر سوداء على صفحتي المبلّلة أصلاً بالمدمع، فتلوّثتُ كلّي بكآبة لم أعد أقدر على التخلّص منها، غير أنّ كل هذا لا يمنعني من تذكّر ألف مرة شعرتُ فيها بأن روحي تطير من الفرح بين أشخاص أحبوني بصدق وضحكوا على أحزاني معي، وهل أستطيع الشعور بأمان الجلوس حول الموقد مع عائلتي، بينما تحيك أمي الصوف ويقشّر لي أبي البرتقال إذا ما ذهبت لآخر الأرض؟
ليست الغريزة ما يصرخ فيّ أن أرحل، وليست الغريزة ما سيعيدني يوماً ما، بل شيء واحد لم أعد أخجل بالاعتراف به: الحب... مجاز
أفكّر بكل هذا حتى لا تقتلني حقيقة أن أجمل أيامي كانت تنتهي وأنا جالسة في حضن حبيبي، نشاهد فيلماً لا أقدر على التركيز فيه لأني أركز باللحظة المناسبة لأقبّله.
لكنّي أكتب هذا النص وجميع من كتبتُ عنهم بعيدين، وهذا وحده تبرير كاف لأن أكتئب دون أن يقول أحدهم أنّي "مزودتها"، لماذا إذن ما زلتُ أريد أن أنجو؟
ورقة جديدة؟
ليست الغريزة ما يصرخ فيّ أن أرحل، وليست الغريزة ما سيعيدني يوماً ما، بل شيء واحد لم أعد أخجل بالاعتراف به: الحب.
لم أتخيّل في أي يوم من أيام حياتي أن أحب نفسي، وبما أني أعرف أنك لا تقدر على حب أحد بصدق إن لم تحب نفسك أولاً، لم أتخيل ذاتي أحب أحدهم بشكل صحّي، وبأعجوبة كبيرة. أنقذتني سوريا.
منحني كل ما سبق صفعات كثيرة، اضطررتُ بعد غالبيتها لطحن عظامي وإعادة تشكيلها لأنهض، ولأن أتخلى عن معظم أفكاري ألف مرّة، حتى توقّفتُ عن العند دون مبرّر ولنتُ دون أن أسيح، والأهم أنّي اضطررت لمصالحة نفسي لأنه ما من خيار آخر إذا أردتُ أن أكمل.
هكذا إذن، مُنحتُ من الوداعات ما يكفي لأن ألتقي ذاتي، والكثير من الخيبات لأن أسحب منها مهمّتها كشمّاعة للحزن وللذنوب، وهكذا بخطوات صعبة، ربّتُ على كتف الطفلة داخلي، وفتحتُ المجال لها بأن تبكي ثم ترضى؛ وللشابة أن تتعلّم وتحبَّ وتخطئ دون عقاب، وللمفاجأة، بدل أن أنكسر صرت راضية.
لربما لم تكن سوريا مكاناً مثالياً لأحب نفسي، لكنها مثل جنية طيبة ألبستني فستاناً ملوّناً وحولت فئران رأسي إلى خيول، هكذا ذهبتُ إلى حبيبي بكلّ ما فيّ كأني في حلم؛ ومع الساعة الثانية عشر جاءت بسرعة، غير أنّي تركتُ معه شيئاً خاصاً أكثر من الحذاء، تركت قلبي.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.