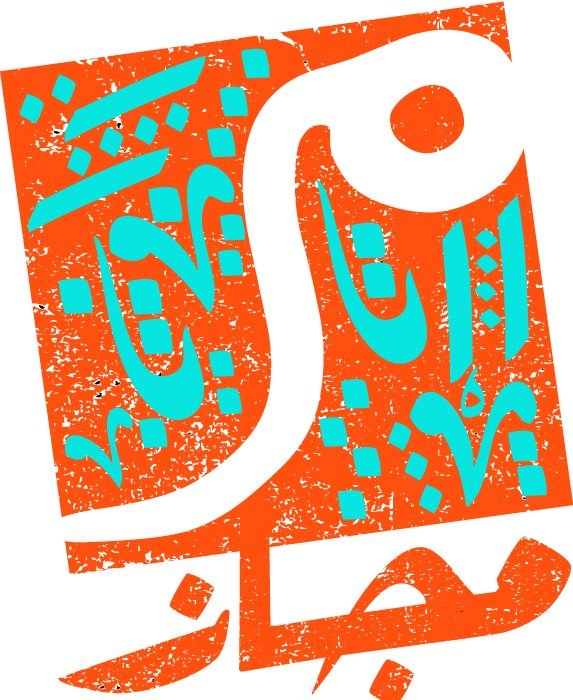 نوستاجيا خفيفة
نوستاجيا خفيفة
كلما سرت في ذلك الشارع، أقف أمام محل النظارات لأتأمل الأشكال المختلفة. منذ طفولتي، طاردني ذلك النموذج النمطي للفتاة المثقفة، ذات الشعر الملموم للخلف، والتي ترتدي النظارة بإطارها الأسود، كأن تلك الحدود الزجاجية هي ما تضيف لحديثنا قيمة وتحدّد تصوراً عنا وعن رؤيتنا للحياة.
حينما كبرت قليلاً وأخبرني الطبيب أن نظري ضعيف، لم أنجح طوال الأعوام في اقتناء إطار أريده. أشتري نظارات مختلفة دون رغبة حقيقية مني. كانت كلها نفس الشكل: إطار أسود رفيع، مستطيل، ممل، لأنني ظننت أنه يضفي علي غرابة ووقاراً ما.
حقيقة الأمر لم أنجح طوال تلك المحاولات في النظر للحياة من خلف الزجاج. كنت أمضي طوال الوقت واعية للغاية أن هناك ساتراً شفافاً يمنعني من تأمل الحياة بشكلها الحقيقي.
أمضي وقتي كله محاولة تخيل أنني سجينة في غرفة زجاجية، أتجول بها وسط الناس. يوماً ما أخبرني أحد أصدقائي عن ذلك الفيلسوف الذي كان يرى أن الحياة ربما هي ما اعتدنا على رؤيته. لو ولدنا بنظارات ذات زجاج وردي فإن الحياة التي نعرفها ستصبح وردية للأبد، ولن ندرك حقيقة الأشياء.
أتذكر ذلك الحديث، فيتزايد إحساسي طوال الوقت بأنني مثل ذلك الفيديو الذي شاهدته يوماً عن الفتى الذي يملك مناعة ضعيفة للغاية، فيعيش داخل فقاعة لا يغادرها كيلا يصاب بأي أمراض.
لم يغادرني ذلك الإحساس الخانق أنني أتلصص على الناس من خلف تلك النوافذ المتحركة التي أصبحت أحملها فوق وجهي. أنزعها أول يوم لمدة ساعتين، وأتركها في درج المكتب، وأعتاد الرؤية والعمل بدونها. تمتد الساعتان لتصبحا يومين، فأسبوع، وهكذا حتى أنسى مكانها، وقد تكاثرت فوقها الأوراق والأغراض حتى نسيتها تماماً.
لم يغادرني ذلك الإحساس الخانق أنني أتلصص على الناس من خلف تلك النوافذ المتحركة التي أصبحت أحملها فوق وجهي (نظاراتي). أنزعها أول يوم لمدة ساعتين، وأتركها في درج المكتب، وأعتاد الرؤية والعمل بدونها... مجاز
أتحمل ذلك الصداع الذي يداهمني كل فترة غير راغبة في إعادة التجربة، حتى ينتهي الأمر بي واقفة أمام ذلك المحل مجدداً لأشتري إطاراً جديداً بعدما فشلت محاولاتي كلها في التحرّر من الآلام التي لا تغادر رأسي. أقوم بتجربة العديد من الأشكال والأحجام، حتى أجد ذلك الإطار الوردي الذي بدا الأفضل على الإطلاق. كنت سعيدة تلك المرة لا أدري لماذا. ربما لأن بداخلي كنت أعلم أنني تلك المرة أختار نظارة تعجبني فعلاً.
أذهب للمنزل وأرتديها وأتأمل نفسي أمام المرآة. أحاول عدم إظهار فرحتي الطفولية أمام ابني، لكني أشعر بأن شيئاً ما ليس على ما يرام. أنظر طويلاً. شيء ما بي لم يعد كما كان. ألمّ شعري للخلف. نفس الإحساس. أطلق شعري ليغطي جزءاً من وجهي. لكن مازال هناك شيء مفقود. تأتيني الفكرة ببطء أنني صرت أشبه والدتي الراحلة كثيراً لذلك أشعر بالغرابة. يرتجف جسدي حينما أدرك أنني أنظر لنفسي كأنما أطالع وجهها هي، وأنها كانت طوال عمرها ترتدي نفس النظارة بنفس الشكل، لكن بإطار ذهبي بدلاً من الوردي.
لطالما تشابهت مع أمي في كل التفاصيل. نحمل نفس ملامح الوجه، نفس الشعر ونفس العينين. أحببت صورها وهي صغيرة في الكلية، لأنني كنت أتخيلني داخل تلك الصور في السبعينيات، بتنوراتهن القصيرة وألوان ملابسهن المشرقة. حتى الآن لم أحتفظ لها بصورة داخل محفظتي سوى صورتها في الجامعة التي تشبهني كثيراً، بابتسامتها الخجولة وشعرها الأسود القصير المنسدل على طول كتفيها. لم أحب صورها اللاحقة التي كانت تمثل التسعينيات، بالحجاب ولون الشفاه الأحمر وملابسهن ذات الصدريات الواسعة التي كانت تضيف لأوزانهن وأعمارهن أضعاف.
كنت أحاول طوال الوقت أن أبدو مختلفة عنها. منذ بداية دخولي الكلية وأنا أصر على تحديد عيني بقلم الكحل، ليختلف منظر وجهي وملامحي عنها. أصر على إطالة شعري وجعله مموجاً باستخدام العديد من الكريمات، عكس شعرها القصير الناعم. أحاول الحفاظ على وزني منخفضاً على عكسها. فقط كيلا أسمع الجملة التي مللتها ويرددها الجميع عن مدى التطابق بيننا.
اليوم أسقط مجدداً في ذلك التشابه عن طريق تلك النظارة. لكن بدلاً من الشعور بالضجر من التعليقات المكرّرة، أشعر بالحنين لذلك الوجه الذي افتقدته بوفاتها منذ سبع سنوات للأبد.
أتأمل ملامحي مجدداً، ملامحها التي تبدو من المرآة. أشعر بالغرابة أن هذا الوجه ربما لا ينتمي لي حقاً، بل ينتمي لها في نهاية الأمر. هل نسعى طوال حياتنا لإيجاد أبناء لنا كي يتبقى لنا ولو صورة حية داخل تلك الحياة؟ هل بسبب ذلك يتصارع الأم والأب على ملامح أبنائهم، وكل منهما يرغب أن يكون الطفل يشبههما في النهاية؟ هل كنت أنا لوحة لها على تلك الأرض بعد كل شيء؟
تنتابني غرابة كلما نظرت إلى السطح المنعكس. أمدّ يدي على سطح المرآة وأشعر أنني ألمس ملامحها هي. لم يعد الأمر مشاهدة عالم من خلف زجاج فقط، بل صار مشاهدة شخص آخر يتحرك أمامك... مجاز
رغماً عني، صرت أشعر أن هذا الوجه ليس وجهي. تنتابني غرابة كلما نظرت إلى السطح المنعكس. أمدّ يدي على سطح المرآة وأشعر أنني ألمس ملامحها هي. لم يعد الأمر مشاهدة عالم من خلف زجاج فقط، بل صار مشاهدة شخص آخر يتحرك أمامك.
ماتت أمي في 2014 من السرطان، بعد محاولات للنجاة ومحاربة استمرت أعوام. رغم أني كنت أصحبها في كل تفاصيلها وجولات المستشفيات وتعبها وشفائها ثم تعبها مجدداً، إلا أنني لم أستطع أن أمحو ذكرى ملامحها يوم وفاتها داخل مخيلتي. كأن ذاكرتنا تتوقف عند لحظة معينة دون أي رغبة في الحركة أو استرجاع المزيد من الصور، بقي مشهدها الأخير وهي مستلقية على الفراش، بملامح وجهها المتعب وشعرها الخفيف لا يفارق ذهني، ويمنعني من استحضار أي شكل آخر لها من داخل ذهني.
حاولت كثيراً بعدها مشاهدة العديد من الصور لها لتنشيط ذاكرتي لكن دون جدوى. حين أغمض عيني لا أراها سوى في آخر يوم لها، وبقيت تلك ذكراها في مخيلتي. لكنني اليوم أصبحت كلما نظرت داخل المرآة أجدها أمامي، تطالعني بملامح أخرى أكثر شباباً مما عهدتها وبتغييرات بسيطة.
كنت في البداية أجفل قليلاً ولا أشعر أنني بمفردي في الغرفة، كأنها جالسة معي طوال اليوم ولا تفارقني. لم أكن قد اعتدت هذا الحضور الدائم، خاصة أنني قبل وفاتها لم أكن أعيش معها حتى في نفس المدينة. بمرور الوقت صرت أكثر قدرة على التماهي مع ذاتها والتقرب منها أكثر. بالعكس، صرت أسترجع السنوات التي ابتعدنا فيها عن بعض، لتتبدل بسعادة بوجود ما أحمله منها الآن. بدأت لمحات عن لحظات جميلة لنا معا تومض مجدداً في ذاكرتي التي كانت قد تعطلت بفعل مرارة المرض. أحاول أحياناً تقليد ضحكتها قليلاً كي أستعيد سعادتها داخلي وصوت ضحكتها الرنانة المميزة. أسترجع زياراتنا للأطباء، مبيتنا معاً في المستشفيات، جلساتنا أمام البحر في جليم قبل أن يحولوه لممر من المقاهي المتشابهة. تتحرك الذاكرة كالوجود الذي يفرض نفسه عليَّ شيئاً فشيئاً.
أصبحت الآن أكثر سعادة باقتناء تلك النظارة الوردية، بل أعتبرها أفضل ما اقتنيت في الأعوام الماضية. أشعر أنني بطريقة أو بأخرى اقتنيت بوابة زمنية ترجعني وقتما أردت لرحم خرجت منه يوماً، ولملامح طالما افتقدتها، حتى أصبحت تملأ الهواء من حولي، طاردة ذكريات الموت من ذاكرتي القديمة الصدئة.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


