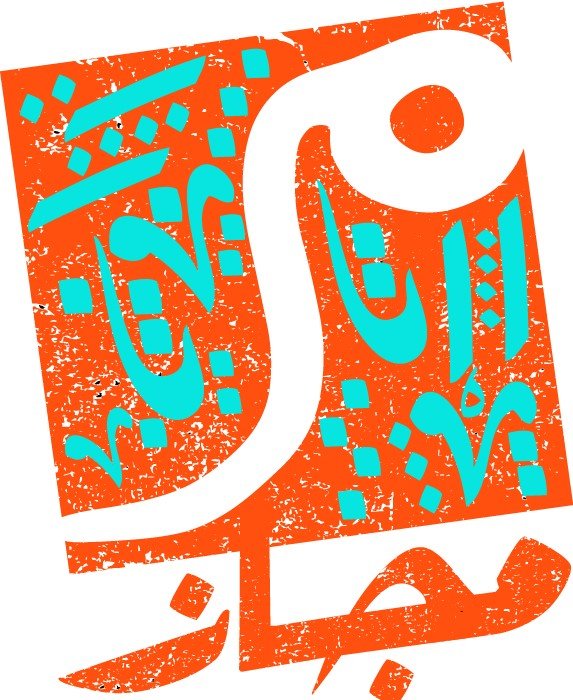 النائم في هوى المنحدر
النائم في هوى المنحدر
فصام هزلي
على الرغم من عيشي طفولة أقرب ما تكون إلى الريفية، لأن حيّنا لم يكن سوى غزواً شبه مدني للبرية، امتداداً ليد التعقيد في رحم البساطة، إلا أن هذا الامتداد لم ينجب شخصية مائلة إلى أحد الاتجاهين، بل لم ينجب شخصية متزنة قط، فها هو التشتت كان وما زال سمةً تعرّفني عند الآخرين.
وما دعم ذلك أيضاً اللكنات المختلفة التي أخذتها عن والديّ، فأبي -مثلاً- يميل نحو البداوة أصلاً واكتساباً، أما أمي فتقبع على الضفة الأخرى منه، لذلك أُجبرتُ على السير في مسارين مختلفين في وقت واحد؛ ففي جلسة واحدة أكلم أمي عن رغبتي بترك المدرسة والعمل كراعي ماشية بلهجتها، وأبرّر توبيخ أبي -الذي يريدني خريج تاريخ- بالرد بلهجة أخرى...
وكما كنتُ كان حيّنا، فهناك تجد بيتاً طينياً بقباب، يجثو إلى جانب بيت من الطوب الأبيض، فيشكلان التقاء حضارات هزلي، ترى قطيع أغنام يشل حركة شارع بلا مبالاة، وحتماً سترى دجاجة أو إوزة تتقافز أمام عجلة دراجة نارية بهيجان واضح.
خطوات سريعة فاجرة
في مرحلة المراهقة أظن أني كنت إنساناً سوياً، على الأقل في نظري وبمفهوم المجتمع المحيط بي، سوي لدرجة تشبيهي أحياناً من قبل المحيطين بي بــ "بنت البيت". لم يكن لي خروج ولا تأخر، لا رفاق سوء كما يقال، ولا حتى رفاق حسن إلا ما ندر.
أنظر نحو تابوهات المجتمع من مسافة تحتاج تلسكوباً، ولأنني لا أمتلك تلسكوباً، كنت أسترق النظر إليها في مخيلتي فقط، حيث أكون شخصاً آخر، فاجراً، أضاجع بنت الجيران، ومعلمتي ومعلمات الصفوف الأخرى، أضاجع تلميذات المدرسة والمارّات، مذيعة الأخبار والمغنية، بوضعيات مختلفة أختلقها وأنتهي من كل ذلك بشعور نشوة في مخيلتي. وليس بأبطأ من ذلك أعود لأستعيد لقب "بنت البيت".
ثلاثة أطفال يتحلقون بي، يواجهون الأيام باتخاذي درعاً، يتسلقون سلالم العمر متكئين عليّ، أنا الذي سقطت عن شجرة الحياة مرات عديدة. ثلاثة أطفال ينادوني "بابا" فأتهرّب لأني لا أدرك متى أصبحت أباً لهؤلاء... مجاز
شباب غير ملحمي
اختصاراً للوقت واستغلالاً لعنفوان الشباب، ولكيلا تضيع من بين يديّ فرصة المرور في تجربة أو اثنتين أتفاخر بها في سن متقدمة، صرت أقدم على محاولات لفت أنظار الفتيات، كل اثنتين منهن معاً، فتراني أجاهد في سبيل الوصول إلى فتاة مهتمة بالعلم، من خلال انكبابي على الدراسة بنهم، وأواظب على العيش والظهور بشخصية اللامبالي، سعياً للفت نظر فتاة ترنو إلى اللحظة الآنية.
وهكذا، أرمي بقلبي هنا وصنارتي هناك. أداوم على الدراسة تارةً وألج اللهو من أضيق شبابيكه تارةً أخرى، وفي أفضل الأحوال كان الفشل صيدي، والانصياع لكليْ شخصيتيّ هو النتيجة.
بين الأب الصالح والمراهق المتأخر
أستفيق صباحاً، فأجد ثلاثة أطفال يتحلقون بي، يواجهون الأيام باتخاذي درعاً، يتسلقون سلالم العمر متكئين عليّ، أنا الذي سقطت عن شجرة الحياة مرات عديدة. ثلاثة أطفال ينادوني "بابا" فأتهرّب لأني لا أدرك متى أصبحت أباً لهؤلاء...
أتهرّب لكون سجادة العمر ما تزال مفروشة أمامي، أو هكذا أظن... أتهرّب لأني لا أريد لفتاة عابرة أن تجفل من كوني أباً قبل أن تدخل شراكي المنصوبة دائماً. أتهرّب لأن الوقت هرب من مرمى فهمي طوال تلك المدة، والآن أعتقد أني قبضت على بعض منه.
لكم أن ترموني بحجر الانفصام، لكن لا تطلقوا عليَ رصاص الأنانية، فلا توجد في ثلاجة ذكرياتي ثمرة واحدة، أتغذى بها في لحظة جوع.
الشاعر والعامل المياوم خصمان في جسد
عندما وصلت هنا، استبدّت بي الحياة، أفرغت جعبتي، ثم أوقفتني في ساحة للعمال المياومين، ومن دون أن أفكر بعقلية السلمون وأسبح عكس التيار، أو أراوغ القدر بالتفافة مخادعة، أسلمت نفسي لما جرى. فراح النهار يقطفني بعمل مضنٍ ويختار الليل لي لقباً كبيراً "الشاعر". تفتح المجرفة في راحتيّ تقرحات في النهار، ويداويها القلم ليلاً. أستفيق على زعيق أرباب العمل وشتائمهم، ثم أغفو على محادثة أنادى بها "أستاذ".
وفي ذلك الوقت، حتى القدر جاء ليلعب معي لعبة الانفصام؛ ففي إحدى المرات، وبينما كنت منهمكاً بعتالة حملٍ من أقفاص البندورة في سوق الخضار، كانت قصائدي تُقرأ في أمسية مهمة أُقيمت للتعريف بي في المركز الثقافي الرئيس في مدينة كوبنهاغن، وبين كل زفرة تعب وأخرى أطل على شاشة هاتفي لأعرف رأي الجمهور المرموق بقصائدي، وذلك من خلال صديقة حاضرة في الفعالية، بين كل قفص وآخر يتهيّأ الشاعر الماكث داخلي للصراخ بأقذع مفرداته أن أتوقف هنا، إلا أن العامل داخلي يجبره على الصمت بإرسال كلتا يديه باتجاه قفص آخر وبسرعة.
تقول صديقتي: "اثبت على شخصية محددة، يكفيك تأرجحاً". ألقي ابتسامة إليها، ثم أعود إلى عملي كبهلوان في سيرك حياتي القصيرة... مجاز
وعلى هذه الحال عشت لسنوات، بين المفارقات الساخرة والحقائق الوقحة، بين انصياع العامل واستغلاله للجسد الذي يسكنه، وبين تمرد الكاتب ومزاجيته، أطالب هذا بهدنة وأوبخ ذاك على أفعاله التي كادت أكثر من مرة أن تودي بجسدنا إلى قعر إصابة خطيرة أو موت محقق.
نتائج طبيعية لبهلوان في سيرك الحياة
اليوم، لم أنجُ من نفسي، لم أنجُ من ألاعيب القدر معي، فكل ما سبق دفع بي إلى حفرة عميقة من التوتر في التعامل مع الآخر، أحتاط من فتح بوابة يومي لمارّ لطيف، وأشرعها في وجه ظلٍّ شرير. هذا ما جعل مني شخصين في جسد واحد، ومن المؤكد هذا ما تقصده صديقتي حين تقول: "اثبت على شخصية محددة، يكفيك تأرجحاً". ألقي ابتسامة إليها، ثم أعود إلى عملي كبهلوان في سيرك حياتي القصيرة.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


