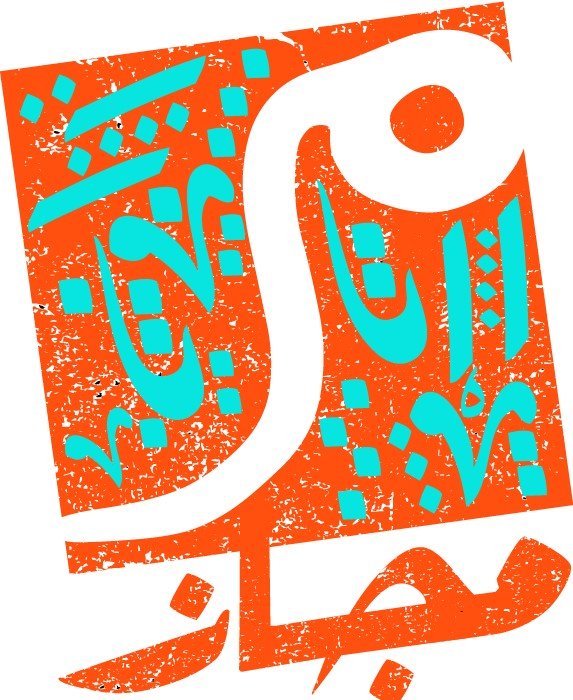 حياكة الكلام
حياكة الكلام
كل عناصر الخفّة تجتمع في تلك الصورة، لكن أبداً لا يمكنني تحريكها. تظل رغم ما يحيطها من ظلال ملونة وغبش دافئ، صورة جامدة، ربما لأن مركزها منتزع عنوة من قبل سيدة بدينة بيضاء، أراها تقرفص على الأرض في جلباب منزلي، ينبثق منه وجه دائري يفوح برعونة طازجة وثغر مبتسم، كمن اختصّ وحده بسرٍّ تافه وبهيج، ابتسامة من لم يختبر الآلام بعد. يتكور داخل الجلباب ثديان أموميان، بلا صلابة أو رخاوة، بل في لين العطاء وثبات عزمه.
في الصورة أجلس أمامها طفلاً في السادسة، ربما أكبر بأشهر قليلة أو بعام، أستمع إلى حكاية أغلب الظن أنها للشاطر حسن، وهو الشيء الوحيد المتحرّك بتلك الصورة، أراه يحمل مشعلاً ويقف فوق سور، ويحاول أن يتجاوز الظلمة وحراس الملك، متسللاً إلى الأميرة.
تلك السيدة هي زوجة عمي، ولا أعلم لم تطارد تلك الصورة ذاكرتي بإلحاح، فقد صارت على هامش حياتي منذ ثلاثين عاماً على الأقل، وانقطع بيننا كل خيط. لم أقابلها خلال تلك الفترة إلا مرات معدودات فرضتها زيارات الأقارب، أكتفي فيها بتبادل سلام مقتضب سريع، ثم أتجاهلها، الحقيقة أني كأغلب من في العائلة، فضلت إسقاط وجودها، كلما كبر بي العمر. لا شيء مشترك بيننا إلا تلك الصورة.
أذكر أنها مرّة ومرتين لامتني على هذا الهروب، ثم استسلمت لتفضيلي باب الشقة المقابل، حيث تسكن جدتي وزوجة عمي الأخرى. النفور نفسه صرت أشعر بها تجاه عيالها، رغم أن ابنتها الكبرى كانت صديقة طفولتي المقربة، ثم حال بيننا هذا الشيء الذي انتقل إليها من الأم، وما صارت عليه، سيدة مفرطة البدانة والجهل والغضب، كان لذلك الشيء رائحة حقيقية غير محببة، حتى أنه بإمكاني استشعارها الآن.
عائلتي طبعاً تكره اللصوص وتحتقر المغامرين، أما العشاق- فهم كشأن كل شائن في نظرهم ومارسوا أغلبه سرّاً- لم يوجدوا قط... مجاز
كانت الوحيدة من بين زوجات أعمامي التي لم تكمل تعليمها، آتية من أحراش فقر تجاوزته العائلة في جيلها الثاني، وإن لم أكن مخطئاً، أظنها لم تكن تجيد القراءة، وكانت تترجم جهلها إلى عادات مستهجنة بعضها يرتقي إلى مرتبة القذارة، أو هكذا لاحظت من انطباعات الآخرين، ربما استقبلت استهجانهم في طفولتي بحيادية، لم أقرّر شيئاً، ربما رفضت ما يقولونه، ثم عدت وتصرفت على أساسه.
تزوجها عمي كنزوة في شبابه، أصرّ على الرغم عن تحذيرات جدتي ورفضها، ربما لأن جمالها كان في جوهره سوقياً ووحشياً كروحه النزقة الفهلوية بعض الشيء، وهو أمر آخر أرادت العائلة أن تتخلّص منه، ذلك الزواج لم تغفره الجدة (التي حظيت بعمر طويل يتغذى على أحقاد تافهة ورهيبة) فشنّت حرباً ضروساً ضدها، شاركنا فيها جميعاً بالصمت أو التواطؤ، ولا أعفي نفسي، أنا الذي طردتها إلى أقصى هامش ممكن.
لا شيء خارق في الحكاية التي كانت تقصّها، لم تكن منبعاً للأدب في حياتي، سمعت القصة مئات المرات من أقارب مختلفين، يخلطون أحياناً – وربما أنا من أفعل- بين الشاطر حسن والسندباد البري وعلاء الدين، تلك القصص شبه رسمية، أناجيل صغيرة مهذبة يسمح بتداولها في عالم الصغار، رغم أن فحواها على عكس كل ما تؤمن به عائلتي: فقراء يفوزون بالحياة والحب والثروة بالاحتيال على النظام الاجتماعي، لا بالعمل، قوة سحرية غامضة ترفعهم من مجاهل النفور إلى الجاذبية المطلقة، فعائلتي طبعاً تكره اللصوص وتحتقر المغامرين، أما العشاق- فهم كشأن كل شائن في نظرهم ومارسوا أغلبه سراً- لم يوجدوا قط.
بتوسيع الكادر الذي تظل زوجة عمي مركزه. أرى ظلالاً ملونة لأقاربي، سهرة عائلية أخمّن أنها كانت ليلة رأس السنة، فلسهر هذا اليوم فرادة في لذته يختلف عن باقي المناسبات، أو لأن رائحة محمصات ساخنة تضرب أنفي، إذا ما تذكرت.
أذكر أيضاً صراخه زوجة عمي الهيستيري الغاضب، تشبه حينها حيواناً وحشياً يبثّ الرعب، لكن في حقيقة الأمر، هذا صراخ من امتلكه الذعر، حشرجة روح تود لو حطمت البدن لتفر بعيداً... مجاز
كنا متحلّقين حول شريط فيديو يعرض النسخة الكاملة لمسرحية "شاهد ما شافش حاجة"، أحضره عمي من بلد عربي، ما يجعل من الأمر حدثاً هاماً في بداية الثمانينيات، أن الشريط سيعيد إلى حنجرة عادل إمام كل ما حذفته الحكومة وسبب لها قلقاً لم أفهمه، وقتها كان كل شيء يبدو اختراعاً، حدثاً مدهشاً وأزلياً في الآن نفسه، الفيديو، عادل إمام، اللمة المنزلية، رجل البوليس الغامض الذي يحذف الكلام، وبالطبع الشاطر حسن.
كنت قد فقدت خيط الضحك، رغم أني أدركت طفلاً أن الفتنة- على عكس كل ما شوهته مراهقتي وألاعيب أخرى- تتولد من الرتابة والتكرار، حيث لا شيء سيتغير، لن ترتبك الصور أو تشوّه وستحتفظ بالهيئة المناسبة إلى الأبد، وهو ما يجعل السعادة أمراً مستحيلاً، ما أفسد علي المشاهدة أني انتظرت الشيء المثير الذي أغضبهم لدرجة أنهم حذفوه وجعل من تلك النسخة أمرا مرادفاً للاحتفال. انتظرت وانتظرت، ولم أجد شيئاً واحداً لم أسمعه من قبل، هل خُدع عمي، أم لم أكن قد استوعبت حينها ما يعنيه الممنوع من القول؟
لم ينجدني من خيبة الأمل سوى زوجة عمي، عندما تنحّت بي على هامش الصورة التي صارت مركزها، في ركن قصي بجوار الباب، المنفذ الوحيد للخروج من الكادر، ربما ما فتنني في قصتها المكرّرة كالمسرحية، أنها كانت سعيدة. أهذا ما كانت تفعله؟ لم تكن تقص الحكاية علي بل على نفسها.
لا أعرف الكثير مما حدث لها فيما بعد، سوى أنها ظلت تسمن وتسمن، كأنها كانت تحول الإهانات إلى دهون، ربما كي تتمكن من الصمود أو شن حرب مضادة تبتلع فيه جدتي ذات الجسد الضئيل والكراهية العملاقة في قضمة واحدة. ربما أذكر أيضاً صراخها الهيستيري الغاضب، تشبه حينها حيواناً وحشياً يبثّ الرعب، لكن في حقيقة الأمر، هذا صراخ من امتلكه الذعر، حشرجة روح تود لو حطمت البدن لتفر بعيداً.
تزوج عليها عمي سراً، لم تكتشف العائلة هذا الزواج إلا عندما صار له ابن في التاسعة، وقد حاولوا حذفه كشأن – كل شيء غريب وشائن- ونبذوا الزوجة الجديدة، ربما كانت اللحظة الوحيدة التي توحدوا فيها معها، فالتهديد تلك المرة كان موجهاً للجميع.
في كل الأحوال لقد خسرت في النهاية، كل ما نجحت في جنيه هو أنها قايضت النار التي تعتمل بداخلها بإجبار زوجها على أن يجري لها عملية لشفط الدهون. أتذكر أني رأيتها بعد أن أجرتها، كانت تشبه الصورة القديمة، قد استعادت شيئا من الحلاوة والوجه الهادئ المطمئن، ولاح شبح الابتسامة اللاهية، خجولاً وشاحباً كأنها تعزت عن كل الإهانات، لكن ذلك أيضاً لم يصمد، سرعان ما تراكمت الدهون، وصارت أكثر بدانة من ذي قبل، تلك المرة لم تكن تشن حرباً ضد أحد سوى نفسها، وهي الحرب الوحيدة التي ربحتها.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.





