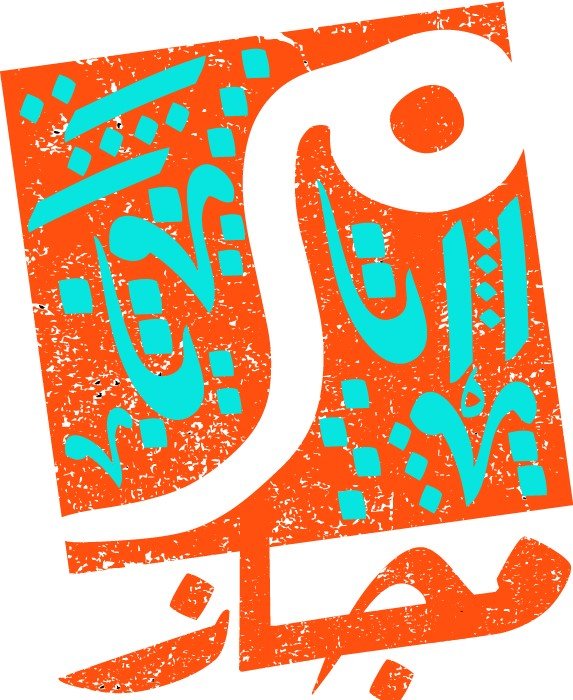 حياكة الكلام
حياكة الكلام
قادتني قدماي نحو بيتنا القديم الذي لا يسكنه أحد. دخلت من الباب الكبير لأجد نفسي أقف أمام إحدى الحجرات. كان الصدأ قد فرض سطوته حول مقبض الباب الذي كان يوماً أعلى من رأسي. حركة غير عادية وأصوات لشيء لم أفهمه للحظات قبل أن أفتح النور، لأجد عائلة كاملة من الفئران تنظر لهذا الغريب الذي تجرأ ودخل حجرتهم بلا استئذان.
العائلة هي فأران كبيران يجلسان في إحدى الزوايا، ينظران بعيون تملؤها الحسرة بعد أن فشلا في تربية ثلاثة فئران من أبنائهما تدور بينهما معركة حامية الوطيس. سقف الحجرة عال، تتدلى منه خيوط العنكبوت، حيطان مرتفعة تناطح الحزن وتضاهي قسوة السنين. النوافذ مغلقة، لا تسمح لهواء الخريف المحمل برائحة الأرض بالدخول، ثمة كراكيب تحاوطني، أجبرتني على التحرّك ببطء شديد وكأني أتعلم المشي للتو.
أسمع معركة الفئران وكأن العالم ليس به متسع أو مكان للطيبين. لا شيء في المكان ذو قيمة. كلها ملابس بالية ممزقة وكتب دراسية مصفر لونها. أزحت التراب عن أحدها، كان كتاب التاريخ، قبل أن تقرض الفئران جزءاً من الغلاف لتمحي بأسنانها الصغيرة الحادة حرفي الألف واللام.
لم تنجح المصيدة في صيد فأر واحد حتى تحلّلت بداخلها ثمرة الطماطم. وقعت عيني على مكتبي القديم الذي كنت أذاكر فوقه دروسي في الإعدادية، أعلاه مفرش زاهي الألوان عليه ثلاث زجاجات كوكاكولا فارغة، وأدوية للقلب، وقلم نشف حبره، وورقة مالية فئة الخمس وعشرون قرشاً مقطوعة. فتحت الدرج ليسقط من بين يدي على الأرض داكنة اللون. جلست في وضع القرفصاء، ألملم الذكريات التي تبعثرت على الأرض.
أمسكت سبحة جدتي ومسحت حباتها في ملابسي لأزيل عنها التراب وبعض خيوط العنكبوت. كنت أشم رائحة يدها العطرة التي تفوح من بين الحبات. كانت سبحة "بهجة" لا تفارق يدها، حتى عندما تنتهي من التسبيح، تلفّها حول معصم اليد. تذكرت عندما كنت في العاشرة من عمري أخاف من سبحة "بهجة". أظن أنها مسحورة تخبرها حباتها بكل شيء قبل وقوعه.
كنت أشم رائحة يدها العطرة التي تفوح من بين الحبات. كانت سبحة "بهجة" لا تفارق يدها، حتى عندما تنتهي من التسبيح، تلفّها حول معصم اليد. تذكرت عندما كنت في العاشرة من عمري أخاف من سبحة "بهجة". أظن أنها مسحورة، تخبرها حباتها بكل شيء قبل وقوعه... مجاز
ذات مرة حذرتني من صيد الفراشات والركض خلفها. لم أسمع كلامها حتى سقطت على الأرض في حفرة ضيقة أثناء مطاردة فراشة وكسرت ساقي. ظننت أن السبحة قد أخبرتها بالأمر قبل حدوثه. ذات ليلة ذهبت إلي بيتها حاملاً وجبة العشاء. كان الأكل إذا لمس يدها أحاطته البركة. انتظرت حينها حتى فرغت من صلاتها، وبدأت تناجي ربها بصوت مسموع وهي تقول: "يوم هزيل ويوم رحيل".
سألتها عن سر هذا الدعاء، فقالت بلهجتها الصعيدية: "بدعي ربنا إن اليوم اللي يمسكني فيه المرض يكون آخر يوم لي في الدنيا، واليوم التاني أموت. عايزة يا ولدي الحِمل يبقى خفيف".
باتت تكرّر هذا الدعاء بعد كل صلاة، ثم تمسك سبحتها وتجري حباتها بين أصابعها، وبعد نحو سبعة شهور، وفي يوم شديد الحرارة من صيف يونيو، رقدت "بهجة" على سريرها النحاسي تودع الدنيا، يلتفّ حولها أولادها وأحفادها، بينما هي تنظر للسماء بوجه ناصع البياض، يحارب خيوط التجاعيد التي حفرها الزمن. كان شعرها أشقر مائلاً للبياض، يتطاير في الهواء بفضل المروحة القريبة منها، ترتدي ثوباً أسود به ورود خضراء متناثرة على ثوبها الذي يلمع من نظافته.
لم يدم مرض "بهجة" سوى يوم واحد، وفي اليوم التالي استجاب الله لدعائها التي كانت تردده: "يوم هزيل ويوم رحيل".
أمسكت يدها التي كانت تخيط لي ملابسي وتصنع لي "الكعك بالسكر" لتتفتح تجاعيد وجهها لابتسامة خفيفة، وكانت المرة الأولى التي لا أرى فيها السبحة بين يدها. لم يدم مرض "بهجة" سوى يوم واحد، وفي اليوم التالي استجاب الله لدعائها التي كانت تردده: "يوم هزيل ويوم رحيل". شاهدت في جنازتها رجالاً من جيراننا يبكون مثل الأطفال وكأنهم فقدوا أمهاتهم للتو. قال أحدهم لوالدي إن قلب "بهجة" كان بداخله كنز من الحب.
أفقت على صوت الفئران التي نقلت معركتها فوق مرتبة ممزقة خرج من أحشائها القطن، وعلى دموعي التي تساقطت في الدرج، وضعت السبحة، آخر ما تبقى من رائحة "بهجة" حول معصم يدي، وبدأت في وضع الأشياء بالدرج الذي فتح طاقة الذكريات. ألقيت بداخله روشتة طبية وبكرة خيط أبيض، وبطاقة تأمين صحّي تحمل اسمي بجوارها جملة طالب بالصف الرابع الابتدائي، وصورة لي أنظر فيها بعيون مفتوحة ممتلئة بالدهشة، ربما كنت حينها أرى مستقبلي وهو يحترق من كثرة شعاع النور.
نهضت من فوق الأرض لأثبت الدرج داخل مكانه بالمكتب فسقط منه على الأرض شيء أحدث بعدها صوتاً ذا رنة خفيفة. كان نور اللمبة باهت لا يضئ كل ما في الحجرة. جلست مرة أخرى في نفس المكان، تحت المكتب القديم، أتحسّس مكان ما وقع على الأرض حتى لمسته، حينها ارتعشت يدي كمن مسّه جان. هو خاتم أمي الفضي الذي فقدته منذ سنين، وقالت حينها إنها خلعته من إصبعها قبل أن تعجن الدقيق.
كانت أمي تغسل كيلات القمح وتنثرها فوق مفرش كبير وتتركها تجفّ تحت أشعة الشمس. تذكرت أول مرة ذهبت معها إلى الطاحونة. كان الشتاء قارصاً والسماء ملبدة بغيوم تنذر بالمطر. تمنيتها تمطر حتى لو تحولت طرق القرية إلي بركة من الطين وتعرّت جذور أشجار الجوافة. وصلنا إلى ماكينة الطحين. كان صوتها عالياً يصم الآذان، زحام شديد ما بين البشر وأشولة الدقيق.
فرغت جدتي من صلاتها، وبدأت تناجي ربها بصوت مسموع: "يوم هزيل ويوم رحيل". سألتها عن سر هذا الدعاء، فقالت بلهجتها الصعيدية: "بدعي ربنا إن اليوم اللي يمسكني فيه المرض يكون آخر يوم لي في الدنيا، واليوم التاني أموت. عايزة يا ولدي الحِمل يبقى خفيف"... مجاز
بجوار الطاحونة دكان بقالة يمتلكه رجل عجوز. استأذنت أمي وذهبت لأشتري منه حلوى "العسلية". كنت أسمع طقطقة حبات المطر فوق التراب. الجو مبهج. كل ما في المكان حولي يشعّ بهجة عدا مدرستي الابتدائية ذات اللون الأصفر، والتي تبعد عن الطاحونة نحو عشرة أمتار. بعد نحو ساعة جاء دورنا. كان الرجل يمسك حبوب القمح ويسكبها في الماكينة من أعلى، فتخرج من أسفل ذرات دقيق ناعم من بين قواديس قماشية، بعدها يعبئ لنا رجل آخر الدقيق في الشوال، لنقطع نفس الرحلة إلى البيت.
في صباح اليوم التالي كانت أمي تضع الدقيق داخل إناء نحاسي كبير وتسكب عليه الماء وبدأت في خلطه بيد واحدة. تمكنت من وضع قبلة على يدها الأخرى قبل أن تخبئها في العجين، بعدها قطعته إلى خبز على شكل دائرة، وتركته تحت أشعة الشمس حتى يخمر، ثم جلست أمام الفرن تقيد ناره بأعواد القطن والسمسم حتى يسخن سطح الفرن وتلقي عليه الخبز ومحبة مني.
أجلس بجوارها أنتظر أول رغيف خبز يخرج من الفرن، بينما يأتي صوت عبد الغني السيد قادما من راديو جارنا:
كفاية البعد شاور عقلك وهاود
جبال الكحل تفنيها المراود
كفاية البعد كفاية
رماني في الهوى عشق الأحبة
غلبني يا جميل طبع المحبة
عندما انتهت أمي، وذهبنا إلي بيتنا الكبير، تذكرت أنها خلعت الخاتم وهي تعجن الدقيق، حينها باءت كل محاولاتي بالفشل في العثور عليه. حزنت أمي على فقدان الخاتم الذي ورثته عن أمها وهي تقول إنها كانت ترى وجه جدتي في الفص الأزرق كلما نظرت للخاتم. لم يقطع حبل الذكريات غير ذلك الفأر الذي ضاقت عليه الحجرة بما رحبت ومرّ فوق حذائي.
وضعت الخاتم في جيبي، وأنا أسأل نفسي: هل ستفرح أمي عندما أخبرها أني عثرت علي الخاتم بعد سنين، ولن يفارق إصبعها لأنها باتت لا تقوى على عجن الدقيق؟ وهل ستفرح "بهجة" عندما يصلها دعائي كلما انتهيت من التسبيح على حبات سبحتها التي لم تكن مسحورة؟
لست متأكداً، ولكن الفرحة التي تأكدت منها باتت جلية فوق وجه الفأرين الكبيرين، عندما خمدت نار الحرب المشتعلة بين الفأر الصغير وإخوته حول سبب لا يعلمه إلا الله ومن يحمل شفرة الفئران.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.





