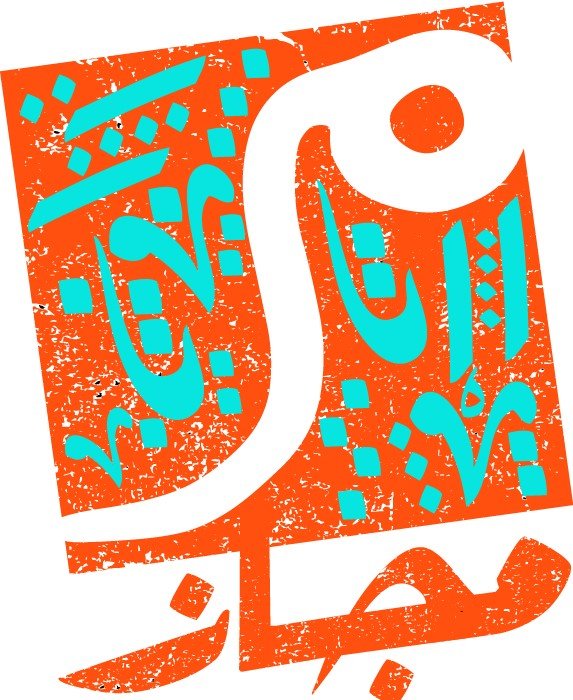 حياكة الكلام
حياكة الكلام
أغلق باب البيت، وأتجه نحو العمل. الشوارع هادئة، يسير الناس فيها كأن على رؤوسهم الطير، فمنذ سرت شائعة بوجود العملات المعدنية في الشوارع، التي يحصل عليها من يخفض رأسه ويدقِّق جيداً في الوحل، تغيَّرت المدينة جذرياً.
الجميع يسيرون ويحدِّقون ويتفحصون جيداً أي تفصيل لشيءٍ لامع. يقولون إن المبالغ التي حصلوا في البداية لم تكن كبيرة، ولكن - كل عدة أسابيع – يتغير وضع أحد سكان المدينة بنحو لافت، ما يُعيد إلى الأذهان قصة "النسر المجنَّح" الذي يرمي العملات كل ليلة. إنه يحاول توزيعها قدر ما يستطيع، لكنها أحياناً تتساقط منه، أو ربما يملُّ فيرمي بقية محتويات الكيس كيفما اتفق.
أسهرُ كل ليلة على الرصيف، لأدخِّن بعيداً عن جوِّ المنزل الخانق، ولم أرَ ذلك المجنَّح قط. في الليل أيضاً تخفتُ حدَّة البحث، لأن معظم العملات تكون قد التُقطت، إضافةً إلى صعوبة البحث في الظلام، لكنك قد ترى شخصاً ينحني إن رأى شيئاً يلمع صدفة، بينما يُفضِّل معظم سكان المدينة النوم باكراً، لبدء البحث منذ الصباح.
تطولُ جلساتي على الرصيف، بعد نهار عمل طويل، فالجو هنا ألطف من جوِّ المنزل الخانق، فالكهرباء غالباً مقطوعة.
يتغيَّر شكل المدينة باستمرار، وسكانها يتناقصون ويهاجرون أو يلجؤون إلى أماكنَ تكون فيها أجرة البيوت أرخص، ونادراً ما ألتقي شخصاً ممن كنت أعرفهم.
الراتب الذي يدفعونه لي، لا يكفي ثمن المواصلات إلى العمل، وعلب القهوة المثلَّجة التي أشربها هناك. التدخين أيضاً يقضي على معظمه، وما زلت مندهشة: كيف أعيش حتى اليوم مع نقود لا تكفي لدفع ثمن تلك الأشياء البسيطة، مع أني أعيش مع أهلي؟
قد تظنون أني محظوظة، وأجد نقوداً على الأرض، مثل كثيرين في هذه الأيام. ولكن للأسف لديَّ ديسك في الرقبة، ولا أستطيع النظر إلى الأسفل.
بالمناسبة، أنا كاتبة، ولكن ليس لدي تلك الكتب المشهورة. لقد كتبتُ أطروحةً عن تشارلز ديكنز، وحصلت بسببها على الماجستير، وبعدها تابعتُ العمل بوظيفة عادية في الجامعة، فكتابة عمل آخر قد يستغرق سنوات، إذا أردت إكمال المشوار والحصول على الدكتوراه. أما أن أصبح مدرِّسة في الجامعة، فهو أمر صعب، وربما لا أريده أساساً.
حياتي بسيطة، أخرج إلى العمل، وقد أعود بعد ساعتين. أساعد أمي في أعمال المنزل، ثم أنزل لأتمشَّى، أو أجلس على الرصيف. وفي الليل، أرسل المقالات إلى بعض المواقع الثقافية، ومعظمها بالمجان، أو أعمل متطوعة في صياغة مقالات بعض المواقع.
بينما أقطع طرقات الحارة الترابية نحو موقف الباص، رأيتُ شاباً يسير في الاتجاه المعاكس، وينظرُ نحو السماء. كان مشهداً غريباً في مثل هذا الوقت، يبدو أنه لم يسمع بشائعة العملات.
لو كنتُ أستطيع توقيفه وإخباره عما يضيع منه، فلا يستيقظ كثيرون في مثل هذا الوقت، حتى أنا لو لم أرغب في الانصراف مبكراً لما خرجت مبكِّرةً هكذا.
يوجد احتمال آخر، قد يكون ابن عائلة غنية، ولكن ما الذي سيجبره على السير في هذه الحالة في حارة كهذه. قد يكون مدمناً، ولا يحسُّ بما يجري حوله، وقد يكون كاتباً يبحث عن فكرة جديدة.
أكملتُ طريقي إلى العمل متناسيةً ذلك الشاب، بعد أن تخيَّلتُ له نهايات دراماتيكية عدة. يمثِّل أسوأها سقوطه في حفرة، وموته.
دخلتُ إلى المكتب، ووصلتُ الهاتف بالكهرباء، فهذه إحدى الميزات القليلة لتأتي إلى العمل، وبدأت بملء السجلات بالأرقام. إنها عملية بسيطة، ولكن هنا فقط ما زلنا نقوم بها يدوياً. إنها عملية مملة، وتستغرق وقتاً طويلاً، للتأكد من تلك الأرقام، ووضع نتيجة في نهاية كل صفحة.
- احذرْ السقوط في الوحل.
- أي وحل؟ ... الشوارع تلمع كالمرآة.
لم أرُدْ...
- الجو دافئ اليوم، ويبدو من أيام الصيف المسروقة.
كان الجو سديمياً كئيباً، فما الذي يقوله هذا الشاب؟ إنها المرة الثانية التي أصادفه... أخبرتُه أنني أجلس كل مساء على ذلك الرصيف، ويسرُّني أن أراه، وتابعت طريقي إلى العمل بخطى بطيئة كالعادة.
- كل يوم أجد شيئاً مختلفاً؛ إنني أعمل على رسم المعالم الزائلة: عربات الطعام في الشوارع.. مجانين المدينة والمتسوِّلون.. لقاءات العشاق أول مرة... ولكن انظري إلى موضوعي المفضَّل.
الجميع يسيرون ويحدِّقون ويتفحصون جيداً أي تفصيل لشيءٍ لامع. يقولون إن المبالغ التي حصلوا في البداية لم تكن كبيرة، ما يُعيد إلى الأذهان قصة "النسر المجنَّح" الذي يرمي العملات كل ليلة. إنه يحاول توزيعها قدر ما يستطيع، لكنها أحياناً تتساقط منه، أو ربما يملُّ فيرمي بقية محتويات الكيس كيفما اتفق... مجاز
نظرتُ إلى الأوراق، ورأيتُ شيئاً لم أتصوَّره مطلقاً. لذتُ بالصمت، بينما راح يحدِّثني عن القزم الذي يحمل الفجر إلى البلاد، بأكياس مثقوبة، يسقط معظم ما فيها في أثناء الليل على الطرقات.
- لذا لا يصل سوى هذا الفجر الكئيب؟
- إن المدفع الذي يطلق الشمس كل صباح، قد فقد الكثير من طاقته، هو الذي لم يعتد خسارة كل هذا الذهب (يجيب).
إذن، قزم يحمل كيساً مليئاً بالذهب، ويمضي في شوارع المدينة كل يوم.
- إنه تشاكي.
- ومن هو تشاكي؟
- القزم الذي يرمي النقود يومياً. إنه يعمل لديَّ.
- ماذا؟
- القصة طويلة. سأرويها لك غداً.
- وماذا لو لم أرك غداً.
- اطمئني. الأيام كثيرة، وكلها متشابهة.
مرّ اليوم التالي مختلفاً عن كل ما سبقه. كنت أرتِّب الأفكار، وأحاول فهم علاقة الشاب بالقزم. لو اقتصر الأمر على اكتشاف سرِّ القزم لكان جديراً بالكتابة عنه، أما أن تكون للشاب علاقة بالأمر، فهذا يُعيد اللغز إلى البداية، ويجعلني أنتظر المساء بفارغ الصبر.
- من هو شاعركِ العربيِّ المفضَّل؟
لا أعرف لماذا بدأ بهذا السؤال، أم أنه أراد التشويق وتغيير الموضوع. قلت له:
- تشارلز ديكنز.
لم يُدهشه جوابي، لا بد أنه يعرف "قصة مدينتين" و"قصة عيد الميلاد"، ولو من طريق الأفلام، وربما حتى "أوليفر تويست" أو "الآمال الكبيرة"، فهي شائعة جداً، ولكنه تابع الحديث بأن كل شخص قد يصل إلى نقطة قد ينغلق بعدها مسار تفكيره؛ هوس يشغله عن كل شيء. أناس يتوقف حبهم للشعر عند المتنبي أو أحمد شوقي، وأناس يحبون مطرباً بعينه، وأناس تتوقف كتاباتهم عند أفكار فيلسوف ميت أو ناقد معاصر. قال عرضاً إني متوقفة عند تشارلز ديكنز، لذا لا أستطيع إكمال عمل جديد.
طبعاً لم أتوقَّع هذا الكلام من شاب بعمر 16.5، ولكني سألته: أين توقفت حياتك؟ فأجاب: 69.
- في يومٍ ما، دخلتُ إلى مغارة في بيت جدي، في طرف المدينة. كنتُ أظنُّها مغارة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار، ولكني مضيتُ في سرداب، ثم في نفق طويل، وانحدرت. قطعت ربما أكثر من 1500 متر حتى وصلت إلى مكان يشبه البركان الخامد.
- (متابعاً) هناك وجدتُ صخرة تسد المدخل، وما إن فتحت البوابة، حتى خرج القزم. قال إنه محبوس هنا منذ سنوات، ثم سألني عن رقمي المفضل. كنت أنوي أن أقول "رقم 5"، فهو الرقم المفضَّل لمعظم الناس، ثم تجرَّأت وقلت له: "69"، فقال إنه سيحقق لي 69 أمنية، مكافأةً لي. هل تذكرين الخوخ الذي كان يتساقط على المدينة منذ سنتين؟
- (أجبته) طبعاً، يومها سقط الخوخ، وكان يصطدم بالأرض، ويفسد، ولم نستفد منه سوى بعض الانزلاقات.
- كانت تلك أمنيتي الأولى.
- يمكن أن أصدِّق قصة القزم، ولكن أن تكون أمنيتك "خوخ"!
- 69 رقم كبير، وبدا كأنه بلا نهاية. لذا، كانت أمنياتي مثل هذه.
- ربما لو كانت أمنية واحدة لاخترتَ تدمير المدينة.
- لا، لا، لا... لست من حزب النيزك. ثم إن القزم كان سيفعلها بمفرده، ألا ترينَ أنه حرّ الآن، ولا تزال الشمس مريضة.
- ربما لأنك تثقل عليه بأمنياتك.
- أبداً، معظم أمنياتي الأولى كانت تدور حول الطعام، وتوزيعه، مثل الخوخ. كنت يومها أجلس على سطح أعلى بناء في المدينة وأراقب القزم وهو يرمي الخوخ، وأنا جالس آكل من رأس الكومة الكبيرة. ومرة طلبت من القزم توزيع الفروج المشوي على معظم البيوت، ومرة طلبت منه توزيع البيتزا.
- اللعنة، أفسدت السحر. أي شخص يستطيع توزيع البيتزا!
- كنت يومها متعباً، ولم أفكر جيداً.
- لكن، ما هي أمنيتكَ أنت؟
- كنت سأطلب أمنيتي في المرة الأخيرة، وأعتزل. ولكن قبلها طلبت أشياء كثيرة حاولت بها أن أجعل المدينة أجمل. استمر ذلك فترة جيدة. ثم فكرتُ في وسيلة تحقق شيئاً مستداماً، لا ينتهي، وكان هذا أغبى شيء فعلته.
- لماذا؟
- لقد كلفني 50 أمنية دفعةً واحدة، أي انتقلت من الرقم 18 إلى الرقم 68 بطرفة عين.
- وكيف ذلك؟
- إنه خيار متاح، أو – كما يقولون - عرض خاص: تستطيع أن تعلق مع القزم في أمنية واحدة تتكرر كل يوم إذا تخلَّيتَ عن 50 أمنية.
- أعرفها... إنها الذهب، فأنت من يوزع الذهب كل يوم.
- وتلك المشكلة
- أين المشكلة؟ أنت تستطيع أن تكون أغنى شخص الآن.
نظرتُ إلى الأوراق، ورأيتُ شيئاً لم أتصوَّره مطلقاً. لذتُ بالصمت، بينما راح يحدِّثني عن القزم الذي يحمل الفجر إلى البلاد، بأكياس مثقوبة، يسقط معظم ما فيها في أثناء الليل على الطرقات... مجاز
- المشكلة الأساسية أنني في حال طلبتُ أمنيتي الأخيرة رقم 69، ستتوقف الحلقة عن الدوران، وتنكسر، ويتوقف توزيع الذهب. والمشكلة الثانية أنني مضطر إلى الاستيقاظ كل يوم، والسير مع القزم الأمتار الأولى، لآخذ حصتي مما يرميه. أنا لا أنام تقريباً، وبعد أن كنت في الأيام الأولى مستمتعاً في ما يحصل، وأرسم القزم وهو يوزع الذهب، مثلما رسمته وهو يرمي الدجاج المشوي أو جوز الهند أو فاكهة التنين أو حتى الكنافة النابلسية، وبالمناسبة فشل في صنعها، وأخبرني أن إمكانياته محدودة رغم كل شيء، ولا تصل إلى الكنافة النابلسية...
- المهم...
- يعني أنني عالق. أنا لا أكبر منذ وجدتُ القزم، وكان هذا جميلاً في البداية، ثم تحوَّل إلى كارثة.
- لكنك تستطيع أن تطلب أمنيتك الأخيرة، وتكسِر الحلقة.
- ولكني سأخسر الذهب.
- بالمناسبة، لم تقل لي حتى الآن: ماذا كانت أمنيتك الأخيرة؟
- لا داعي لذلك.
- لماذا؟ لقد قلتَ كل شيء. هل هو أمر محرج؟
- ليس كثيراً.
- ممم
- لقد كانت أمنيتي التي ادَّخرتُها حتى النهاية: أن أمارس وضعية 69 مع أشهر مغنية في المدينة.
نظرتُ إليه باشمئزاز.
- لا طبعاً، عدلتُ عن الفكرة.
- عدلتَ عن الفكرة، أم أن المغنية سافرت.
- ربما الأمران معاً. ولكن الذهب كان ما يشغل بالي.
- كنتُ حللتُ لك المسألة، ولكني لا جنسية.
- وهل تظنين أني أقبل بممارسة الـ 69 مع أي كان؟ مع احترامي طبعاً.
- قلت لي 69.
- كان عمري 16.5.
- وما زال.
أصبحتُ أعرف قصة القزم، ومن أين جاء، ولكن نهايتها بقيت مفتوحة. ما زلت أرى الشاب كل فترة، ونادراً ما يجلس معي ليقصَّ حكاياته التي استُنزفَتْ، وحتى رسوماته باتت قديمة حتى بالنسبة إليه، ويشتهي لو يرسم غيرها، لو يستطيع.
- ربما عليك إذن أن تجد أمنيتك الحقيقية، وتنتهي المسألة.
- وهل يجب أن تنتهي؟
- انظر، ليس أمراً جميلاً ما يحدث، وهذا الذهب حوَّل الناس إلى بُله. نعم، من الأفضل أن ينتهي الأمر.
- أنتِ ربما ليس لديك مسؤوليات. في النهاية، أنت كاتبة. مع احترامي طبعاً.
- ولكنها ليست حياة.
- إنهم سعداء.
ربما أمارس وضعية 69 مع الشاب لأجعله يتجاوز الأمر، ربما أصبحت هذه أمنية في عقلي الباطن، ربما يسقط الشاب والقزم معاً داخل البركان، وتبقى الأمنية الأخيرة معلَّقة في السماء.
سألني مرة: لماذا لا تكتبين عن فلوبير؟ ولم أدرِ من أين سمع به. قلتُ له إن وصوله إلى المغنية أسهل من وصوله إلى مدام بوفاري.
ربما يستمر الوضع هكذا حتى يتحرّر القزم بطريقة ما، أو يموت الشاب. أو ربما ببساطة يطلب أمنية بسيطة، ويرتاح. وحتى يحدث شيء من هذا، ستبقى كتاباتي تُسفَح هكذا بلا نتيجة، مثل حياة الشاب المتوقفة في عمر 16.5 عند الرقم 69.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.





