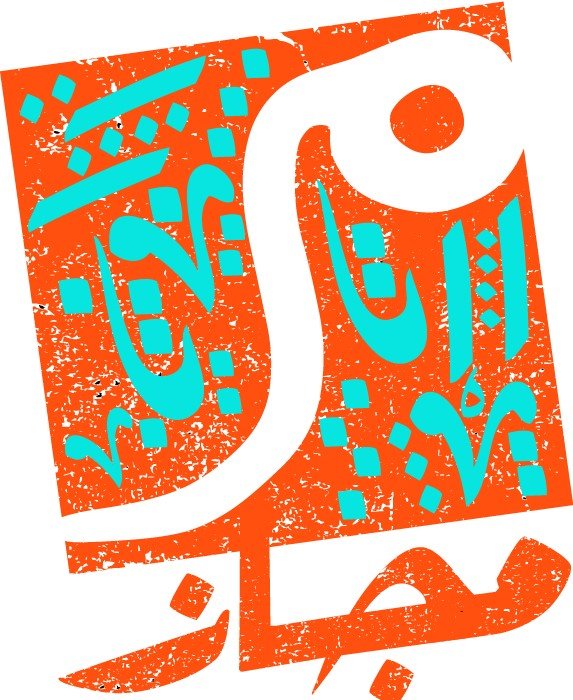 حياكة الكلام
حياكة الكلام
أنا هنا، قريباً من اليابسة، لكنني أُعدّ نفسي للأسوأ، للغرق، لوضعٍ أجد نفسي فيه وسط البحر، دائماً. كأن تغرق باخرة أركبها يوماً في رحلة حول العالم، وبدل الذين سيفاجئهم الوضع ويغرقون، سأستعمل مهارتي التي أكسبتني إياها التداريب، وأسبحُ بذراعين قويتين تدرّبتا جيداً، ثم أصل جزيرة أُصبح "رُوبِينْسُونَها".
أنا هنا، أتدرب على النجاة من الغرق، في بحر هائج، يتحدّاني بموجاتٍ أعلى من سابقاتها، قوّة انكسارها لا طاقة لي على مواجهتها، بينما أسحبُ نفسي خارجة بكامل قواي، لأفرّ من جبروت الأمواج الهائجة. كانت قوتي تتهاوى، والبحر يضحك كأنّني نكتة ألقاها أحدهم فيه.
بدأ المتوسط موجة هيجانه ليلة أمس، لكنني لم أشأ هَجْر قُربه يوماً واحداً من عطلتي السّنوية. لن أُضيّع فرصة التعوّد على السباحة قريباً من الخطر، حتى لو كان البحر غاضباً ولا يطيق نفسه أو أحداً فيه، قلتُ لنفسي. لكنه قابلني بعدوانية لصّ، أو حقد جار بغيض. وفي لحظة الالتقاء الأول ببرودته، لم يسمح بدخولي البطيء، الذي أتبلّل فيه سنتيمتراً سنتيميتراً، ثم أرفع حفنةَ ماء، أُخفّف بها حرارة وجهي الذي أحرقته الشمس.
منذ زمن بعيد اعتدتُ عدم تعريض جسدي لصدمة الغطس السّريع في الماء، رفقاً به. في مرات كثيرة يأتي أحد الأطفال، خلال عملية دخولي البطيئة إلى البحر، يرتمي في الماء ويسبح ويغادر، وأنا لا أزال في طريقي إلى البلل. فقط حين يصل الماء إلى عنقي، أغطس رأسي في الماء، أنتعش قليلاً ثم أسبح على مهلي، منتعشة بالبرودة الخفيفة التي تحقّقت بمهل ومتعة. أو بالبرودة المثلجة التي تُصدر صوت "فَشْفَشة" في الماء، وأنا أغطس كاملة، وتندفع مسام جلدي ويقف شعر رأسي انفعالاً من الصدمة الباردة، كأن إبراً رقيقة ترتطم بمسامي في وقت واحد.
أدخُل الماء مثل السّيخ السّاخن الذي يقلب الإسفنجات السّعيدة وسط المقلاة الضخمة، لأمحو تاريخاً من الاحتراق. أوّل ما ينطفئ فيّ عقلي الذي يصبح أخفّ من بالون هواء، لا يعود يذكر شيئاً مما حدث قبل الارتماء في الماء... مجاز
أبتسمُ لذكرى أوّل نكتة طفولية: تضيعُ إسفنجة لأحدهم "فطيرة مغربية تشبه الدّونات الأمريكية"، فجأة يدوس على شيء يئنُّ: "فْشّْ". يقول الطفل الفرح: "عْليكْ كَنْفَتّشْ". أدخُل الماء مثل السّيخ السّاخن الذي يقلب الإسفنجات السّعيدة وسط المقلاة الضخمة، لأمحو تاريخاً من الاحتراق. أوّل ما ينطفئ فيّ عقلي الذي يصبح أخفّ من بالون هواء، لا يعود يذكر شيئاً مما حدث قبل الارتماء في الماء.
خفّة الكائن البحري
لا يمثّل الخروج من بحر هائج التحدّي الوحيد، فحتى الدّخول إليه معقد. فحالما تجاوز الماء ركبتي، أمسكني البحر من قدمي، دافعاً إيّاي بعنف على رملٍ حجري، مرّتين خلال محاولتي الدخول. كانت الدَّفعتان كافيتين لأتبلّل بالكامل، وآخذ علقة محترمة. حاولتُ مجاراة الأمواج التي تصبح أقلّ عنفاً في الداخل، دخلتُ إلى العمق حيث التدرّجات تبدو على علوّها، محتمَلة، هروباً من قوة انكسار الأمواج، إلى لحظة اندفاعها المتمهّل، قبل أن تسكب نفسها على الشاطئ .
ما من حدثٍ يثير الانتباه أكثر من رؤية الغرقى يمشون مجدداً على الأرض.
لاحظتُ أنني وحدي من يسبح، وكل الجحافل البشرية على الشّاطئ، لم تقربِ البحر. قلت إنّ الأمر ليس بهذا السّوء. أنا أسبح بحذر، ولم أتعمّق كثيراً. تخيّلتُ نفسي وسط عاصفةً في المحيط، أستلقي على ظهري في الماء العكر المزاج، مثل سماء غائمة. فجأة اعترضتني دوّامة تفاديتُها بمشقة، لم أشأ أن أهلع، قاومتُ دقّات قلبي المرتعب، وسبحتُ بقوّة خارجها. حينها قلتُ يكفي، إنّ الوضع جدّي يا بنت، ولا مزاح مع البحر إذا غضب، قد يؤدي التّدريب على النجاة من الغرق إلى الغرق.
تفاديتُ طلب المساعدة من نساء توجهن نحوي، ربما بدافع من رؤيتي أسبح رغم هيجان البحر. كان لا يزال في يدي بعض الكبرياء الذي دخلتُ به، ولا يمكن أن أسمح للبحر أن يُحوّل صورة المرأة القويّة التي دخلت البحر الهائج وحدها، دوناً عن أمة الصيف المستلقية على الرّمال بحكمة الجبناء، لعبرةٍ لمن يعتبر.
الهروب إلى الأمام
بعد ربع ساعة، شعرت أنني اكتفيت من السّباحة الخائفة. حاولتُ الخروج، واقتربت من منطقة تكسّر الموج. دفع البحر خلفي ثلاث موجات ضخمة. أسقطتني الأولى، مع أنّني كنت أقف على الأرضية الرّملية.
نهضتُ. حاولتُ الإسراع بالخروج، بقدمين هوائيتين. لكنّه عاجلني بثانية دفعتني بقوة إلى الأسفل. اندفع الماء إلى فمي وأنفي، وانسدّت منافذ التنفّس أمامي. بعد تبدّد قوتها، ارتفعتُ بصعوبة ولم أصدّق أنني فعلت. رفعتُ رأسي، كسهم متردّد، لأصرخ وأطلب النّجدة. كنتُ مدركة أنني لن أخرج منها، وإذا فعلت فإن الثالثة محتومة.
آخر ما يفعله الغرقى
رفعتُ يدي مثل كل الغرقى، لا أدري ما إذا كانت لتُرى ويُسرعُ إليّ بعدها. إنّها حركة طبيعية، آخر محاولة للغريق ليهزم البحر، بالاستعانة بصديق. في ذلك الجزء من الثّانية، رأيتُ شابين قريبين مني. غريب كيف تصبح الرّؤية حاسمة وحادة في هذه اللّحظات. ولأنني كالعادة، أعتبر طلب المساعدة ضعفاً، توجّهت للأضعف، من باب تضامن الضعفاء، وكدليل أن الأمر بسيط ولا يستحق الجلبة، رغم أنّني كنت أنازع. صرختُ بلكنة شمالية، وبصوت مخنوق تُحاصره الأمواج: آالعايل، يا ولد...
التفت الشّابان معاً، لكن أَكبرَهما كان الأسرع، وفيما يدفع البحر موجته الثالثة تجاهي، وأنا أقع وسطها عديمة الحيلة، مستسلمة لقوة الماء، وحتمية الغرق. امتدّت يدُ الشاب، كما تمتد الحياة لتُخرج جنيناً. أمسكتُ اليد بشدة، غير مصّدقة أنها وصلت إلي قبل أن يسحبني البحر إلى عتمته. حاولتُ التماسك والنّهوض من بين مخالب الماء. كدت أُوقع الشاب، لولا تماسكِ المعتزّ بنفسه.
أسحبُ نفسي خارجة بكامل قواي، لأفرّ من جبروت الأمواج الهائجة. كانت قوتي تتهاوى، والبحر يضحك كأنّني نكتة ألقاها أحدهم فيه... مجاز
شعرتُ للحظة بالرّغبة في السّقوط من اليد التي تتشبّث بي. خطرت لي العودة إلى الماء، لأنّني شعرت بتعب شديد، من محاولة الخروج من المواقف الصّعبة. ولأنني أفكر منذ فترة في أن أترك للأشياء أن تأخذ مجراها أحياناً، لعل ذلك يوقظ فيها بعض الحماس.
هذه يدٌ لن أنساها
لم تستطع إرادة أخرى، أو صوت آخر إطلاق سراح يد الشاب، وقفتُ بصعوبة وحاولت الاتزان، بضغط أصابع قدمي في الأرض، في كلّ خطوة وسط الماء، الذي كان جارفاً، رغم أن قوّته الغادرة تنحسر وتنسحب الآن، تاركة الحجم الطبيعي للماء في الشّط. جرّتني يد الشّاب الذي لم أر ملامحه أبداً. واصلتُ الضّغط على كل خطوة لمقاومة الماء، والدوخة التي زلزلتني. أخيراً وصلت إلى الرّمل الجاف. أطلقت يد الشاب بعد أن جلست على الأرض.
لم أر ملامح صاحب اليد التي أخرجتني من الماء، والذي قال كلمة واحدة :ارتاحي هنا. جاء آخر بماء، ثم غادرتُ ساحبة نفسي من العيون الفضولية، إنه لمن المدهش رؤية خارجٍ من الموت. ما من حدثٍ يثير الانتباه أكثر من رؤية الغرقى يمشون مجدداً على الأرض.
أدخلوني... أخرجوني
اليوم هدأ البحر لكني فقدتُ ثقتي فيه، وشجاعتي التي استجمعتها خلال اليومين الماضيين، بتشجيع من رفيقتي السبّاحة الماهرة التي دعتني للدخول أعمق في البحر. هذه الشّجاعة ذابت تماماً، وها أنذا اليوم ألتفتُ في الماء بفزعٍ كلّي. كلّ حركة أخالها طعنة غادرة.
كلّ التّداريب التي أجريتها على الغرق، وتخيّلي لنفسي أطفو وسط المحيط الرّمادي الوجه وأنا أسبح في مسبح فندقٍ، أو شاطئ آمن، وسباحتي الجيدة التي كانت تعتمد على شجاعة ووجود سباحين جيدين بالقرب، لأغوص. كلّ ذلك بلا معنى الآن، لأعود إلى السّباحة التي تعادي الماء، بدل أن تصادقه.
صرتُ أدخل لأسبح بحذر نسبي، في البحر الهائج، ثم أنادي من يخرجني، لأنّني أخاف أن أدير ظهري للبحر. أخاف أن تُفجّر موجة نفسها فوق رأسي، مثل انتحاري حقود، أو تُكسّر جسدها الهلامي على جسدي، وأتفتّت في الماء كأن الذي بيننا ثأراً قديماً.
أخاف أن أغرق قبل الأوان، وتفوتني بحار كثيرة لم أدخلها، وسفن لا تغرق، رغم تحفّزي المزمن لقتال الأمواج وحاجتي إلى أن أكون روبنسون كروزو، ولو لمرة واحدة.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


