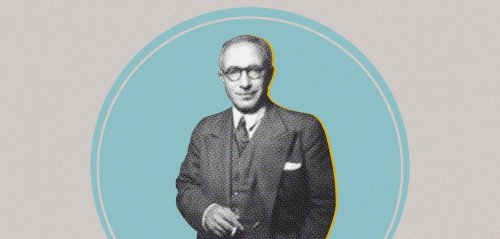مهما سافرت وتنقّلت في بلاد الأرض، ورغم الراحة التي أحصل عليها أحياناً، بل غالباً في تنقلاتي، فإن لحظة وصولي إلى الأراضي الفرنسية تعني لي الأمان المطلق.
حين تحدثت مرة أمام أصحابي وأقاربي عن علاقتي بفرنسا، وارتباط مفهوم الأمان لدي بهذا المكان، اختلف معي أغلبهم، قال أحد أبناء عمومتي المقيمين في ألمانيا إنه جاء في زيارة إلى باريس، وعانى فيها من سوء الطرقات، وازدحام الشوارع، وعدم توفر النظافة كما ينبغي لمدينة كبرى، وإنه لن يعود البتة لزيارة هذا البلد.
أتفهّم شعور أي أحد لا يعيش في فرنسا، حين يتذمّر من باريس، ولكن باريس ليست فرنسا، إنما هي مدينة التعب، حتى لأبنائها الأصليين، أما بالنسبة للغرباء، فهي مطحنة نفسية، تقتل الشغف والأمل، وتعزّز الوحدة والعزلة والقلق.
باريس مدينة جميلة وساحرة عن بُعد، أما أن تعيش فيها، فسوف تنتهي العلاقة السحرية الخارجية سريعاً، إن لم تكن ثرياً وليست لديك هموم العمل، والمال وبدل الإيجار والتنقلات.
باريس مدينة جميلة عن بُعد، أما أن تعيش فيها، فسوف تنتهي العلاقة السحرية سريعاً، إلا إذا كنت ثرياً وليست لديك هموم العمل، وبدل الإيجار والتنقلات.
للمرة الأولى في حياتي الفرنسية، وأنا هنا منذ أكثر من ثمانية عشر عاماً، أسافر من مدينة فرنسية إلى باريس، دون أن أكون مارقة بها، بحكم سفري الخارجي، عائدة أو متجهة إلى أوروبا، أو أحد البلاد العربية.
رأيت باريس بغتة، بعينيّ مواطنة فرنسية غير باريسية، ووجدت ذلك الألم الذي تكشّف لي بعد تقشير الجلدة السطحية لأضواء باريس والصخب وجمال العمارة وسحر نهر السين.
نزلت في محطة "المونبرناس" متجهة صوب موعدي قرب "بلاس دو إيتالي"، ومن هناك، كان عليّ التوجه إلى معهد العالم العربي، ففضّلت حافلة الطريق على قطار الأنفاق "المترو"، حتى لا أغيّر عدة خطوط، حيث إن الباص يتجه مباشرة إلى وجهتي دون تغيير.
كما أفعل في مدينتي الساحرة المطلة على المحيط الأطلسي حين يصعد أحدنا في الباص، يلقي التحية على السائق يبتسم لنا بمودة وألفة، وينتظر أن نجلس حتى يسير، وحين ننزل، نقول عبارات سريعة: "شكراً، إلى اللقاء، نهار سعيد". والسائق يرد بالمقابل بمودة.
في باريس، لم أسمع صوت سائق الباص فيما إذا كان ردّ على تحيتي، ولاحظت أن كل من ينزل من الباص، يفعل ذلك بطريقة أتوماتيكية خالية من الحميمية، دون أن يقول أية كلمة، كأن السائق هو روبوت وليس كائناً من لحم ودم.
في مدينتي الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي حين يصعد أحدنا في الباص، يلقي التحية على السائق فيبتسم لنا، وحين ننزل، نقول: شكراً، نهار سعيد". والسائق يرد بمودة
هذا السلوك في مدينتي يُعتبر قلة ذوق، أذكر أنني كنت مرة على عجل، في باص مليء بالطلاب، وحين نزلت دون كلمة تحية، رفعت إحدى الشابات صوتها تقول لي: "نهار سعيد سيدتي". أحسستُ بالحرج، وكأنها توبّخني بلطف، لأنني نزلت بصمت!
عذابات الناس في المترو
بين الساعة السادسة والثامنة مساء، مواعيد العودة من العمل، تقدّم وجوه الناس في المترو الخارطة الحقيقية لمدينة باريس.
حين كنت أقيم في باريس، قبل قرابة سبع سنوات، كنت معتادة رؤية الكتاب في أيادي الركاب، لا تترك عينا أحدهم كتابه، وكانت هذه إحدى نقاط إعجابي بالفرنسيين عموماً وبالباريسيين خصوصاً.
لكن هذه العادة تراجعت بشدة، إلى أن صار مشهد أحدهم ممسكاً بكتاب في المترو شبه نادر، إذ حلّت أجهزة الموبايل مكان الكتب، لنرى الوجوه غارقة خلف الشاشات، لا أحد ينظر إلى ما حوله، الجميع منفصل عما يحيط به، يصنع لنفسه دائرته الخاصة، في عالمه الافتراضي.
في زحام الخط رقم 2، وجدتني أقف قرب شاب يرتدي ملابس رسمية، وهو عائد من عمله على الأغلب، فتحت هاتفي فقط لأتأكد من وصول رسالتي إلى الصديق الذي أتجه للقائه، وأعلمه بأنني سأتأخر، أغلقت الهاتف على الفور بعد أن أنهيت مهمتي السريعة، وقعت عيني في عين الشاب، وابتسم لي بحسرة، فرددت عليه بابتسامة إيجابية.
تواطؤ سريع جرى بيننا، كان مفاده أنه اعتقد كما لو أنني أنتظر رسالة عاطفية لم تصلني، بينما كان ردي بأن كل شيء على ما يرام.
نزل الشاب في المحطة التالية، ورغم أناقة ملابسه المبالغ بها، يبدو أنه يعمل في فندق أو في مصرف أو مؤسسة تهتم بالمظهر الخارجي، لكن أمارات العزلة النفسية والقلق كانت بادية على وجهه.
أما في طريق العودة، قرابة العاشرة ليلاً، حيث يُضاف على مشهد انهماك الركاب بالهواتف النقّالة، مشهد احتساء الكحول بطريقة حزينة. فقد تأملت طويلاً ذلك الشاب الذي يشرب البيرة وحده، داخل المترو، ويتودد إلى الآخرين.
ولأنه يعرف قسوة معظم الباريسيين وعزلتهم ورفضهم، دون تعميم، فقد حدد الشاب الثمل دائرته الحميمية التي يحتاجها وهو في حالة عزلة تحاول كسر ألمها، ليتحدث مع رجل إيطالي مع ابنتيه، فيتكلم بصوت مرتفع، من مقعد مقابل لا مجاور، يسألهم عن رأيهم في باريس، ويتمنى لهم إقامة طيبة.
إن الباريسيين يشعرون بالوحدة داخل هذه المدينة الكبيرة، التي تبتلع البشر وتفرض عليهم قوانين صارمة في آليات التواصل
الشفقة التي انتابتني صوب الشاب الأنيق في طريق الذهاب، هي ذاتها التي شعرت بها صوب هذا الشاب الوحيد في طريق العودة. إن الباريسيين يشعرون بالوحدة داخل هذه المدينة الكبيرة، التي تبتلع البشر وتفرض عليهم قوانين صارمة في آليات التواصل.
إذا كان الأمر بهذه القسوة على الفرنسيين أنفسهم في بلدهم، فكيف سيكون بالنسبة للأجانب؟
من هنا تبدو فكرة المنفى قوية ومتسلطة على الغرباء، لأن باريس صعبة حتى على أبنائها المولودين فيها، إذ يسود الشعار التاريخي القديم الذي التصق برأسي منذ وصولي إلى فرنسا، لتعريف باريس في ثلاث كلمات: عمل، نوم، مترو.
باريس صعبة حتى على أبنائها، إذ يسود الشعار التاريخي القديم الذي التصق برأسي منذ وصولي إلى فرنسا لتعريف باريس في ثلاث كلمات: عمل، نوم، مترو.
من هنا نرى التوتر في المترو، لأن الباريسي يكون ذاهباً إلى عمله، حيث الاختناق غالباً وقلق ساعات العمل، أو عائداً منه، يحلم بلحظة وصوله إلى سريره لينام، متخلّصاً من ضغط نهاره.
هذا الإيقاع الباريسي المُرهق للفرنسيين القادمين من مدن أكثر استرخاء، كحالتي، أنا المقيمة حالياً بعيداً عن باريس، في مدينة لا تلهث خلف وسائل المواصلات، ولا يركض فيها الناس للّحاق بالقطار، ولا يتذمر فيها الناس متحدثين مع أنفسهم، أو يشربون الكحول داخل عربات المترو، أو على مداخل المحطات أو أرصفتها، للانتقام من الوحدة والقلق. ليتحول هذا الإيقاع إلى كابوس بالنسبة للأجانب، وأعني خاصة السوريين القادمين من بلاد تقدر كثيراً معنى" الاستضافة"، وتسود فيها العلاقات الاجتماعية الدافئة.
أذكر مارغو، السيدة الباريسية التي كنت أعطيها دروساً في اللغة العربية، لتتمكن من التواصل مع عائلة زوجها اللبناني، والتي كانت تحيا ذعر أن يتركها، لأنه يشعر بالعزلة في باريس.
كانت مارغو تتعلم العربية، لتعوّضه عن عائلته أيضاً، تستفسر مني عن كثير من السلوكيات لتحيطه بدفء العائلة، وكانت تأتيني دائماً إلى ساعتنا العربية، متجهمة وقلقة: "لا أعرف كيف أجعله يشعر بالعائلة هنا!". إذ يتذمر زوجها من افتقاد الفرنسيين لمفهوم العائلة الدافئ وحسّ الجيران.
لهذا، حين كنا في مقهى، نحن مجموعة أصدقاء فرنسيين، مع صديقة سورية جاءت حديثاً إلى فرنسا، وتأخر بنا الوقت، وقررنا أن نبحث عن مطعم في مدينتنا التي تنام باكراً، وتعذر علينا العثور على مطعم بعد منتصف الليل، فوجئ الجميع حين عرضت صديقتنا السورية التوجه إلى بيتها.
صديقتي السورية ذاتها، حين أتصل بها لأسألها عن أمر، فتقول لي: "أها، أنت قريبة، اصعدي نشرب قهوة".
باريس المنفى الكبير، المدينة التي يلهث خلفها العالم، ويلهثون داخلها، كي لا تبتلعهم الزحمة، هي المكان الأقسى في فرنسا
تهزني عبارة صديقتي، إذ من النادر جداً أن يستقبل فرنسي صديقه دون موعد مسبق، ليشربا القهوة، ثم يتابع كلٌ منهما برنامج عمله، بسبب ضغوط العمل هنا، ودقة المواعيد وكثرتها، الأمر الذي لا يترك الوقت للصداقات التلقائية، وللعائلة.
لهذا فإن المنفى بطريقة ما، هو للفرنسيين كذلك، الذين يضطرون إلى الذهاب إلى باريس، لأن اقتناص ساعة من نهار أحد أفراد العائلة، خارج مواعيد مسبقة، وإجازات محددة سلفاً لهذا الغرض، مهمة صعبة كأنك ستغادر من بلد لآخر.
باريس المنفى الكبير، المدينة التي يلهث خلفها العالم، ويلهثون داخلها، كي لا تبتلعهم الزحمة، هي المكان الأقسى في فرنسا، على الفرنسيين، وعلى الأجانب، وعلى السوريين أيضاً، لأنهم أبناء الأمكنة الرحبة والترحيب.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.