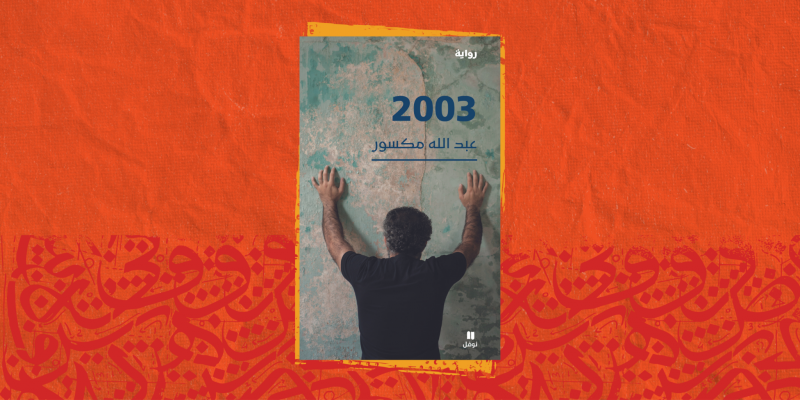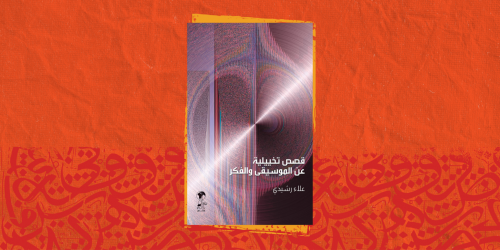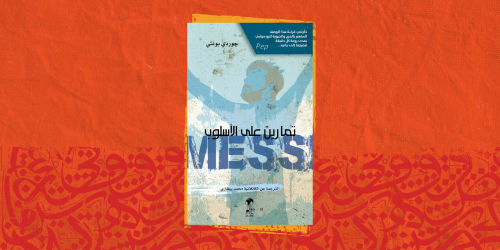هذه البلاد تخاف من التعلُّق بالمطلق، منيعةٌ ضدّ الإطراء ولا يغريها أبداً النفاذ إلى الجوهر، أسقَطَت العثمانيين وطردت الإنكليز وها هي تخرجُ من وطأةِ الحكم المستبدّ. سنواتها الخاليةُ علَّمتها كيفَ تُصافِح مَن يأتيها باليد اليمنى، بينما تكون يدها اليسرى على السلاح، صفحات التاريخ فيها لا تحتفظ بروايات الضعفاء وقصصهم. هذه البلاد لا تخاف من البشر الساكنين فيها وإنّما تخافُ من أحلامِ الشيطان القابعِ داخلهم، عشتُ فيها على هامشِ حياتِها بين ثنائيّتَي المواطن الصالح والطالح، عارفاً تماماً الفرق الكبير – في شوارعها – بين الخصم والعدوّ. فكيفَ وضعتني، قبلَ أن تُسدِلَ الستار على المشهدِ الأخير من حقبة عراق صدّام حسين، في واجهةِ الأحداث؟
خرجتُ من العيادة باتّجاه شارع السعدون، لأول مرّة أمشي فيه منذ بدء الحرب، المحالّ العامرةُ بالفرح المؤقَّت الممزوج بالبؤس قد أُغلِقت، والطريق المؤدّي إلى مقاهي أبي نُوّاس قد سُدَّ تماماً. تبدو المدينة وقد صارت مدينة أشباح خلا بعض الشبّان وكثيرٍ من الجنود والمدرّعات التي ترفعُ العلمَ الأميركي، أو السيّارات المدنية التي تعلوها الراية البيضاء، وجدتُ نفسي فجأةً في ساحةِ معركةٍ مُنتَهية، أو ربّما لم تحدث أصلاً، في المدينة. يركضُ بعض الجنود على الشريط الرملي الواسع الموازي لنهر دجلة، بعضهم دسَّ جسده بين أعواد البردي وآخرون رمَوا أنفسهم في النهر، الباقون ابتلَعَتهُم الخنادق المحفورة حديثاً بينما لاحقهم وابلٌ من الرصاص الصادر من بندقيات «إم 60». إنّها الجولة الأخيرة في المعركة، انفجارٌ يليه انفجار كأنَّ رأسَ نمرٍ جائعٍ يطيرُ فوق المدينة وهو بحالة الجهوزية التامّة للانقضاض على أيِّ فريسة.
راح السائق يكيل الشتائم لصدّام باعتباره مسؤولاً عن كلّ ما حدث، حالةٌ من الفوضى والعشوائية في كلّ شيء... من رواية "2003"
تبحثُ العاصمةُ عن أسلافِها بينما يأكلُ الذئبُ شوارعَها. حملتُ جسدي على قدمَيَّ مستحضراً حواسّي كلَّها؛ السمعَ والبصرَ واللمسَ والشمَّ والتذوُّقَ والقلبَ والعقل، حاولتُ أن أستحثَّها كلَّها لتعملَ بعيداً عن الذاكرة والحاضِر الذي يفرِضُ أدواتِهِ الآن من أمامي ومِن خلفي ومِن فوقي بمنطق القوّة والأمر الواقع، مشيتُ حتى بداية ساحة الفردوس، الأحجارُ التي تناثرَت من قاعدة التمثال الذي أُسقِطَ قبل ساعات ما تزال مكانها بينما اختفت أجزاء التمثال كاملة من المكان، الصحافة والكاميرات في كلّ زاوية. رأيتُ بعض الوجوه التي أعرفها، لقد زارني مرافقٌ عراقي مع صحافي نرويجي مع بداية أبريل في العيادة، كان الصحافي يبحث عن ملاذٍ آمنٍ للسكَن إذا ما عمَّت الفوضى ببغداد بعد أن بدأ ممثّلو وزارة الإعلام بمضايقة الصحافيين الأجانب وابتزازهم من خلال إجبارهم على البقاء في أماكن محدّدة. تحاشَيت النظر إلى الجَمع، وأكملت الطريق باتّجاه جامع 17 رمضان ومنه إلى أمام فندق الشيراتون حيث وجدتُ سيّارة أجرة، ارتمَيتُ إلى جانب السائق ككتلةٍ صخرية هبَطت فجأةً من أعلى جبل، بعد أن أخبرتُهُ عن وجهتي نحو الكرخ.
– إلى شارع السفارات.
– أين في شارع السفارات؟
– بعد النفق، هناك تقيم أختي!
حقيقةً لا أخت لي في هذه البلاد أو خارجها، لكنّي لم أشأ إخبارَ السائق عن نيّتي الذهاب إلى السفارة الفلسطينية، فقد سمعت من بعض الصحافيين لحظةَ مروري بساحة الفردوس عن اعتداءات يمارسها العراقيون بحق الفلسطينيين في بغداد باعتبارهم كانوا مستفيدين من امتيازات خاصّة منحها لهم النظام الذي بدأَ يُعرَّفُ رسمياً «بالنظام السابق». راح السائق يكيل الشتائم لصدّام باعتباره مسؤولاً عن كلّ ما حدث، حالةٌ من الفوضى والعشوائية في كلّ شيء.
«البلاد تسير نحو مستنقعٍ كبير، بينما صدّام يظهر في الأعظمية لدقائق ثمّ يختفي، الجيش العراقي كأنّه مجموعةٌ من الأشباح التي طارَت»، قال السائق ثمّ بدأت الدموع تنهمر من عينيه.
سرَحتُ في الأفق البعيد حتى وصلنا إلى جسر السنك الذي كان مغلقاً بسبب وجود شبّانٍ عرب يحملون أسلحة كلاشنيكوف قديمة ويربطون رؤوسهم بشماغات حمراء وبيضاء، فعاد السائق إلى جسر الجمهورية. شبّاكُ السيّارةِ نصف مفتوح عن يميني، شعرتُ بأنَّ الريحَ تعوي في شوارع بغداد بينما ترتفعُ طائراتُ التحالف الدولي والهيليكوبترات على مقربةٍ من الأرض بطمأنينةٍ كاملة. في مدخل الجسر كانت سيّارة مدنية تحترق وجثث ساكنة في سيّارات أخرى، الجسر مغلق وسيطَرات أميركية في المكان تفتِّشُ المارّة رجالاً أو راكبي سيّارات. تحسَّستُ الورقة المطويّة التي دسستها في جيب جاكيتي الداخلي، كأنّني أتحسّس قطعة سلاحٍ مخفيّة في بلادٍ بدأت تغرقُ بالسلاحِ حتى أُذُنيها.
رواية "2003" لعبد الله مكسور صدرت مؤخراً عن دار نوفل-هاشيت أنطوان، ونقرأ فيها حكاية متخيّلة عن صدام حسين وألم الأسنان الذي دفعه للظهور من مخبئه أثناء اجتياح العراق
رتلٌ من الدبّابات الكبيرة يحتلّ خطّاً كاملاً من الشارع فوق الجسر بينما سمحت السيطرة في مدخل الشارع لبعض السيّارات بالمرور من ضفة إلى أخرى. دباباتٌ تلتصقُ بعضها ببعض، مجمَّع القصر الجمهوري يبدو واضحاً على طرف الجسر، جنودٌ من المارينز يتخِّذون وضعيات مختلفة في الرتل الطويل. هذه بغداد الجديدة التي تسير على إيقاع الرشّاشات الخارجة من فتحات الدبّابات العسكرية الأميركية.
الزمن يطول أكثر من المعتاد، هكذا تغدو الدقائق في مدينةٍ يسكنها الموت من الأرض والسماء، يهاجمها ويخترق أبوابها دون استئذان. قرّرت الذهاب إلى عبد الرحمن العايش أو كما يُحبُّ أن يُنادى باسمه الحركي «أبو الكرم». علاقتي به تعود إلى سنواتي الأولى في العراق، كبُرنا معاً، درسنا معاً، لقد وُلِد في بغداد ضمن الجيل الثالث من الفلسطينيين الذين قدِموا عام النكبة وقبلها. جدُّه الأول وصل إلى بغداد منفيّاً من فلسطين عام 1939 بعد إدانته بدعم الشيخ فرحان السعدي الذي أعدمته قوات الانتداب البريطاني وهو صائم. كثيراً ما كان العمّ أبو عبد الرحمن يتحدّث عن هذا الرجل وهو يشير إلى صورة تجمع الشيخ فرحان بالجدّ الأول مع آخرين في قضاء جنين، يحكي عنه بكثيرٍ من الاحترام والتقدير ويهاجم في ذات الوقت وجوه الحركة السياسية في فلسطين بذلك الزمان، الصورة نقلَها عبد الرحمن معه إلى بيتِهِ بجانب السفارة الفلسطينية بعد تعيينه فيها، كثيراً ما خضنا النقاشات حول تجربة السعدي كامتداد لحركة المقاومة الأولى التي قادها عزّ الدين القسّام من سوريا حتى فلسطين، التشابك الجغرافي، الزماني، المكاني، كله يفرِضُ نفسه في صورة واحدة تختصر مشهد اقتياد السعدي وهو في الثمانين من عمره نحو المِشنقة مواجهاً حبل الإعدام. قبل هذا المشهد بأسابيع اعتُقل جدّ أبو الكرم بعد الهجوم على قافلة إنكليزية في قرية المزار، دفعَ والده كثيراً من المال حتى يُخفَّف الحكم من الإعدام إلى النفي. لطالما ردّد والد أبو الكرم جملة قالتها جدَّته لابنها حين خروجه من البلاد كي تخفّف عليه من وطء الحدث:
– خلف الجسر سترى الجنّة.
ردَّ الابنُ يومها:
– هل ترينَ الجنّة بعدَ الجسر أم قبلَه يا أمّي؟
لم يترك الجدُّ الأول خلفه سوى بعض الحكايات التي تناقلها الأبناء في العائلة من جيل إلى جيل، وجَد أبو الكرم بعض الأوراق الصفراء التي كتب عليها الجدّ بقلم رصاصٍ كلمات بأحرف كبيرة في آخر أيّامِه ببغداد، أرادها الجدُّ حبلاً سريّاً يصلُهُ بهناك، رغم يقينه أنّه سيموت وسيُدفَنُ هنا في بغداد. ذاكرةٌ يُفرِغُها الرجلُ بكثيرٍ من الحرص، بشكلٍ قريبٍ إلى رسم المصحف، وكأنَّهُ يستعيد في داخله الطفلَ بكُتّابِ القرية، كثيرٌ من الكلمات ضاعَ مع الزمن لكنّنا استطعنا فكَّ بعض الرموز وربط القصص.
هذه البلاد لا تخاف من البشر الساكنين فيها وإنّما تخافُ من أحلامِ الشيطان القابعِ داخلهم، عشتُ فيها على هامشِ حياتِها بين ثنائيّتَي المواطن الصالح والطالح... فكيفَ وضعتني، قبلَ أن تُسدِلَ الستار على المشهدِ الأخير من حقبة عراق صدّام حسين، في واجهةِ الأحداث؟
يقول الجدّ في حكاياته التي تناقلناها بيننا:
«كنتُ في السابعة من عمري حين ضرب الجراد البلاد، جاء على شكل غيمةٍ كبيرة غطَّت السماء، وانقضَّ على الأرض، ضاعت المحاصيل واستولى الجراد على المخزون من الغذاء، جرَّبَ الناسُ كلَّ شيء للخلاص منه، أخذوا بكلِّ نصيحة، أذكر ذلك المهندس اليهودي الذي أتى من مصر لعلاج المسألة، طلبَ من الناس حفر الخنادق وملأها بقطعِ القماش والأكياس ثمّ إضرام النار فيها، كانت تلك المرة الأولى التي أرى فيها النار بهذا الشكل، لقد كان الجراد مثل قشرة الأرض كأنّه يحمل الشرار من النار على ظهره، لكنَّ النارَ أتت على المحاصيل التي نجَت من الجراد. كان عاماً قحطاً، جاع فيه الناس حتى صارت المرأةُ تُزوَّجُ على مهرٍ مقداره كيس من القمح. جيش السلطان كان مشغولاً بمعارك أخرى، وحدهم الضبّاط العرب في الجهادية كانوا يتواصلون مع الناس، أذكرُ اثنين منهم كانا برتبة رئيس، الأول اسمه رضا وقد تزوّج بعمّتي عليّة لأشهر قبل أن تبتلعه حياة العسكر، أمّا الثاني فكان اسمه حكمت، أُصيبَ بحروقٍ كثيرة في ظهره فمكَثَ أسابيعَ في الغرفة التي جمعت رضا وعمّتي، قبل أن يغيب الضابطان إلى الأبد بعد وصول أوامر من الوالي بضرورة الالتحاق بالجبهة».
يتقفى الكاتب أثر جده في مسيرته المتضاربة من خلال أوراقه التي تركها، على ضوء مستجدات المنطقة المشتعلة
كان لوقع هذا المقطع في عينيَّ حضورٌ كبير، فأيُّ الأقدار هذه التي تدفعُ بالبشر إلى دوائرَ لم تكن في حساباتهم أبداً، وكَم تتآمرُ الأيّامُ في ما بينها لتضعنا في تتاليها أمام معادلات صعبة، لقد كنتُ ذلك الحفيد الذي مرَّ جدّه الأول وزوج جدَّتِه نجوى بالعائلة الفلسطينية.
الغلاف الخلفي للكتاب
أميركا دخلت إلى العراق. الحرب قائمة. صدّام متوارٍ يدير العمليات من الكواليس. لكنه سيظهر فجأة ذات منتصف ليل في عيادة طبيب أسنان بسبب وجع في ضرسه، وسيشاهد من النافذة المطلّة على ساحة الفردوس انهيار تمثاله وحكمه. ولكن، قبل أن يغادر تلك العيادة، سيترك للطبيب ورقة شكر ممهورة باسمه ستكلّف الطبيب غاليًا في معتقلات الأميركان. رواية مكسور شيقة، تتجاوز سرد الوقائع لتغوص في ديناميات السياسة والقوى المتحكمة على أرض العراق، رجوعًا إلى جذور العائلات وصراعات المنطقة، من خلال بحثه في أوراق جده الذي شارك في الجيش العثماني، عملَ على تزويد البلدان العربية بالسلاح اللازم للمعركة المصيرية مع الاستعمار، أنشأ علاقات مع القيادة النازية آنذاك، ثم اضطلع في بيع أراضٍ للوكالة اليهودية في فلسطين.
يتقفى الكاتب أثر جده في مسيرته المتضاربة من خلال أوراقه التي تركها، على ضوء مستجدات المنطقة المشتعلة، وتطورات مصيره الشخصي الذي سيكون قاتمًا لا محالة على خلفية كل هذا. جيلٌ ضائع بأحلام ضائعة يسلّم بلادًا ضائعة لجيل جديد ضائع. رواية ثرية على المستوى التاريخي والسياسي، وممتعة على المستوى الشخصي لقصة بطلها.
...
عبد الله مكسور: صحافي وروائي عربي (مواليد سوريا-1983)، يعمل بالصحافة المرئيّة والمكتوبة منذ عام 2007، حائز على إجازة جامعية في الآداب والعلوم الانسانية، عضو في الاتّحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين البريطانيين، وفي نادي القلم الدولي ونادي القلم الفلاماني في بلجيكا، مدرّب دولي في الأمن والسلامة المهنية الصحافية وتغطية أماكن الصراع والتوتّر. يقيم في المملكة المتّحدة حيث يعمل منتجاً للأخبار في التلفزيون العربي. صدر له ستة أعمال روائية حتى الآن.
...
جميع الحقوق محفوظة لـنوفل-دمغة الناشر هاشيت أنطوان ©
الرواية متوافرة في أفرع نوفل-هاشيت أنطوان في لبنان، والعالم، ومتوافرة على نيل وفرات،. وأمازون كيندل.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.