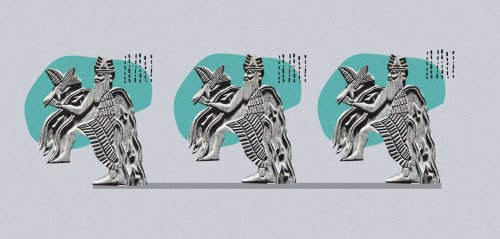رغم تيقن الإنسان الأول من وجود قوى غيبية مُطلقة قادرة على التحكم في مصائره وأقداره، فإن الأقدمين لم يفرقوا بشكل واضح بين الإلهي والبشري. كان هناك تماهٍ وتداخل بين الصنفين. يعبر عن ذلك ما ذكره المؤرخ الأمريكي ويل ديورانت في كتابه "قصة الحضارة". يشرح ديورانت المسألة فيقول:
"معظم الآلهة البشرية قد كانوا -في ما يظهر- عند البداية رجالاً من الموتى ضُخموا بفعل الخيال، فظهور الموتى في الأحلام كان وحده كافياً للتمكين من عبادتهم، لأن العبادة إن لم تكن وليدةَ الخوف، فهي على الأقل زميلته، وخصوصاً من كانوا أقوياء إبان حياتهم، فألقوا الخوف في نفوس الناس. هؤلاء يرجح جداً أن يُعبدوا بعد موتهم، ولذلك تجد الكلمة التي معناها (إله) عند كثير من الشعوب البدائية، معناها في الحقيقة (رجل ميت)، وحتى اليوم، ترى كلمة (Spirit) في الإنكليزية وكلمة (Geist) في الألمانية معناهما إما روح وإما شبح".
رغم تيقن الإنسان الأول من وجود قوى غيبية مُطلقة قادرة على التحكم في مصائره وأقداره، فإن الأقدمين لم يفرقوا بشكل واضح بين الإلهي والبشري. كان هناك تماهٍ وتداخل بين الصنفين
خلال البحث في تاريخ الثقافات الإنسانية نلاحظ أن هناك صوراً مختلفة للتداخل بين الحقلين الديني والبشري. وسنجد أن تصور كلِّ ثقافة لهذا التداخل كان رهيناً، بالمقام الأول، لطبيعةِ وظروفِ تطوّرِ كلِّ ثقافة.
الملك الإله في الحضارة المصرية القديمة
ظهرت الدولة المركزية في مصر في فترة مبكرة من عمر الحضارة الإنسانية. تمكن بعض الملوك الأقوياء من إخضاع الوادي والدلتا لسيطرتهم المطلقة، وتطلب الحفاظ على هذا الوضع اعترافَ الجميع بالشرعية المطلقة للملك الجالس على العرش.
كان ادعاء البنوة الإلهية الحلّ الأمثل للتأكيد على الشرعية الملكية. بشكل عام اعتقد المصريون القدماء أن ملوكهم أبناءُ للآلهة الكبرى مثل أوزير ورع وأمون. يقول الدكتور سليم حسن في كتابه "موسوعة مصر القديمة" موضحاً تلك النقطة: "وقد كان ملوك مصر منذ نهاية الأسرة الرابعة عندما يعوز الفرعون منهم المؤهلات التي تُبرِّر له ارتقاء عرش البلاد، يحتال في إيجاد حُجَج ترفعه إلى عرش الملك أمام أعين الشعب الذين كانوا ينظرون إلى الفرعون نظرةَ الإله، وأنه من دم إلهي خالص، أو بعبارة أخرى كان يُعدُّ ابنَ الشمس".
اعتادت القصة النمطية التي تكرر تصويرها كثيراً على جدران المعابد أن تبيّن أن الإله أمون قد أتى إلى زوجة الملك السابق، وأنه قد عاشرها جنسياً لتحمل منه بابن. سيصير هذا الابن في ما بعد ملكاً متوّجاً على البلاد. استمرت تلك التيمة -أن الملك ابن للإله- حاضرة حتى قدم الإسكندر الأكبر إلى مصر في القرن الرابع قبل الميلاد. سافر الإسكندر إلى معبد أمون في سيوة ،واعترف الكهنة ببنوّته لأمون، وبذلك حظي بالشرعية اللازمة لحُكم مصر.
"معظم الآلهة البشرية قد كانوا، في ما يظهر، عند البداية رجالاً من الموتى ضُخموا بفعل الخيال، فظهور الموتى في الأحلام كان وحده كافياً للتمكين من عبادتهم"... ويل ديورانت في "قصة الحضارة"
من جهة أخرى، اعتُبرت قصة الاسم الحوري من الدلائل القوية المؤكدة على اعتقاد المصريين القدماء بتماهي الإلهي مع البشري في شخص الملك المصري القديم. تحكي القصة التقليدية أن خلافاً على الحكم قد دبّ بين الأخين أوزير وست. كان أوزير ملكاً طيباً يحكم في سلامٍ وحكمة، بينما كان ست شريراً يريد أن يستحوذ على ما في يدِ أخيه. تمكّن ست من خداع أوزير، وأقنعه أن يستلقي في أحد التوابيت الخشبية. أغلق بعدها التابوت، ورماه في النيل. مات أوزير ولكنّ أرملتَه الوفية إيزيس لم تيأس، فتتبعت التابوت حتى عثرت عليه. ولمّا عرف ست قام بتقطيع جثة أخيه لعدد كبير من القطع، ووزعها في أقاليم مصر.
تتبعت إيزيس جميع القطع، وجمعت الجثمان، وتمكنت من إحياء زوجها بفعل بعض الطقوس السحرية، وحملت منه بابنها حورس، بينما اختار أوزير أن ينزل لعالمِ الموتى. تتحدث القصة على الصراع الذي اندلع بين حورس وعمّه، وأن الأول قد حكم مصر في نهاية الأمر بموافقة جميع الآلهة. حرص ملوك مصر على ربط أنفسهم بالإله حورس باعتباره الحاكم الشرعي على مصر. ظهر ذلك الحرص في أحد الأسماء الملكية الذي يُعرف باسم حورس أو الاسم الحوري. كان من المعتاد أن يكتب الملك اسماً له داخل السِرخ، وهو شكل لواجهة لقصر الملك. فوق هذا السِرخ رُسم الصقر الذي يرمز للإله حورس.
أنصاف الآلهة في تاريخ الإغريق والرومان
اختلف التصور العام للآلهة اليونانية والرومانية عن مثيله في الثقافات الإنسانية القديمة. لم تحظ تلك الآلهة بنفس الدرجة من التقديس والرهبة والتبجيل، ونُظر إليهم في الكثير من الأوقات بصفتهم مجرّدَ أسلافِ عظماء لليونانيين والرومان. من هنا لم يكن من الغريب أن يسود الاعتقاد بأن تلك الآلهة قد سكنت جبل الأوليمب على الأرض، وأنها لم تعش في السماء كما اعتقدت باقي الشعوب في آلهتها. نتج عن ذلك أن اليونانيين اعتقدوا أن التواصل بين الآلهة والبشر كان يحدث بسهولة ويُسر. ومن ثم عرفت الثقافة اليونانية مصطلح نصف الإله "Demigod" والذي يشير للشخصيات الأسطورية التي يكون أحد والديها إلهاً والآخر إنساناً.
يشرح ويل ديورانت الظروف التي ظهرت فيها أنصاف الآلهة عند اليونانيين، فيقول: "وكان يحدث أحياناً أن ينزل الإله ويتقمص جسمَ إنسان، فيستحيل هذا الإنسان إلهاً، وقد يتصل الإله جنسياً مع امرأة من الآدميين فتلد بطلاً- إلهاً، كما فعل زيوس مع أكمينا فوَلدت هرقل. وكان كثير من المدن والجماعات، وأبناء الحرف أنفسهم، يصلون أنسابهم ببطل من أبناء الآلهة، فكان أطباء اليونان مثلاً يصلون نسبهم إلى أسكلبيوس".
كان يحدث أحياناً أن ينزل الإله، في تاريخ الإغريق والرومان، ويتقمص جسم إنسان، فيستحيل هذا الإنسان إلهاً، وقد يتصل الإله جنسياً مع امرأة من الآدميين فتلد بطلاً-إلهاً كما فعل زيوس مع أكمينا، فولدت هرقل
ويوضح ديورانت حالة التماهي بين الآلهة والبشر في الثقافة اليونانية القديمة، فيقول: "ويمكن القول بوجه عام إن اليونان لم يكونوا يفرقون بين الآدميين والآلهة بقدر ما نفرق نحن بينهم؛ فقد كان كثير من آلهتهم لا يقلون في آدميتهم عن القديسين عندنا، اللهم إلا في مولدهم، وكانوا قريبين إلى عبادهم قرب القديسين إلينا. وكان بعضهم مثل ديونيسس يموتون وإن سموا بالخالدين".
في السياق نفسه، روجت الثقافة الرومانية لمفهوم أنصاف الآلهة؛ على سبيل المثال روجت الأساطير الرومانية لكون رومولوس (باني روما) وأخيه ريموس أبناءً لإله الحرب مارس من الكاهنة ريا سيلفيا المنحدرة من نسل المحارب الطروادي العظيم إينياس. كما أشاعت الأساطير أن باخوس إله الخمر هو ابن الإله جوبيتر من البشرية سيملي. من جهة أخرى عرف الرومان عبادة الأباطرة بوصفهم شخصياتٍ مقدسة بدءاً من زمن الإمبراطور الأول أغسطس. كان يتمّ تقديم القرابين لهم، ووضع تماثيلهم في المعابد. ونُظر لرفض تقديسهم على كونه نوعاً من أنواع الخيانة التي لا يمكن التسامح معها.
الكرستولوجيا: السؤال الأزلي في المسيحية
على النقيض من اليهودية التي فرقت بشكل صارم بين الإلهي والإنساني، بنت المسيحية عقيدتها الإيمانية على أساس أن اللاهوت والناسوت قد اجتمعا معاً في شخص يسوع الناصري. وأكدت المصادر المسيحية أن يسوع هو نفسه المسيح الموعود الآتي من نسل داود الملك، والذي انتظره اليهود طويلاً لتخليصهم من الضعف والهوان.
يؤمن المسيحيون أن الله تجسّد في المسيح، وأنه -أي الله- اختار أن يقدم نفسه كذبيحة مقدسة لخلاص البشر من الخطيئة التي لحقت بهم عندما أكل آدم -أبو البشر- من الشجرة المحرمة. من هنا فاللّه في المسيحية "إله واحد مثلث بقوام عقله (الأب) وكلمته (الابن) وروحه الذين هم الأب والابن والروح القدس".
شهد التاريخ الكنسي المسيحي الكثير من القضايا الإشكالية والجدلية التي تعلقت بترسيم العلاقة بين الأقانيم الثلاث وبين بعضهم عموماً، وبين الأب/الله والابن/المسيح على وجه الخصوص. كان السؤال حول حدود تماهي الإلهي والإنساني حاضراً بقوة في الوجدان المسيحي الجمعي، وحاول اللاهوتيون والكهنة أن يبحثوا عن إجابة قاطعة له في كل وقت. عُرفت مجموعة الدراسات والأفكار التي قُدّمت في سبيل الوصول لإجابة على ذلك السؤال باسم الكرستولوجيا. على سبيل المثال، ساد الجدل في القرن الرابع الميلادي حول أزلية الابن، وإذا كان قديماً مثله مثل الآب.
على النقيض من اليهودية التي فرقت بشكل صارم بين الإلهي والإنساني، بنت المسيحية عقيدتها الإيمانية على أساس أن اللاهوت والناسوت قد اجتمعا معاً في شخص يسوع الناصري
عُقد مجمع نيقية سنة 325م، واتفق المجتمعون على أن الآب والابن من طبيعة واحدة. في القرن الخامس تجدد الجدل من جديد، ذهب نسطور بطريرك القسطنطينية إلى أن المسيح ولد كواحد من البشر، وأنه تحول إلى إله عند العماد، وبقي على تلك الحالة حتى صلبه. تم رفض ذلك الطرح في مجمع أفسس سنة 431م، وتم التأكيد على الجوهر الإلهي ليسوع. تسببت كلُّ تلك المناقشات اللاهوتية في وضع القانون الذي يُعرف باسم قانون الإيمان المسيحي، والذي جاء فيه: "بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد، الله الأب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى.
نؤمن بربٍّ واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الأب قبل كلِّ الدّهور، نور من نور، إله حقّ من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للأب في الجوهر، الذي به كان كلّ شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. تأنّس وصلب عنا".
بين وحدة الوجود والتأليه المباشر لبعض الأعلام في تاريخ الإسلام
فرّق الإسلام بشكل صريح بين الإلهي والإنساني. وأكدت الكثير من النصوص المعتبرة على تنزيه الخالق والبعد عن تشبيهه بأي من المخلوقات. بالرغم من ذلك أشارت بعض النصوص القرآنية للروح الإنسانية بصفتها أمراً غيبياً مقدساً، وأنها من عند الله نفسه. على سبيل المثال ورد في الآية رقم 29 من سورة الحجر في سياق الحديث عن خلق آدم وبثّ الروح فيه: "فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ". يعلق فخر الدين الرازي (المتوفى 606هـ) في تفسيره المسمى "مفاتيح الغيب" على تلك الآية فيقول:
"ولَمّا أضافَ -يقصد الله- الرُّوحَ إلى نَفْسِهِ دَلَّ عَلى أنَّهُ جَوْهَرٌ شَرِيفٌ عُلْوِيٌّ قُدْسِيٌّ، وذَهَبَتِ الحُلُولِيَّةُ إلى أنَّ كَلِمَةَ (من) تَدُلُّ عَلى التَّبْعِيضِ، وهَذا يُوهِمُ أنَّ الرُّوحَ جُزْءٌ مِن أجْزاءِ اللَّهِ تَعالى، وهَذا غايَةُ الفَسادِ، لِأنَّ كُلَّ ما لَهُ جُزْءٌ وكُلٌّ، فَهو مُرَكَّبٌ ومُمْكِنُ الوُجُودِ لِذاتِهِ ومُحْدَثٌ. وأمّا كَيْفِيَّةُ نَفْخِ الرُّوحِ، فاعْلَمْ أنَّ الأقْرَبَ أنَّ جَوْهَرَ النَّفْسِ عِبارَةٌ عَنْ أجْسامٍ شَفّافَةٍ نُورانِيَّةٍ، عُلْوِيَّةِ العُنْصُرِ، قُدْسِيَّةِ الجَوْهَرِ، وهي تَسْرِي في البَدَنِ سَرَيانَ الضَّوْءِ في الهَواءِ، وسَرَيانَ النّارِ في الفَحْمِ، فَهَذا القَدْرُ مَعْلُومٌ. أمّا كَيْفِيَّةُ ذَلِكَ النَّفْخِ فَمِمّا لا يَعْلَمُهُ إلّا اللَّهُ تَعالى".
اعتمد الكثير من الصوفية على الآية السابقة في القول بما عُرف باسم وحدة الوجود، والتي تعني أن الله والطبيعة حقيقة واحدة، وأن الله هو الوجود الحق، وأن كلّ الموجودات والماديات ما هي إلا إعلان عن وجود الخالق دون أن يكون لها وجود قائم بذاته. من الأمور الشواهد التي تماشت مع ذلك المعتقد ما ورد في الحديث القدسي الوارد في صحيح البخاري: "... وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الَّذي يُبْصِرُ به، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها".
ذهب الكثير من الصوفية إلى أن الولي إذا بلغ درجةً عالية من درجات التقوى والطاعة أفاض الله عليه بعضاً من نفحاته الإلهية الربانية، والتي تظهر في جوارحه وحواسه المختلفة. يقول الصوفي الحسين بن منصور الحلاج (المتوفى 309هـ) معلناً عن تماهيه مع الحقّ:
أَنا أَنتَ بِلا شَكٍّ/فَسُبحانُكَ سُبحاني
وَتَوحيدُكَ تَوحيدي/وَعِصيانُكَ عِصياني
أَنا أَنتَ بِلا شَكٍّ/فَسُبحانُكَ سُبحاني
وَتَوحيدُكَ تَوحيدي/وَعِصيانُكَ عِصياني
أما الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي (المتوفى 638هـ)، وهو القائل بنظرية وحدة الوجود، فينشد في المعنى نفسه:
العبد ربٌّ والربُّ عبد
يا ليت شعري من المكلف
إن قلت عبدٌ فذاك ربّ
أو قلت ربٌّ فأنّى يكلف؟
على الجهة المقابلة، نجد أن هناك بعض الدعوات التي عملت على تأليه عدد من الشخصيات المهمة في التاريخ الإسلامي؛ على سبيل المثال قالت فرقة السبأية في القرن الأول الهجري إن علي بن أبي طالب لم يكن إلا الله نفسه، وأنه لم يمت، وإنما يعيش في السحاب: "وأن الرعد صوته والبرق سوطه". وقد أخذت تلك الفرقة اسمها من عبد الله بن سبأ، الذي يختلف الباحثون حول حقيقة وجوده التاريخي. أيضاً ظهرت فرقة الراوندية في بدايات العصر العباسي وتأثرت بالعقائد المزدكية، وقال أتباعها بأن الخليفة أبا جعفر المنصور هو نفسه الله عز وجل.
أما الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، فقد قيل إنه قد دعا الناس لتأليهه. يذكر ابن الجوزي (المتوفى 597هـ) في كتابه "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم": "زاد ظلم الحاكم وعن له أن يدعي الربوبية، فصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون له: يا واحدنا يا أحدنا يا محيي يا مميت!".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.