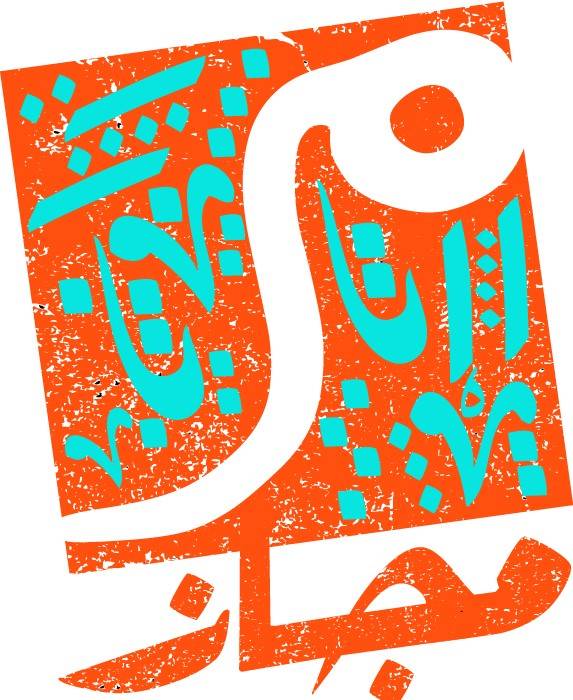 الحواس العاطلة
الحواس العاطلة
هناك سحرٌ في الأيدي، في اللّمس، وانتظار اللّمس.
المميّز في سينما "بريسون" أنّها تصل القطع الصّغيرة من المسافات والحبكة عبر اليدين. لذلك شاهدت كلّ أفلامه بلا أيّ وقت مستقطع. من بعده صارت لي طريقة جديدة في النّظر.
اعتدت دائماً التقاط النّاس من أعينهم، اكتشاف الرّغبة والرّهاب والحبّ والخوف واللّذة من هناك. بعد بريسون لم أعد أنظر إلّا صوب ذلك الجزء الصّغير الّذي يتحرّك في أجسامهم، اليدين. يمكنك أن تعرف كلّ ما تحتاجه من هناك. لماذا يبدأ كلّ شيء من هناك؟ المصافحة الأولى، طلب اليد لعقد القران، ممارسة الجنس الأولى واللّمسات الأولى، الوداعات والتّلويحة الأخيرة في المطار.
قد نستغني عن الجسد في هذا كلّه، ويمكن لليد القيام بالمهمّة بأكملها. هذا ما فعله بريسون بالتّحديد: تخلّى عن وظيفة الشّخصيّة وحوّل أفلامه السّاحرة إلى قصص أبطالها اليدين، هذا مخيف!
لم أكن أعرف أنّني قد أجد يداً تجعلني أفكّك حركتها بهذه التّفاصيل المملّة. كلّ الأيدي جميلة، كلّها تملك سحراً، ولكن تلك اليد كانت مختلفة. اليد التي اكتشفتها في العشرين وجعلتني أكتشف نفسي من خلالها. مثل الّذي يمرّر يده على جسدك ويشفي جرحاً غائراً. هذا ما فعلَتْه تماماً.
في العشرين يمكننا أن نصير كلّ ما يحلو لنا، وأن نكتشف ما لا يمكن أن نكتشفه قبلها بدقائق. ولكنّني لم أعرف أنّني سأحتفل بمرور هذه الدقائق من العمر بوحدة هائلة. بالعادة تصير وحيداً تماماً في الثّلاثين أو الأربعين، تكون قد صارت الوحدة تليق بك بكلّ صورها. ولكن هذه المدينة تحوّل مسار حيواتنا إلى المسار الّذي يحلو لها، لن تسألك عن التوقيت ولا عن قدرتك على تحمّل الفوارق التي تحلّ عليك فجأة. وربّما هي لعنة العشرين لا أكثر.
لماذا يبدأ كلّ شيء من هناك، من اليد؟ المصافحة الأولى، طلب اليد لعقد القران، ممارسة الجنس الأولى واللّمسات الأولى، الوداعات والتّلويحة الأخيرة في المطار... مجاز
في العشرين جعلتني بيروت ما يحلو لها. امرأة في زاوية البار تشرب البيرة وتدخّن سيدرز رفيع. أقلّب في الزّجاجة يميناً وشمالاً، أحاول الالتهاء بوحدتي وأدخّن سيجارة تلو الأخرى. أحاول تجاهل الدّوار المستمرّ، قهقهة الناس، جمعات الأصدقاء، ثرثرة الأحبّة من حولي والنّظرات المحدّقة بي من كلّ مكان. على الأغلب يتساءلون: "ماذا جرى لها؟".
ما الّذي جرى لي حتّى أجلس وحيدة إلى هذا الحدّ، أعدّ خساراتي، وأتحسّر عليها، كمن خسر كلّ شيء في لعبة قمار عابرة. لم أخسر في القمار، بل لم أمارسه يوماً. خسرت كلّ ذلك بلا الرّهان وبلا اللّعبة حتّى.
أحبّ الخميس هنا في بيروت، يذكّرني باللّحظة التي جلست فيها جوليا روبرتس فوق أرضيّة غرفتها وراحت تتلذّذ بالقيام بلا شيء. كان ذلك في فيلم eat, pray and love. هذه لذّتي في الخميس، ألا أفعل شيئاً. تركت عملي في الخميس، شربت الكثير من البيرة في الخميس، أحببت وتركت الكثير من الرجال في الخميس. ولكن عندما أقرّر أن أفعل شيئاً أزور الحانات المنفية. أجرّبها واحدة واحدة، مثل سائحة في بلاد العجائب.
أزور الحانات التي لم يسمع بها أحد والتي نسيها أصحابها حتّى، تلك التي تبدو فيها الكأس بسيطة، وطعمها خفيفاً، ولكنّني في ذلك الخميس اخترت حانة مختلفة في زاوية شارع بدارو الّذي صار ضيّقاً على حاله.
هذه لذّتي في الخميس، ألا أفعل شيئاً. تركت عملي في الخميس، شربت الكثير من البيرة في الخميس، أحببت وتركت الكثير من الرجال في الخميس
كانت منزوية ولكنّها تسطو على الشّارع بأكمله. ما إن دخلت حتّى استقبلتني فتاة في مقتبل عمرها، تصبغ شعرها باللّون الأحمر وترفعه عن وجهها بعناية. تستقبلني دائماً بالابتسامة ذاتها، لم تغيّر فيها تجعيدة. أبادلها الابتسامة وأنظر إلى البار مباشرة: هل ينظر إليّ رجل البار؟ ربّما قد نظر إليّ سابقاً ولم ألمح ذلك. إنّه من الرّجال السّريعين حتّى في مشيته، يبدو متخفياً أحياناً بقدرة هائلة بالسرعة. يلتقط كلّ شيء بلا دليل واضح لذلك. لو كان مجرماً متخفياً لنجح في ذلك. لا يمكن أن تدخل نملة إلى المكان إلا ويعرف بأمرها. هذه الأرض له، وهذه الطاولات له، وهذا البار كلّه له. وكان سيكون كلّ شيء عاديّاً لولا وجوده غير العادي. هو من يعطي المكان قيمته الغريبة. يجعل الحانة من الطراز الثقيل وكأنّها ملك لأدا كولمان أو جيري توماس الأميركي.
أتساءل عن المكان الّذي سأجلس فيه بالرّغم من أنّني في كلّ مرّة سأختار زوايا المكان. ما زال مكاني محفوظاً هناك وفي كلّ الأماكن التي زرتها مسبقاً. لم يجلس أحد على تلك الطاولة غيري. الطاولة وحيدة للغاية. وعندما أكون وحدي أجلس في نهاية البار حيث يمكنني رؤية الجميع، النّساء والرّجال، الوحيدين والأصدقاء، العشّاق والسّكارى والمتحرّشين.
كانت يداه تسكبان اللّذة، يحرّكهما بسرعة هائلة ولكنّها غير مزعجة. ينقل الـJin من يد إلى يد، ويخضّها جيّداً حتّى تصير جاهزة تماماً. يلعب بلذّتنا لعباً. ولا يتعنّى رفع ناظريه نحونا حتّى. شاب نقش وشماً دقيقاً على كفّيه. خيطان أحمران رفيعان مثل الدّم، أتخيّل جيّداً كيف يمكن أن تمتد تحت ثيابه الثّقيلة. تمشي فوق الشّرايين مثل صورة الـ3D لما وراء جلده.
أتأمل ثيابه جيّداً في كلّ مرّة، وأعرف أنّه لا يرتدي شيئاً عن عبث، بل يقضي ساعات محاولاً الظّهور علينا بهذا التّكوين؛ قميص منقوش وبنطلون قماشي عالي الخصر، مع حزام أسود عريض من الجلد الأصيل. يبدو مثل العصابات الحديثة التي نشأت في ضواحي أمريكا. حين يفتح البيرة يستقبلها في يده بخفّة هائلة، يرفعها من البرّاد الّذي يخفيه في زاوية ما ويضعها أمامي على البار.
أعرف أنّه في خميس قادم أريد أن أصنع فيلماً حزيناً للسينما من لقطة طويلة لأيد كثيرة. أمّا يدك الكبيرة فأريد أن أتركها للأنس فقط... مجاز
في تلك اللّحظة بالتّحديد أنسى أن أقدّم تشكراتي، أو أن أنظر في عينيه حتّى أعرف أين ينظر بالتّحديد. لكنّني أتابع يديه بهيامٍ عارفةً أنّ حركة يده ستدلّني جيّداً على موضع نظره. وفي كلّ مرّة لا يخيب ظنّي. إنّه ينظر إلى وجهي، وأحياناً إلى صدري لا محالة. أمّا اللّحظة المقدّسة من بين كلّ تلك اللّحظات فهي لحظة وضع اللّمسات الأخيرة على الكأس. يرشّ لحظاته رشّاً، ينتقي الفاكهة التي تبدو أكثر ترتيباً، ويضعها بملقطه الحديدي. يعطي الكأس نظرة سريعة ليتأكّد من رضاه عنه تماماً.
أكاد أؤمن أنّه قادر على رمي الكأس بأكمله وصنع واحد غيره إن لم يرض عنه تماماً. كؤوسه مختلفة وكأنّه يحترمها ويقدّسها وهي تبادله ذلك. لذلك طعمها مختلف، وتبدو لي كل الكؤوس من بعده عاديّة. صرت أعرف كيف تكون الكأس فنّاً يُشرب وليس فقط يُنظَر إليها. وصار يُخيّل لي مشهدنا نحن الاثنين مثل مشهد في فيلم كيشلوفسكي الشّهير عن التلصّص والحبّ. لقد ورثت كلّ شيء من هناك.
في عمر التّاسعة اكتشفت تعلّقي بوالدي. كما اكتشفت تفاصيل جسده التي تنعكس على جسدي. أصابع القدمين، شكلّ أصابع اليد، تكوينة الأظافر، النّمش الّذي يغطّي الكتفين. في يد والدي اليمنى عقدة بين اصبعيه، تبدو واضحة أكثر من أيّ شيء آخر. هي ذاتها في تلك اليد التي اكتشفتها. يداه تشبهان يديْ والدي تماماً، تذكراني بذات الأبوّة، بذات السّلطة، وبذات القوّة التي أرغب بفرضها عليّ بطريقة ما.
لا أعرف متى تبدأ عقدنا النّفسية بالتّراكم، ولكنّني أعرف أنّه في خميس مقبل أريد أن أصنع فيلماً حزيناً للسّينما من لقطة طويلة لأيدٍ كثيرة. أمّا يدك الكبيرة فأريد أن أتركها للأنس فقط، في خميس بعيد، حين نكبر وأجلس وحيدة أمام البار وتفتح لي البيرة بيدك الوحيدة، بيد والدي التي لم تعد وحيدة.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


