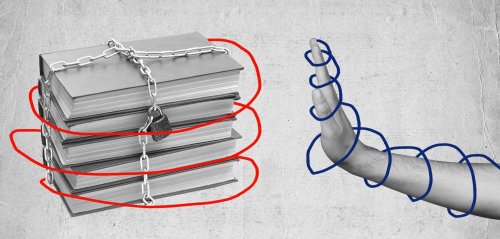حاسماً الجدل الذي رافق نهاية القرن التاسع عشر حول الدولة وتعريفاتها، حصر ماكس فيبر ماهية هذا التنّين متعدد الرؤوس، كما يصفه توماس هوبز، في كون الدولة "تجمعاً سياسياً يملك الحق في تنفيذ العنف الجسدي فوق إقليمها".
ومن هذا التحديد انبثقت مقولة "احتكار العنف الجسدي المشروع"، بوصفها تعريفاً لسلطات الدولة، وليس تبريراً للعنف ضد الشعب، إذ تحل الدولة محل حالات القوة الأخرى، على عكس السلطات المتعددة للعصر الإقطاعي: الكنيسة والملك والنبلاء، وفي ذلك تعريف مختصر للسيادة الحديثة.
وفي المعسكر المقابل للمدرسة الفيبرية، تتفق الماركسية التقليدية على تعريف مشابه للدولة من خلال حصرها في بعدها الطبقي، النابع أساساً من احتكار "جهاز الدولة القمعي" من طرف طبقة ضد بقية الطبقات.
لكن هذا الامتياز الحصري في استخدام العنف ضد السكان لم يكن دائماً بيد الدولة، وإنْ كان دائماً بيد الفئات/الطبقات/الأنظمة المهيمنة، ذلك أن التاريخ السياسي المعاصر حافل بنماذج "توكيل ممارسة العنف" من طرف الدولة لفائدة تشكيلات وهياكل موازية، في سبيل خدمة مصالح وسياسات القوى المهيمنة. وشيوع هذه الممارسة لم يكن بعيداً عن العالم العربي من خلال توظيف الميليشيات أو التشكيلات شبه العسكرية وشبه الأمنية، كما في سوريا وليبيا ولبنان، بوصفها نماذج معروفة، لكن قليلين مَن يعرفون أن هذا النمط من العنف كان شائعاً في تونس المعاصرة، وإنْ بدا بأساليب ذات خصوصية محلية، إلا أنه يشترك في كنهه الفاشي وخدمته لمصالح الفئات الحاكمة مع بقية النماذج العربية.
لجان الرعاية... الميليشيا الأم
في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، نجحت نخبة من قيادات الحزب الدستوري، القادمة من منابت اجتماعية تنتمي في أغلبها إلى صغار الفلاحين وصغار الكسبة والفئات الوسطى، بقيادة الحبيب بورقيبة، في افتكاك قيادة الحركة الوطنية من الاحتكار الأرستقراطي الذي مثله عبد العزيز الثعالبي ورفاقه من أبناء الأعيان.
وفي سياق شديد التأزم، نجح بورقيبة ورفاقه في إعادة بناء الحركة على نمط الأحزاب الأوروبية الحديثة من خلال ربطها بالشعب والقَطع مع "نضالية العرائض والوفود" التي كانت تُرفع للمقيم العام والملك، وتشكيل تنظيم حزبي ممتد وصحافة تحريضية وتشكيل "لجنة نظام"، أقرب في مهامها وهيكلها إلى الميليشيا المدنية، ربما تأثراً بشيوع الأفكار الفاشية في ذلك الوقت.
في مذكراته السجالية مع أستاذ علم الاجتماع المولدي الأحمر، يتحدث الوزير السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي الدستوري، وأحد الذين اتُّهموا تاريخياً بأنهم من قادة العمل الميليشيوي في تونس، محمد الصياح، عن الجذور التاريخية لميليشيا الحركة الوطنية، التي ستتحول بعد الاستقلال إلى ميليشيا الحزب الحاكم، ويقول: "قصة الميليشيا قديمة في تاريخ الحزب. إنها تعود إلى أحداث المؤتمر الاستثنائي لنقابة العمال التي كان يرأسها أبو القاسم القناوي في منتصف الثلاثينيات. ففي سنة 1937، أقيم بتونس مؤتمر استثنائي لهذه النقابة بمشاركة الحزب الدستوري الجديد، الذي أسسه بورقيبة قبل ببضع سنوات (1934). في ذلك الوقت، رأى بعض المناضلين أن القناوي رجل وطني مهم ساهم في إحياء النقابة التي أسسها محمد علي الحامي في العشرينيات، لكن مستواه الثقافي لم يكن يسمح له بفهم أبعاد تأسيس مثل هذا الإطار بالنسبة للحركة الوطنية، ورأوا بأن من المصلحة أن يرأس هذه النقابة مَن هو قادر على فهم تلك الأبعاد. وفي تلك السنة كان الهادي نويرة (قيادي في الحزب الدستوري) عائداً من فرنسا بعدما أنهى هناك دراسته في الحقوق، فالتفّ حوله المناضلون ورشحوه لرئاسة تلك النقابة. لكن القناوي انسحب وأراد إيقاف المؤتمر، فرفض المؤتمرون ذلك وواصلوا أشغالهم وانتخبوا الهادي نويرة على رأس تلك المنظمة. وإثر تلك الأحداث بدأت الصحافة الفرنسية تتحدث عن ميليشيا حزبية قامت بالانقلاب على المنظمة النقابية بتونس. أما كلمة ميليشيا فقد استوحتها الصحافة آنذاك مما كان يجري في إسبانيا خلال الحرب الأهلية، حيث انضم الكثير من المدنيين بعضهم إلى الجمهوريين والبعض الآخر إلى جماعة فرانكو الملكية فسُمّوا ميليشيات. ومن ثم بدأت الصحافة تتحدث عن ميليشيا حزبية يستعملها الدستوريون في نشاطهم السياسي وتقول إن ذلك يتم بإيحاء من الشيوعية العالمية".
لاحقاً، ومع اقتراب حصول البلاد على استقلالها النهائي، وخلال فترة الاستقلال الداخلي التي دامت عاماً كاملاً (1955)، شرع النظام الجديد في إعادة هندسة البلاد وفقاً لرؤية "الزعيم الواحد والحزب الواحد"، مدشناً عهده الجديد بحملة تطهير واسعة للمعارضة "اليوسفية"، وكانت بقيادة صالح بن يوسف الذي عارض شكل الاستقلال ومضمون اتفاقياته، وقادتها ميليشيا حزبية أطلق عليها اسم "لجان الرعاية".
ويشير الوزير الصياح، وهو إلى ذلك المؤرخ الرسمي لتاريخ الحركة الوطنية في عهد بورقيبة، إلى أن تشكيل هذه اللجان كانت له دوافع أمنية ملحة في ذلك السياق، إذ منعت اتفاقية الاستقلال الداخلي الحكومة التونسية من أن يكون لها جيش أو قوات أمن. وهكذا فإنه في الوقت الذي كان بورقيبة يحاول فيه إقناع الفرنسيين بالتعجيل بالموافقة على تكوين إطار أمني داخلي، كان وزير الداخلية يعمل دون أن تكون له أي قوات أمن تحت تصرفه.
إلا أن الوثائق التي كُشفت بعد سنوات ضمن تقارير "هيئة الحقيقة والكرامة" بعد الثورة، أكدت أن تأسيس "لجان الرعاية" منذ ربيع 1955 كان من بين أهدافه: "تنفيذ المداهمات والإيقافات بالتعاون مع القوات الفرنسية ضد المقاومين اليوسفيين خاصة إثر بروز الخلاف بين صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة حول شكل الاستقلال، الأمر الذي خلّف عدداً كبيراً من ضحايا التعذيب والتصفية الجسدية، مثل اغتيال المناضل مختار عطية، والاختطاف مثلما حدث لعبد الحميد الفقيه. ففي السياق ذاته تقرر تصفية صالح بن يوسف يوم 28 كانون الثاني (يناير) 1956 بعد مداهمة منزله وبتنفيذ من طرف لجان الرعاية مع قوات الأمن الفرنسية، إلا أن بن يوسف كان قد تمكن من الفرار قبل تنفيذ العملية باتجاه ليبيا، فتم اغتيال سائقه علي بن إسماعيل."
ميليشيا الحزب الواحد
استقرار الأوضاع لصالح بورقيبة بعد الاستقلال ودخول البلاد في حالة من "تأميم العمل العام" شملت حظر العمل الحزبي والصحف المستقلة، لم يمنع النظام من إعادة إنتاج ميليشيات حزبية موازية للجهاز القمعي، وعي عملية شهدت خلال الستينيات نمواً كبيراً، ليتوجه "الجهد الميليشيوي" نحو سياسات المراقبة والمعقابة التي استهدفت أساساً في تلك الفترة اليسار الطلابي في الجامعة وخارجها.
"قليلون مَن يعرفون أن نمط العنف الممارَس من خلال توظيف الميليشيات أو التشكيلات شبه العسكرية وشبه الأمنية كان شائعاً في تونس المعاصرة. وإنْ بدا بأساليب ذات خصوصية محلية، إلا أنه يشترك في كنهه الفاشي وخدمته لمصالح الفئات الحاكمة مع بقية النماذج العربية"
فقد بدأت ميليشيا الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم بتنفيذ عمليات "بلطجة" ضد طلبة اليسار الجديد إلى جانب مهام المراقبة والوشاية على نحو مستقل تماماً عن الجهاز القمعي الرسمي. ومن نماذج تلك الاستقلالية الغريبة ما يرويه وزير الداخلية في تلك الفترة، الباجي قائد السبسي، في مذكراته حول حادثة اختطاف نشطاء من الحزب الشيوعي المحظور: "في يوم 12 آذار (مارس) 1968 وبينما كنت في جلسة عمل مع الباهي الأدغم (رئيس الوزراء) بمشاركة محمود المسعدي (رئيس البرلمان) ومحمد الصياح تمهيداً لعقد ندوة للولاة، أعلمني مدير ديواني الأستاذ الحبيب عطية بتعرضه لعملية اختطاف من وسط المدينة وبأن مختطفيه نقلوه على متن سيارة لا تحمل لوحة أرقام. اتصلت مباشرة بالطاهر بلخوجة (مدير الأمن) للتأكد من أن مصالحنا لا علاقة لها بهذه العملية، فأكد لي ذلك، وقال إن الأستاذ زهير السافي قد اختطف أيضاً، واقترح عليّ تقصي الأمر في ‘نهج روما’ في إشارة إلى مقر الحزب. وكان الأستاذ السافي، الذي يرأس اللجنة التونسية للتضامن مع فيتنام، قد برز منذ شهريين بمناسبة الزيارة الرسمية التي أداها نائب الرئيس الأمريكي هيوبرت همفري إلى تونس، بنشر عريضة وقع عليها 162 من المدرسيين والمثقفين من أجل السلام في فيتنام، والمطالبة بالخصوص بإيقاف القصف الأمريكي فوراً والاعتراف بجبهة التحرير الوطني باعتبارها الممثل الشرعي لفيتنام الجنوبية. ولم تسبب هذه المبادرة حرجاً يذكر لدى الوفد الأمريكي بقدر ما أثارت من سخط لدى الرئيس بورقيبة الذي كان منحازاً كلياً إلى جانب الولايات المتحدة في حربها على فيتنام. كنت أعرف أن الحزب يلجأ في ظروف معيّنة إلى عمليات تخويف محدودة، بوسائله الخاصة، في الوسط الطلابي، حيث كان اليسار نشطاً جداً يتصدى بشدة للشباب الدستوري. كانت هذه التحركات تُصنَّف في خانة العنف الحزبي أو تصفية حسابات بين مجموعات من الشباب. اختليت بمحمد الصياح مدير الحزب لأقول له إنني علمت للتو أن الأستاذين زهير السافي والحبيب عطية قد تعرضا إلى عملية اختطاف في ظروف غامضة. وتبين لي أنه كان على علم بما جرى".
ومع تصاعد المعارضة اليسارية التي خرجت من أفقها الطلابي الضيق إلى العمل الشعبي من خلال التنظيمات السرية، ونجحت في وقت من الأوقات في السيطرة على الجامعة كلياً، خاصة بعد عام 1972 وفك الارتباط بين الاتحاد العام لطلبة تونس والحزب الحاكم، وجد النظام نفسه مجبراً على توسيع مجال عمل الميليشيا الحزبية داخل الجامعات، بوصفها الخزان الأساسي لليسار الجديد. وهنا، يتحدث الوزير محمد الصياح في مذكراته عن كواليس النقاشات داخل النظام حول السيطرة على الحركة الطلابية، مشيراً إلى أنه في في عام 1977 "تمت مناقشة اقتراح داخل الديوان السياسي للحزب الحاكم، الذي استشار وزير الداخلية الطاهر بلخوجة في إمكانية توفير العناصر اللازمة للقيام بمهمة حفظ الأمن في الجامعة، لكن هذا الأخير مانَعَ في ذلك متعللاً بأنه ليس لديه فائض من الموارد البشرية يمكن أن يكلفه بذلك. وردّ الهادي خفشة، وزير الدفاع، على الطلب متحججاً بأن الجيش لا يمكنه أن يقوم بحفظ الأمن في مثل هذه المؤسسات، وهكذا انتهى النقاش بأن يوفر الولاة الكادر المطلوب، وذلك من خلال قرار ممضي من طرف رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من وزير التربية".
لكن وجه الميليشيا الحزبية المكشوف لن يظهر إلا بعد سنوات، وتحديداً خلال الصراع بين النظام والاتحاد العام التونسي للشغل، في أعقاب إضراب كانون الثاني (يناير) 1978 وخلاله، حين لعب أعضاء هذه الميليشيا أدوراً مركزية في قمع الانتفاظة النقابية، سواءً من خلال ممارسة العنف المباشر أو عبر مهام الملاحقة والمراقبة والوشاية.
ويعترف محمد الصياح في مذكراته بوجود هذا الجسم القمعي الموازي دون أن يسميه ميليشيا قائلاً: "في عام 1978، خلال أحداث الإضراب العام للاتحاد العام التونسي للشغل تمت الاستعانة بشبان دستوريين بطلب من الديوان السياسي للحزب، الذي لاحظ أن قوات الأمن وحتى قوات الجيش لا تكفي لضمان تطبيق قانون حظر التجول الذي بدأ سريانه يوم 26 كانون الثاني (يناير) 1978 فاجتمع بمكتب الهادي نويرة (رئيس الحكومة) وقرر تكوين هذا الإطار الأمني الرديف، الذي سماه أعضاؤه ‘مساعدو أعوان الأمن’ وقد كان لهؤلاء لباس موحد ولا يمكن لهم التواجد في الشارع إلا بصحبة عون أمن مسلح".
مع صعود زين العابدين بن علي إلى السلطة (1987) أصبح النظام أكثر اعتماداً على أجهزته القمعية، إذ لم يعد يتحرج من قمع أي تحرك شعبي أو سياسي بالجهاز الرسمي للدولة، حتى وإنْ كان داخل أماكن كانت من المحرمات في عهد بورقيبة مثل الجامعات. لذلك، لم تعد لهياكل القمع الموازية والميليشيات الحزبية أدوار في ممارسة العنف بشكل مباشر، باستثناء بين عامي 1990 و1992، خلال الصراع بين النظام والحركة الإسلامية، والذي تشكلت خلاله ميليشيا حزبية جديدة تابعة للحزب الحاكم تحت اسم "لجان اليقظة" كانت مهمة أعضائها مشاركة رجال الشرطة في التصدي للتظاهرات ومراقبة أعضاء التنظيم الإسلامي، خاصة في المناطق الحدودية، حيث دأب الإسلاميون على التسلل هرباً من الملاحقة القضائية نحو ليبيا والجزائر.
وبعد استقرار الأوضاع، تفرّغت هذه اللجان، وعلى مدى عشرين عاماً، لممارسة مهام "المراقبة"، لا سيما في الأوساط الريفية والنائية والحدودية. وتشمل المراقبة مراقبة تجمعات المواطنين، حتى الاجتماعية منها كحفلات الأعراس وما يُقال فيها والمقاهي وغيرها من أشكال التجمع غير السياسي، ومراقبة العناصر المنشقة داخل المجتمع، كالمعارضيين والنقابيين وكل مَن تُشتمّ منه أي رائحة لرفض الوضع السائد.
أما في المدن، فقد شكّل النظام منذ بداية التسعينيات ما يعرف بـ"لجان الأحياء"، وهي المقابل المديني للجان اليقظة، ومهمتها الأساسية كما يصفها تقرير لوزارة الداخلية كشفته هيئة الحقيقة والكرامة: "الالتصاق اليومي والمباشر بحياة السكان والاستقطاب وربط علاقات حميمية مع السكان". وإلى حدود عام 2004، بلغ عدد هذه اللجان حوالي 353 وضمت 3563 عضواً، أنفقت عليها الدولة حوالي مليون ونصف المليون دولار، وفقاً لتقرير الهيئة.
روابط حماية الثورة: الوجه الإسلاموي
أنهت الثورة تماماً وجود الحزب الواحد، لكنها لم تنهِ سمات الحزب الحاكم، في نزوعه نحو الهيمنة والقضاء على الخصوم. بدلاً من شعار "الوحدة الوطنية" الذي كان يتذرع به النظام السابق للقضاء على أي تعدد فكري أو سياسي في البلاد، احتكرت حركة النهضة، الحزب الحاكم الجديد بعد 2011، تمثيل الثورة، أو حاولت ذلك، كي تثبت شرعية حكمها في مواجهة خصومها. لكنها في الوقت نفسه كانت فاقدةً للثقة تماماً بالأجهزة الرسمية للدولة، سواء أكانت إدارية أو قمعية، لذلك عملت منذ البداية على السيطرة على وزارة الداخلية، بوصفها الجهاز الأكثر قوة في البلاد.
"العنف الإلكتروني المنظم والمؤشرات الميدانية لعنف سياسي في طور التشكل يمكن أن تعيد مستقبلاً إنتاج أشكال جديدة من الميليشيات الموالية للنظام السياسي والداعمة له، في ظل تنظيم سياسي يتجه نحو ‘بناء قاعدي’ يقوم على حكم الحشود"
ولم تكتفِ الحركة الإسلامية بهذه التغييرات لإخضاع وزارة الداخلية وتحييد القيادات الأمنية التي تخشاها، وتخشى انقلابها على المسار الذي كان جارياً، بل عمدت إلى الحل السحري الذي لجأت إليه جميع الأنظمة السابقة وهو "العنف غير المؤطر داخل مؤسسات الدولة" من خلال خلق أجسام موازية غير أمنية لتقوم بمهام أمنية لا تريد أن تتورط فيها بشكل رسمي، أو يمنعها القانون المنظِّم للأسلاك الأمنية من القيام بها. ولعل أبرز هذه الأجسام "روابط حماية الثورة" التي كان يقودها عناصر تابعون لحركة النهضة تنظيمياً وفكرياً وتنسق عملها مع مكاتب الحركة أينما وجدت.
شكلت هذه الروابط التي وُجدت في أغلب المدن أداةً قمعية مناسبة للإسلاميين في ممارسة العنف ضد الخصوم دون الوقوع في الحرج، إذ شارك عناصرها في قمع أغلب التظاهرات التي خرجت في الفترة بين 2012 و2013 ضد حكومة حركة النهضة، جنباً إلى جنب مع قوات الأمن، بل إن الأمر وصل إلى مهاجمة مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل في كانون الأول (ديسمبر) 2012 في إطار الصراع مع المنظمة النقابية.
وبلغ الأمر أشده في تشرين الأول (أكتوبر) عندما قامت عناصر من هذه الروابط باغتيال لطفي نقضّ، منسق حركة نداء تونس، في مدينة تطاوين، جنوبي شرق تونس. كما مارست هذه الروابط أدوراً أمنية موازية للجهاز الأمني الرسمي، بعد أن كلفتها حركة النهضة، الحاكمة حينذاك، بالقيام بالمراقبة والتحري ضد شخصيات وتنظيمات وجمعيات، وقد كُشف عن هذا الدور بعد صفقة السلاح التي تورط فيها رجل الأعمال فتحي دمق في عام 2012.
هذا العمل الإسلامي الميليشيوي لم يكن جديداً. فحتى قبل أن تكون في السلطة، كان لحركة النهضة منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي خبرات تاريخية في تشكيل مجموعات شبه عسكرية/ أمنية، لكنها كانت دائماً تشكيلات ذات طابع سري، حملت أسماء عديدة منها "المجموعة الأمنية" و"الجهاز الخاص" و"مجموعة الإنقاض"، وكانت في عام 1987 قاب قوسين من السيطرة على الحكم بعد التخطيط لانقلاب عسكري فشل في الساعات الأخيرة بعد سيطرة بن علي على القصر الرئاسي ليلة السابع من تشرين الثاني (نوفمبر). كما تُتهّم الحركة حالياً بإدارة جهاز سري، هو امتداد لأجهزتها السرية القديمة، للسيطرة على أجهزة الدولة القضائية والأمنية والاقتصادية، وما زال هذا الملف حتى اليوم منشوراً أمام القضاء ومن بين المتهمين فيه رئيس الحركة راشد الغنوشي بوصفه قائداً لهذا الجهاز.
حُراس الرئيس: أول العنف إلكترونياً ثم ينهمر
هل توجد ميليشيات موالية للرئيس قيس سعيد اليوم؟ لا يمكن القطع بإجابة شافية على هذا السؤال حتى اليوم، ذلك أن سعيد ما زال بالكاد لم ينهِ عامه الأول في الحكم منفرداً بلا شركاء، بعد انقلاب 25 تموز (يوليو) 2021 شبه الدستوري.
لكن العديد من المؤشرات توحي بأننا سائرون إلى إعادة إنتاج حالة من الحشود الموالية، ذات السلوك الفاشي، يمكن أن تتحول إلى مجموعات/ ميليشيات في يد النظام السياسي لتصفية الحسابات مع الخصوم، دون توريط الجهاز الأمني الرسمي. وبدت هذه المؤشرات واضحة خاصة خلال العام الحالي بعد أن طرح قيس سعيد برنامجه للمرحلة الانتقالية، وضمنه الاستفتاء على الدستور الجديد، وما رافقه من تشكّل جبهات معارضة تدعو لمقاطعة المسار والاستفتاء. فقد دأب أنصار الرئيس على مهاجمة تجمعات المعارضة في الشوارع وإطلاق الشتائم وشعارات التخوين ضدها، على النحو نفسه من ممارسات روابط حماية الثورة في عهد حكم حركة النهضة الإسلامية.
لكن الملمح الأبرز لنشاط "أنصار الرئيس" وحُراس صورته السياسية هو العمل المنظم لهم في إطار مجموعات أو ميليشيات إلكترونية ذات نزوع فاشي واضح تهاجم كل خصوم الرئيس وتصادر أي آراء تختلف مع رؤيته السياسية وتتصيد المخالفين والمعارضين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال آليات قمعية كالتشهير والفضح والشتائم وإطلاق أوصاف الخيانة والعمالة واحتكار الصفة "الوطنية"، وهي ترجمة للخطاب العام والأساسي للرئيس نفسه الذي يقوم على مخاطبة الشعب بوصفه وحدة معنوية متماسكة وتقسيم السكان إلى أغلبية شعبية "وطنية صادقة" وأقلية نخبوية "خائنة وفاسدة"، وهي السمات الكبرى لأي خطاب شعبوي.
هذا العنف الإلكتروني المنظم والمؤشرات الميدانية لعنف سياسي في طور التشكل يمكن أن تعيد مستقبلاً إنتاج أشكال جديدة من الميليشيات الموالية للنظام السياسي والداعمة له، في ظل تنظيم سياسي يتجه نحو "بناء قاعدي" يقوم على حكم الحشود.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.